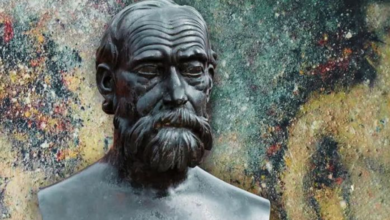التديُّن ومقام العرفان
د. إدريس غازي
يختص المتدين في مساره التعرفي بالتحقق بمقام العرفان؛ «إذ أفضل أوصاف الإنسان العرفان، وأفضل العرفان معرفة الديان؛ لأمرها بكل إحسان، وزجرها عن كل عدوان».([1])
والعرفان بوصفه فعلا تعرفيا بانيا للممارسة الدينية، يختص بالأوصاف التالية:
1.1. التذكر:
يقتضي العرفان بوصفه فعلا تذكريا، أن المتدين يستحضر حقيقتين وجوديتين تبرران فعله التذكري وهما:
ـ ازدواجية الوجود الإنساني: حيث إن الإنسان يتواجد في عالمين: عالم مرئي هو عالم الشهادة، وعالم غير مرئي هو عالم الغيب.
ـ فطرية المعاني الدينية: حيث إن الإنسان يختزن في ذاكرته الروحية معاني الدين وقيمه، فالإنسان خلق «على هيئة تحفظ سابق صلاته بعالم الغيب، بحيث تحمل روحه قوة خاصة أشبه بذاكرة سابقة على ذاكرته التي يملكها في العالم المرئي، وهذه القوة الروحية التي تحفظ عالم الغيب أو قل الذاكرة الغيبية أو الأصلية اختصت في الإسلام بمصطلح الفطرة».([2])
والمتتبع لمعاني التذكر في الاستعمال القرآني يجد أن من معانيه إقامة التدين على مقتضى الفطرة الإلهية المحفوظة في ذاكرة المتدين الغيبية، والاجتهاد في تبين «وجوه حضورها في عالم الشهادة، حتى يجعل منها قوام حياته في هذا العالم، فترتسم في ذاكرته المرئية ارتسامها في ذاكرته الغيبية»([3]).
أما المعاني الروحية الفطرية المحفوظة في الذاكرة الغيبية للمتدين، والتي يسعى إلى استحضارها وتنزيلها في عالمه المرئي([4])، فتنتظم إجمالا في الأصول التالية:
- أصل الألوهية؛
- أصل الوحدانية؛
- أصل التعبد للإله الواحد.
وهي حقائق إيمانية جامعة تحقق بها الإنسان في عالم غيبي هو عالم الميثاق، حيث أخذ الحق سبحانه وتعالى على خلقه العهد بحفظ هذه الأصول، والإقرار الإجمالي بمقتضياتها، إذ قال سبحانه: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (172)أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، (173) كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون (174)﴾[الأعراف، الآيات: 172-173-174]، فأصل الألوهية يوجب الإقرار بوجود الله سبحانه، وأصل الوحدانية يقتضي الشهادة بوحدانية الله تعالى، وأصل التعبد للإله الواحد يوجب إقامة التعبد وفق إرادة المعبود الواحد وشرعه.
إن الأصول الإيمانية المقررة في عالم الميثاق هي التي ورد الأمر باستحضارها وتذكرها بوصفها نعما وأفضالا ربانية في سائر الشرائع المنزلة، وخاصة في الوحي الخاتم، حيث قال تعالى:﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور ﴾ [المائدة، 8].
وإذا كان دين الإسلام هو الطور الخاتم من أطوار الوحي الإلهي، فإن تنزيل المتدين لمقتضياته في عالم الشهادة معناه التحقق بمراتبه الثلاث الجامعة لمبانيه وأركانه وأصوله، أي للإسلام والإيمان والإحسان،«فمباني الإسلام خمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمدا ﷺ عبده ورسوله، وهما كواحدة؛ لاتصال إحداهما بالأخرى في الوجوب والحكم، وإقام الصلوات الخمس، وهي كواحدة منها؛ لتعلق كل واحدة بصاحبتها، وإيتاء الزكاة، وهي كالصلاة؛ لاقترانها بها والاشتراط بها، وصوم رمضان، وحج البيت، وهما كشيء واحد من الفرض، فهذه الخمس كواحدة منهن في إيجاب العقد واعتقاد الوجوب، وإن اختلف الحكم في سقوط فعل بعضها بشرط»([5]).
وأما الإيمان فأركانه سبعة: «الإيمان بأسماء الله وصفاته، والإيمان بكتب الله تعالى وأنبيائه، والإيمان بالملائكة والشياطين، والإيمان بالجنة والنار، وأنهما قد خلقتا قبل آدم ﷺ، والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها، حلوها ومرها، وأنها من الله تعالى قضاء وقدرا، أو مشيئة وحكما، وأن ذلك عدل منه، وحكمة بالغة، استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها، لا يسأل عما يفعل، ولا تضرب له الأمثال بملزمات العقول، وتمثيلات المعقول، تعالى عن ذلك علوا كبيرا (…) والإيمان بما صح من حديث رسول الله ﷺ، وقبول جميعه، وافتراض طاعته وأمره على العباد والتزام ذلك؛ إذ قد جعل الله تعالى طاعة رسول الله ﷺ من شرط الإيمان، وقرنها بطاعته»([6]).
وأما الإحسان فمداره على تحقيق الإخلاص في العبادة، وإيقاعها على مقتضى مراقبة المعبود سبحانه ومشاهدته([7])، وذلك لأن «للعبد في عبادته ثلاث مقامات: الأول: أن يفعلها على الوجه الذي يسقط معه التكليف، أي مستوفاة الشرائط والأركان، الثاني: أن يفعلها كذلك وقد استغرق في بحار المكاشفة حتى كأنه يرى الله تعالى، وهذا مقامه ﷺ كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والثالث أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده، وهذا هو مقام المراقبة، فقوله: (فإن لم تكن تراه)، نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة، أي: إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية فاعبده وأنت بحيث إنه يراك، وكل من المقامات الثلاث إحسان، إلا أن الإحسان الذي هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول، لأن الإحسان بالأخيرين من صفة الخواص ويتعذر من كثير»([8]).
وبفضل مقام الإحسان يتحقق للمتدين النزول في مراتب الدين واستجماع الاتصاف بكمالاته، قال العلامة الطيب بن كيران عند قول العلامة ابن عاشر:
| وأما الإحسان فقال من دراه إن لم تكن تراه إنه يـــراك |
أن تعبـد الله كأنـك تــــراه والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك |
«(وأما الإحسان فقال) في تفسيره (من دراه)، أي عرفه وهو النبي ﷺ الذي هو أعلم الخلائق بحقائق الأشياء على ما هي عليه، هو (أن تعبد الله) مشاهدا له ببصيرتك، حتى (كأنك تراه) ببصرك، فتقصر وجهتك عليه، وتستغرق نظرك فيه، إذ محال أن تراه وترى معه سواه، وهو مقام الفناء في التوحيد، (إن لم تكن تراه) هذه الرؤية لقصورك عنها، فراقبه بأن تستحضر اطلاعه عليك، وإحاطة علمه بأحوالك الظاهرة و الباطنة، فـ(إنه يراك) من حيث لا تراه»([9]).
وقال العلامة سيدي إدريس الوزاني: «فأشار ﷺ إلى الأصل الذي يثمر تلك الآداب([10]) التي هي روح العبادة والمقصود منها، ولذا قيل مقام الإحسان يجري في العبادة مجرى الأرواح في الأجساد، وعليه تدور مقاصد الصوفية»([11]).
2.1. التعبد:
يقتضي العرفان بوصفه فعلا تعبديا، أن المتدين يتقرب إلى المعبود سبحانه بإقامة الاشتغال التعبدي على مقتضى الموافقة لإرادة الشارع المتجلية في تكاليفه الشرعية، والمتدين في تقربه هذا لا يعدو كونه مستحضرا لما أودع في فطرته من معاني التعبد، إذ التعبد فعل فطري قائم بالإنسان قيام الأصول الإيمانية التوحيدية في ذاكرته الأصلية.
وينبني الاشتغال التعبدي لدى المتدين على قاعدة إقامة الفرائض والإتيان بالنوافل سواء في صورتي الأمر أوالنهي، وهذه الأعمال التعبدية هي قربات يتحصل بها التقرب والسير في مدارج العبودية، وتتعلق بها سعادة العبد وصلاحه قلبا وقالبا، «إذ سعادة الإنسان في معرفة الديان، وطاعة الرحمن بفعل ما أمر به في السر والإعلان، وترك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان، مما يتعلق بالقلوب والأبدان، فنبدأ بإصلاح القلوب، فإنها منبع كل إحسان، وكل إثم وعدوان، فإن القلب إذا صلح بالمعرفة والإيمان، صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان، وإذا فسد القلب بالجهل والكفران، فسد الجسد كله بالمعاصي والطغيان.
وصلاح القلوب ضربان:
أحدهما: قاصر كالمعرفة والإيقان.
والثاني: متعد كإرادة الجود والإحسان.
وصلاح الأجساد ضربان:
أحدهما: قاصر كالركوع والسجود.
والثاني: متعد كالعفو والجود.
وفساد القلوب ضربان:
أحدهما: قاصر كالشك والشرك.
والثاني: متعد كإرادة البغي والعدوان.
وفساد الأبدان ضربان:
أحدهما: قاصر كترك العبادات القاصرة.
والثاني: متعد كالنميمة والبهتان.
ومن لطف الرحمن أنه لم يأمرنا إلا بما فيه مصلحة في الدارين أو في إحداهما، ولم ينه إلا عما فيه مفسدة فيهما أو في إحداهما. والمصلحة لذة أو سببها، أو فرحة أو سببها. والمفسدة ألم أو سببه، أو غم أو سببه، فإن اشتمل فعل على مصلحة ومفسدة، فالعبرة بأرجحهما، فإن استويا فقد يخير بينهما، فانحصر الإحسان في جلب المصالح الخالصة أو الراجحة، وفي دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة، وانحصرت الإساءة في جلب المفاسد الخالصة أو الراجحة، وفي دفع المصالح الخالصة أو الراجحة»([12]).
وبالنظر إلى تفاصيل وجزئيات القربات والأعمال التي يتحقق بها الاشتغال التعبدي، والتي نص عليها الإسلام إجمالا وتفصيلا، يمكن تبين أصولها الجامعة فيما اصطلح عليه الشارع بالمباني والأركان الخمس: وهي الشهادتان، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، فهي قوام الاشتغال التعبدي لدى المتدين، وإنما اعتبرت هذه القواعد الخمس أصول الاشتغال التعبدي وجوامعه لأمرين:
أحدهما: لاتفاق سائر الشرائع على كلياتها، وكونها من الحقائق الكونية التي لازمت الإنسان في سائر أوضاعه وأطواره، وهذا ما أشار إليه شاه ولي الله الدهلوي بقوله: «وقد بين النبي ﷺ في حديث: (بني الإسلام على خمس) (…) أن هذه الأشياء الخمسة أركان الإسلام، وأن من فعلها ولم يفعل غيرها من الطاعات قد خلص رقبته من العذاب، واستوجب الجنة، (…) وإنما خص الخمسة بالركنية؛ لأنها أشهر عبادات البشر، وليست ملة من الملل إلا قد أخذت بها والتزمتها، كاليهود والنصارى والمجوس وبقية العرب على اختلافهم في أوضاع أدائها، ولأن فيها ما يكفي عن غيرها، وليس في غيرها ما يكفي عنها، وذلك لأن أصل أصول البر: التوحيد، وتصديق النبي، والتسليم للشرائع الإلهية»([13]).
وثانيهما: أن على هذه القواعد الخمس مدار سائر فصول التعبد وجزئياته، وإحكام الاشتغال بها لدى المتدين محقق لإقامة فروعها من وظائف التعبد على الوجه الأحْكَم، ولذلك نجد من العلماء من اكتفى بإفراد هذه الأركان بتتبع أسرارها وآدابها دون غيرها من فروع الأعمال الشرعية؛ لحاظا منه لهذا الاعتبار، يقول الإمام الشعراني: «وإنما قصرنا الآداب والأسرار على أركان الإسلام دون غيرها من الزوائد الواردة في الشريعة؛ لأن هذه الخمسة هي الأساس الذي تبنى عليه سائر الأحكام، فإذا أحكم المريد آدابها، وراعى أسرارها، ترقى منها إلى فروع الشريعة وتوابعها. وإن لم يحكم آدابها فهو واقف، ولو عبد الله إلى قيام الساعة»([14]).
يختص الاشتغال التعبدي بالأوصاف التالية:
أ. الموافقة الكونية:
والمقصود بها أن في إقامة المتدين للتعبد تحقيقا لأمر أصلي فطرت عليه سائر المخلوقات والأكوان، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات، الآيات: 56-57-58]. فالإنسان يوافق الموجودات على اختلاف أجناسها ومراتبها في كون الخلق إنما هو لمقصد التعبد لله سبحانه وتعالى، وإقامة التعبد وتحقيقه يختلفان بحسب اختلاف الأوضاع الوجودية والاستعدادات الخلقية لكل مخلوق: ﴿ ألَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَٰفَّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [النور، 41]، مع الاشتراك في المعنى الكلي الأعم، وهو مطلق إقامة التعبد للحق سبحانه خوفا ورجاء ومحبة([15])، ومن شأن الإخلال بنظام التعبد، إِن بإقامته بغير ما أراد المعبود، أو بالتنكر للمعبود رأسا على سبيل الكفر، الإخلالُ بناموس الوجود، والخرق لما وضع عليه العالم من التعبد لله عز وجل. يقول الإمام الشعراني في شأن الصلاة باعتبارها عماد الدين ورأس العبادات: «إن الوجود كله بأجزائه كلها، دائم الصلاة لله تعالى بدوام وجوده، لا ينفك عن الصلاة طرفة عين، فإنه في مقام العبودية لله تعالى في كل وقت ونفس، فمن أدمن النظر رأى الوجود كله ظاهرا وباطنا مصليا: ﴿ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً﴾ [الإسراء، 44]، ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد، 16]، فمن ترك الصلاة فقد خالف الخليقة كلها، وأخل بنظام العالم»([16]).
ويقول عن الزكاة: «إن الوجود كله إذا نظرته بعين الاستبصار وجدته متعبدا لله تعالى بالزكاة، كما هو متعبد بجميع شرائع الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران، 82]، وإذا نظرت إلى الأرض التي هي أقرب الأشياء إليك وجدتها تعطي أقرب الخلق إليها، وهم الذين على ظهرها، جميع بركاتها، لا تبخل عليهم بشيء مما عندها في فصول العام كلها. وكذلك النبات يعطي ما عنده تشبها بأصله وهو الأرض في الظاهر، وكذلك جميع أنواع الأشجار، وكذلك الحيوان، وكذلك البحر والسماوات والأفلاك والشمس والقمر والنجوم، والكل متعاون بعضه مع بعض، لا يدخر شيئا من قوته وما عنده في طاعة الله؛ لأن الوجود كله فقير بعض إلى بعض، قد لزمه الفقر، وشملته الفاقة، فعطف بعضه على بعض، وتعاونه في طاعة الله، وإعطاء ما عنده هو زكاته دائما بدوام وجوده. فمانع الزكاة قد خالف أخلاق الرحمن، وأخلاق أهل السماوات والأرض، وجميع المخلوقات والموجودات، وباين الفطرة»([17]).
وقال في شأن الصوم: «إن اعتبار الصوم عام في الموجودات كلها، قد شملها جميعا، فإن الصوم من معانيه، إمساك جميع الموجودات وتقييدها عن الخروج عن وظائفها التي قيدت لها، فإذا نظرت إلى الموجودات كلها وجدت كل واحد منها قد لزم ما قيد به، وأمر به. فترى الثقيل قد أمسك في مقامه لا ينتقل، والخفيف لا يصعد من مقامه، فكل شيء مزموم بزمام الأمر، وممسوك بإمساك الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وذلك صيام كله في حق كل موجود مما يناسب كل موجود: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران، 82]، ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران، 19]، ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران، 84]؛ لأنه دين الله الذي افترضه على جميع خليقته، وفطرته التي لن تجد لها تبديلا أو تحويلا. فصوم العالم ضبطه نفسه، وإمساكه ذاته بانحيازه إلى بارئه سبحانه وتعالى، خضوعا لحكم الأمر طوعا أو كرها، والانقباض عن أن يسترقه شيء غير الله تعالى. وهذا إذا نظرته بحقيقة النظر وجدته عاما في جميع جواهر العالم كله، كونا وشرعا، وحالا ومقالا»([18]).
ب. القصدية:
يختص الاشتغال التعبدي باعتباره فعلا اختياريا للمتدين([19]) بخاصية الانبناء على القصد، و القصد إجمالا سلوك إرادي ناشئ عن معنى شعوري يعد مبعث سائر أعمال الإنسان وتصرفاته الظاهرة والباطنة([20]).
وهذا المعنى اصطلح عليه بالإرادة([21])، أو النية([22])، أو القصد([23])، وهو المعنى الذي يتعين على المتدين -في إقامة الاشتغال التعبدي- حفظه وتعهده بالرعاية قصد تحصيل التوجه فيه، وصرف قوادح الإرادة عنه كالسهو واللهو والغفلة.
وباعتبار القصد معنى شعوريا ينبني عليه توجيه الاشتغال التعبدي، فإن هذا التوجيه لا يتحقق إلا باستيفاء الضابطين المقصديين التاليين:
- تحصيل الصفة الامتثالية:
ومقتضاها أن المتدين باعتباره مكلفا مطلوب بتحري قصد الشارع في إقامة التعبد، بحيث تجري تصرفاته على مقتضى الموافقة الشرعية، وإذ ذاك يتحصل للمتدين تعبد جامع لأوصاف التسديد، وذلك لأن «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع، والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة، إذ قد مر أنها موضوعة لصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. ولأن المكلف خلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة -هذا محصول العبادة- فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة»([24]). ولأن مقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء إخراج الإنسان عن دواعي الأهواء، والتحقق بالعبودية الخالصة لله عز وجل، والقاعدة أن «كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق، من غير التفات إلى الأمر والنهي أو التخيير فهو باطل بإطلاق، لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل، فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق، لأنه خلاف الحق بإطلاق، فهذا العمل باطل بإطلاق (…)، وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر أو النهي أو التخيير فهو صحيح وحق؛ لأنه قد أتى به من طريقه الموضوع له، ووافق فيه صاحبه قصد الشارع، فكان كله صوابا، وهو ظاهر»([25]). ولأن في بناء الأعمال على مجرد الأهواء والاسترسال في الشهوات، دون اعتبار الإذن الشرعي ومراعاة مقاصده، مظنة للابتداع الصريح، والحرمان من التوجيه الصحيح، فيكون هذا البناء الفاسد سببا في دخول مفاسد وآفات خلقية على المتدين كالرياء، وقد يتأدى به الأمر إلى التحلل من ربقة التكليف جملة، والانقلاب من التعبد لله تعالى إلى التعبد للطاغوت.([26])
- تحصيل الصفة التجردية:
وحاصلها أن المتدين في مسعاه التعبدي مطلوب بتخليص قصده من شوائب الأغراض والحظوظ الملابسة لقصده التعبدي، والتي تعكر على صفو إرادته و تلبس على توجهه، وليس تحصيل التجرد في القصد إلا الاجتهاد في التخلق بخلق الإخلاص، ودرء قوادحه التي يعتبر الرياء أشدها قدحا في خلوص نية المتعبد وقصده.
وإذا كان مبنى الإخلاص على تجريد النية من الشوائب وإفراد القصد عن العلائق، فإن حقيقته تقابل الإشراك؛ إذ «الإخلاص يضاده الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك، إلا أن الشرك درجات، فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية، والشرك منه خفي ومنه جلي وكذا الإخلاص. والإخلاص وضده يتواردان على القلب، فمحله القلب، وإنما يكون ذلك في القصود والنيات. وقد ذكر حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث، فمهما كان الباعث واحدا على التجرد، يسمى الفعل الصادر عنه إخلاصا بالإضافة إلى المنوي، فمن تصدق وغرضه محض الرياء فهو مخلص، ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص. ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب»([27]).
وإذا كان قصد التقرب لدى المتدين قد لا يتخلص له تمام التخلص، بفعل الشوائب والعوارض التي لا تنفك عنه وتشوش عليه، ولأن الإخلاص «قلما يستيقنه العبد من نفسه وإن بالغ في الاحتياط»([28])، فإن المتدين مطلوب «أن يكون أبدا بعد كمال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول، خائفا أن تكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من ثوابها. وهكذا الخائفون من ذوي البصائر، وهكذا ينبغي أن يكون كل ذي بصيرة»([29]).
إن من مقتضى تحقيق الإخلاص في التعبد، أن يتعهد المتدين نيته بالتحسين والتكثير والتنمية المتواصلة، فلا يقتصر في العمل التعبدي الواحد أو الطاعة الواحدة على النية الواحدة، بل يقوم بتعديدها وتجديدها حسب الإمكان، مما يكون سببا في تزكية العمل وقبوله عند الله تعالى، وفي هذا السياق يقول أبو عبد الله محمد بن الحاج: «الإخلاص إنما يكون بالقلب، وذلك أن لابن آدم جوارح ظاهرة وجوارح باطنة، فعلى الظاهرة العبادة والامتثال، وهو قوله تعالى: ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله ﴾ [البينة، 5]، وعلى الباطنة أن تعتقد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله مخلصة في ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿ مخلصين له الدين﴾ [ البينة، 5]، فالأصل الذي تتفرع عنه العبادات على أنواعها هو الإخلاص، وذلك لا يكون إلا بالقلب، فعلى هذا الجوارح الظاهرة تبع للباطنة، فإن استقام الباطن استقام الظاهر جبرا، وإذا دخل الخلل في الباطن دخل في الظاهر من باب أولى، فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن تكون همته وكليته في تخليص باطنه واستقامته، إذ أن أصل الاستقامة منه تتفرع، وهو معدنها، وقد نص الحديث على هذا وبينه أتم بيان، فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب﴾، وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه﴾، (…) فينبغي أن يكون المؤمن محافظا على نيته ابتداء، فإذا أراد أن يزيد في عمله ينظر أولا في نيته فيحسنها، فإن كانت حسنة فينميها إن أمكن تنميتها، وما افترق الناس في غالب أحوالهم إلا من هذا الباب، لأن الغالب على بعضهم تقارب أفعالهم، ثم إنهم يفترقون في الخيرات والبركات بحسب مقاصدهم وتنمية أفعالهم»([30]).
ج. طلب التدرج الارتقائي:
ومعناه أن الاشتغال التعبدي ليس ممارسة ساكنة لا حركة فيها، ولا مرتبة واحدة لا احتمال لمراتب أخرى فيها، وإنما هو على التحقيق سلوك أخلاقي مداره على النزول في مراتب التعبد الممكنة والمختلفة؛ إذ للتعبد بمقتضى هذا الاعتبار سلم يحتمل درجات ومراتب تعبدية متفاوتة، بحيث يكون المتدين في منزلة تعبدية معينة أعبد من التي دونها، أو يكون أقل تعبدا باعتبار المنزلة التي تعلوها، والمرجع في تبين مراتب الاشتغال التعبدي هو النظر في مقدار التزام المتدين بمعايير العمل في مسعاه التقربي، وفي مدى القدرة على صرف الموانع والآفات الحائلة دون تحقيق مقصده التعبدي، وعليه فالاشتغال التعبدي بموجب هذه المعايير يحتمل مراتب متفاوتة تقتضي من المتدين عدم الإقامة على وضع اشتغالي واحد، وإلا بقي بمعزل عن الظفر بمطلوبه التقربي ونيل مقصوده التعبدي؛ فيتعين عليه الدخول في طور تعبدي أرقى وأعلى من الذي دونه، حيث يوجب عليه هذا الطور الأرقى إقامة التعبد على معايير العمل المشخص. وبفضل الانضباط بموجبات العمل ومعاييره وقيمه، أمكن للمتدين الاقتراب من مطلوبه التعبدي بطريق أيسر من الذي دونه، كما أمكن له تحقيق تعبده على وجه جامع بين مقتضيات التشخيص والتحقيق، ولزوم حمى التعظيم والتنزيه.
وبمقتضى هذه الحقيقة الاشتغالية، يتبين أن المتدين مدعو إلى طلب الكمال عن طريق النزول في مراتب العمل واستجلاب فوائده الروحية وآثاره الأخلاقية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال المعاينة الحية التي تقوم مقام السند المؤيد للاشتغال، ومن هنا يستشرف المتدين مرتبة تعبدية أرقى([31])، وتمتاز بكون المتدين فيها يأخذ في التقلب في مراتب الاشتغال الشرعي عبر إقامة الفرائض على أكمل الوجوه، والاجتهاد في الإتيان بالنوافل؛ الأمر الذي يجعل التعبد في هذا المساق ممارسة تحقيقية يستشرف المتعبد من ورائها آفاق الغيب، وتنفتح له بها عوالم الروح، ويحقق بها استحضار المعية الربانية والتجرد من سائر التبعيات.
إذا كان المسلك التعبدي مبناه على الاجتهاد في الإتيان بالنوافل بعد إحكام الفرائض، فإن مسلك التقرب بالذكر يعد أس الاشتغال التعبدي فيها، لأنه الأليق بمطلب التحقق والتخلق المقومين لهذه المرتبة التعبدية، فالذاكر «لما كان يلتمس استكمال الأخلاق، وكانت حقيقة الأخلاق أنها تجارب وخبرات لا مجرد أفكار وتصورات، فإن معاني الأسماء تأتيه، وحقائقها تظهر له في التجارب الحية لا في الأفكار المجردة. وبهذا يكون التقرب بالذكر تجربة حية وتجربة إحسان، حيث إن سبب تعرف الذاكر على معاني الأسماء هو تعرفها ذاتها له، هبة من الله، لا تعرفه هو عليها كسبا منه»([32]).
وإذ يعتبر الذكر المسلك التعبدي الأنجع في تحقق المتدين بالمحبة الإلهية، وتحصيل العرفان الشهودي، فقد خصه الشارع الحكيم بسائر مراتب الطلب وأناطه بالترغيب والحث على الإطلاق والتقييد، والعموم والخصوص، والإجمال والتفصيل، ومن خواص الذكر وامتيازه على سائر المطلوبات الشرعية: «أن الله ما وصف بالكثرة شيئا إلا الذكر، وما أمر بالكثرة من شيء إلا من الذكر. قال: ﴿والذاكرين الله كثيرا والذاكرات﴾ [الأحزاب، 35]، وقال: ﴿ اذكروا الله ذكرا كثيرا﴾ [الأحزاب، 41]، وما أتي الذكر قط إلا بالاسم: الله خاصة، مُعَرّى عن التقييد، فقال: ﴿اذكروا الله﴾، وما قال: بكذا، وقال: ﴿ولذكر الله أكبر﴾ [ العنكبوت، 45]، ولم يقل: بكذا، وقال: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة، 203]، ولم يقل: بكذا، وقال: ﴿ فاذكروا اسم الله عليها﴾ [ الحج، 34]، ولم يقل: بكذا. وقال: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام، 119]، ولم يقل: بكذا. وقال ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله»، فما قيده بأمر زائد على هذا اللفظ؛ لأنه ذكر الخاصة من عباده اللذين يحفظ الله بهم عالم الدنيا، وكل دار يكونون فيها، فإذا لم يبق في الدنيا منه أحد، لم يبق للدنيا سبب حافظ يحفظها الله من أجله، فتزول وتخرب»([33]).
3.1 التفكر:
إن التفكر تجربة عرفانية يحياها المتدين، ويدخل بمقتضاها في تفاعل مخصوص مع نفسه والآفاق من حوله، فيستفيد بها مزيد التحقق في المعرفة، وبالغ الرسوخ في التخلق.
والتفكر فعل عرفاني يختص بالأوصاف الإجمالية التالية:
أ. الوصف الاستدلالي:
وبيانه أن التفكر فعل عقلي يتقوم بالاستدلال، إذ تتحصل المعارف فيه من خلال الانتقال([34])من معطيات معلومة، بغية تحصيل معطيات أخرى كانت مجهولة قبل الطلب، فالتفكر فعل استدلالي صريح إذ يتقوم بالبناء والاستنتاج، وهذا ما أشار إليه الغزالي بقوله: «اعلم أن الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. ومثاله أن من مال إلى العاجلة، وآثر الحياة الدنيا، وأراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة، فله طريقان، أحدهما: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنيا، فيقلده ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر، فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادا على مجرد قوله، وهذا يسمى تقليدا ولا يسمى معرفة. والطريق الثاني: أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار، ثم يعرف أن الآخرة أبقى، فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة، وهو أن الآخرة أولى بالإيثار، ولا يمكن تحقق المعرفة بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين. فبإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرا، واعتبارا، وتذكرا، ونظرا، وتأملا، وتدبرا»([35]).
ب. الوصف التوليدي:
وحاصله أن التفكر فعل استدلالي يحصل به إثمار المعارف وتكثيرها وتوليدها، وهكذا تغتني التجربة العرفانية لدى المتدين من خلال توارد المعارف واغتنائها بفعل التفكر، «والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت في القلب على ترتيب مخصوص، أثمرت معرفة أخرى، فالمعرفة نتاج المعرفة، فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى، حصل من ذلك نتاج آخر، وهكذا يتمادى النتاج، وتتمادى العلوم، ويتمادى الفكر إلى غير نهاية»([36]).
ج. الوصف العملي:
تتجلى الدلالة العملية للتفكر في كون المعارف الحاصلة به تفيد في إحياء داعية الاشتغال لدى المتدين وتقويم سلوكه، فليس المقصد من التفكر استفادة الأفكار المجردة، وإنما إقامة الأعمال الحية، ومما يؤيد الدلالة العملية للتفكر أنه يستعمل في بعض السياقات اللغوية لإفادة معنى الاعتبار، لما فيه من الانتقال إلى تحصيل الفكرة المقترنة بالعبرة المفيدة في تحقيق العمل وتقويم السلوك، كما يستعمل التفكر أيضا في بعض هذه السياقات لإفادة معنى التدبر؛ «لما فيه من الاقتفاء والاتباع، اقتفاء الأدبار وتتبعها، إذ ما يهم في التفكير ليس فقط التمكن من الفكرة، ولكن أيضا اقتفاؤها واتباعها في العمل والسلوك»([37]).
إن للتفكر مآلا عمليا يظهر فيما يحدثه من تغيير لأحوال القلب تغييرا يفيد في تجديد شمولي لأخلاق المتدين، وتوسيع معارفه. قال الإمام الغزالي مقررا هذا المعنى: «وأما ثمرة الفكر: فهي العلوم والأحوال والأعمال، ولكن ثمرته الخاصة العلم لا غير. نعم إذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. فالعمل تابع الحال، والحال تابع العلم، والعلم تابع الفكر، فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها (…) وإن أردت أن تفهم كيفية تغيير الحال بالفكر، فمثاله ما ذكرناه من أمر الآخرة، فإن الفكر يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثار، فإذا رسخت هذه المعرفة يقينا في قلوبنا، تغيرت القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وهذا ما عنيناه بالحال، إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها، والنفرة عن الآخرة وقلة الرغبة فيها. وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته، ثم أثمر تغير الإرادة أعمال الجوارح في اطراح الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة، فههنا خمس درجات:
* أولاها: التذكر، وهو إحضار المعرفتين في القلب.
* وثانيتها: التفكر، وهو طلب المعرفة المقصودة منهما.
* والثالثة: حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها.
* والرابعة: تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة.
* والخامسة: خدمة الجوارح للقلب بحسب ما يتجدد له من الحال»([38]).
د. الوصف الاعتباري:
وبيانه أن التفكر سلوك تعرفي مبناه على الاعتبار، والاعتبار قوامه: «العبور من أحكام النظر إلى أسرار العبر، فيكون المعتبر هو من يرى الظواهر على أنها آيات، وينسب السيادة على الكون إلى صاحب هذه الآيات»([39]).
وهكذا فالمتدين يزاول في فعل التفكر نظرا مخصوصا يعتبر المخلوقات آيات دالة على خالقها سبحانه، وأن ما اشتمل عليه العالم من المكونات إن هو إلا مظهر ومجلى لقدرة المكون سبحانه وإبداعه وكمال صنعه وحكمته، فيتحصل للمتدين بمقتضى هذا النظر الحِكْمِي الجامع والواصل بين عالمي الملك والملكوت، كمال الإيمان ورسوخ الأخلاق.
وكلما اتسع نطاق التفكر في الآيات([40])، وقوي استشعار معاني الألوهية وأسرار الربوبية في سائر المظاهر والظواهر -في نفس الإنسان والآفاق من حوله- كان ذلك سببا في اكتساب المتدين مزيد الرسوخ الإيماني، والارتقاء في مدارج التخلق الرباني، وإذا حصل الاستغراق في التفكر انفتح للمتدين باب المعرفة الشهودية.
الهوامش:
([1])- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، ص: 57، تحقيق إياد خالد الطباع، الطبعة: 4، 2006، دار الفكر المعاصر، بيروت – لبنان، دار الفكر، دمشق – سورية.
ويقول شاه ولي الله الدهلوي في كتابه خزائن الحكمة: «ملاك الحكمة عرفان ذات الله سبحانه بذاته، ثم عرفان أسمائه بخصوصيتها وأحكامها، ثم عرفان النشأة المنتشئة وظهور أسماء الله سبحانه فيها بوجه خاص، ثم الأسماء العودية بأحكامها وإفضائها إلى الله تعالى» ص: 26، تحقيق أحمد فريد المزيدي، الطبعة:1، 2008، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
([2])- روح الدين، من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، طه عبد الرحمن، ص: 51-52. ط1، 2012، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب.
([3])- نفسه، ص: 52.
([4])- اصطلح الدكتور طه عبد الرحمن على تسمية فعل تنزيل المعاني الروحية الغيبية على العالم المرئي ب«التشهيد»، حيث يرى أن «استقرار الفاعل الديني في العالم المرئي هو، في نهاية المطاف، الاشتغال بتنزيل العالم الغيبي إلى العالم المرئي، فيتبين أن حقيقة هذا التنزيل أنه عبارة عن ممارسة فعل خاص نصطلح على تسميته ب«التشهيد»، فالفاعل الديني لا يفعل إلا أن يشهد العالم الغيبي أو إن شئت قلت، أن يخرجه على صورة العالم المرئي، إذ لولا هذا التشهيد لما صبر على الابتلاء بالمرئيات، إذ يغدو يراها تجليات غيبية، ولما تقوى على تحمل المسؤوليات، إذ يعان عليها بإمدادات روحية، ولا ريب أن هذه حقيقة فيها قدر من الخفاء، لِمَا رسخ في الاعتقاد من كون حدود العمل الديني هي عين حدود الحياة الغيبية». روح الدين، ص: 46.
([5])- قوت القلوب، لأبي طالب المكي، 3/1281. تحقيق الدكتور محمود إبراهيم محمد الرضواني، ط1، 1422هـ -2001م، مكتبة دار التراث، القاهرة.
([6])- نفسه، 3/1282.
([7])- وأدنى مراتب هذا التحقيق، إتقان العبادة على الوجه الموجب للخروج من العهدة، وأعلاها تحصيل المعرفة الشهودية الحاصلة من المكاشفة والمعاينة.
([8])- إكمال إكمال المعلم، للإمام الأبي، 1/114-115. ضبط وتصحيح: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية.
([9])- شرح العلامة الطيب بن كيران على توحيد ابن عاشر، ص: 138، مطبعة التوفيق الأدبية (دون تاريخ).
([10])- أي الآداب اللائقة بين يدي الله تعالى حال العبادة.
([11])- النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب، 2/423، الطبعة الأولى، 1352 هـ، المطبعة الإسلامية بالأزهر. والجزء الأول من الكتاب طبعته الأولى سنة 1348هـ، المطبعة المصرية بالأزهر.
([12])- شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام، ص: 52-53.
([13])- حجة الله البالغة، 1/279، تحقيق السيد سابق، الطبعة الأولى: 1426هـ – 2005م، دار الجيل.
([14])- الفتح المبين في جملة من أسرار الدين، أو أسرار أركان الإسلام، ص: 21-22، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى، 1999م، دار الكتب العلمية.
([15])- يقول أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: «وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة، وكل منها فرد لازم، والجمع بين الثلاثة حكم واجب، فلهذا كان السلف يذمون من تَعَبد = = بواحد منها، وأهمل الآخرين، فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف، والإعراض عن المحبة والرجاء، وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده، والإعراض عن الخوف، وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد، نشأت من إفراد المحبة، والإعراض عن الخوف والرجاء». استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، ص: 25-26، تحقيق ودراسة مجدي قاسم، الطبعة الأولى، 1990م، دار الصحابة للتراث بطنطا.
([16])- الفتح المبين، ص: 40.
([17])- الفتح المبين، ص: 45-46.
([18])- نفسه، ص: 49.
([19])- يقول الشاطبي: «إن كل عمل معتبر بنيته فيه شرعا، قصد به امتثال الشارع أو لا، وتتعلق إذ ذاك الأحكام التكليفية (…) فإن كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضا من الأغراض، حسنا كان أو قبيحا، مطلوب الفعل أو الترك أو غير مطلوب شرعا. فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجإ والنائم والمجنون، وما أشبه ذلك، فهؤلاء غير مكلفين (…) فليس هذا النمط بمقصود للشارع، فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بد فيه من القصد، وإذ ذاك تعلقت به الأحكام، ولا يتخلف عن الكلية عمل البته». الموافقات، 2/248-249. ويقول أيضا: «فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها، كفعل النائم والغافل والمجنون» الموافقات، 2/246.
([20])- يقول الغزالي: «اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد، وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران: علم، وعمل، العلم يقدمه؛ لأنه أصله وشرطه، والعمل يتبعه؛ لأنه ثمرته وفرعه، وذلك لأن كل عمل أعني كل حركة وسكون اختياري فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور: علم، وإرادة، وقدرة؛ لأنه لا يريد الإنسان ما لا يعلمه، فلابد وأن يعلم، ولا يعمل ما لم يرد، فلا بد من إرادة. ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض، إما في الحال، أو في المآل. فقد خلق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه، ويخالفه بعض الأمور، فيحتاج إلى جلب الملائم إلى نفسه، ودفع الضار المنافى عن نفسه، فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشيء المضر والنافع حتى يجلب هذا ويهرب من هذا، فإن من لا يبصر الغذاء ولا يعرفه لايمكنه أن يتناوله. ومن لا يبصر النار لا يمكنه الهرب منها، فخلق الله الهداية والمعرفة وجعل لها أسبابا وهي الحواس الظاهرة والباطنة -وليس ذلك من غرضنا- ثم لو أبصر الغذاء وعرف أنه موافق له فلا يكفيه ذلك لتناوله ما لم يكن فيه ميل إليه ورغبة فيه وشهوة له باعثة عليه، إذ يرى الغذاء ويعلم أنه موافق ولا يمكنه التناول؛ لعدم الرغبة والميل ولفقد الداعية المحركة إليه، فخلق الله تعالى له الميل والرغبة والإرادة -وأعنى به نزوعا في نفسه إليه وتوجها في قلبه إليه- ثم ذلك لا يكفيه؛ فكم من مشاهد طعاما راغب فيه مريد تناوله عاجز عنه لكونه زمنا؟ فخلقت له القدرة والأعضاء المتحركة حتى يتم به التناول، والعضو لا يتحرك إلا بالقدرة، والقدرة تنتظر الداعية الباعثة، والداعية تنتظر العلم والمعرفة= =أو الظن والاعتقاد، وهو أن يقوى في نفسه كون الشيء موافقا له، فإذا جزمت المعرفة بأن الشيء موافق ولا بد وأن يفعل، وسمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعثت الإرادة وتحقق الميل، فإذا انبعثت الإرادة انتهضت القدرة لتحريك الأعضاء، فالقدرة خادمة للإرادة، والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة. فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة، وهي الإرادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافق للغرض إما في الحال وإما في المآل. فالمحرك الأول هو الغرض المطلوب وهو الباعث، والغرض الباعث هو المقصد المنوي، والانبعاث هو القصد والنية». إحياء علوم الدين، 5/6-7. تحقيق سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، 2004م.
([21])- الإرادة هي: «الصفة المخصصة لأحد طرفي الممكن لما هو جائز عليه، من وجود أو عدم، أو هيئة دون هيئة، أو حالة دون حالة، أو زمان دون زمان، وجميع ما يمكن أن يتصف الممكن به بدلا عن خلافه، أو ضده، أو نقيضه، أو مثله، غير أنها في الشاهد لا يجب لها حصول مرادها، وفي حق الله تعالى يجب لها ذلك، لأنها في الشاهد عرض مخلوق مصرف بالقدرة الإلهية، والمشيئة الربانية هي ومرادها، وهي في حق الله تعالى معنى ليس بعرض، واجبة الوجود، متعلقة لذاتها أزلية أبدية، واجبة النفوذ في ما تعلقت به». الأمنية في إدراك النية، القرافي، ص: 117، تحقيق ودراسة: د. مساعد بن قاسم الفالح، الطبعة:1، 1988م، مكتبة الحرمين الرياض.
([22])- النية هي: «إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يفعله، لا بنفس الفعل من حيث هو، ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة، وبين قصدنا لكون ذلك الفعل قربة، أو فرضا، أو نفلا، أو أداء، أو قضاء، إلى غير ذلك، مما هو جائز على الفعل، فالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والإيجاد هي المسماة بالإرادة، ومن جهة أن هذه الإرادة مميلة للفعل إلى بعض جهاته الجائزة عليه، تسمى من هذا الوجه نية، فصارت الإرادة إذا أضيف إليها هذا الاعتبار صارت نية، وهذا الاعتبار هو تمييز الفعل عن بعض رتبه». الأمنية في إدراك النية، ص: 119-120.
([23])- القصد هو: «الإرادة الكائنة بين جهتين، كمن يقصد الحج من مصر ومن غيرها، ومنه السفر القاصد، أي في طريقة مستقيمة، وهذا المعنى يستحيل على الله تعالى». الأمنية في إدراك النية، ص: 121.
([24])- الموافقات، 2/251.
([25])- الموافقات، 2/132.
([26])- تدبر قوله تعالى: ﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البقرة، 257].
([27])- إحياء علوم الدين، 5/24.
([28])- نفسه، 2/32.
([29])- نفسه، 2/32.
([30])- المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات، لابن الحاج، 1/11-12، تحقيق أحمد فريد المزيدي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، (د.ط.ت).
([31])- وهي كما يقول أبو الفرج بن رجب الحنبلي: «درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات، والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله كما قال: ﴿ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه﴾». جامع العلوم والحكم، 3/1075، تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور، ط: 2، 2004م، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر.
([32])- العمل الديني، ص: 171.
([33])- الفتوحات المكية لابن عربي، 3/345، ضبط وتصحيح: أحمد شمس الدين، ط: 1، 1999م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
([34])- قال الشيخ زروق عند قول ابن عطاء الله في الحكم: (الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار) ما نصه: «الفكرة هنا التفكر. والمقصود استعمال الفكر في استخراج المعلومات، فهي سير القلب، أي: مشيه وانتقاله= =بالنظر في ميدان أي: موقف الأغيار، أي: المخلوقات، فالقلب يسير بفكره في الخلائق على حسب مراتبه». شرح الحكم العطائية للشيخ زروق، ص: 379، تحقيق: أحمد زكي عطية، منشورات الجامعة الليبية، كلية الآداب،1391هـ – 1971م.
([35])- إحياء علوم الدين، 5/82.
([36])- إحياء علوم الدين، 5/83.
([37])- منطق الكلام، حمو النقاري، ص: 9.
([38])- إحياء علوم الدين، 5/-83-84.
([39])- سؤال الأخلاق، ص: 133.
([40])- يلاحظ أن جل آيات التفكر في القرآن الكريم وقع التنبيه فيها إلى الآيات، وفي هذا الصدد يقول سيدي ابن عجيبة في تفسير قوله تعالى: ﴿ويتفكرون في خلق السماوات والأرض﴾ «استدلالا واعتبارا، وهو أفضل العبادات، قال ﷺ: «لاعبادة كالتفكر»؛ لأنه المخصوص بالقلب، والمقصود من الخلق (…) فلما تفكروا في عجائب المصنوعات، قالوا: ﴿ربنا ما خلقت هذا باطلا﴾، أي عبثا من غير حكمة، بل خلقته لحكمة بديعة، من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان، وسببا لمعاشه، ودليلا يدله على معرفتك، ويحثه على طاعتك، لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك.» البحر المديد في تفسير القرآن العزيز، 1/414. تحقيق عمر أحمد الراوي، الطبعة الثانية: 1426هـ – 2005م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
_________________________________
*نقلًا عن موقع” الرابطة المحمديَّة للعلماء”-المغرب.