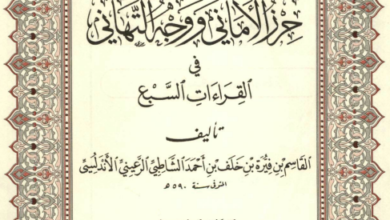جماليَّات التصوير في شعر المتصوِّفة
عبد الكريم الرحيوي
إجادة التصوير ترجمان سعة المخيال، ومعيار رحابة أفق المبدع، به تُكتَسب شاعرية الشاعر، وبلاغة المترسل، وخطابة المتكلم… ولئن اتفق شعراء العرب، مثلاً، على ضروب من التصوير، وصنوف من التخيّلات، قصداً أو طوعاً؛ لتبدّتْ بجلاءٍ في مواضيع تشاركت فيها مخيّلتهم، إلا أن لشعراء التصوف فيها ترميزات خاصّة، وإشراقات متميزة، وومضات متوهجة منزاحة عن المعتاد.
إن الصورة الشعرية لدى الشاعر الصوفي ترتقي لتعبر عن رؤية داخلية من خلال تجربة سلوكية روحية تنطلق من العالم المادي، وتترقى من حال إلى حال، سعياً وراء الفناء الروحي والانعتاق من سجن المادة. إنها «صورة واقعية من حيث إنها تكشف عن الأصلي، والجوهري، لكنها في الوقت نفسه تنفلت من الواقع الملموس، حيث إنها تشير إلى ما يتجاوزه، وهي في ذلك ليست وصفاً بل هي ضوء يخترق ويكشف»، ويجسد كوامن النفس ولواعجها.
وبهذا المنظور تمسي الصورة في الشعر الصوفي روحية ذوقية لا تدرك بالحواس ولا بالعقل، وإن كانت تتوسل بألفاظ لغوية مألوفة في الكلام البشري، هذه الألفاظ تحيل إلى مدلولات عالم التصوف بأسراره الروحانية ومعارفه الربانية، يتم إدراكها بتأويلها وفق سياقها الصوفي؛ لتتبوأ بذلك مكانة جديدة تختلف نسبياً عما علق بها من تصوّر في نقدنا القديم.
ولنعطف توًّا على حال الصورة الشعرية على المستوى التطبيقي؛ لنتبين وجوه الاستعمال الفني لدى شعراء التصوّف؛ منطلقين من نموذجين نزعم أنهما الأكثر شيوعاً لدى شعراء هذا التيار، وهما: صورة الحب والحرب، وصورة الطبيعة.
صور الحب والحرب
استعان الشاعر الصوفي بمقوماتِ الحرب ومخلفاتِها النفسيةَ والجسميةَ الأليمةَ على المكابد، ليعكس أن فعل الحب والتعلق بالمعشوق على بدنه وروحه هو نفسه فعل الحربِ بالمتنازعين.
وقد وجد هذا الشاعر في عُدّة الحرب من سهام ونبال ونِصال وسيوف ونيران ملتهبة، وفي مخلفاتها من جروح وعلل وعاهات، ضالّتَه لتصوير المعاناة الشديدة التي يتكبدها، والحرقة التي يحياها، لجمع العذاب والألم في طرفيْ الصورة: عذاب الحبّ والتعلق بالمعشوق (الحق)، وألم الحرب وويلات العراك.. وذلك بسبب وقوع هذا الشاعر تحت سلطان الحب، وما يثيره الجمال الساحر للمحبوبة في قلبه من أشواق ملتهبة وعواطف حارة وحنين متجدد.
ولم يكن عشق الصوفي وتعلّقه شأنَ عشقِ غيره النساءَ والتشببِ بهن، ولكنه حب من نوع آخر، إنه ارتباط روحي ووجداني بالحق، وتمسّك خارق بالذات الإلهية، وليس ما تختزنه أشعار المتصوفة من تغزّل، وما تحتويه من تشبيب بالنساء، ووصف للمفاتن وأوجه الجمال والجلال إلا ترميز باطن للمحبة بمعناها الصوفي.
لقد أجمع المتصوفة على معشوق واحد، محبوب فرد صمد، لا يشاركه في هذه العاطفة شيء، وهو الله جلّ جلاله، وهذه الحقيقة «لَغَّزَها» العارف بالله الحلاج في قوله:
أحرفٌ أربعٌ بها هامَ قلبي
وتلاشت بها همومي وفكري:
ألفٌ تألف الخلائق بالصَّفْــ
ـحِ ولامٌ على الملامة تجري
ثم لامٌ زيادة في المعاني
ثم هاءٌ بها أهيمُ وأدري
والألف واللامان والهاء ملفوظ اسم الجلالة: الله (جل جلاله).
ومن هذا التهيام قول رابعة العدوية متعشقةً:
مَنْ ذاقَ حبَّكَ لايزال متيَّماً
فَرَحُ الفؤاد – متيماً – بلبالُ
مَنْ ذاقَ حُبَّكَ لا يُرى متبسِّما
مِنْ طول حُزنٍ في الحشا إشعالُ
والإشعال من متعلقات الحروب ونيرانها المتلظية التي تأتي على أسباب الحياة، استعارته الشاعرة لبناء صورة عاشقة. «وإذا كان العبد كذلك وتحقق بمقام المحبة، هرب الشيطان من قلبه وكان بمنآة عن وساوسه».
ومما استند فيه شعراء التصوف إلى معجم الحرب لبناء صورهم الفنية العاشقة قول الكتاني:
وكم طرحتنا مقلة الحرب بغتة
فصرنا أحاديثاً بألسن سوقتي
فتقلبات العين في معرض الحديث عن معجم الشر تقابلها شرور الحرب وويلاتها، فالمشابهة في الاستعارة هنا ملائمة.
ومن ذلك قول ابن الفارض:
يا رامياً يرمي بسهم لِحاظه
عن قوس حاجبه الحشا إنفاذا
فبنى صــــورة قاتلــــة فاتكـــة على استعارة السهم للحظ، من جهة، والقوس للحاجب من جهة أخرى؛ إبانةً عن فعلِ نظرة المحبوب في حشا المحب، فِعْلَ السهم المنطلق من قوسه في جسد الهدف.
وشبيهه مما يصور قوة نظرة المحبوب وآثارها في المحب قول رابعة:
حسْبُ المحبِّ من الحبيب بعلمه
أنَّ المحب ببابه مطروحُ
والقلبُ فيه إن تنفَّسَ بالدجى
بسهام لوعات الهوى مجروحُ
وفي هذه الصورة ترميز إلى تعلق الشاعر بالمحبوب، وأثر هذا التعلق على قلبه الهائم بهواه، فالصورة غارقة في الرمزية جرياً على عادة شعراء التصوف.
إن تحرير الروح من قــــيد الجــــسد المحبوسة فيه واجب، لأن الصوفيــــة لا يـــدركــــون الحقائـــــق ولا ينعمون بالقرب من المحبــوب «الحق» بأجسامهم، بل بأرواحهم، فيتركون هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجردون، والتجريد عند الصوفية هو «إماطة السوى والكون عن السر والقلب».
لذلك نجد هذا النوع من الصور، الذي يشخص فناء أجسامهم وذوبانها، مطردا في أشعارهم، وهي صور يستدل بها على المجاهدة والمكابدة لإزالة الحظوظ البشرية المانعة من تحقيق القرب من المحبوب والدنو منه للفناء فيه والبقاء به روحياً.
هي صور بيانية تشكلت من ذات الشاعر الصوفي وأحاسيسه وعواطفه، عبر استعانته بأوصاف الحرب ومتعلقاتها، فأسقط عليها حاله النفسية، لتعكس قيمة المحبوب ومكانته لديه؛ درجةَ الجنوح لاعتزال أهله وأقربائه من أجل «سواد عيون المحبوب»، نحو ما يجليه العارف بالله أحمد زروق في تائيته المشهورة:
ألا قد هجرت الخلق طُرًّا بأسرهم
لعلي أرى محبوب قلبي بمقلتي
وخلّفت أصحابي وأهلي وجيرتي
ويتمت نجلي واعتزلت عشيرتي
ووجّهت وجهي للذي فطر السَّما
وأعرضت عن أفلاكها المستنيرة
وعلّقت قلبي بالمعالي تهمماً
وكوشفت بالتحقيق من غير مرية
صور الطبيعة
فعلى هدي الشعراء العرب القدامى؛ عمد شعراء التصوف إلى عناصر الطبيعة في هدوئها وسكونها لاستمداد صور تعكس خباياهم، وتجلّي أسرار مواجيدهم. ومن تلك العناصر ما هو نوراني (الشمس، الكواكب، النجوم، النهار، الليل…) ونباتي (الزهور، الأشجار، الثمار…)، ومائي (البحر، المطر، السحاب…)، وحيواني (الظبي، المهاة، الشاذن، الحمام…).
ومما اطرد منها في شعرهم؛ تشبيه المحبوبة بالبدر والشمس لبيان إشراقها وعلو مكانتها، نحو قول ابن الفارض:
هي البدرُ أوصافاً وذاتي سماؤها
سَمَتْ بي إليها همّتي حين هَمَّتِ
وقول الحلاج:
طَلَعَتْ شمسُ مَن أحبُّ بِلَيلٍ
فاستنارتْ فما لها مِن غُروبِ
إنَّ شمسَ النهارِ تغرب بالليـ
ـلِ، وشمسُ القلوب ليسَ تغيبُ
فخفّى الشاعر شمس الظاهر، التي يعلمها الناس ويألفها الجمــــيع، بشمس الباطن التي تتوهج في دواخل العارفين، ومدارج السالكين، وهي شمس لا تغيب مطلــــقاً ولا تخضــــع للتعـــاقـــــب الزمني بين اللـــيل والنهار على المعتاد المألوف، وفي ذلك تصوير تفتقت له ذائقة الصوفيين.
وقوله أيضاً:
يا شمسُ، يا بدر، يا نهار
أنت لنا جنة ونار
وقول الكتاني:
فُتِنـْتُ بشمس الحســن لمـا تسـترت
بشمس لهــا منها عليها حجــاب
وما ثم من يقوى لقرص شعاعهـــا
كفاحـــاً علــى أن ليس ثَمّ نقــاب
فتتجلى استعارة الشمس للحقيقة بجامع التوهج والوضوح في كل، حيث أنزلها الشاعر منزلة المرأة الحسناء التي كشفت النقاب عن وجهها فتجلى ساطعاً نيراً مشعاً.
وقول محي الدين بن عربي:
إذا طلعَ البدرُ المنيرُ عشاءً
رأيتَ لهُ في المحدثاتِ ضياءَ
وليسَ لهُ نورٌ إذا الشمسُ أشرقتْ
وقد كان ذاك النورُ منه عشاءَ
فما النورُ إلا من ذكاءٍ لذاكَ لمْ
يكن يغلب البدرُ المنير ذكاءَ
وهذه الصور، وإن بدت سطحية؛ فإن باطنها يعكس مخيالاً خلاقاً يعبر عن واقع الشاعر النفسي وحاله الوجدانية، فالشمس والبدر رمز لتجلي الأنوار الإلهية التي تغمر قلبه ووجدانه بالنور، وتمحو ظلمات نفسه وأدرانها، ولقد شبهها بالشمس أو البدر، والأولى أعظم نوراً – بل هي أصله ومنبعه – لتصوير حال شعورية.
إن اقتران الذات الإلهية والتجليات الربانية بالنور ومصادره مرجعه كون النور صفة أصلية جوهرية؛ فهي منبع الوهَج ومصدر الطهر والصفاء، وبِطاقتها النورانية يتحرك الكون وتـــــدور الأفلاك، مصداقاً لقــــوله تــعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (سورة النور/ من الآية 35).
لقد تفتقت شاعرية المتصوفة في إبداع تراث شعري ينماز عن غيره من أشعار العرب بتعدد الانزياحات، وتشعب الترميزات، وكثافة الصور الفنية وتعانقها، من خلال الاستمداد من محيط الشاعر ومعيشه من جهة، ثم من سعة مخياله وخصوبة رؤاه من جهة أخرى، ما ساعده على إجلاء ما يختلج في دواخله من أسرار ربانية، وأحوال ومقامات وتجليات ومكاشفات ومشاهدات ومجاهدات وكرامات .
_______________________________
*نقلاً عن موقع مجلة “العربي”.