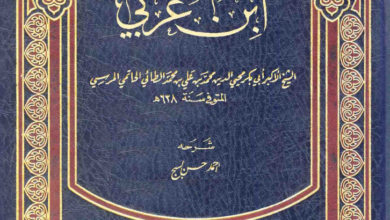لعبة اللغة؛ رحلة الإنسان مع المعنى
الصادق الفقيه
دبلوماسي سوداني، الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، الأردن،
وأستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية، جامعة صقاريا، تركيا.
تقول الحقيقة العلمية إن كل البشر يولدون ولديهم ملكة الكلام، لكن متى بدأنا القدرة على تنظيم أفكارنا بلغة مفهومة يُفضي الحديث بها إلى المعنى، فهذا ما لم تتفق الأبحاث والدراسات بعد على تاريخ دقيق له. غير أننا نكشف بمرور الوقت أن لغاتنا هي أدوات تكيفية فريدة، شكلتها البيئة، وكل واحدة منها تؤثر على كيفية إدراكنا للوقت في الفضاء العام، وكيف نتذكر الأحداث. ورغم أن التواصل البشري يعتمد على نفس الأسس الجينية؛ مثل الحيوانات الأخرى، إلا أن البعض ينشأون بميل أكبر للتعاون، مما يُساعد على تَشَكُّل التواصل الرمزي عبر اللغة. وقد تغلب الإنسان قديماً على الكثير من مصاعب الحياة وعقباتها بتطوير لغة التواصل وتكثيف التعاون والعمل الجماعي. لذلك، تتطلب مواجهة التحديات الرئيسة في عصرنا الحاضر فهماً أعمق لوظيفة اللغة؛ كيف تطورت، وكيف أثرت على تطورنا البيولوجي والثقافي، وكيف تستمر في تحديد هويتنا، وكيف نختبر العالم، الذي نعيش فيه معاً، من خلالها. ونُدرِك أن التطور هو قصة الاستجابة الإبداعية للتحدي البيئي، الذي يعمل على تنظيم تجربتنا، التي تشمل الجذور التطورية للتواصل البشري عبر النماذج العقلية واللغة السلوكية الأساسية، والتي نتشاركها مع جميع الأنواع، وباعتبارها، أي اللغة، هي الأداة الأكثر مرونة للتكيف البشري.
لقد استخدم الإنسان، منذ بدء الخليقة، لغة رمزية لأول مرة لتبادل الفهم واكتساب الخبرة. وتعد المحاكاة الصوتية جزءاً من تراثنا الجيني، وتكمن وراء طقوسنا وألعابنا ورياضاتنا ورقصنا حتى يومنا هذا. وساعدت الثقافة الشفوية على التواصل التعاوني، والتخطيط الجماعي، واتخاذ القرار المجتمعي، والتفاوض، والقواعد والأعراف، إذ تمت الاستجابة لكل هذه الاحتياجات بالكلام. واكتشف الإنسان أنه للمرة الأولى، يمكن تعزيز تماسك المجموعة من خلال القصص والأساطير، والرموز الخارجية. وأدت القدرة على تسجيل الأفكار، خارج الذاكرة البشرية، إلى نهضة الفن والكتابة والرياضيات، التي فتحت الباب أمام أفكار جديدة وطرق مستحدثة في التفكير، وجعلت المعرفة في متناول المزيد من الأفراد والمجتمعات. ومثلما حرم الفيروس التاجي “كورونا” بعضنا من حاستي “الشم والتذوق”، دعونا نتخيل التأثير الكارثي لفيروس غامض يحرمنا من اللغة، فالمؤكد أن الحضارة الحديثة ستفسح المجال بسرعة للفوضى، ويضيع المواطنون في فراغ اتصالي؛ إعلامي ومعلوماتي، غير قادرين على التنسيق، أو المساومة، أو التفكير مع بعضهم البعض. إذ إنه بدون القدرة على نقل المعلومات والمهارات بسهولة من شخص لآخر، لمشاركة الأفكار، أو وضع الخطط، أو تقديم الوعود، من الصعب أن نتخيل أنه كان بإمكاننا تحقيق التطور الثقافي والتكنولوجي للصيادين والبدو المعاصرين، ناهيك عن المجتمعات الأكثر تعقيداً. إن امتلاك خازنة “معلوماتية”، تؤدي احدى وظائف الدماغ البشري، لا يكفي، فاتساع الهوة بين مجتمعات القردة والمجتمع البشري في مجالات الثقافة والتكنولوجيا قد لا تنتج فقط من التكوين الخَلْقِي للدماغ، ولكن ربما يكون الاختراع البشري للغة هو العامل الرئيس، الذي تنبع منه معظم الاختلافات الأخرى.
ألق التميز:
وتبياناً لما قدمت ه قصة الميلاد المشترك بين الإنسان واللغة، أقول إني تلقيت كتاباً لمراجعته، وكان تاريخ نشره، في صفحة المعلومات، التي تلي واجهة غلافه، أول ما لفت نظري وجعله يتألق ويأتلف بلؤلؤٍ من المثاني الوضيئة، وتزين بالرقم 22.02.2022، الذي تحتفي بتميزه “لعبة اللغة” الإنسانية في بهائها البصري، وبنيانها التشكيلي الجمالي، وموسيقاها الصوتية الدالة على جنس المتحدثين بها، والناطقين لمفرداتها، إلى جانب بيانها التعبيري الناقل للمعنى. وكأني به مأخوذ بـ”سِفر العدد”،[1] أو مقتبس منه، لاحتفاء بعدد غُيِّبَت عَنَّا مضامينه، ويتخفى عن عقولنا معناه، وترك لـ”حدسنا” الخيار في أن يستكشف كنهه. رغم أن غالبية فلاسفة اللغة العاملين؛ في التقليد التحليلي حول “الحدس”، يشتركون في العمل على ما بدأ يُعرف بـ”نظريات الحقيقة المشروطة عن المعنى”، فما هو إلا زعم بأننا نعرف صورة رقم، أو معنى كلمة ما، عندما نعرف الدور، الذي يلعبانه في الجملة، ونعرف معنى الجملة عندما نعرف الظروف، التي يمكن أن تكون قيلت في ظلها؛ باعتبارها أبسط وحدات المعنى التركيبية. ويتوافق هذا مع الرأي القائل بأن الجمل تتكون من مخزون محدود من العناصر الأبسط، التي يمكن إعادة تجميعها بطرق جديدة، ثم إعادة استخدامها بطرق مبتكرة، طالما أننا نفهم صور تلك التعبيرات الفرعية كمساهمات في معاني الجمل، فيما يمكن الإشارة إليه بسياق “النص”. وربما تكون المحاولة اللغوية، بهذا الفهم، هي أكثر الإنجازات البشرية إثارة للدهشة، إذ لا يُفهم أي نص فيها إلا على نحو يقتضيه المنطق.
وعلى الرغم من أن بدايات اختراع الأرقام لا تزال غير مفهومة جيداً، إلا أننا نشاطر “كاليب إيفريت” في قوله إن الأرقام هي الأخرى ابتكار لغوي رئيس ميّز جنسنا البشري وأعاد تشكيل التجربة الإنسانية.[2] وبالنظر إلى تاريخ نشر هذا الكتاب مجدداً، يمكننا أن نفهمه كمعنى لجملة لا يمكن الحصول على شروطها الحقيقية أبداً، أو لا يمكن التحقق منها من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وفقاً لمحددات منطق اللغة ومناهج تحليلها. على سبيل المثال، كل رقم زوجي هو مجموع اثنين من الأعداد الأولية، أي أن معرفة ما يجب أن تحصل عليه من هذه “الصدفة” الرقمية التاريخية هو بعض الشروط، التي تقول لنا إن معرفة صورة معينة للأرقام تمثل هي الأخرى شروطاً قابلة للفصل، لذلك، لا يمكن أن يكون المعنى مجرد التحقق من وضع شخص ما في حالة معينة ومعرفة الجمل، التي ينطقها بمفردات نستطيع فك “شفراتها”، وفهم مقاصدها من خلال ما تحمله من مخزون بياني. وحتى في العصر الحجري القديم، أدركنا، كما يقول “إيفريت” إن تتبع جوانب العالم الطبيعي قد يُحَسِّن فُرصنا في البقاء على قيد الحياة. فقد كنا نسجل الكميات، باستخدام أرقام ما قبل التاريخ، لعشرات الآلاف من السنين.[3]
وهنا أستأذن القارئ لأزعم أن الكتاب لم يرد بهذا “التزامن” في رسم صورة “التوقيت” توسيع حسابه في قوائم التوزيع؛ من خلال تضمين شروط، أو تحسينات رقمية، لكن ربما أراد، أو قد يكون تَقَصَّدَ، تقديم الدلالة الاستنتاجية الصحيحة للتاريخ كـ”جُملة” ذات معنى، واستخدام جديد صحيح له، وإظهاره كأحكام حول أدلة كافية، أو محتملة لحقيقة زمنية جاذبة. وبالتالي، نجح في التأكيد على أن بعض أشكال العروض التقديمية للتحقق الذاتي، التي يمثلها هذا التاريخ ستدعم فكرة الترويج، وتسمح للقراء باشتقاق جميع ميزات استخدام صور الأرقام مثل اللغة ومعناها. على الرغم من أن نسخة ورقية أخرى منه، صدرت بتاريخ 14.4.2022، بما قد يمثل نقطة شائكة بالنسبة للكثيرين ممن يشككون في مثل هذه الإحالات، والأسس المعرفية للمعنى المستبطن في صور هذه الأرقام بشكل عام. ففي حين أن التحليل اللغوي لا يهيمن على التفكير في هذه الحالة كجزء من الفلسفة التحليلية؛ كما كان الحال في معظم القرن العشرين، فإنه يظل مجالاً حيوياً يستمر في التطور مع العصر الرقمي الحديث. [4]وكما في الأيام الأولى للفلسفة التحليلية، كان هناك اهتمام كبير بالتوازي بين محتوى الأقوال وإسناد المحتوى إلى الحالات العقلية، لكن صارت “الرقمنة” الراهنة تهيمن على قياسات المعنى، وابتعد العديد من علماء الإدراك عن الافتراض التحليلي الكلاسيكي القائل إن الأرقام، كما الأفكار لها رمزية، أو تشبه الجملة ذات المحتوى.
مؤلفان:
إن هذه الرؤية للغة، هي بلا شك، ممتازة لكيفية عمل المعنى، وتستوجب القول إن هناك بعض الأفكار الشائقة في الكتاب، التي هي قيد العرض هنا في هذه المراجعة العامة، والتي يجئ القصد فيها لجعل القارئ يشعر بالفضول لمعرفة مقدار الجذب، الذي ستجمعه هذه الأفكار في المجتمعات العلمية، وما ستخلقه في دوائر الفضاء العام. لذلك، يحسن تقديم من قاما بتأليف هذه الأفكار ليتذكرهما العلماء ويتعرف عليهما العامة، فـ”مورتن إتش كريستيانسن”، هو أستاذ علم النفس في كرسي ويليام كينان جونيور بجامعة كورنيل، وأستاذ العلوم المعرفية للغة بجامعة آرهوس في الدنمارك؛ و”نيك تشاتر”، هو أستاذ العلوم السلوكية بجامعة وارويك ببريطانيا. ويعملان معاً؛ في هذا الكتاب، على إشراك رواة القصص، الذين يحدثون عن كيف حاول الفلاسفة، والمؤرخون، وعلماء الطبيعة، واللغويات، والأنثروبولوجيا، وحتى علماء الرياضيات، وعلماء الكمبيوتر، حل ألغاز اللغة. ففي سرد حكاياتهما، يغوص المؤلفان عادة في حفرة مليئة بثقوب المجهول، ولا يبلغون بسهولة مقاصد وغايات ما يتطلعون لبلوغه. هل يتحدث كل الناس المعاصرين مع بعض الاختلافات المستجدة للغة “آدمية” بدائية؛ كما في قصة “آدم وحواء”.[5]
وبحثاً عن أدلة للإجابات، يلجأ المؤلفان كريستيانسن وتشاتر إلى كتاب “سفر التكوين” في الكتاب المقدس، وعمل القديس أوغسطين،[6] وأفكار فيلسوف القرن العشرين “لودفيج فيتغنشتاين”، الذي نشرت مقالاً عنه تزامناً مع الاحتفال بمئويته، في موقع “التنويري”.[7] كما أورد المؤلفان قصة “شفرة نافاجو”، التي استعملت بين أفراد جيش الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.[8] لكن، ما هي السمات الفريدة للدماغ البشري، التي تسمح للبشر بتعلم اللغة؟ وتقفياً لأثر الإجابة، يستكشف المؤلفان أفكار نعوم تشومسكي، الذي نظر في إمكانية أن يولد الأطفال بمخطط “قواعد عالمية” مشفرة في جيناتهم وأدمغتهم. [9]كما أنهما ينظران إلى “الشتات الأفريقي”! ويقترحان أن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو “كيف أصبح الدماغ البشري متكيفاً بشكل جيد مع اللغة؟”ومع الاعتراض المبدئي على هذه الانتقائية العنصرية، واختيار مجموعة بشرية واحدة لإجراء الملاحظة، قد يكون من اللائق أيضاً قلب السؤال إلى: “كيف أصبحت اللغة تتكيف بشكل جيد مع الدماغ البشري؟” إذ نظر تشومسكي في مخطط “قواعد عالمية”، التي إن صحت فرضيتها يتوقع أن تنطبق على “الشتات” اليهودي، الذي ينتمي تشومسكي إليه، وعلى جميع من جربوا العيش في مجتمعات غير مجتمعاتهم، خاصة المستعمرين البيض، الذين انتشروا في كل الأرض، وعاشوا بين كل الثقافات واللغات.
محتوىً وأمثلة:
انتظم الكتاب؛ بعد صفحات التعريفات والإهداء، في مقدمة مفتاحية، وثمانية فصول وخاتمة حملت عنوان: “ستنقذنا اللغة من الفردانية” إشارة إلى قدرتها على اتاحة التواصل وتوثيق عُرى العلاقات الجماعية، وانتهت الصفحات بلوازم إزجاء الشكر لمن وجب لهم، وسجل التعريفات، وما ثبت من هوامش ومراجع، وفهرس عام. وأسهبت المقدمة في عرض “الاختراع العرضي الذي غير العالم”، والذي هو “لعبة اللغة”، التي برع في التعبير بها البشر. وتوزعت الفصول بين قضايا الكتاب الأساسية؛ فجاء الفصل الأول تحت عنوان: “اللغة كأحرف”. بينما شرح الفصل الثاني مقصده تحت عنوان: “طبيعة انتقال اللغة” عبر الأمكنة والأزمنة. وعرض الثالث إلى “خفة المعنى التي لا تُطاق”، مستفيضاً في شرح المفردات وما تحمله بعضها من معانٍ متعددة، ومتعارضة أحياناً، وما يولده ذلك من إشكالات. وتناول الفصل الرابع “النظام اللغوي عند حافة الفوضى”، وركز الخامس على “تطور اللغة من دون تطور بيولوجي”، فيما اختص السادس بمناقشة “اتباع كل طرف لخطوات الآخر”. واستعرض الفصل السابع “أشكالاً لا نهائية من الجمال” في اللغات المختلفة وتراكيبها، وتوسع الفصل الثامن والأخير في تِبْيَان “الدائرة الافتراضية: العقول والثقافة واللغة”، منبهاً إلى قول “ليف فيجوتسكي” “إن علاقة الفكر بالكلمة ليست شيئاً بل عملية، وحركة مستمرة ذهاباً وإياباً من الفكر إلى الكلمة ومن الكلمة إلى الفكر”.[10]
لقد تناول الكتاب، عبر هذه الفصول، أمثلة من البيئة يسهل هذه الأيام التعرف عليها؛ ليس لأننا أصبحنا أكثر وعياً بما حولنا من مخلوقات، ولكن لأن وسائل التواصل الاجتماعي جلبتها إلينا في شكل “أيقونات”، أو مفردات مهيمنة على أساليب تواصلنا. إذ يقول الكتاب إن الطيور “تغرد”، وأقول ما أكثر ما تزحمنا به “التغريدات” البشرية هذه الأيام، لا بل أن “تويتر” علمنا “السقسقة”، بدلاً عن “شقشقة” الطيور، للتعبير عن “توترات” أحوال معاشنا الاجتماعية، وأزمات أقضيتنا السياسية. ويذهب المؤلفان إلى أن القرود الخضراء لها نداءات إنذار منفصلة للتحذير من الأفاعي والنمور، وأزعم أننا صرنا نقلدها برموز “الإيموجي”، الذي استبدلنا بصورها الصامتة مفردات اللغة الناطقة في وسائل التواصل الاجتماعي. ويقولان إنه يمكن لبعض الشمبانزي والببغاوات تقليد الكلام البشري، وأخشى أن نحرمهم من هذه الميزة لأن “الرقمنة” أضعفت قدرتنا على الكلام. وفي حين تتواصل العديد من أنواع الحيوانات بطرق مهمة لبقائها على قيد الحياة؛ يتصارع كريستيانسن وتشاتر، في كتابهما “لعبة اللغة”، مع هذا السؤال: لماذا إذن البشر هم الحيوانات الوحيدة ذات المهارات اللغوية المتقدمة؟ وهذا لأن اللغة، وفقاً لكريستيانسن وتشاتر، ليست اختراعاً بقدر ما هي إلا ارتجال، “لعبة الحزورات على مستوى المجتمع، حيث تعتمد كل لعبة جديدة على تلك، التي مرت من قبل، ويتم إعادة اختراعها باستمرار جيلاً بعد جيل. ويكتسب الأطفال الكلمات والعبارات ليس من خلال استيعاب القواعد، أو النطق وفقاً للأنماط، التي ولدوا بطريقة ما للتعبير عنها، ولكن عن طريق القفز إلى اللعب والارتجال بحرية؛ ونحن نتحدث من دون معرفة قواعد لغتنا تماماً، أو على “السليقة”، كما نلعب التنس دون معرفة قوانين الفيزياء، أو نغني دون معرفة نظرية الموسيقى. بهذا المعنى الحقيقي للغاية، نتحدث ونفعل ذلك بمهارة وفعالية، دون معرفة لغتنا على الإطلاق. وفي تاريخ العرب مِصْدَاقٌ لهذا حيث صَحَّتْ لغة أهل البادية وحسن بيانهم من غير أن يكونوا متعلمين لقواعد مكتوبة، أو قوانين ناظمة لمخارج حروفهم وموسيقى قراءاتهم.
ووفقاً لكتاب “لعبة اللغة”، يقوم الأفراد جميعهم، والثقافات بأكملها، بإعادة تجميع اللبنات الأساسية، أو “المباني الجاهزة” للمفردات والأرقام، للتواصل بشكل عشوائي، إذ تتطلب المواقف المستجدة كلمات وعبارات جديدة، التي غالباً ما تكون قد تغيرت مع الزمن. وعند التحدث، فإن الشاغل الأساس للشخص ليس أن يكون صحيحاً، ولكن أن يتم فهمه، أو فيما يُشبه محاولة استيفاء شرط الحاجة؛ والحاجة أم الاختراع. لذلك، فإن النهج النظري، الذي اقترحه كريستيانسن وتشاتر حول اكتساب اللغة وتطورها يعكس بشكل وثيق الأفكار، التي صاغها تشارلز داروين حول تطور علم الأحياء.[11] فقد زعم داروين أن الاختلافات البيولوجية تنشأ عن طريق “الصدفة”، وتصبح سمات ثابتة فقط إذا كانت مفيدة.[12] ويقول كريستيانسن وتشاتر، كما سبق، عن اللغة ما يشبه “تخريجات” داروين هذه، على الرغم من أن مصطلح بـ”الصدفة” قد لا يكون أفضل مصطلح لوصف ما يقوم عليه التغيير، الذي يُتَوَقَّع له أن يُؤدي وظيفة. ولذلك، ينصحنا المؤلفان بأن الكلمات ليس لها معانٍ ثابتة، بل هي أدوات مستخدمة في الوقت الحالي للتعبير عن معنىً، ربما يتبدل، أو قد يتغير لضرورات مستقبلية. إذ إن “لعبة اللغة”، بحد ذاتها، هي عبارة عن مجموعة كلمات وعبارات تُعرضُ في حُلَّةٍ “جميلة”، على الرغم من أن كلمة “جميلة” هنا لا تعني أن نثرها وعرضها مصمم بدرجة عالية من الدقة والألق، وإنما لقدرتها ووفائها بالحاجة لإبلاغ المعنى بأفضل وجه. ونجد في الكتاب أن كريستيانسن وتشاتر يستخدمان الكلمات للغرض نفسه، الذي يعتقدان أن أي شخص يفعله، أي أن يُفهم إذا تحدث، وأن يَفْهَم إذا قِيلَ له.
لكن، نلحظ في عموم الكتاب أن كلماته لها التزام جذبٍ ثانٍ، وهو إبقاء القراء مأخوذين بجمال أسلوبه بشكل كامل، ويدفعهم الفضول لتتبع حججه حتى النهاية. فقد نثر المؤلفان مفردات وعبارات جذلة، وضَمِنَا بذلك تتبع القراء لهما صفحة تلو الأخرى، وفصلاً تلو الآخر، مع فرصة التمتع بحكايات مثيرة، وملخصة بشكل عام في العنوان الفرعي للكتاب: “كيف خلق الارتجال اللغة وغير العالم”. وكمقياس لما لدى رواة القصص الجيدين، فإن ما أراده مؤلفا “لعبة اللغة” كنصيحة غير مكتوبة هي ألا يتعجل القارئ، عندما يحتاج إلى مزيد من المعلومات، بالتحقق منها في قسم الملاحظات فقط، مع أهمية استخدم الملاحظات كمراجع. ومع ذلك، ستجد أنه بعد الانتهاء من الجزء الرئيس من الكتاب، وقراءة جميع الملاحظات، أن هناك الكثير من القصص، التي تستحق استحضارها. فهل تعلم أن المستعمرين البيض طاردوا وأطلقوا النار على السكان الأصليين في “تييرا ديل فويغو”، الذين استقبلوا بترحاب الرحالة البريطاني جيمس كوك، وطاقم السفينة “إتش إم إس إنديفور”، عام 1769؟ وعادوا ثانية بذات الروح السلمية ليرحبوا بتشارلز داروين وطاقم السفينة “إتش إم إس بيجل”، في عام 1832؟ وهل تعلم أنه بالنسبة لبعض أنواع الطيور المغردة، تغني الأنثى أيضاً للحال والجمال؟ وهل تعلم أنه على الرغم من مئات السنين من البحث والتكهنات المتضافرة، ما زال العلماء لا يعرفون متى بدأ البشر الحديث؟ وهل تعلم أن الكلمات المرئية للغة الإشارة تُنسى بسرعة أكبر من المفردات المسموعة في الكلام؟
الأسئلة الحائرة:
إن ما تقدم من أسئلة، وغيرها، تبدو حائرة، إذ مرت قرون من المعرفة أظهرت فيها “لعبة اللغة” كيف يتعلم الناس التحدث؛ ليس فقط من خلال اكتساب معاني وقواعد ثابتة، ولكن عن طريق التقاط وإعادة استخدام وإعادة دمج أجزاء لغوية لا حصر لها بطرق جديدة. لذلك احتشد هذا الكتاب بالأسئلة: ما هي اللغة؟ لماذا لدينا لغة؟ ومن أين تأتي اللغة؟ ولماذا هي مهمة؟ وبالاعتماد على أمثلة مسلية ومقنعة من جميع أنحاء العالم، يوضح الكتاب: كيف تتكيف ذاكرتنا قصيرة العمر مع فيضان الصوت المتسارع، الذي يمثل الكلام اليومي. ولماذا تعتبر هذه اللغة تحدياً لعلماء اللغة رغم أن الأطفال الصغار يتعلمونها بسهولة. ولماذا تتنوع لغات العالم بشكل مذهل، ولماذا لا يتحدث شخصان نفس اللغة تماماً. ولماذا البشر لديهم لغة، لكن القرود والشمبانزي ليس لديهم لغة. وكيف أعطتنا اللغة عقلاً كبيراً وغيرت مجرى التطور، وكيف أن اللغة لا تُحِدُّ، ولكنها تُشَكِّل، كيف نُفكر. وفي النهاية، لماذا ما توصلنا إلى فهمه حول كيفية عمل اللغة، يمنحنا أملاً أكبر لمستقبلنا.
إننا قد ننسى غريزة اللغة، لأنها قصة مرتبطة بكيفية تكوين اللغة مع تقدمنا الاجتماعي العمراني. ويعترف الكتاب أن اللغة ربما تكون هي القدرة الأكثر إثارة للإعجاب للبشرية، التي لا تزال غير مفهومة جيداً. ويوضح لنا كريستيانسن وتشاتر أين أخطأت أجيال من العلماء الباحثين عن قواعد اللغة. ويقولان إن اللغة لا تتعلق بالقواعد النحوية الملموسة، ولكن بالحرية شبه الكاملة، شيء مثل لعبة “الحزورات”،[13] مع المطلب الوحيد هو الرغبة في التعلم والفهم. غير أنه من وجهة النظر الجديدة هذه، يجد المؤلفان حلولاً مقنعة لألغاز رئيسة مثل أصول اللغات، وكيف يمكن تعلم اللغة، ويمهدان لمناقشات طويلة الأمد؛ مثل، ما إذا كان وجود معنيين لكلمة “أزرق” يغير ما نراه. في النهاية، أظهرا أن العائق الحقيقي الوحيد للتواصل هو خيالنا. وعلى الرغم من أن اللغة متجذرة بعمق في كل ما نقوم به، إلا أنها محيرة للغاية، إذ كيف يمكن للضوضاء، أو الإيماءات، أن تنقل المعنى على الإطلاق؟ وما هي الأنماط المختلفة في الأصوات والكلمات والمعاني، التي تتكون منها اللغة، ومن أين أتت؟ ولماذا يعتبر فهم كيفية عمل اللغة تحدياً هائلاً لجيوش من علماء اللغة المحترفين بينما يمكن لكل جيل جديد من الأطفال إتقان لغتهم الأم بسهولة في سن الرابعة؟ وهل تستطيع الآلات فهم اللغة؟
لقد جرى إعاقة التقدم نحو الإجابة على هذه الأسئلة، والعديد من الأسئلة الأخرى، بسبب الاعتقاد الخاطئ الأساس بأن التقلبات في اللغة اليومية هي ظِلٌ شاحبٌ للغةٍ مِثالية، حيث يكون للكلمات معاني واضحة، ويتم تجميعها معاً باتباع قواعد نحوية محددة جيداً. لكن هذه القصة التقليدية تتداخل فيها أشياء متخلفة تماماً، فاللغات الحقيقية ليست متغيرات مشوهة؛ قليلاً، أو كثيراً، لنظامٍ لغويٍ أكثر نقاءً وتنظيماً. بدلاً من ذلك، تكون اللغة الفعلية دائماً مسألة ارتجال، لإيجاد طريقة فعالة لتلبية متطلبات التواصل في الحال الراهن، لأن البشر، وفقاً للكتاب، هم متواصلون مرحون، ومزاجيون، ومبدعون، وكلماتهم لا تأتي إلا تدريجياً بمعانٍ أكثر استقراراً. لذلك، تعلمنا أن الانتظام النحوي المستقر نسبياً ليس نقطة البداية، بل هم النتيجة من أجيال لا حصر لها من التفاعل التواصلي، والتي من خلالها تصبح الأنماط اللغوية أكثر رسوخاً من أي وقت مضى. وسنرى أن اللجاجة الظاهرة، والاعتماد على اللهجات العامية، وسوء الانضباط في الكلام المعاصر، لا يمثل تجسيداً خشناً لبعض المثالية. وبدلاً من ذلك، فإن لغة مثل العربية، وبأنماطها المعقدة، وأساليبها المتفاعلة، وقواعدها المتداخلة، وجمالياتها الأخاذة والمحيرة، وسموها النابض بالحياة، هي نتاج تاريخها، وخصوصيتها، وعدد لا يحصى من المفردات، التي أدت بشكل تدريجي؛ مقصود وغير مقصود، إلى إنشاء أنظمة نحوية معقدة اليوم. لذلك، فإن الظهور التلقائي للنظام اللغوي في المجتمعات البشرية هو قصة رائعة مثل ظهور الحياة نفسها.
انفجار المعرفة:
لقد كانت اللغة هي “نار بروميثيان”، التي أشعلت انفجار المعرفة البشرية، واعتبرت أحد الألغاز الثلاثة العظيمة، التي لا تزال تثير حيرة علماء الأحياء التطورية. وأزعم أن الكثيرين قد سمعوا بتعبير “نار بروميثيوس”، لكن لا يعرف غالب الناس ما تعنيه، ومن أين أتت، إذ تُفْصِح معرفة مثل هذا التعبير عن “انتقائية”، أو ثقافة عالية للشخص، تَنُمُّ عن دراسة الأساطير، وسعة الاطلاع. لذلك، من أجل فهمٍ كاملٍ لمعنى الوحدة اللغوية لـ”نار بروميثيان”، نحتاج هنا فقط إلى مجرد تَذَكُّر محتوى الأسطورة، وتحليل أحداث القصة الجميلة عن البطل النبيل والآلهة الذين أظهروه.[14] وكما قال “ريتشارد دوكينز”، يقدم كريستيانسن وتشاتر شرحاً رائعاً لما يُقَرِّب فهم هذه الأسطورة، ويعرض وصفاً واضحاً للمشكلة، ومعالجة عادلة وسخية للنظريات المتنافسة، تليها دعوة حيوية ومقنعة بشكل فكاهي لحلها.[15] وهذا ما جعل” تيم هارفورد” يصف الكتاب بأنه قلب كل ما اعتقد أنه يعرفه عن اللغة رأساً على عقب، لأنه مقنع ومليء بالتفاصيل الرائعة.[16] ويشاركه هذا الرأي “دانيال إيفريت” بحديثه عن أن “لعبة اللغة” هي قصة أصلية للغاية ومقنعة عن كيفية تطوير البشر لأعظم اختراعاتهم، وهي اللغة. إنها تستند إلى سنوات من البحث الرائع، الذي أجراه كريستيانسن وتشاتر، وتُظهر علم اللغة في أفضل حالاته. وبجانب متعة القراءة، يستحق الكتاب دراسة متأنية من قبل أي شخص مهتم بطبيعة ووظيفة وأصول الاتصال البشري.[17] فالكتاب، في قول ” باربرا تفرسكي”، هو رحلة ممتعة عبر الأنواع والثقافات من خلال طرق اختراع اللغة وإعادة اختراعها، تتخللها قصص ثاقبة ستشعر أنك مضطر لإخبار أي شخص على مرمى البصر بها.[18]
إن هذا كتاب يجادل بشكل أساس في أن نعوم تشومسكي كان لديه بعض الأفكار العظيمة، لكنه في النهاية كان خاطئاً في بعض تقديراته وتقريراته وتبريراته. ومثل غيره، وقع في مجازفات “تبسيط” قد تكون صُممت بشكل مقصود لربط القارئ بمتابعة تصفح الكتاب، مع إعطائه فكرة عن الاتجاه النهائي للفكرة المركزية، التي تتطلع لخلق لغة عالمية متحررة من قيود خصوصية القواعد. رغم ما عهدناه أن غالب المؤلفين يخشون باستمرار من “الفوضى” في استعمالات اللغة، حتى أثناء الترويج لبعض فوائدها الخفية. وحجتهم في ذلك هي أن اللغة؛ مثل الإنسانية، تتطور بشكل أفضل وأكثر فائدة داخل حدود القواعد، وبالتالي داخل حدود الأحكام، ولأن التعريف الحرفي لـ”الفوضى” هو الكتابة والكلام “بدون أحكام”. وهذا هو المكان، الذي يتعارضون فيه؛ في النهاية، مع أفكار تشومسكي، التي تدعو للغةٍ كونيةٍ، وآلة نحويةٍ عالميةٍ. وبالنسبة لشخص غير مختص في مجال اللغات، قد يجد أن هذا الكتاب فيه اختبار قوي لموضوع القواعد والأحكام، وإن كُتِبَ بلغة يمكن متابعتها بسهولة، وحتى عند المناقشات التقنية قام كل من كريستيانسن وتشاتر بعمل موفق في استخدام استعارتهم الجارية للعبة “الحزورات” لشرح الاختلافات وأوجه التشابه فيما كانوا يصفونه باستخدام نظام يعرفه الكثير من القراء جيداً، ويمكن أن يتجاوبون معه بسهولة شديدة.
انتقاء المعنى:
تقول الفلسفة إننا قد نفهم الأسماء، وغيرها من تعبيرات الإحالة، على أنها “انتقاء” للمراجع الدلالية للمعنى، التي تنسب إليها بقية الجملة لتعبر عن شيء ما، بشكل تقريبي للغاية.[19] من هنا، كانت نظريات المعنى المشروطة بالحقيقة جذابة جداً لأولئك الذين يفضلون دلالات طبيعية واختزالية، ولا يروق لهم أي شيء خارج العالم الطبيعي كشرح لهذا المعنى. وقد جرى، في النصف الثاني من القرن العشرين، توجيه الكثير من الاهتمام في هذا المجال إلى نظريات هذه المراجع الدلالية، نظراً لأهمية شرح مساهمتها في الحسابات النظرية للحقيقة. إن الرأي بأن معنى الأسماء الصحيحة كان دالة لمجموعة من الأوصاف، قاد العديد من الفلاسفة إلى البحث عن تفسير مشروط للحقيقة لتضمين مثل هذه الأوصاف في شروط التحقق من الجمل، التي حدثت فيها كوسيلة للتفسير. ومع ذلك، بدأت موجة جديدة من الاهتمام بأشكال مرجعية أكثر مباشرة في السبعينيات. وفي حين أن مثل هذا المزيج من الاستخدام والتحقق قد يكون واضحاً للجمل والشروط، التي يتم الحصول عليها أحياناً، إلا أنها مسألة أخرى تماماً في الحالات، التي لا يحدث فيها ذلك، كنظرتنا لاتساق الأرقام هذه، والتي تزيأ بها تاريخ نشر الكتاب.
إن هذا مبحث عميق، وذهبت فيه اجتهادات كثيرة، ولا شك أن هناك حاجة إلى مزيد من التفصيل للأفعال والمفردات المنطقية والأرقام وفئات المصطلحات الأخرى، ليس هذا مجال حصرها، لكن نُشير فقط إلى أن معظم الفلاسفة اتخذوا العمود الفقري لحساب المعنى ليكون دلالة، واستخدام اللغة ليكون عملية لإدارة العلامات “الرموز” والعلاقات مع المعنى. وقد تشير هذه العلامات إلى الأشياء بشكل مباشر، أو قد تفعل ذلك بشكل غير مباشر من خلال الوقوف على شيء ما في أذهاننا، على غرار ما قال به جون لوك، الذي وصف الكلمات بأنها “علامات على الأفكار”، التي تجعل الإنسان يَحِسُّ بالمعنى لِيُدْرِكه.[20] ومع ذلك، واجهت الحسابات، التي أكدت على الإشارة إلى المصطلحات على أنها مكونة لمعنى معظم التعبيرات، مشكلتين خطيرتين؛ هما، الفشل في شرح إمكانية المصطلحات غير المرجعية، وعدم القدرة على التعرف على الجمل الوجودية السلبية، لأن الإدراك الحسي يعتبر كاملاً ودقيقاً، لكن التجريد هو أول عملية ذهنية تنتمى لملكة الفهم، التي نستطيع بها الوصول إلى الأفكار المركبة. وقد مَرَّت قرون من الأبحاث والدراسات، بما في ذلك جهود الفلاسفة؛ مثل فيتغشتاين، ومؤخراً تشومسكي، ويظهر الآن كتاب “لعبة اللغة” ليوضح كيف يتعلم الناس التحدث؛ ليس من خلال اكتساب معاني وقواعد ثابتة فقط، ولكن، كما أسلفنا، عن طريق التقاط وإعادة استخدام، وإعادة دمج أجزاء لغوية لا حصر لها بطرق جديدة. من هنا، وبالاعتماد على أمثلة مسلية ومقنعة من جميع أنحاء العالم، يشرح الكتاب كيف تتكيف ذاكرتنا قصيرة العمر مع الطوفان المتسارع من الأصوات، التي هي الكلام اليومي. وتعتمد لعبة كريستيانسن وتشاتر على مجموعة رائعة من الأمثلة لإظهار الطريقة، التي تعمل بها اللغة، وقد شكلت تطورنا وهي ضرورية لمستقبلنا.
فلسفة اللغة:
يُستخدم مصطلح “فلسفة اللغة” عادةً للإشارة إلى العمل في مجال الفلسفة التحليلية الأنجلو أمريكية، وجذورها في الفلسفة الألمانية والنمساوية في أوائل القرن العشرين. غير أن لدى العديد من الفلاسفة، خارج هذا التقليد، وجهات نظر حول طبيعة اللغة واستخدامها. وأصبحت الحدود بين الفلسفة “التحليلية” و”القارية” أكثر سهولة بمرور الوقت، ولكن معظم الذين يتحدثون عن هذا المجال يجتذبون مجموعة محددة من المؤلفين التقليديين، الذين يصرون على اتباع الطرق المتعارف عليها. مع معرفتنا بأن تاريخ فلسفة اللغة يبدأ في التقليد التحليلي بالتقدم في المنطق وبتوترات داخل الحسابات التقليدية للعقل ومحتوياته في نهاية القرن التاسع عشر. ونتجت ثورة من نوع ما عن هذه التطورات، المعروفة غالباً باسم “المنعطف اللغوي” في الفلسفة. ومع ذلك، واجهت برامجها المبكرة صعوبات خطيرة بحلول منتصف القرن العشرين، وحدثت تغييرات كبيرة في الاتجاه نتيجة لذلك.
لقد حدث الكثير من الإعداد لما يسمى بـ “المنعطف اللغوي” في الفلسفة الأنجلو أمريكية في منتصف القرن التاسع عشر، إذ تحول الانتباه إلى اللغة، واعتبر الكثيرون أنها نقطة محورية في فهم الإيمان وتمثيل العالم، وصار يُنظر إليها على أنها “وسيط للمفاهيم”، كما يرى ويلفريد سيلارز.[21] وفي وقت لاحق، طور المثاليون العاملون في أعقاب “إيمانويل كانط” حسابات “متعالية” أكثر تعقيداً لظروف إمكانية التجربة، وقد أثار هذا ردود فعل قوية من الفلاسفة الواقعيين والمتعاطفين مع العلوم الطبيعية.[22] وحقق العلماء أيضاً تقدماً، في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، في وصف الوظائف المعرفية، مثل إنتاج الكلام والفهم، كظواهر طبيعية، بما في ذلك اكتشافهم لمنطقة “بروكا” ومنطقة “فيرنيك”، وهما مركزان عصبيان للنشاط اللغوي.[23]
بيد أن “جون ستيوارت ميل” أعاد العمل حول هذا الوقت تنشيط التجريبية البريطانية، التي تضمنت مقاربة للغة تتبعت معاني الكلمات الفردية للأشياء، التي أشاروا إليها.[24] وأدت تجريبية “ميل” إلى الاعتقاد بأنه لكي يكون للمعنى أية أهمية لفكرنا وفهمنا، يجب علينا شرحه من حيث خبرتنا. وبالتالي، يجب فهم المعنى في نهاية المطاف من حيث الكلمات، التي تمثل مجموعات من انطباعات عن هذا المعنى. وقطعاً لا يشارك جميع المهتمين باللغة ميول “ميل” التجريبية، على الرغم من أن معظمهم شاركوه في إحساسه بأن الدلالة، بدلاً من الصفة، يجب أن تكون في مركز تفسير المعنى. وتُشير الكلمة إلى شيء ما من خلال الوقوف عليه، كما يرمز اسم “بالتيمور” إلى مدينة معينة على الساحل الشرقي لأمريكا؛ وتُشير الكلمة ضمنياً إلى شيء ما عندما “تدل على سمة” بمصطلحات “ميل”، حيث تشير كلمة “أستاذ” عموماً إلى خبير في مجال أكاديمي، وشخص لديه أنواع معينة من السلطة المؤسسية. بالنسبة لمعظم التعبيرات، اعتقد الفلاسفة أن فهم معانيها يعني معرفة ما تمثله، لأننا غالباً ما نفكر في الأسماء الصحيحة، التي تعمل ببساطة كتسميات للأشياء، والتي تشير إليها. فقد مال “ميل” أيضاً إلى استخدام “المعنى” في الحديث عن الدلالة، وقد يكون لديه تحفظات على القول إن أسماء العَلَم لها “معانٍ”، على الرغم من أن هذا لا ينفي أنها تشير إلى أشياء.
مفهوم اللغة:
لقد أكد فيتغنشتاين، من خلال التحليل المنطقي، أنه يمكننا الوصول إلى مفهوم للغة على أنها تتكون من افتراضات أولية مرتبطة بالعناصر المألوفة الآن لمنطق الدرجة الأولى، أي أن أية جملة لها معنى يمكن أن يتم تقديمها به بشكل واضح في مثل هذا النظام، وأية جملة لا تخضع لمثل هذا التحليل لن يكون لها معنى على الإطلاق. وكل ما يمكن التفكير فيه على الإطلاق يمكن التفكير فيه بوضوح، وكل ما يمكن قوله، يمكن أن يقال بوضوح. وادعاء فيتغنشتاين هنا ليس لأننا لا نستطيع تجميع الكلمات معاً بطرق غير واضحة؛ في الواقع، نحن نفعل ذلك طوال الوقت. بل بالأحرى، عند قيامنا بذلك، فإننا لا نعبر عن أي شيء له معنى. فقد يحظى ما نقوله بإيماءات موافقة من زملائنا المتحدثين، وقد نفهم شيئاً مهماً، لكن ما نقوله لا ينقل أي شيء ذي معنى. ويعكس هذا جزئياً وجهة نظر فيتغنشتاين المبكرة بأن الافتراضات “تصور” العالم، وهذا لا يعني أن نقشاً مكتوباً، أو نطقاً لفظياً لجملة يشبه بصرياً تلك الحالة، التي تعبر عنها. بدلاً من ذلك، يشبه شكل الافتراض صورة بعض الحقائق في العالم، وما كان مطلوباً لفهم هذا كصورة للعالم هو فقط ما كان مطلوباً في حالة الصور الفعلية، أي أنه تنسيق للعناصر في الصورة مع الأشياء الموجودة خارجها، وستكون الحقائق المنطقية صحيحة بفضل العلاقات بين افتراضاتها. وإذ يمكننا القيام بذلك الآن، كانت اللغة توضح شيئاً ما بجلاء؛ حيث لم نتمكن من تصوره قبل افتراضه، على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا، وكأن الكلمات كانت لا تقول أي شيء على الإطلاق. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن كل شيء عن المعنى وفهمنا للعالم لم يكن مسألة تعريف واضح، أو أي شيء يمكننا قوله.
والمعروف أن فيتغنشتاين اعتنق أيضاً عدداً من الآراء في نهاية “المراجعات” على الانتماء والإرادة والأخلاق وما يمكن أن يقال عنها؛ لكن تظل هذه بعضاً من أصعب نقاط التفسير في عمله. إذ اعتبر فيتغنشتاين نفسه أنه قد وضع حدوداً لما يمكن أن تقوله الفلسفة، وأغلق الرسالة دون تعليق إضافي بقوله، “بما أننا لا نستطيع التحدث، يجب أن نبقى صامتين”. ربما قاد هذا الصمت الوضعيين إلى أن نظرية التحقق من المعنى ستكون فيها الجمل التحليلية صحيحة بحكم معاني مصطلحاتها، في حين أن جميع الجمل التركيبية يجب أن تعترف بنوع من معايير التحقق التجريبية، وأن أية جملة لا يمكن التحقق منها بواحدة، أو بأخرى من هذه الوسيلة تعتبر بلا معنى. وفي عالم الواقع، يستبعد الوضعيون هذا الادعاءات ليس لأنها ذات أهمية صوفية، أو باطنية، ولكن أيضاً لأنها تفتح مجالات واسعة من علم الكلام في الأخلاق والميتافيزيقا، كما مارسها العديد من الفلاسفة وأهل العرفان. لذلك، واجهت نظرية المعنى التحققي صعوبة كبيرة على الفور تقريباً، وغالباً بسبب الاعتراضات بين الوضعيين. على سبيل المثال، فإن أية جملة تُشير إلى النظرية نفسها لم تكن تحليلية ولا تخضع للتحقق التجريبي، فهي إما أن تدحض نفسها بنفسها، أو لا معنى لها.
ففي كتابه ” تحقيقات فلسفية”،[25] الذي نُشر عام 1953 بعد وفاته، قطع فيتغنشتاين عن بعض التطلعات النظرية للفلسفة التحليلية في النصف الأول من القرن. إذ سعى فلاسفة اللغة التحليليون جاهدين إلى إيجاد أنظمة منطقية أنيقة، ومن خلال التحقيقات، اقترح أن اللغة عبارة عن مجموعة متنوعة وزئبقية من “الألعاب اللغوية”، وأنشطة اجتماعية موجهة نحو الهدف، الذي كانت الكلمات، التي استخدمت من أجله مجرد أدوات كثيرة لإنجاز ذات الأشياء، بدلاً من المكونات الثابتة والأبدية في بنية منطقية. فقد كان التمثيل والدلالة والتصوير بعض الأهداف، التي قد نحققها في لعب لعبة لغوية، لكنها بالكاد كانت الأهداف الوحيدة. وأدى هذا التحول في فلسفة فيتغنشتاين إلى اهتمام جديد بالأبعاد “البراغماتية” لاستخدام اللغة. لذلك، فإن الحديث عن الأهمية البراغماتية للتعبير بهذا المعنى هو النظر في الكيفية، التي يمكن أن يتجلى بها الإدراك في الأفعال، أو في توجيه الأفعال، وبالتالي، تحويل انتباهنا إلى الاستخدام بدلاً من المفاهيم المجردة للشكل المنطقي الشائعة في الأشكال السابقة من الفلسفة التحليلية.
هكذا، إذا كانت اللغة خاصة، فإن الطريقة الوحيدة لتأسيس المعاني ستكون من خلال شكل من أشكال التعبير الشخصي. على سبيل المثال، التركيز على تجارب المرء والقول بشكل خاص، “سأطلق على هذا الإحساس اسم “ألم”. ولكن لتحديد معنى الإشارة، يجب أن يثير الأمر شيئاً ما لدى المتحدث تدفعه لاستخدام هذه الإشارة بشكل صحيح في المستقبل، وإلا فلن يكون للتعبير المفترض أية قيمة. بافتراض أننا بدأنا بمثل هذه الحلقة الخاصة، فما الذي يمكن أن يحدث في الاستخدامات اللاحقة للمصطلح؟ لا يمكننا أن نقول ببساطة إنه يشعر بالشيء نفسه بالنسبة لنا، كما فعلنا من قبل، أو يضربنا نحن بنفس الطريقة، لأن هذه الأنواع من الانطباعات شائعة حتى عندما نرتكب أخطاء، وبالتالي لا يمكن أن تشكل دليل صحة. قد يقول المرء إن على الشخص أن يتذكر فقط كيف استخدم نفس الطريقة في الماضي، لكن هذا لا يزال يتركنا نتساءل. ماذا يتذكر المرء في هذه الحالة؟ إلى أن نقول كيف يمكن لحلقة خاصة أن تؤسس نمطاً للاستخدام الصحيح، إذ إن الذاكرة تكون بجانب هذه النقطة. للتخفيف من هذه الصعوبة، وجه فيتغنشتاين انتباهه إلى مجال الظواهر العامة، واقترح أن أولئك الذين يقومون بنفس التحركات، وفقاً للقواعد، يتشاركون في “شكل من أشكال الحياة”، التي اعتبرها معظمهم ثقافة المرء المنتمي، أو مجموع الممارسات الاجتماعية، والتي يشارك فيها الفرد مع الجماعة.
مسك الختام:
سيجد القارئ، في هذا الكتاب، منظوراً ثورياً قد يُغير، تقريباً، أشياء كثيرة، اعتقدنا أننا نعرفها عن اللغة، ويرى كيف تكشف لعبة “الحزورات”، إذ يتم حظر الاتصال اللغوي، بشكل متناقض عن رؤى عميقة حول كيفية عمل اللغة. ويتضح كيف يكون الدماغ قادراً على ارتجال “الحركات” اللغوية بمعدل سريع مذهل، وكيف نخلق المعنى “في الوقت الحالي”، وكيف تنبثق الأنماط الغنية والمعقدة في اللغة من تراكم طبقات الألعاب السابقة بدلاً من ذلك. من مخطط وراثي فطري، أو من غريزة اللغة، وكيف أن اللغات في تغير مستمر، وكيف يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم لغة مشتركة أن يخلقوا لغة من نقطة الصفر بسرعة مفاجئة، ولماذا من المحتمل أن تكون اللغة قد أعيد اختراعها بشكل مستقل مرات لا تحصى، ويمكن أن تتطور الألعاب اللغوية في اتجاهات عديدة، مما يؤدي إلى التنوع المذهل للغات في جميع أنحاء العالم، ولا يعد إنشاء اللغة مهماً في حد ذاته فحسب، بل إنه يغير طبيعة التطور أيضاً، إنه ما يجعل الثقافة الإنسانية ممكنة بقوانينها وأديانها وفنونها وعلومها واقتصادها وسياستها.
من هذا المنظور، فإن تعلم اللغة يشبه تعلم أن تكون جزءاً من سلسلة من ألعاب “الحزورات”، التي لا تنتهي على مستوى المجتمع، إذ تعتمد كل لعبة جديدة على تلك، التي مرت من قبل. ولا يبدأ كل جيل جديد من متعلمي اللغة من الصفر، ولكنه ينضم إلى تقليد من الألعاب اللغوية، التي كانت قيد التقدم من قبل أن يتذكرها أي شخص. ومن أجل الانضمام إلى اللعبة، يحتاج الطفل، أو الشخص البالغ، الذي يتعلم لغة ثانية، إلى الدخول في لعبة لغوية جديدة، والبدء في اللعب بشروطٍ مختلفةٍ. مما يعني أن هذه هي الطريقة المُثلى، التي يتقنون بها تدريجياً تحديات تواصلية محددة، واحدة تلو الأخرى. إذ إن تعلم اللغة هو معرفة أن تصبح لاعباً ماهراً في “الحزورات”. لذلك، فإن لعب الألعاب اللغوية بنجاح، يحتاج إلى أن يكون المنخرطين فيها ماهرين في التعامل بشكل عفوي وتلقائي مع التفاعلات البشرية اليومية، وبهذا لن يكونوا بحاجة إلى تعلم نظام تجريدي للأنماط النحوية، لأنهم ليسوا بحاجة لِتَذَكُّر قواعد لغتهم تماماً، كما يلعبون الكرة دون معرفة قوانين الفيزياء، أو يغنون دون معرفة نظرية الموسيقى، وبهذا المعنى الحقيقي والمهم للغاية، فنحن نتحدث ونفعل ذلك بمهارة وفعالية، من دون معرفة لغتنا على الإطلاق.
إن كل هذا هو ما يحاول كريستيانسن وتشاتر تِبْيَناهُ، وكما أوردنا في البدء، فهذا كتاب رائع حقاً، ويجب أن يقرأه كل شخص مُحِبٌ للغة، أو عاشق للكلمة، أو مولَعٌ بأساطير البدايات. وبالتالي، أي مهتم باللسانيات، إذ قام المؤلفان بعمل جاد باستعارة لعبة “الحزورات”، واستخدامها لشرح الاختلافات وأوجه التشابه، فيما كانوا يصفونه بنظام يعرفه الكثير مِنَّا جيداً، ويمكن أن يرتبط به بسهولة شديدة. فكل من يحب تعلم اللغات، سيكون متشوقاً لمعرفة ما يمكن أن يجده في كتاب “لعبة اللغة”، لأنه بشكل عام، سيمنحه قراءة ممتعة ومسلية، ويقدم له عدداً من النظريات والأمثلة المثيرة للاهتمام. وأعتقد أن عرض هذه النظريات و”الحزورات” كان مناسباً بشكل خاص، وكانت هناك بعض المعلومات المفيدة؛ بين الصفحات، حول كيفية عمل الجوانب المختلفة للمفردات والقواعد، بلغات متنوعة حول العالم. مع ملاحظة، لم تفت على آخرين ممن طالعوا الكتاب، أن قسماً، أو قسمين، منه قد اتسما بشيء من الجفاف، ورتابة هنا وهناك، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر من هذا السِفْر القيم، يمكنني القول باطمئنان إن قراءته والاستمتاع به من قبل اللغويين والأشخاص العاديين على حدٍ سواء، ستكون مُجدِية، وذات نفعٍ كبير، نظراً لأن المفاهيم المقدمة فيه شُرِحَت جيداً، وعُرِضَت بشكل عام بمصطلحات سهلة، فإذا كنت معنياً بتاريخ اللغة وكيف تعلمناها، ونتعلمها، فستجد؛ بلا شك، كتاب “لعبة اللغة” مُفيداً وجديراً بالاهتمام.
لهذا، ولغيره، وقع كتاب: “لعبة اللغة: كيف خلق الارتجال اللغة وغيّر العالم”، لمؤلفيه مورتن كريستيانسن ونيك تشاتر، في نفسي موقعاً حسناً، لما قدماه من قراءة رائعة، تغطي الطرق المختلفة، التي تتطور بها اللغة، والعوامل، التي لعبت دوراً لإظهار هذا التطور. إذ قاما بتوضيح المكان، الذي يجب أن يكون فيه المفهوم جيداً، وكيف يُصاغ ويُلفَظ بهدف إظهار كيفية عمل كل نقطة، لا سيما عندما تنظر إلى كيف يمكن لقرار عاطفي بسيط أن يحدث فرقاً كبيراً بين ما تراه وما تشعر به أنك تراه. وإذا تفحصنا هذا الكتاب بنظرة متأمِّلَة، فإن تلخيص جميع النقاط يُسَهِّل الوصول إليها دون فقد السياق، والذي كان بالنسبة لكتاب عن اللغة هو كل ما كان يجب أن يكون عليه. إنه يغطي طبيعة كيفية إضاءة اللغة للمعنى، وكيف يمكن تشويهه بعدم إحسانها. فالإشارة إلى أن الإبداع المرتجل للغة البشرية هو، الذي يجعل التواصل الحقيقي بين البشر من الصعب تقليده بواسطة الذكاء الاصطناعي. وهذا بدوره له آثار عميقة على ما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر ستتمكن حقاً من التفوق علينا في المستقبل القريب، أم لا.
تفاصيل:
[1] جاءت تسمية هذا السفر “العدد” عن الترجمة السبعينية المسيحية، وعنها أخذت كل الترجمات الحديثة. وهذه التسمية تناسب الإصحاحين الأول والسادس والعشرين من السفر حيث ورد في كل منهما إحصاء عددي للشعب اليهودي، إذ جرى الإحصاء الأول في سيناء في السنة الثانية لخروجهم، وتم الثاني بعد حوالي 39 سنة في سهول موآب قبل دخولهم أرض الميعاد مباشرة. أما النسخة العبرية فجاء فيها اسم هذا السفر “بمدبار”، أي في البرية، وهما الكلمتان الرابعة والخامسة في الإصحاح الأول والتسمية العبرية تعبر بأكثر دقة عما حواه السفر، لكونه سفر رحلات الشعب اليهودي في البرية.
[2] كاليب إيفريت، أستاذ ورئيس قسم الأنثروبولوجيا في جامعة ميامي بأمريكا، يستكشف بحثه الموسوم: “الأرقام وصنعنا: العد ومسار الثقافات البشرية”، الذي صدر في 13 مارس 2017، عن مطبعة جامعة هارفارد، تقاطع اللغة والفكر. ويقول إن هناك أرقام يمكن التنبؤ بها في الطبيعة، ولكن لدينا نحن البشر إحساس رقمي فطري “دقيق” للأعداد التي تصل إلى ثلاثة فقط. ويقترح عالم الأنثروبولوجيا كاليب إيفريت أن “الأرقام” أو “الكلمات والرموز الأخرى لكميات محددة” هي “مجموعة رئيسية من الابتكارات القائمة على اللغة التي ميزت جنسنا بطرق لم يتم تقديرها بشكل كافٍ. … لقد أعادوا تشكيل التجربة الإنسانية”.
[3] قبل 44,000-43,000 سنة، قام شخص ما في السلاسل الجبلية بين جنوب أفريقيا وسوازيلاند بنحت تسعة وعشرين خطا في جانب شظية البابون، ربما لتتبع الأيام في دورة قمرية. في فرنسا، عظم عمره 28000 عام يعرف باسم لوحة Abri Blanchard يحجب النقوش التي قد تمثل أيضاً مراحل وحركة القمر؛ ويحمل قرن الوعل لأيائل الرنة عمره 10 آلاف عام عثر عليه بالقرب من ميامي الحالية علامات حصيلة تشير على الأرجح إلى كميات، مثل الأيام أو دورات القمر.
[4] ريمي ريفيل، “الثورة الرقمية..ثورة ثقافية؟”، ترجمة “سعيد بلمبخوت”، إصدار عالم المعرفة، المجلس الوطني للفنون والثقافة، الكويت، يوليو 2018. يناقش هذا الكتاب تأثير “الرقمنة” على الثقافة، سواء في طريقة إنتاج النصوص، أو توزيعها، أو طبيعة التفاعل الإنساني على الانترنت، ومن تأتي أهميته للمتخصصين في الإعلام، والثقافة، وعلم النفس، والتربويين.
[5] إن قصة “آدم وحواء”، هي أول رواية متكاملة تُليت علينا في الديانات الإبراهيمية. وباعتبارهما أول رجل وامرأة، فإنَّ هذه القصة أساسية للاعتقاد القائل بأن الإنسانية هي في جوهرها عائلة واحدة، حيث ينحدر كل شخص من زوج واحد من الأسلاف الأصليين.
[6] يعتبر القديس أوغسطين أعظم فيلسوف مسيحي في العصور الوسطى، وبالتأكيد هو الفيلسوف صاحب التأثير الأعمق والأطول في الأخلاق والسياسة، ونظريته في المعرفة.
[7] الصادق الفقيه، “مئوية فيتغنشتاين؛ مراجعات في مسارات المنطق الفلسفي”، مجلة وموقع التنويري، عمان، الأردن، 27 مايو 2021. https://altanweeri.net/6431/1
[8] كانت “شفرة نافاجو” مبادرة من الطبيب البيطري “فيليب جونستون”، ابن مبشر مسيحي، نشأ في محمية “نافاجو” للهنود الحمر في شمال نيو مكسيكو. وعلى الرغم من أنه لم يكن من قبيلة “نافاجو”، فقد تعلم اللغة عندما كان شاباً. في وقت لاحق، سمع جونستون عن جنود يتحدثون لغة “التشوكتو” فاقترح أن يتواصلوا عبر الراديو، ويخدعون الألمان في معركة حاسمة. وقد استخدم المصريون في حرب أكتوبر لغة “النوبة” لإيصال رسائلهم بين وحداتهم العسكرية المختلفة.
[9] ظلت نظرية نعوم تشومسكي اللسانية بمثابة طفرة حقيقية غيرت من مسار اللسانيات، ورسمت لها طريقاً نحو تحقيق نجاحات باهرة. وما استغربناه هو لماذا أشار تشومسكي إلى “الشتات الأفريقي” كحالة دراسة، ولم يأخذ اليهود، الذين ينتمي إليهم، والذين ارتبطت بهم كلمة “شتات”.
[10] ليف فيجوتسكي، “الفكر واللغة”، الصادر عام 1934، من كتاب “لعبة اللغة”، ص 198.
[11] تعيّن الداروينية شكلاً مميزاً من التفسير التطوريّ لتاريخ وتنوع الحياة على الأرض، وردت صيغته الأصلية في الطبعة الأولى من كتاب “أصل الأنواع On the Origin of Species”، في عام 1859. يصوغ هذا المدخل أولاً “داروينية داروين” من حيث هي خمس موضوعات، هي: فلسفيّة مميزة: الاحتمال والصدفة، وطبيعة الانتقاء وقوته ونطاقه، والتكيف والغائية، والاسمية مقابل “الجوهرية/الماهية” حول الأنواع، وطريقة التغيير التطوري وإيقاعه.
[12] ينظر له في بريطانيا كمستكشف لأرض الجنوب وبحار شهير، قام بمهام وطنية لخدمة بلاده، لكنه بالنسبة للشعوب الأصلية التي استكشفها كان يعد غازياً ومستعمراً ودموياً.. كانت تييرا ديل فويغو، التي تقع في أرخبيل الطرف الجنوبي من قارة أمريكا الجنوبية مقسّمة بين الأرجنتين وتشيلي، ويسميها أهلها من الـ”هاوش” بالاسبانية، التي تعني “أرض النار”، من أولى المحطات، التي مر بها كوك في رحلته الأولى على متن سفينة “إتش إم إس إنديفور”.[13] بالنظر إلى أن الحزورات تتضمن الحصول على نقطة عبر الإيماء، باستخدام اليدين عادةً، فقد يبدو أن فكرة اللغة كحزورات لا تنطبق على اللغة المنطوقة. بعد كل شيء، اللغة المنطوقة، أو النطق من أي نوع، غير مسموح به عادة في لعبة الحزورات. هل تعني قصة اللغة من الحزورات أن اللغات البشرية بجميع أنواعها يمكن إرجاعها إلى شكل من أشكال لغة الإشارة؟ من بين أمور أخرى، يشك مايكل توماسيلو، عالِم علم النفس التنموي بجامعة ديوك في نورث كارولينا، في أن هذا قد يكون هو الحال.
[14] تقول أسطورة “بروميثيوس” إنه من أجل تسهيل الحياة على الناس، سرق بروميثيوس النار من الآلهة وأخذها إلى الناس العاديين، مضحياً بنفسه من أجل هذا الهدف النبيل. والنار هنا ترمز إلى نور المعرفة، التي تبدد المخاوف والشك الذاتي والاستسلام لأحداث مستقبلية مجهولة. لذلك، يرتبط معنى الوحدة اللغوية “نار بروميثيان” ارتباطاً وثيقاً بالمعرفة الفكرية والإبداع.
[15] ريتشارد دوكينز هو مؤلف كتاب: “الجين الأناني”، مطبعة جامعة أوكسفورد، الطبعة الأولى عام 1976، وفيه يقدم دوكينز حجته حول التطور من خلال التركيز على الجين نفسه، بينما اعتبر آخرون أن التطور يحدث على مستوى الفرد أو المجموعة. ويرى دوكينز هنا عملية الانتقاء الطبيعي بشكل مختلف، ليس الفرد فيها أكثر من وعاء لـ”جين أناني” دافعه الوحيد هو ضمان بقاءه في المستقبل، حتى لو كان ذلك يعني موت الفرد.
[16] وإشارتنا إلى الأرقام قد يتأتى فهمها بقراءة كتاب تيم هارفورد، الموسوم بعنوان: “كيف تجعل العالم يضيف”، الصادر عن مطبعة ليتل بروان، في 7 مايو 2020، وفيه يقول إن الأرقام والإحصائيات الجيدة تساعدنا على رؤية أشياء عن العالم من حولنا وعن أنفسنا، كبيرها وصغيرها، التي لن نتمكن من رؤيتها بأي طريقة أخرى.
[17] اشتهر عالِمُ اللسانيان دانييل ل. ايفريت بكتابه المعنون: “لا تنم فهنا توجد أفاعٍ: الحياة واللغة في غابات الأمازون”، الذي أصدرته بانتيون بوك، بلندن، عام 2009. وقد سجل فيه تجربته في دراسة لغة الـ”بيراها”، التي يصفها بأنها “لا تشابه اللغات الأخرى.” وذلك لأنها لا تعرف تصريف الأفعال بصيغة الماضي، وتفتقر تماماً للأرقام، وليس فيها أية لفظة للدلالة على الألوان، ولا أي تعبير للدلالة على الحروب، أو على الملكية الخاصة. وأبناء الـ”بيراها” لا يعرفون شيئاً عن “الأساطير”، التي تدل على أصولهم الأولى.
[18] قدمت عالمة النفس “باربرا تفيرسكي”، في كتابها: “العقل في حركة: كيف شكلت الحركة الفكر”، الصادر عن مطبعة بايزك بوكس، في 21 مايو 2019، نظرية جديدة رئيسة للإدراك البشري، قائلة إن الحركة، وليس اللغة، هي أساس الفكر، فعندما نحاول التفكير في طريقة تفكيرنا، لا يسعنا إلا التفكير في الكلمات. وفي الواقع، وصف البعض اللغة بأنها مادة الفكر. لكن الصور يتم تذكرها أفضل بكثير من الكلمات، ووصف الوجوه والمشاهد والأحداث يتحدى الكلمات.
[19] “فلسفة اللغة”، بقلم مايكل ب. وولف، موسوعة الإنترنت للفلسفة، ISSN 2161-0002، https://iep.utm.edu/lang-phi/، الأحد 3 أبريل 2022.
[20] لقد كان لوك فيلسوفاً تجريبياً حسياً ومن أكبر أعمال لوك مقال عن الفهم الإنساني، الذي يشرح فيه نظريته حول الوظائف، التي يؤديها العقل “الذهن” عند التعرف على العالم. واشتهر جون لوك زعيم الحسيين بعبارته المشهورة: “إذا سألك سائل: متى بدأت تفكر؟ فيجب أن تكون الإجابة: عندما بدأت أحس”. وقد سلم لوك بعجز العقل البشري وقصوره عن معالجة ما يتجاوز حدوده وإمكانياته وقد وضح ذلك في معظم كتبه ولا سيما كتابه “مقال في الفهم الإنساني”، وكتابه “عن العقل البشري”، وخلاصتهما أن العقيدة السائدة قبل لوك هي أن العقل البشري يشتمل على بعض الأفكار الفطرية الموروثة منذ الولادة دون أن يكتسبها العقل من التجارب، التي تمر به أثناء الحياة ولقد بلغ من رسوخ هذا المذهب في نفوس أنه لم يكن يستهدف حتى لمجرد البحث والجدل.
[21] صاغ ويلفريد ستوكر سيلارز (20 مايو 1912 – 2 يوليو 1989)، الذي كان فيلسوفاً أمريكياً ومطوراً بارزاً للواقعية النقدية، مصطلحات معينة شائعة في الفلسفة، مثل “فضاء الأسباب”. يشير هذا المصطلح إلى شيئين، هما: وصفه الشبكة المفاهيمية والسلوكية للغة، التي يستخدمها البشر للتغلب بذكاء على عالمهم، وإشارته إلى حقيقة أن الحديث عن الأسباب، والتبرير المعرفي، والنية ليس هو نفسه، ولا يمكن بالضرورة ربطه، بالحديث عن الأسباب والآثار، بمعنى أن العلوم الفيزيائية تتحدث عنها. وقد أحدث بذلك ثورة في كل من المحتوى ومنهج الفلسفة في الولايات المتحدة.
[22] اهتم فيلسوف الأنوار إيمانويل كانط (1724 – 1804)، بالشأن الديني في كتاب، أو العقلية المتعالية على الزمان والمكان، لا الشعائر التاريخية. لكن المصدر الأساس لأفكار هذه الفلسفة كان كتاب “نقد العقل المحض”، الذي صدر عام 1781م.
[23] تُنسب منطقة “فيرينك” إلى الدكتور كارل فيرنيك وهو طبيب أعصاب ونفسي ألماني. وقد افترض وجود صلة بين القسم الخلفي الأيسر من التلفيف الصدغي العلوي والقدرة على فهم الكلمات والمقاطع التي ترتبط بالصور الحسية والحركية للكلمات المنطوقة. وتُنسب منطقة “بروكا” إلى مكتشفها عالم الأعصاب الدكتور بول بروكا، وتوجد في مقدمة الفص الأيسر من الدماغ في الفص الجبهي، وهي المسؤولة عن تنفيذ عملية الكلام حركياً، وتشكيل وبناء الكلمات والجمل، وعن استخدام صيغة الجمع ووصف الأفعال واختيار الكلمات الوظيفية والسياق اللغوي كحروف الجر والعطف، وتقترب من، وتشترك مع، المناطق المسؤولة عن التحكم بحركة الجسم.
[24] رغم أن جون ستيوارت ميل اقتصادي بحكم تخصصه إلا أنه فيلسوف ومفكر؛ يعد من رموز المذهب النفعي وأحد أقطاب الفلسفة التجريبية، وأثرها في فلسفة اللغة.
[25] شر الكتاب بعد وفاته باللغة الألمانية في عام 1953، وباللغة الإنجليزية في عام 1959، وصدر بالعربية عن المنظمة العربية للترجمة، في 1 أبريل 2007. وناقش فيتغنشتاين العديد من المشكلات والألغاز في مجالات علم الدلالات، والمنطق، وفلسفة الرياضيات، وفلسفة علم النفس، وفلسفة الفعل، وفلسفة العقل، ويطرح وجهة النظر القائلة بأن التشويش المفاهيمي المحيط باللغة، الذي يأتي من الاستخدام هو أصل معظم المشاكل الفلسفية.
___________
* نقلًا عن موقع “التنويري”.