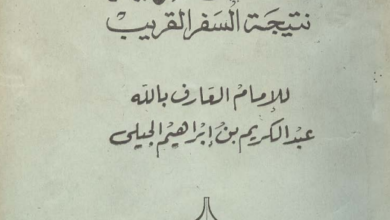الرَّوابط الموجودة بين الفلسفة والعرفان
مُحمَّد حسين بن موسى اللواتي
(هذا المقال مترجم من كتاب للشيخ مُرتضى المطهري، بعنوان “عرفان حافظ” باللغة الفارسية. والشيخ مطهري هو فكِّرٌ إسلامي كبير، وأحد أبرز رموز النهضة الحديثة في الفكر الديني. له عشرات المؤلَّفات والأعمال والنظريات والأفكار. استشهد مطلع انتصار الثورة الإسلامية في إيران).
—————————————————-
مَقصُوْدنا مِنَ “الفلسفة” هُو الإلهيَّات والفلسفة الأولى، أو الإلهيَّات التي تُناسب العِرفان، وليس الفلسفة بمعناها الواسع.
الحكمةُ الإلهيَّة قُسِّمت إلى قسمين (في اصطلاح المتأخرين): الأمور العامة أو الإلهيات بالمعنى الأعم، والإلهيات بالمعنى الأخص -ولم يذكر الشيخ الرئيس بن سينا في اصطلاحاته هذا المعنى.
هدفُ الفلسفة الإلهية بالنسبة للإنسان هو: أن يصبح الإنسان في نظامه الفكري كل العالم، ومن حيث المعرفة يصبح عالماً عقليا.
بينما هدف العرفان بالنسبة للإنسان هو: أن يصل الإنسان بكل وجوده إلى الحقيقة (الله) أن يفنى في الله، أن يصل.
طريق الحكيم وطريق العارف طريقان مختلفان؛ فطريق الحكيم هو طريق المنطق والبرهان، بينما طريق العارف هو طريق التزكية، والتصفية، والسير، والسلوك.
كما يُوْجَد هنالك تفاوت في الوسيلة أيضًا؛ فمركب الحكيم هو العقل، ومركب العارف هو القلب.
فلنرَ الآن أنَّه متى وُجِد العرفان على هيئة علم: علم ذُكر له موضوع وفائدة؟
فمثلا عرفان محيي الدين يختلف عن عرفان الشبلي النعمان؛ ففي عرفان الشبلي نرى رجال أهل عمل، بينما نواجه في عرفان محيي الدين الكُتب والكتابة، والتي انتشرت بوسيلته، وبوسيلة تلاميذه على صورة علم نظري.
فما هو موضوع العرفان؟ هل هو الوجود والوجود المطلق، وهل المقصود من ذلك هو الله؟
يُمكننا أنْ نرى هنا مُشابهة قريبة للعرفان بالحكماء والحكمة الإلهية؛ لأنَّ موضوع الحكمة الإلهية هو (الموجود بما هو موجود)، والتفاوت كامن في أن الحكيم يرى “الموجود بما هو موجود”، مفهوم كلي له مصاديق عديدة، ولكن في نظر العارف فإنَّ مسألة المفهوم ليست مطروحة أساسا؛ فهو يعتقد بحقيقة واحدة فحسب، وهي “ذات الحق”.
الحكيم يرى أن ذات الحق “موجود مطلق” أيضا؛ حيث ينقسم “الموجود بما هو موجود” عنده إلى: موجود، وجوده عبارة عن عين ذاته (أي الله)، وموجود وجوده زائد عن ذاته (أي كل ما عدا الله).
لنرَ متى وصلت الحكماء إلى هذه المسألة، وهي أن “الحق ماهيته آنيته”؟ هل كانت موجودة في زمان أرسطو، أو هذه المسألة قد طرحت في الفلسفة الإسلامية فحسب، وهي من ضمن تلك المسائل التي وجدت بسبب المواجهة بين آراء الفلاسفة والمتكلمين؟
لدينا شيئان مُسلَّمان هنا؛ أولا: لا نرى مثل هذه المسألة في كلام أرسطو وأفلاطون، بينما نراها في كلام ابن سينا.
فهل كان هنالك وجود للمذاهب الفكرية في الفترة الفاصلة بين أرسطو وابن سينا؛ بحيث قد أخذ ابن سينا والأفلاطونية الجديدة آراءهما منها، أم لا؟ من الممكن ذلك، وإلا فلا يوجد لدى أرسطو نفسه تصور عن الله غير “المحرك الأول”.
ونفس هذا التساؤل مطروح في موضوع العرفان: فهل تعدُّ نظرة العرفاء -والتي يرون فيها أنَّ وجود الحق موضوع لعلمهم- ابتكارية، أم أنَّ هنالك من قبلهم من كان يرى ذلك أيضا؟ من أجل التحقيق في هذه المسألة، يجب التوجه لأفكار الغنوصية والأفلاطونية الجديدة (1).
الحكمة الإلهية علمٌ يبحث في “عوارض الموجود بما هو موجود”، وإثبات وجود الله (واجب الوجود) يعدُّ من إحدى مسائل هذا العلم. فإثبات هل أن الموجود واجب أو ممكن، جوهر أو عرض…كلٌّ هذا (واجب، ممكن…) يعدُّ من عوارض “الموجود بما هو موجود”.
فمسألة وجود الواجب مسألة من مسائل الحكمة الإلهية، وهنالك حيث يعتبر العارف أن موضوع علمه هو (الموجود المطلق)؛ فإنَّ ذلك يعدُّ مسألة من مسائل الحكمة الإلهية، ومن حيث أنَّ موضوع كل علم لا يثبت في نفس ذلك العلم، بل يرجع في إثباته لعلم كلي آخر، وعليه فالعارف لا يحتاج إلى إثبات أن الله هو موضوع العرفان، ولكن الحكيم يثبت ذلك؛ لأن ذلك يعد من مسائل الحكمة الإلهية.
الخلاصة:
في نظرة الفيلسوف، فإنَّ مسألة وجود الله مسألة علمية، بينما في نظر العارف مسألة وجود الله هي موضوع علم (وجود وجود الحق). ومثلما أن في نظر الفيلسوف موضوع علمه -الموجود بما هو موجود- هو أمر بديهي ولا يحتاج للإثبات، فإنَّ في نظر العارف الله أمر بديهي ولا يحتاج لإثبات أيضا. الموضوع هنا هو موضوع بديهي؛ لذلك لا يحتاج للإثبات، ولا يعني ذلك أن لا يحتاج أي موضوع للإثبات، وما يجب إثباته هو صفاته فحسب. أما مسائل العرفان، فهي عبارة عن صفات وأسماء وتجليات ذات الحق تعالى.
أحد وجوه الاختلاف الأخرى الموجودة بين الحكماء والعرفاء هي أنَّ العرفاء يعتقدون بتجلٍّ واحد، ولا يعتقدون بالتكرار في التجلِّي؛ وذلك طبقا للآية “وما أمرنا إلا واحدة…”. فلله تجلٍّ واحد فحسب وهو “الوجود المنبسط”، والذي يسمونه أحيانا “بالحق المخلوق به”، كما لديهم أسماء أخرى له أيضا.
العرفاء لا يعبرون عن التجلي “بالعلية”. أما الحكماء، فهم يقولون بوجود مراتب للوجود والموجودات (أول ما صدر، وثاني ما صدر)، ويقولون بوجود عِلة غير ذات الحق تعالى أيضا، ولكن في طول ذات الحق.
العارف -وفضلا عن عدم استخدامه تعبير “العلية”- لا يعتقد بالتجلي الأول والثاني والثالث أيضا، ولو كان ذلك في الطول (2). فهو لا يقول بصدور عن ذات الحق تجلٍّ أول، ومن التجلي الأول تجلٍّ ثان.
العارف يقول بتجلٍّ واحد فحسب والمسمى “بالوجود المنبسط”، ويقول إنَّ كل الأشياء (كل الماهيات) وُجدت بذلك التجلي الواحد، ولا يقول مثل الفيلسوف بوجود علل بعدد الماهيات.
العارف يقول: كل الماهيات (الأعيان الثابتة) ظهرت بتجلٍّ واحد، وهي من لوازم تجلي ذات الحق تعالى، وظهورها عبارة عن ذلك التجلي الواحد.. هو يعبر عن الوجود المنبسط “بالظل” و”المرتبة الجمعية” (أي: تلك المرتبة التي تجتمع فيها كل الأعيان الثابتة).
كل هذه صور الخمرة وكل هذه النقوش المخالفة المظهر..
هي نور واحد لوجه الساقي واقعة في الكأس
الكثرات التي يقول بها الحكيم (الكثرات الطولية والعرضية، والأفلاك والعناصر، و…) هي كلها في نظر العارف من لوازم الوجود المنبسط؛ لذا فهو يقول بالوجود المنبسط “الحق المخلوق به” (أي الحق الذي خلقت وظهرت كل الأشياء به).
ولقد انتقد “المير داماد” كلام الحكماء -القائلين إنَّ الصادر الأول هو العقل الأول- وقال: الصادر الأول يجب أن يكون موجودا بحيث يكون كل الأشياء، ولا يمكن أن يكون موجودا في طول الموجودات الأخرى. وفي الواقع، فإن المير داماد هنا قد مال للعرفاء.
العرفاء يعتقدون أن الأشياء في كل “آن” تتجدد؛ ففي نظرهم أن العالم دائما في حالة فناء وإعادة الوجود، ولكننا نتخيل أنه عبارة عن شيء ثابت، في الحال:
في كل زمان تتجدد الدنيا…
ونحن لا خبر لنا عن التجديد في البقاء.
مسألة العلية:
الحكماء يطرحون في رؤيتهم مسألة الصدور والمصدر والصارد…؛ بمعنى أن الفلاسفة يعتقدون بنوع من نظام للموجودات صادر عن ذات الحق بترتيب معين (الصادر الأول والثاني والثالث).
بينما العرفاء لا يعتقدون لا بالصدور والمعلولية، ولا بتكاثر الصادرات. فالعارف عدو للكثرة، ومخالف للقول القائل بوجود ثانٍ للحق، وإنْ كان هذا الثاني معلولا وصادرا عن الحق.
العارف يعتبر وجود أي موجود بالجنب من الحق شريك للبارئ، ويرى أن الاعتقاد بذلك شرك، وطبقا لهذا فهو مخالف لأي نوع من العلية.
العارف يعتقد بالتجلي؛ فمفهوم “الخلق” الوارد في القرآن، هو في نظر الحكيم “علية” ذات الحق، بينما هو في رؤية العارف “تجلٍّ” لذات الحق.
فهل هذا النزاع نزاعٌ لفظي فحسب؟ بمعنى أن كلمة “الخلق” القرآنية، تسمى لدى العارف “بالتجلي” ولدى الحكيم “بالعلية”؟ لا، ليس هذا نزاعا لفظيا.
في التجلِّي والظهور هناك نوع من الوحدة الحاكمة بين الظاهر والمظهر؛ فالمظهر هو نفسه الظاهر، حقيقة التجلي هي نفسها المتجلي، تجلي شيء ما ليس أمرا ثانيا للشيء؛ فتجلي حقيقة ما، هو عبارة عن مرتبة من مراتب نفس تلك الحقيقة، وليس بمعني أنه موجود بالجنب من تلك الحقيقة.
ومن ضمن أعمال الملا صدرا العظيمة أنَّه قرَّب بين مفهوميْ “العلية” و”التجلي”، وأثبت أنَّ المعلول الواقعي (ليس إلا شأنا من شؤون العلة، وظهورا من ظهورات العلة ووجها من وجوهها)؛ ففي واقع الأمر أنَّه قد أرجع العلية إلى التجلي.
سابقاً كانوا يفترضون أن الرابطة الموجودة بين العلة والمعلول هي التي تربط بينهما، وذات المعلول ذات مستقلة ومرتبطة بالعلة، وهذا الارتباط يعدُّ زائدا على ذات المعلول؛ فمثلا إذا كان ألف علة والباء معلول، فإن الباء تعد منتسبة للألف، فهي حقيقة لها انتساب بالألف.
بينما أثبت الملا صدرا أنَّ المعلول الواقعي -وبتمام حقيقته- هو عين انتسابه لعلته؛ فحقيقة المعلول هي عين إضافته لعلته، وليس الأمر هو أن العلة تشرق المعلول، فيكون المعلول شيئا تعلق به الإشراق.
فالإيجاد هو عين الموجود، والإضافة هي عين المضاف، “فالإشراق” هنا هو عين “الشروق”؛ فليس المعلول ذاتا يتعلق بها الإشراق، والملا صدرا يثبت بالبرهان أن حقيقة العلية ترجع للتجلي.
العرفاء مخالفون للعلية -التي كان يقول بها الفلاسفة من قبل- فطبقا لما كانت تقول به الفلاسفة هو: أن ذات الحق علة للأشياء، فذات الحق -والتي هي علة- هي نفسها شيء، وعليتها -أي خلقها وإيجادها- هي شيء آخر، ووجود المخلوق هو شيء ثالث.
أمَّا في نظر الملا صدرا، فيصبح الخلق والمخلوق شيئا واحدا، ويعدان من شؤون العلة، وهما ليسا مُنفصلين عن العلة وثانيين لها. بمعنى أن التفاوت العلية مع المعلول -أي الإيجاد مع الوجود- هو تفاوت ذهني محض فحسب؛ فالكثرة الموجودة بين الإيجاد والوجود هي صرف كثرة من صنع الذهن.
أمَّا الكثرة الموجودة بين العلة والمعلول، فهي كثرة واقعية، وفي عين الحال ليست خالية من نوع من الوحدة. بمعنى أن المعلول ليس ثانياً للعلة، بل هو شأن من شؤونها، وبمنزلة الاسم والصفة لها؛ فالعلاقة بينهما مثل علاقة كل موصوف بصفة، والمسمى بالاسم، واللذين يعدان مرتبتين من مراتبهما.
إننا إذا ما وصلنا لحقيقة الأشياء (إلى وجودها)؛ فلا يمكننا حينها أن نفصلها عن المضاف إليه (الله)، ولكن لكوننا ندرك ماهيات الموجودات، فنشاهد الكثرة لا الوحدة.
في فلسفة الملا صدرا تمَّ التصالح بين عقيدة الفلاسفة والعرفاء، فإنَّه قد توصَّل إلى أن العلية ليست سوى التجلي، والتجلي لا يمكن أن يكون غير العلية.
نظرية “الخلق الجديد” للعرفاء:
مُفاد هذه النظرية لدى العرفاء هو “الانفصال”، ومعنى الانفصال هو أن العالم يتجدد لحظة بلحظة، ولا توجد فيه أي رابطة اتحادية بين هذا “الجديد” وذاك “القديم”، بل ما هو موجود هو قبض وبسط متعدد.
العرفاء لا يستدلون على ادعائهم هذا، بل يقولون هكذا قد كشف لنا (الوجود المنبسط فعله، والوجودات الخاصة أو الماهية أثره). ويقول الحاجي السبزاواري: “الماهيات توجد بالوجود المنبسط، والعالم عبارة عن الماهيات”؛ فالماهيات قد ظهرت “بتجلٍّ” واحد، والذي هو الوجود المنبسط، وهي منتسبة لهذا الوجود.
المراد من “العالم” عند العرفاء هو نفس هذه “الماهيات”. ولكن طبقا “للحركة الجوهرية”، فإنَّ هذه المسألة تعد غير صحيحة؛ لأن ما يلزم الحركة الجوهرية هو أن يكون الوجود وجودا سيالا متصلا، أي يكون على طول الزمان شيئا له الاستمرارية. طبقا للحركة الجوهرية؛ فالشيء المتحرك -والذي له حركة في جوهر أو عرض معين- إذا ما اتصف فإنه يتصف بوجود عرضه، هذا ما تؤيده نظرية الوجود السيال، لا أن الشيء ينعدم ثم يعاد للوجود. ففي الحركة الجوهرية لا محلَّ “للإيجاد والإعدام”.
موضوع الحركة باعتباره يساوي “المادة”، وباعتبار آخر، فإنَّ موضوع الحركة وما فيه الحركة هما شيء واحد، واختلاف الموضوع عمَّا فيه الحركة هو باعتبار (لا بشرط وبشرط لا)؛ مثل: البياض والأبيض.
والأمر في باب الحركة الجوهرية هو هكذا أيضاً؛ لأن الحركة فيها قائمة بذات، بينما في الحركة العرضية (ما قامت فيه الحركة) هو غير الحركة.
في الحركة العرضية -التي يكون فيها الموضوع جوهرا- وما فيه الحركة والذي هو العرض نفسه، يكون مثاله “جسم متحرك في البيض”.
وعلى كلِّ حال، ففي نظر صدر المتألهين، تعدُّ نظرية “الخلق الجديد” صحيحة.
قبل صدر المتألهين لم يقل أحد بأنَّ العالم يتجدد آنا بعد آن؛ لأنهم لم يكونوا قائلين بالحركة الجوهرية، كانوا يقولون إن الصور باقية (مثل: صورة الحجر، والشمس، والفلك)؛ حيث يمكنها أن تبقى لملايين السنين. أما إذا تبدلت صورة التراب إلى النبات، فلا يعد هذا من قبيل التبديل آنا بعد آن؛ فالأعراض هي التي تتغير لا الجواهر.
وطبقا لهذا، فإنَّ هذه النظرية للعرفاء لدى القدماء من الحكماء لم تكن صحيحة بتاتا، ولكن في عقيدة الملا صدرا -الذي يرى أن العالم ينوجد آنا فآنا- تعد صحيحة “بل هم في لبس من خلق جديد…”، ولكن ليس بمعنى التجديد الانفصالي.
الأنواع غير متناهية، وعليه وبناءً على القول “بأصالة الماهية” يلتزم هنا محالا؛ لأنه يلزم منه أن يصبح اللامتناهي محصورا بين الحاصرين، ولكن إذا ما قلنا “بأصالة الوجود” تُصبح هذه الماهيات اللامتناهية منتزعة من مراتب الوجود.
ذكر صدر المتألهين في المجلد الثاني من الأسفار في الفن الخامس، والذي قد بحث فيه عن الحركة الجوهرية تحت عنوان “في أن نحو وجود الأجسام الطبيعية ليس إلا على سبيل التجدد والانقضاء الحدوث الاستمراري من غير دوام ولا بقاء”، فصولا في هذا الفن، ونقل في البعض من تلك الفصول أقوالا للقدماء من الفلاسفة من قبيل أرسطو حتى الحكماء الإسكندرية؛ حيث أراد بذلك التأييد على ما ادعاه. كما أنه قد خصص في آخر هذا الفن مكانا لكلمات العرفاء، وذكرها تحت هذا العنوان “في نبذ من كلام أئمة الكشف والشهود من أهل هذه الملة البيضاء في تجدد الطبيعة الجرمية الذي هو ملاك في دثور العالم وزواله”.
وقد نقل هناك قسمين من كلمات لمحيي الدين بن العربي، واللذين يعدان جملتين عجيبتين: “قال المحقق المكاشف محيي الدين العربي في بعض أبواب الفتوحات المكية”، و”إنْ من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم” أي من اسمه الحكيم؛ فالحكمة سلطان هذا الإنزال الإلهي، وهو إخراج هذه الأشياء من هذه الخزائن إلى الوجود أعيانها.
ثم قال: فبالنظر لأعيانها هي موجودة عن العدم، وبالنظر إلى كونها عند الله في هذه الخزائن. ثم قال: وأما قوله تعالى “ما عندكم ينفد” صحيح في العلم منها لعين الجوهر، والذي عنده أعني عند الجوهر من كل موجود إنما هو ما يوجده الله في محله من صفات وأعراض وأكوان، وهي في الزمان أو الحال الثاني من زمان وجودها أو حال وجودها ينعدم من عندنا، وهو قوله تعالى: “ما عندكم ينفد وما عند الله باق”، وهو تجدُّد الجواهر الأمثال والأضداد دائما من الخزائن، وهذا معنى المتكلمين: “العرض لا يبقى في زمانين”، وهو قول صحيح حر لا شبهة فيه.
وقال: وأما صاحب النظر، فما عنده خبر بشيء من هذا التنبيه النبوي، لا نظر فكري، وصاحب النظر مقيد تحت سلطان فكره، وليس للفكر فيه مجال.
وقال أيضا في الباب السابع والستين وثلاثمائة: ما يحكي عن عروج وقع بحسب الباطن حين مخاطبته مع إدريس النبي -عليه السلام- بهذه العبارة: قلت له: إنني رأيت في واقعتي شخصا بالطواف أخبرني أنه من أجدادي وسمي نفسه، فسألته عن زمان موته، فقال: أربعون ألف سنة، فسألته عن آدم لما تقرر عندنا من التاريخ لموته، فقال لي: عن أي آدم تسأل؟ عن آدم الأقرب؟ قلت: بلى، فقال: صدق، إنني نبي الله ولا أرى للعالم مدة يقف عليها بجملتها، إلا أنه بالجملة لم يزل خالقا ولا يزال دنيا، والآخرة وأي أجل في المخلوق بانتهاء المدة لا في الخلق؛ فالخلق مع الأنفاس يتجدد، قلت له: فما بقي لظهور الساعة؟ فقال: اقتربت الساعة “اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون”، فقلت: عرفني بشرط من شروط اقترابها، فقال: وجود آدم من شروطها، فقلت: فهل كان قبل الدنيا دار غيرها؟ قال: دار الوجود واحدة، والدار ما كانت دنيا ولا آخرة إلا بكم، والآخرة ما تميزت إلا بكم، وإنما الأمر في الأجسام أكوان واستحالات وإتيان وذهاب لم يزل ولا يزال”.
اصطلاحات من قبيل “الموجود والمعدوم، الواحد والكثير، الجوهر والعرض، والحادث والقديم، والحق والخلق”، وأمثالها، والمتداولة على ألسنة الفلاسفة، قد كانت موجود في اصطلاحات العرفاء أيضا، ولكن مفهوم الفلاسفة لهذه المعاني يتفاوت مع ما لدى العرفاء منها، وسبب هذا التفاوت هو “التوحيد العرفاني” الذي لا يقول لذات الحق من شريك -حتى في الموجودية- والذي كان يتلقى للقول القائل (بوجود موجود حقيقي غير الحق) كنوع من الشرك.
وبعبارة أخرى، جذر اختلاف النظر هذا هو أن الفيلسوف قائل “بالكثرة الوجودية”، والعارف “بالوحدة الوجودية”.
وفي نظر الفيلسوف، هناك وجود للموجودات الحقيقية والمنفصلة عن بعضها البعض على نحو لا يُمكن القول بأنَّ هذا الموجود هو عين ذاك، كما لا يمكن القول بأن ذاك هو عين هذا.
فواحدة من هذه الموجودات المتباينة الذات، والأكثر كمالا من غيرها، واللامتناهية والأزلية والأبدية، وغير المحتاجة لأي موجود آخر، والتي هي عبارة عن عين العلم والقدرة والحياة والإرادة، هي “واجبة الوجود”، بينما سائر الموجودات مع اختلاف درجاتها ومراتبها؛ حيث البعض منها مجردة وبعضها مادية، بعضها جوهر وبعضها عرض، بعضها بالنسبة لغيرها أكثر كمالا… تعتبر كلها “ممكنة الوجود”.
الموجودات الممكنة الوجود تتصف بصفات تعد من مختصات صفات ممكنة الوجود، وذات الحق يجب أن تكون منزهة عن تلك الصفات، وذلك من قبيل (المخلوقية، والكثرة، والحدوث، والجوهرية، والعرضية، والمحدودية، والتجسيم، والحركة، والتغيير) وأمثالها.
وفي عقيدة الفلاسفة، فإنَّ توصيف ذات الحق بهذه الصفات -من حيث أنها تنشأ من نقص ومحدودية الممكن، وتعد من مختصات الممكن- غير جائز، ويعد اصطلاحا “بالتشبيه” أي تشبيه الحق بالخلق المنهي عنه في الروايات الإسلامية.
ولكن: ماذا يقول العارف في هذه المسألة؟ هل هو -والقائل بوحدة الوجود، ولا يرى للحق في الموجودية من شريك- قد أزال كل مثل هذه الاصطلاحات (المحدودية، والمخلوقية، والكثرة، والحدوث، والجوهرية، والعرضية) من قاموسه، أو أنه قد استعملها فعلا؟ وفيما إذا استعملها فكيف كان استعماله لها؟ وهل قد استخدمها في حق غير الله تعالى، من حيث هو لا يقول بوجود ثان في الوجود، ويتغني بنغمة (ليس في الدار غيره ديار)؟
وهل أنه قد استخدم هذه المعاني والمفاهيم في حق ذات الله تعالى أيضا؟ وفيما إذا كان قد استخدمها، فكيف كان ذلك؟
هل كان يرى لذات الحق أنها محدودة وغير محدودة في آن واحد؟ وأنها خالقة ومخلوقة؟ أنها حادثة وقديمة؟ مجردة ومادية؟ كيف كان الأمر لديه؟ الحقيقة هي أن العارف القائل بوحدة الوجود، إذا ما نفى الأشياء فهو ينفيها بهذه الصورة؛ وهي:
1- – أنه يرى أن وجود الأشياء وجود “ظلي وظهوري”، وليس “وجودا حقيقيا”. وعليه، فهو ينفي الوجود الحقيقي دون نفيه للوجود الظلي لها.
2- – أنه يرى أن الأشياء -أي الوجودات الظلية- كلها عبارة عن ظهورات وتجليات وشؤون وأسماء وصفات الحق. وعليه، فهو باعتبار معين يسلب عن ذات الحق في مرتبة الذات، جميع الصفات المختصة بالمخلوقات، بحيث يكون “للتنزيه” هنا الحاكمية الكاملة، وباعتبار آخر يرى أن شؤون وأسماء وصفات الحق لا تعد ثانيا له، بل هي نفس الحق ولكن في مرتبة الأسماء والصفات. ومن خلال هذه الرؤية، فإن الحق في مرتبة أسمائه وصفاته يتصف بكل شؤون المخلوقات من قبيل (المخلوقية، والمحدودية، والحدوث، والكثرة…وأمثالها)؛ بحيث يكون “للتشبيه” هنا الحاكمية الكاملة.
ومن هنا، سمت العرفاء “الخلق” بالحق المقيد، وبسبب رؤيتها هذه قد ارتفع النزاع المعروف بين المتكلمين القائل: هل “التنزيه” هو الأمر الصحيح أم “التشبيه”؛ حيث يلزم القول “بالتنزيه المطلق” عدم إمكانية المعرفة.
العرفاء يقولون بالتنزيه في عين التشبيه، والتشبيه في عين التنزيه. وفي مسألة عينية الذات بالصفات فهم يقولون بالصفات في مرتبة الذات وبعينية تلك الصفات بالذات من طرف، كما يقولون بزيادة الأسماء والصفات على الذات (يعني المخلوقات)، واتحادها بالذات في عين الحال من طرف آخر.
والعرفاء -ومن خلال تلك الرؤية التي يرون بها أن العالم، والذي هو عبارة عن مجموعة من الأضداد، مع ذات الحق، وبنظرة معينة شيئا واحدا- يدعون أن ذات الحق جامعة للأضداد، ويقولون “أن الله تعالى لا يعرف إلا يجمعه بين الاضداد في الحكم عليه بها” (3).
العارف يستخدم لاصطلاح “الجوهر والعرض”، ولكنه يعتقد أن النسبة الموجودة بينهما -والمعروفة لدى الحكيم- هي نفس النسبة الموجودة بين ذات الحق وسائر الموجودات الأخرى، بمعنى أن كل الموجودات بالنسبة لذات الحق هي “عرض وحالة وصفة”، وذات الحق هي جوهر جميع الجواهر والأعراض، ومثلما أن الجوهر يشمل الأعراض، كذلك ذات الحق تشمل كل الأشياء.
قلنا إنَّ العارف يرى أن الوجود الحقيقي منحصر في ذات الحق، ويعتبر سائر الأشياء -وبنظرة معينة- معدومات. في نظر العارف، فإن نسبة ذات الحق للعالم هي نسبة “الشخص للظل”، و”نسبة الشيء للفيء”، ونسبة “العاكس للعكس”. وهذه التعبيرات هي نفسها التي يستخدمها العرفاء في كلامهم.
يقول محيي الدين في فصوص الحكم في “فص اليوسفي”: “اعلم أنَّ المقول عليه “سوى الحق”، أو مسمى العالم، هو بالنسبة كالظل لشخص وهو ظل الله وهو عين نسبة الموجود إلى العالم؛ لأن الظل موجود بلا شك في حس، ولكن إذا كان هنا من يظهر فيه ذلك الظل حتى لو قدرت عدم من يظهر فيه ذلك الظل، كان الظل معقولا لا غير موجود في الحس، بل يكون بالقوة في ذات الشخص المنسوب إليه الظل، فمحل ظهور هذا الظل الإلهي المسمى بالعالم إنما هو أعيان الممكنات، عليها امتد هذا الظل فتدراك من هذا الظل بحسب ما امتد عليه من وجود هذه الذوات” (3).
وعليه، ففي نظر العارف فإن ماهيات الأشياء والتي تسمى “بالأعيان الثابتة” مظهرا ومحلا لظهور ذلك الشيء الذي يسميه العرفاء “بظل الله”، وهو نفسه “الوجود المنبسط” باصطلاح، و”وجود إضافة” باصطلاح آخر.
ويقول أيضا: “فكل ما ندركه هو وجود الحق في أعيان الممكنات؛ فمن حيث هوية الحق هو وجوده، ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات، فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل، كذلك لا يزول باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق؛ فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق، لأنه الواحد الأحد، ومن حيث كثرة الصور هو العالم” (5).
قلنا إنَّ العارف في عين الوقت الذي يقول فيه بوحدة الحق والخلق، ولا يرى الخلق مباينا للحق، ولا يقول له بوجود مستقل، بل الخلق في نظره هو عبارة عن امتداد لنور وجود الحق؛ فإنه يحافظ على المراتب في الوقت نفسه. فللحق حكم في مرتبة الذات، وحكم آخر في مرتبة الخلق.
يذكر محيي الدين في “فص الشعيبي” من فصوص الحكم، كلاما عن معرفة النفس في البين؛ فكما نعلم فإنَّ العرفاء يعتقدون أنه لا يمكن معرفة النفس على نحو حقيقي إلا عبر طريق السير والسلوك.
وفي كلمات العرفاء، يمكننا مشاهدة مثل هذا الكلام أحيانا: للعارف الفلاني، وفي الوقت الفلاني، وفي اليقظة أو النوم، حصلت له “معرفة النفس”. وأحيانا يعبرون عن ذلك “بالتجرد”، ويقولون: حصل له تجردا.
يقول محيي الدين: “معرفة النفس بهذا النوع من المعرفة، هي عين معرفة الحق، ومفاد الحديث المعروف “من عرف نفسه عرف ربه” ليس هو أن يحصل بواسطة معرفة النفس معرفة أخرى، والتي هي معرفة الرب، وذلك مثلما يكون في القياسات الفكرية؛ حيث يولد من العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة، بل معرفة النفس على ذلك النحو من المعرفة، هي عين معرفة الرب؛ لأنَّ الخلق من جهة هو عين هوية وحقيقة الحق، والنفس هي أكمل صور الخلق؛ لأن “إنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته” (الله).
يقول محيي الدين: لم ينل أحد على صورة حقيقية لمعرفة النفس غير الأنبياء والعرفاء، وما قالته الحكماء والمتكلمين في هذا الباب، فهو بسبب عدم وصولهم للحقيقة.
يُوْرد هنا محيي الدين مثلا، ويقول: “كل من يناقش مسألة معرفة النفس عن طريق الفلسفة، فقد استسمن ذي الورم، ونفخ في غير ضرم”. ويقول إنهم مصداقٌ لهذه الآية: “الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا” (6).
العرفاء وبشكل عام -وخلافا للحكماء الذين يرون أن “الأنا الحقيقية” موجود مستقل الذات- يرون أن “أنا الحقيقية” إذا ما عرفت بالمعرفة العرفانية، فإنها من خلال نظرة معينة تعد عين ذات الحق، أي في نظرهم أن “أنا” مساوية لـ”هو”.
هنالك حيث يدعي العارف ويقول مثلا “إني أنا الله”، فإن ما يدركه هو من “أنا” هو غير ذلك الشيء الذي يفهمه الآخرون من كلامه.
ويتخيل الآخرون أنه في إدراك نفسه من خلال “أنا”، يشاهد هذا الموجود المحدود الخلقة، وأنه قد أعطى لهذا الوجود نسبة الألوهية، أو تخيلوا بأنه قد اعتقد أن ذات الله قد حلت فيه.
هذا في الحال الذي يكون فيه العارف فانٍ عن نفسه، وذلك الشيء الذي لا يمكن رؤيته أبدا، هو نفس ذاك الشيء الذي يتلقاه الآخرون كـ”أنا”، بينما يعد هو في نظر العارف عبارة عن “لا شيء محض”.
ابن الفارض العارف المصري المعروف، الذي عاش في القرن السابع، والذي يعد في العرفان الإسلامي وبين عرفاء العرب مثل حافظ بوجه عربي، ولربما كان أقوى من الحافظ، يقول في قصيدته التائية المعروفة:
متى حلت عن قولي أنا هي أو أقل…
وحاشا لمثلي أنها في حلت (7)
ومفاد هذا الشعر هو نفسه الذي قاله الشيخ الشبستري في “حديقة الأسرار”:
الحلول والاتحاد هنا محال…
ففي الوحدة الثنائية عين الضلال (8)
فقد تبيَّن لنا من خلال ما مر أن أحد موارد اختلاف النظر بين العرفاء والحكماء هو مسألة “معرفة النفس”، والتي يخطئ العرفاء فيها الحكماء كثيرا.
ويقول محيي الدين في “فصل شعيبي” عن “الخلق الجديد” (9)، والذي أشير إليه سابقا “وما أحسن ما قال الله تعالى في حق العالم وتبدله مع الأنفاس” في خلق جديد “في عين واحدة، فقال في حق طائفة بل أكثر العالم “بل هم في لبس من خلق جديد” (10)؛ فلا يعرفون تجديد الأمر مع الأنفاس لكن قد أثرت…” (11).
—————————————————-
الهوامش:
- – يرجع لمقدمة العفيفي على “فصوص الحكمة”، ومقدمة كيوان سميعي على شر “كلشن راز”، ومحاضرات عبدالرحمن البدوي في جامعة الإلهيات، و”قيمة ميراث الصوفي” و”بحث في التصوف” للدكتور غني، وورقة “العرفان والتصوف” لي.
2- – السلسلة الطولية مقابلة للسلسة العرضية.
3- – فصوص الحكم، فص الرابع، فص إدريسي.
4- – فصوص الحكم، ص:101.
5- – فصوص الحكم، ص:103.
6- – الكهف:104.
7- – متى عدلت عن قولي “أنا هو”، أو متى سأقول “سأعدل”، وحاشا لواحد مثلي بأن يقول إنه قد حل في.
8- – وله في الكتاب نفسه فصل تحت عنوان “حقيقة أنا” في نظرة عرفانية، يمكن الرجوع إليه.
9- – الرعد:5.
10- – ق:15.
11- – فصوص الحكم، ص:125.
___________________________
*نقلًا عن موقع ” شرق غرب”.