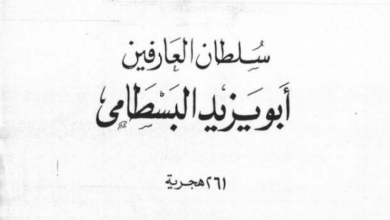رابعة العدويَّة.. إمامة العاشقين التي أفنت حياتها في الحب!
محمد شعبان أيوب
“أحبّك حُبين؛ حبّ الهوى *** وحبّا لأنك أهلٌ لذاكا
فأما الذي هو حُبّ الهوى *** فشُغلي بذكرِك عمّن سواكا
وأما الذي أنتَ أهلٌ له *** فكشفُك للحُجب حتى أراكا”
(رابعة العدوية)
حين نذكر رابعة العدوية فإن صورة الزاهدة العابدة المتصوفة الناسكة تتجسد أمام ناظرينا بسرعة خاطفة؛ صورة المرأة الهادئة الوادعة التي تتجمع أنوار الهداية على وجنتيها، المرأة الأشهر في تاريخ التصوف الإسلامي كله منذ نشأته وإلى يومنا هذا لم تكن حالة عابرة خاطفة بقدر ما يأتي اسمها على الألسن وتتخيله العقول، كما أنها للمفارقة لا تزال لغزا محيرا لعلنا نجلي عنه بعض الغبار وسنوات النسيان والغموض للتذكير بها وبفلسفتها الصوفية الفريدة!
يرى أحد المستشرقين[1] أن الصوفية الأولين ومنهم رابعة، هؤلاء الذين لبسوا الصوف وعُرفوا به، كانوا في الحقيقة زُهّادا وادعين أكثر منهم متصوفة، فإدراكهم المستولي عليهم للخطيئة كانت تصحبه الرهبة من يوم القيامة وعذاب النار؛ تلك الرهبة التي ليس في طوقنا أن نتحققها، والتي صُوّرت في القرآن تصويرا حيا دفعتهم إلى أن يجدوا في الهرب من الدنيا مخلصا لهم؛ ثم إن القرآن يُنذرهم -من جهة أخرى- أن النجاة تتوقف أساسا على مشيئة الله الخفية التي تهدي الصالحين سواء السبيل، وتضل الظالمين عن القصد القويم، وأن حظّهم قد رُقم في اللوح الخالد، لوح عناية الله، لا يستطيع شيء له تبديلا، فيجب أن يعلموا أنه إذا قدّر لهم أن يُنجيهم صومهم وصلاتهم وما يأتون من الأعمال الصالحة فهم لا بد ناجون. واعتقاد كهذا لا بد أن ينتهي إلى التأمل في الله، والخضوع المطلق للمشيئة الإلهية، وتلك ميزة من مزايا التصوف في أقدم صوره.
سنوات البؤس والتعاسة!
تأتي رابعة العدوية البصرية العراقية، المرأة الزاهدة، على رأس هذه الشخصيات البارزة والغامضة في آن واحد في التاريخ المبكر للتصوف الإسلامي، فجل الروايات التاريخية لا تتفق على سنة محددة لولادتها فضلا عن وفاتها التي اختلفت ما بين عامي 135هـ و185هـ، كما أنها لم تكتب كتابا واحدا عن حياتها أو تذكر فيه أهم أقوالها وآرائها في التصوف، وهذه الأمور كانت السمة الأبرز في كبار الصوفية الذين عاشوا في القرنين الأول والثاني من الهجرة، فقد كان زهدهم من النوع العملي لا النظري.
وُلدت رابعة العدوية في بيت من أفقر بيوت البصرة، حتى قيل إن أبويها لم يكن لديهم قطرة سمن حتى يدهنوا موضع خلاصها، ولم يكن هناك مصباح ولا خرق للفّ الوليد، الأمر الذي اضطر الوالد إلى الذهاب إلى الجيران للحصول على زيت لإضاءة القنديل، ورغم أن الرجل كان قد عاهد الله ألا يطلب من أحد حاجة، فإنه ذهب تحت إلحاح زوجه، ورغم ذلك لم يفتح له أحد، هنالك رجع والد رابعة أسيفا، حتى أطرق على ركبتيه ونام، فرأى النبي في منامه قائلا له: لا تحزن! هذه البنت الوليدة سيدة جليلة القدر، وإن سبعين من أمتي ليرجون شفاعتها، وأمره بالذهاب من صبيحة الغد إلى والي البصرة حينذاك عيسى زاذان، ويكتب له ورقة يقول فيها: إن النبي زاره في المنام، وقال له أن يتوجّه إليه ويقول: إنك تصلي مئة ركعة، وفي ليلة الجمعة أربعمئة، لكنك في يوم الجمعة الأخير نسيتني، ألا فلتدفع أربعمئة دينار حلال لهذا الشخص كفّارة عن هذا النسيان! فلما أفاق والد رابعة من نومه كتب الرسالة ودفعها إلى الأمير، فلما قرأها أمر والي البصرة بإعطائه أربعمئة دينار وقال لهم: إئتوني به لأراه، ثم راجع نفسه وقرر أن يذهب بنفسه إلى هذا الرجل، ليتبارك بهذا البيت[2]
رزحت رابعة في الفقر، وزاد من ألمها وفاة والدها تاركا خلفه أرملة سرعان ما لحقت به، ورابعة وأخواتها الثلاث ضعيفات فقيرات خائفات من الحياة وتقلباتها، حتى وقعت الكارثة في قحط عام في البصرة اضطر أهلها على إثره إلى الخروج منها، فتفرقت بهن السُّبل، فرآها أحد الظلمة فأوقعها في الأسر وباعها بستة دراهم لرجل أثقل عليها العمل، وفي يوم من الأيام خرجت من بيت سيدها لقضاء حاجة فإذا رجل يرمقها بشر، فخافت واختبأت وناجت ربّها كثيرا، ويتفق بعض من أرّخوا لها أن هذه اللحظة كانت مفصلية في حياتها.
يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: “هذه اللحظة في حياة رابعة يجب أن تُعدّ نقطة التطور الحاسمة في حياتها الروحية، شأنها شأن تلك الأحوال التي أتينا على ذكرها عند أضرابها من كبار الشخصيات الروحية في العالم، لكنها لا تزال في الأسر المادي لدى ذلك السيد القاسي الذي أرهقها فكان لهذا الإرهاق والإعنات فضل انفجار روحها الباطنة النبيلة”[3].
ظلّت رابعة على منهجها عاكفة عليه لا تبرحه، لا تريد سوى وجه الله ومحبته ورضاه، فقد أدركت الحقيقة وانبلجت لها من قهر المعاناة، وألم اليُتم، وضيم الاسترقاق والعبودية
استطاعت رابعة أخيرا أن تنال حريتها، وتصف بعض الروايات التاريخية جموحها نحو الحرية بأنها انهمكت في في اللذات، بل وصارت تعزف على الناي، لكن على إثر لقاء بالصوفي البصري الكبير رياح بن عمرو القيسي تبدّلت حياتها، وولجت رابعة أبواب الزهد والتصوف وعالمه الرحب، واطرحت حياة اللهو والغفلة، مقبلة على ربها، وربما ما جعلها تتجه إلى هذه الطريق تلك اللحظات التي انكفأت تناجي فيها ربها حين همّ أحدهم بالاعتداء عليها يوم كانت في حياة الرق والعبودية.
الحب طريق رابعة
ليس ثمة شك في أن رابعة تأثرت برياح القيسي، كما أنها تأثرت برجل آخر ملأت شهرته الآفاق، وتربع على عرش التصوف في عصره وهو إبراهيم بن أدهم، وفي مدينة البصرة جنوب العراق، كانت حياة المدينة تجمع النقيضين بصورة لافتة وغريبة، النعيم الصارخ البالغ أوج الشهوات، والزهد القاتم القاسي المعفّر خدّه بالتراب، فانتقلت رابعة من النقيض إلى النقيض، في مدينة الأضداد تلك، كما أنها أدركت أن توبتها كانت رضا من الله وإرداته، وظلت فلسفة التوبة عندها تتكئ على هذا المعنى.
فقد روى القشيري أن رجلا سأل رابعة: “إني قد أكثرتُ من الذنوب والمعاصي، فلو تبتُ، هل يتوب عليّ؟ قالت: لا، بل لو تاب عليك لتُبتَ”. وبهذا يمكن فهم قولها: “أستغفر الله من قلّة صدقي في قولي: أستغفرُ الله”، وقولها: “استغفارنا يحتاج إلى استغفار لعدم الصدق فيه”[4]!
أثرت حياة اللهو في توبة رابعة، فهي حين أحبت في تلك المرحلة فإنها لم تنس ذلك الحب، فقد اجترته معها في توبتها، وجعلت حب الإله مدار زهدها ورؤيتها للتصوف، وقد اصطبغت الشكوى إلى الله بصبغة الحب والرغبة في الاتصال بهذا المحبوب الأعلى، فقد أُثر عنها أنها كانت إذا صلّت العشاء قامت على سطح لها، وشدّت عليها درْعها وخمارها ثم قالت:
“إلهي! أنارت النجومُ، ونامت العيون، وغلّقت الملوكُ أبوابها، وخلا كلّ حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك”، ثم تُقبل على صلاتها، فإذا كان وقت السَّحَر وطلع الفجر قالت: “إلهي! هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر، فليتَ شعري! أَقَبِلتَ مني ليلتي فأهنأ، أم رددتها عليّ فأعزى؟ فوَعزّتك هذا دأبي ما أحييتني وأَعنتني، وعزّتك لو طردتني عن بابك ما برحتُ عنه لما وقع في قلبي من محبّتك”[5].
يرى بعض الباحثين[6] في سيرة رابعة أن الرسالة الروحية لديها بدأت منذ صباها، هبطت عليها وهي تُعاني أشد أنواع العذاب والحرمان، وكيف لا والنقيض يتحول إلى نقيضه، فحرمانها من الدنيا أوصلها بالآخرة، ويأسها منها جعلها تتشبث بالآخرة، وحرمانها من أبويها في عهد مبكر جعلها تسعى نحو الإله الأعظم، وصبرها على المكاره جعلها تثق في الله وتركن إليه وتطمئن إليه، فالقهر الخارجي في حياة رابعة فجّر لديها طاقة روحية هائلة جعل باطنها مختلفا كليا عن ظاهرها، حرمانها من الحب والعطف والرحمة الدنيوية جعلها تبحث عن معاني الحب الباطني بلهف وشوق ولذة كانت تتجسد أحيانا في بلاغتها ووجدها!
أقامت رابعة الحب الإلهي نصب عينيها لا تبرحه، ودارت حلقات صوفيتها ومريديها وأقوالها المأثورة حول هذه الفلسفة التي جعلت المستشرق الفرنسي “ماسينيون”[7] يؤكد أن رابعة العدوية كانت السابقة إلى وضع قواعد الحب والحزن في هيكل التصوف الإسلامي، وهي التي تركت في الآثار الباقية نفثات صادقة في التعبير عن محبتها وعن حزنها، وأن الذي فاض به بعد ذلك الأدب الصوفي من شعر ونثر في هذين البابين لهو نفحة من نفحات السيدة رابعة العدوية إمامة العاشقين والمحزونين في الإسلام.
كانت رابعة تلهج بهذا الحب في كل موضع وأمام كل أحد، أضحى الزمان والمكان لديها “وجودها الخاص” لبث نفثات هذا الحب الصادق، تقول في إحدى مواجيدها ونجاواها[8]:
“يا سُروري ومُنيتي وعمادي *** وأنيسي وعُدّتي ومُرادي
أنت روحُ الفؤاد، أنت رجائي ** أنت لي مؤنسٌ وشوقُك زادي
أنت لولاك يا حياتي وأُنسي *** ما تشتّتُّ في فسيحِ البلادِ
كم بدت منّةٌ وكم لك عندي ** من عطاءٍ ونعمةٍ وأيادي
حبُّك الآن بُغيتي ونعيمي *** وجلاء لعينِ قلبي الصادي
ليس لي عنك -ما حييتُ- براحٌ *** أنت مِنّي مُمَكّنٌ في السوادِ”
حرصت رابعة على بث هذه الفلسفة في زوّارها ومريديها، وكان زوارها من الصالحين من الكثرة والشهرة بمكان، وقد سألتْ مرّة بعضَهم عن سبب عبادتهم الله، فقال أحدهم: إننا نعبده خوفا من النار. وقال آخر: بل نعبده خوفا من النار وطمعا في الجنة. فقالت رابعة: ما أسوأ أن يعبد العابد الله رجاء الجنة أو مخافة النار! وتساءلت: إذا لم تكن هناك جنة ولا نار، أفما كان الله يستحقّ العبادة؟ فسألوها: فلماذا تعبدين أنتِ الله؟ فقالت: إنما أعبده لذاته، أفلا يكفيني إنعامه عليّ بأنه أمرني أن أعبده؟
من أجل ذلك أهملت رابعة شؤون نفسها الزائدة عن الحاجة، وحرصت على لبس ما يستر جسدها ولو كان باليا، والزهد في الطعام ولو كان نفيسا، وقد شقّ على بعض الصالحين أن يروا شيختهم رابعة في هذه الحالة من الفاقة والثياب البالية وهم حولها، فعاتبوها بدعوى أن ما عليها إلا أن تطلب العون وسيقدمون لها ما تريد في الحال، فقالت: إنها لتخجل أن تسأل الناس من متاع الدنيا لأنهم لا يملكونها، وإنما هي عارية في أيديهم! فاستحسنوا جوابها، وزادت حيرتهم؛ إذ كيف لهذه المرأة الفقيرة الزاهدة أن يتحقق لها هذه المرتبة الرفيعة من العبادة والفهم، ولم يسبق أن بلغت امرأة مثل ذلك من قبلها؟ فكان جوابها أنها لم تغتر لذلك، ولم تتكبر، ولم تدّع الألوهية، وذلك شأن النساء العابدات عموما[9].
ترى المستشرقة الألمانية “آن ماري شيمل”، وهي واحدة من أهم من تناولوا تاريخ التصوف وكبار شيوخه برصانة، أن رابعة العدوية كانت المرأة الأولى التي تُدخِل فكرة الحب الإلهي الطاهر في الفكر الصوفي، وصار الحب منذئذ لفظا أساسيا عند عموم الصوفية، ومعروف أن الصوفية، كلفظ عام، تشمل كلَّ حركة باطنية تحمل أبعادا في جوهرها من حيث البحث في الوجود، والقرب من المعبود من طريق الزهد، وعندما يتحول القلب إلى مرآة صافية يمكنها استعمال النور الإلهي. فالصوفية عمَّقت من دراسة أدق خلجات النفس في طريقة مدهشة جديرة بالإعجاب[10].
بل وتزيد شيمل[11] أن رابعة كانت فاتحة مرحلة إبداعية جديدة في الحياة الصوفية، فقد صارت شيخة لمدرسة التصوف في العراق في زمنها، ومن بين كثير من أتباعها من الصوفية الذين كانوا يعيشون ببغداد وما حولها من المدن العراقية وأثمرت آثارهم يتجلى الشيخ الزاهد معروف الكرخي الذي كان من شباب معاصريها، والذي سيكون حجر الزاوية في توسيع رقعة التصوف وبسط نفوذه الجغرافي من المشرق إلى العراق إلى مصر بفضل تأثير شيخته رابعة.
الطريق إلى الله عند رابعة
كان لا بد لرابعة وهي تجمع قواها الروحية أن تحج إلى بيت الله الحرام، ذلك أنه إذا كان الحج فريضة من فرائض الإسلام فإنه يُعدّ بالنسبة للصوفي من أهم الفرائض التي ينبغي له أن يؤديها، فإذا كان عموم الناس يذهبون إلى الحج كاستجابة لنداء الله وتحقيق ما افترضه عليهم، وطلب المغفرة والعفو والصفح منه، والتأسي بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة، فإن الصوفي على الجانب الآخر يريد فوق ذلك رب الكعبة، يريد مناجاته ومخاطبته بما رُبّي عليه من تربية صوفية لها مدركاتها وأبعادها الباطنية الداخلية التي لا يفهمها كثير من العامة.
رابعة أرادت هذا، حين قالت: “إلهي وعدتَ بجزائين لأمرينِ. القيام بالحج والصبر على الشدائد. فإن لم يكن حجي صحيحا مقبولا عندك فيا ويلتاه وما أشدّ هذه المصيبة عندي.. لكن ما جزاء هذه المصيبة”! ثم تخطّت هذه الدرجة وصعدت أخرى حين ناجت ربها وهي في طريقها إلى مكة قائلة: “إلهي إن قلبي ليضطرب في هذه الوحشة، أنا لبِنَةٌ والكعبة حجر وما أريده أن أرى وجهك الكريم. فنادها صوت من فوقها: يا رابعة أتطلبين وحدك ما يقتضي دم الدنيا بأسرها؟ إن موسى حين رامَ أن يُشاهد وجهنا لم نُلق إلا ذرّة من نورنا على جبل فخرّ صعقا”[12]!