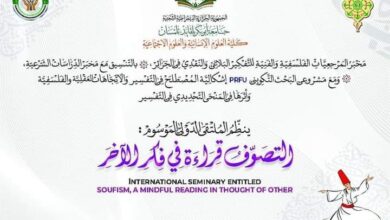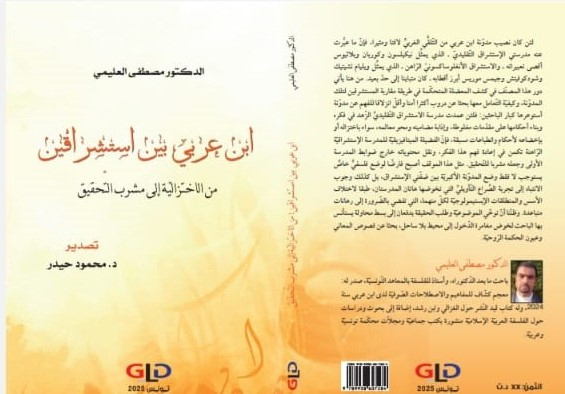
“الإستشراق الذي لم يفقه السر المكنون في عرفان ابن عربي”
ابن عربي بين استشراقين/من الاختزالية إلى مشرب التحقيق”
للباحث التونسي الدكتور مصطفى العليمي
صدر مؤخرًا في تونس هذا الكتاب للأكاديمي والباحث في التصوف والعرفان النظري د. مصطفى العليمي، وذلك تحت عنوان ” ابن عربي بين استشراقين .. من الاختزالية الى مشرب التحقيق ” .
في ما يلي المقدمة التي كتبها د. محمود حيدر كتصدير للكتاب:
___________________________________________
“الإستشراق الذي لم يفقه السر المكنون في عرفان ابن عربي”
د. محمود حيدر
ما وجدت تلقاء ما أتانا به الدكتور مصطفى العليمي، سوى ما يُؤنَسُ إليه في زمن مكتظٍّ بالغم. وعندي أنّى توجَّهت ركائبُ النظر في معارف الشيخ إبن عربي وعرفانه، فمآلها الأنس ومستقرها هدأة العقل. هوذا الحال كلما تشابَهَ العقلُ على العقل، وأشكَلَ الإنسانُ على الإنسان. حتى لكأنَّ قدرُك قضى ألاَّ تعثر على عزيز المعنى إلا في طيَّات ما أنشأه الشيخ الأكبر من فصوص المعاني وعيون الأخبار.
في العادة، لا أستخفي حَيرتي من أي الأبواب ينبغي الدخول إلى عالم إبن عربي. ولقد حضرتني هذه المشاعر لما طلب إليَّ الكاتب التمهيد لمخطوِطِهِ من قبل أن يدفع به إلى الملأ. ذلك على الرغم من انني على علمٍ أن صاحب الكتاب أراد أن يحترث في حقل بيِّن المعالم؛ وهو استظهار الكيفية التي قارب فيها مستشرقو الغرب فضاء الشيخ الأكبر الزاخر بالأفهام والمفارقات.
قلت، أدخل النص واستقرئُ ما قصد إليه صاحبه. وكان عليَّ حالئذٍ أن استفهم مسرى الكلمات لأبلغ القصد. حتى إذا مضيتُ هنيهةً في أرجائها ألفيتني والكلمات على صحبة. كنت أيقنت أن الباحث الحصيف يشاطرني الرأي أن الاستشراق الذي جاءنا على صهوة ذاتٍ مستعلية، لن يكون له حظّ الإحاطة بمكنون العرفان الأكبري وأسراره. وعرفت كذلك، أن دواعي أعمق غوراً أفضت الى قصور العقل الإستشراقي عن فقه الشيخ الأكبر بما يختزنه من مراتب فهم لا حصر لها. بل لعل غلبة حسابيات العقل الإنتفاعي على النفس الميَّالة الى التعرف اللدنِّي، هي أحد الأسباب المكوِّنة لمثل هذا القصور.
وعلى أي وجه، فأنىَّ جرت عليه مدوَّنة الكاتب مصطفى العليمي فإني لم أرها إلا كونها بياناً انتقادياً لميتافيزيقا الاستشراق وهي تتاخم صاحب الفتوحات بشغف موصوف. فلقد رأيتني إذَّاك وسط منفسح معرفي يُغوي بجرعة مضاعفة من التحرِّي والاستشكاف والمعاينة. وأما الذي دعاني إلى هذا، فتوجيه العليمي قارئيه إلى المعضلة المستحكمة بالتفكير الإستشراقي حيال المعرفة العرفانية. عنيت بها ما ترتب معرفياً على التفسير الفينومينولوجي لهذه المعرفة بما هي وعيٌ روحي متعال. فالمستشرقون -على الأغلب الأعم – لم يفارقوا هذا التفسير حتى أولئك الذين دُهشوا بمعارف ابن عربي وطابت لهم الإقامة في محاريبها، مثل نيكولسون وشردكوفيتش وتشيتيك وكوربان وسواهم.
* * *
تحيَّر المستشرقون في أمر إبن عربي وعرفانه. أكثر الذين قرأوه ذهبوا مذاهب شتى في فهمه وتأويله. بعضهم زَهِدَ فيه حتى رأى إليه استئنافاً للأفلاطونية بلسان إسلامي، ومنهم من أنزله عن فرادته بزعم أن جلَّ منظومته العرفانية هي استنساخ لمسيحية غنوصية عمَّت بلاد ما بين النهرين ووادي النيل. وما كان مراد هؤلاء وأولئك من ذلك إلا ليدفعوا عن ثقافة الغرب شائعة الأخذ بعرفان الشيخ الأكبر مرجعيته الوحيانية.
تلقاء هذا النحو من الإستشراق السلبي، سيمضي ندرة من المستشرقين تأويلية تستبطن نصوص إبن عربي على نحو التعرّفُ غير المسبوق بالوظائفية المعهودة للإستشراق الأوروبي. حتى أن من هؤلاء من وصف كتاب “فصوص الحكم” بأنه إعراب بيّن عن الحكمة الرحمانية، بل هو ليس شيئاً آخر غير الحكمة عينها”. فلقد حظي إبن عربي – كما يبيِّن لنا مصطفى العليمي – بتلقٍّ غربيٍّ لافت، عبَّرت عنه مدرستان استشراقيَّتان مختلفتان، يمكن إحالتهما تاريخيًّا إلى مرحلتين: تتعلَّق أولاهما بما نصطلح عليه «الاستشراق التّقليديّ» الذي يمثِّل نيكيلسون وكوربان أقصى تعبيراته، فيما تتعلَّق ثانيتهما بما نسمِّيه «الاستشراق الأنغلوساكسونيّ الرّاهن» الذي يمثِّل ويليام تشيتيك وجيمس موريس أبرز أقطابه، حيث تعود لهما فضيلة إعادة فهم فكر إبن عربي، ونقل مضامينه خارج ضوابط الاستشراق التّقليديِّ، الذي عمد إلى إذابة فكره ومحو معالمه سواء باختزاله، أم بإخضاعه لأحكام وانطباعات مسبقة. مثل هذا الموقف أصبح فارضًا لوضع فلسفيٍّ خاصٍّ يستوجب الانتباه إلى تجربة الصِّراع التّأويليِّ التي تخوضها هاتان المدرستان، جعلت الجماعة العلميَّة الأميركيَّة رافضة تأويلها اعتمادًا على قواعد الهيرمنيوطيقا التّقليديَّة مثلما حدَّدها ديلتاي وشلايرماخر، نظرًا لتطابق تلك القواعد مع بنية محدَّدة من المباحث يكون متن ابن عربي غريبًا عنها، مقترحة التّمسُّك بآليَّات جديدة لفهمها، ومن شأنها أن تمكِّن النصَّ من الانسياب دلاليًّا ليفصح عمّا يريده من دون توجيه إيديولوجيٍّ من المفسِّر، أو تعسُّفٍ مثلما عمد الاستشراق التقليديّ.
* * *
لست أخال الدكتور العليمي إلا على دراية بما أنصرف إليه جمعٌ ممن “استشرقوا” إبن عربي على سبيل البحث المقارن مع التصوف الغربي بجناحيه المسيحي واليهودي. في هذا المنفسح على وجه التعيين رحت أتوقف عند مغزى ما أشار إليه المؤلف لجهة التناظر الروحي بين الحضارات البشرية المختلفة. ولقد استحضر لهذا البيان ما جاء في محاضرة ألقاها الفيلسوف واللاَّهوتي الألماني رودولف أوتو عام 1924 تحت عنوان: “باطنية الشرق وباطنية الغرب”، وفيها يكشف عن نظائر مدهشة بين سانكارا (800 قبل الميلاد)، المعلم الهندي لعقيدة انعدام الثنائية، وبين ايكهارت (260-1327م) المعلم الريناني لنظرية الوحدة البسيطة.
لم يشأ أوتو من مثل هذا التناظر بين معلِّمَيْن صوفيِّين ينتمي كل منهما الى حضارة مختلفة عن الأخرى، إلا بيان الوحدة الواصلة بين التجارب الروحية في الحضارات الإنسانية. أما مغزى الأفكار التي قدمها أوتو في هذا الصدد، فهي في الكشف عن وجود بنى مماثلة في ظاهرة التصوف، بمعزل عن المواضع المكانية والفترات التاريخية. ولئن كان بعض التجارب ينزع الى اتخاذ أشكال متقاربة في التعبير اللغوي وأشكال متقاربة في التعبير الرمزي، إلا أن هذا التماثل لا يلغي التمايز او الاختلاف. على العكس من ذلك، فإن جوهر التصوف – كما يبين أوتو – لا يمكن أن ينبثق الا من مجموع التمايزات الممكنة”. وهو ما نذهب الى تسميته بالحادث العرفاني الذي يتعرض له شخصٌ ما ويحدث انعطافاً باطنياً يبدّل مسارحياته الروحية والمعنوية ليختبر مساراً آخر ونشأة جديدة. صحيح ان التعابير المختلفة للظاهرة الصوفية تتحدد بالظروف التي تفترضها السياقات الدينية او الثقافية المختلفة، إلا أنها تتجاوزها في الوقت نفسه.
لعل الدارس لهذا الاختلاف والتمايز في الاختبارات الروحية، يسعى – لا سيما حين يتعلق الأمر بالتعبير الصوفي- الى إقامة فواصل حاذقة بين النقل (الواعي) والالتقاء (العفوي). وفي الواقع، فلدى التعرض الى النص الصوفي المتعدد، فإننا غالباً ما نخرج من طريقة المقابلة والمقارنة بنتائج مدهشة. وهو ما يمكن ان نلاحظه مثلاً، حين ننتقل من السياق الإسلامي الى سياق آخر ينتسب الى حضارة عميقة الغور في روحانيتها كحضارة الشرق الأقصى. نجدنا في مثل هذه الحال كما لو أننا بإزاء حوار داخلي حميم بين فضاءين مختلفين متباينين، إلا انهما يلتقيان على جوهر واحد. وهو ما يفضي إليه التصوف كإعراب عن وحدة التجربة الروحية. أما نقطة الالتقاء في فضاء التصوف فهي تتمثل في الفضاء العربي الإسلامي بما ذهب إليه ابن عربي في “الفتوحات المكية” من أن الخلاف حقٌ حيث كان.. فقد عنى بهذا مقصوده بوحدة الوجود والشهود. فالله المتجلِّي في عوالم خلقه وحدة واختلاف، وظاهر وباطن، واول وآخر.. وما عْرِفَ الحق إلا بجمعه الأضداد.
من المفيد في هذا الصدد استرجاع مطالعات الباحثة الأميركية أفلين أندرهل Evelyn Undrhill حول التجارب الروحية في الإسلام والمسيحية والبوذية. فقد لاحظت ضرباً من التكامل العميق بين التجارب المذكورة، وذهبت إلى تعريف المبدأ الروحي المؤسس لها جميعاً بالقول ان “ما يسمّيه العالم “تصوّفاً” هو علم المطلقات… اي علم الحق الواضح بذاته، والذي لا يمكن “التفكير فيه بالعقل”…” الصوفي – حسب رؤيتها – هو من يتوق إلى معرفة ما هو مطلق، لكنه يدرك أن المطلق تتعذر معرفته من خلال استخدام العقل فقط. فالمتصوّفة لا يرون في التفكير العقلي، كقاعدة عامة، دليلاً كافياً إلى الروح، ولذلك يستعملون أنواعاً أخرى من النشاط العقلي ليقاربوا المطلق المحيّر. ولما كان لكل ثقافة نصيبها من التصوّف، ورغم اختلاف الأسماء التي أطلقت على المطلق والطرق التي يُسلك إليه من خلالها، يبقى جوهر كل ثقافة متوافقاً مع ما سبق ذكره. هكذا سنرى ان الباحث في التصوف المسيحي فيدنت يوغيس يبحث عما يسميه إدراك اتحاد “الأتمان بالبراهمان” من خلال ممارسات تأملية وزهدية. كانت بوذية الزن تتغيَّأ الوصول إلى الوعي الكوني من خلال تأمل صارم تزول من خلاله ثنائية التفكير كلياً وإرادياً من ذهن السالك؛ كذلك فعل الصوفيون المسلمون حين سعوا إلى اختبار “انتقال الروح” من خلال العيش بعزلة، وتحرير القلب من كل ما سوى الله”؛ أما القديسون الكاثوليك فكانوا يتوجهون نحو اتحاد الروح بالله من خلال الصلاة والصوم والتأمل.
* * *
على غالب الظن ان عدداً من المستشرقين الذين أتى صاحب الدراسة على ذكرهم لم يكونوا غافلين عما شهدته الحضارات الإنسانية من معطيات في ميدان التصوف النظري. وأراني أوافقه القول أن ثمة تشابهاً عميقاً في التحرِّي عن العرفان وحقائقه لدى الأديان المختلفة، وبخاصة المسيحية والإسلام. إذ مع التطوُّرات التي شهدها المسرى التأويلي في فضاء التصوف الإسلامي على سبيل المثال، ينفتح التعريف على أفق يجاوز المداولات المألوفة. فحين يمضي العرفاء إلى استظهار عالمهم الداخلي واختباراتهم الباطنية، فإنهم يعرِّفون التصوف بأنه “النظر إلى الكون بعين النقص”، وما ذاك إلاَّ لاستشعارهم أن الطريق إلى الكمال شرطه العبور من دنيا الموجودات الفانية إلى الوجود الحق. وحين حكم الإنسان على هذا العالم بأنه كون ساقط، فإنه كان يبرهن على حقيقة مؤدَّاها أنه ينظر إلى نفسه بوصفه كائناً شريفاً نبيلاً يتطلَّع صوب الأعلى ويحنُّ إلى الساميات. وها هنا بالضبط يكمن سرُّ اغتراب الإنسان في العالم بوصفه الروح النفيس في كون خسيس. والحال، فإن مقولة الكون الساقط التي أوجبت القول بالاغتراب، بسبب عدم تجانس الروح والمادة، هي أساس الأسس في فهم الصوفية، أو في عواملها الذاتية حصراً. أما قولهم الذي سبق بأن التصوف هو النظر إلى الكون بعين النقص والذي ينسب إلى العارف أبي يزيد البسطامي، فالمقصود به هو ذاك النقص الرابض في صميم الكون كبير إلى حد مريع، بل هو من الضخامة والتوغل في الأشياء بحيث يفترض أن تكون مساحات الخواء شديدة الاندياح، ولولا ذلك لما كان للصوفية أن تعرف طريقها إلى الوجود. فالصوفية بهذا المعنى دفاع ضد الخواء، ومحاولة جلَّى لإدخال الملاء في صميم العالم. أما مصدر حرية الصوفي فعائدٌ إلى أنه يرفض الكون ويطلب الحق من دون سواه، ذلك بأن الصوفية لا تفهم الحرية إلا من حيث هي الله نفسه، مثلما أنها لا تفهم الله إلا بوصفه الحرية الخالصة. ولكن ما هو واضح تماماً أن الصوفية تربط الحرية بالتمرد على المعطى، أو على الكون وقوانين الطبيعة، وكذلك على المجتمع وما يسوده من قوى تاريخية ومادية.
* * *
كُثُرٌ من محقِّقي الشيخ الأكبر انبروا إلى نعت المعارف الصوفية والعرفانية بالسر الذي يتلقاه العارف من دون أن يقدر على الإفصاح عنه بالكلمات. ولعل الإحالات التي اصطفاها العليمي في هذا المورد تشكل مصداقاً لفرضية قصور العقل الإستشراقي عن خوض البحر الخضم لمنظومة الشيخ الأكبر. هذه القضية سيقاربُها في الفضاء الروحاني الغربي اللَّاهوتي والفيلسوف الألماني رودولف أوتو (1869-1937) بضربٍ من الخصوصية المعرفية لمَّا أطلق على الشيء الذي يتوجّه إليه الوعي الألوهي اسم السر الرهيب. والرهيب (tremedum) – بحسب أوتو -هو الذي يضيف إلى السرّ (mysterium) ما ليس كامناً فيه بالضرورة. صحيح أنّ الارتدادات الكامنة في الوعي، والمناسبة لأحد اللفظين، تفيض تلقائيّاً وعفويّاً في الارتدادات التي تناسب اللفظ الآخر، إلاَّ أن أيّ امرئ مرهف الحسّ لا يلبث حين يستخدم اللفظين أن يشعر مثل غيره بأنّ فكرة “السرّ” ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحمولها الوصفيّ والشموليّ، إذ “السرّ” يغدو من تلقاء ذاته، “سرّاً رهيباً” بالنسبة إلينا. ولأن هذا الأخير، يحتاج إلى لفظ يكون وقفاً عليه وحده، فالأنسب له هو لفظ “الدهشة” (Stupor). ذاك أن الدهشة، ببساطة، هي شيء مختلف عن الرهبة؛ فهي تدلّ على إعجاب خاوٍ، وعلى انذهال يستولي علينا فيحبس فينا أنفسنا. وبالواقع، يعني لفظ السرّ- كما يضيف أوتو – لو أُخِذ بمعناه الطبيعيّ دون سواه، فإنه يعني أمراً مكتوماً، أو خفيّاً، بمعنى الشيء الغريب وغير المفهوم، وغير المفسَّر. ومن هذا القبيل، لن يكون السرّ العرفاني- وكما يتبدى في أعمال إبن عربي- سوى مصطلح فكريّ وخاطرة قبسيّة تُستَمَدّ من الدائرة الطبيعيّة موضحة المعنى الواقعيّ إلا أنها عاجزة عن أن تفصح عنه إفصاحاً تامّاً. فما هو سرّيّ، متى أخذ به حسب معناه الدينيّ، إنّما هو “ذو الغيريّة التامّة”، الذي يوجد بتمامه خارج دائرة المعهود، والممكن إدراكه، والمستأنَسِ به، والذي يقع نتيجة لذلك، بالضبط، خلف حدود “المألوف”، ويناقضه، مالئاً الذهن دهشة وذهولاً (..) فالأمر “السريّ” حقّاً يقع خارج إمساكنا به، أو إدراكنا له، وذلك ليس لأنّ لمعرفتنا حدوداً مرسومة فقط، وإنّما لأنّنا نلتقي فيه ما هو “ذو غيريّة تامّة”، بشكل ضمنيّ، وما جِبْلَتُه وصَبْغَتُه لا تقاسان بما لدينا من مثيلهما، وما نرتدّ بإزائه على أعقابنا، من أجل ذلك عينه، فنهوي في الذهول الذي يلقي فينا رعدة الفرائص وانصعاقاً.
وهكذا فإن وجه امتياز العرفان عن باقي الميول والمعارف هو كونه علماً سرَّانياً (من السر) أي أنه علم كامن في السريرة ثم يظهر على وجهتين: إما على نحو العبارة والبحث وهو ما يعرف بـ “العرفان النظري”، أو على نحو السير والسلوك في ما عُرِف بـ “العرفان العملي”. مع هذا التأصيل المفاهيمي، يغدو العرفان بوجهيه المذكورين وحدة علمية، ولو تقدّم فيها الوجه العملي كاختبار باطني، على النظري كتعبير بالكلمات عما يستشعره قلب العارف بالتجربة. لذا لا يمكن الفصل بين هذين الوجهين بحال من الأحوال.
لقد ذهب صاحبنا الدكتور العليمي مذهب الواعي بغاية أمره لمَّا أومأ إلى أصل المشكلة التي وجَّهت الاستشراق ورسمت مناهجه حيال المستودع الثقافي والمعرفي للعالم الإسلامي بدوائره وحقوله المختلفة. ولو كان لنا أن نستخرج مما جاءت به موارده من هذه الجهة بالذات، لألفينا إرهاصاتها في المبتدأ الأنطولوجي للإستشراق. وهنا بالذات تولد المفارقة التالية: كيف لدربةِ معرفةٍ أساسُها وثنية اللوغوس” المستورثة من الإغريق، ان تستقرئ دربةَ معرفةٍ واقعةٍ فوق طور العقل المحض؟ هذا على الحقيقة، تساؤل فلسفي بالدرجة الأولى. ولو كان له أن يأخذ شرعنية المعرفية، فلأنه جاء نتيجة انحباس السؤال الفلسفي في كهف الطبيعة المرئية ولم يتعداه إلى المابعد. ولكن، نَدَر أن سُئِلت الفلسفةُ عن الدّوافع التي جعلتها تميلُ إلى الاعتناء بظواهر الموجودات والإعراض عن الأصل الذي هو علّة إظهارها. قد تكون هذه الندرة عائدةً في الغالب إلى أنّ الفينومينولوجيا لم تكن سوى مركَّبٍ ميتافيزيقيٍّ اتّخذ مكانةً حاكمةً في تاريخ الميتافيزيقا. ابتدأت الملحمة مع السوفسطائيّة وما تلاها، ثمّ مع الانعطافة الأرسطيّة عبر المقولات العشر، ثم امتدَّت إلى عهود الحداثة بأطوارها المتعاقبة. ولقد تخالفت التنظيرات أو تقاطعت، بصدد ماهيّة الفينومينولوجيا، وهويّتها المعرفيّة، وطرائقها في التعرُّف إلى موضوعاتها. ولسوف نرى كيف امتلأ المعجم الفلسفيّ الحديث بما لا حصر له من التعاريف. منها من مضى إلى أنّ المعنى البَدئيّ لكلمة ظاهرة (Phainomenon) مشتقّة من فعل (Phainesthai) بمعنى «ظهر». ومنها من رأى أنّ الظاهرة هي ما يظهر من تلقاء ذاته، أو ما هو بادٍ للعيان، بقطع النّظر عن السبب الكامن وراء إبدائه.
* * *
منشأ المعضلة في ظاهراتيات الحداثة التي أخذ بها المستشرقون عن ظهر قلب، إنما يعود إلى الفهم الميتافيزيقيّ لأوّل ظاهرةٍ وجوديّة. أي إلى ظاهرة نشوء الكون الذي اتّفقت الفينومينولوجيا اليونانيّة والحديثة معاً على أنّه هو الشّيء الذي يظهر من تلقاء ذاته. وبالتالي، هو نفسه الشّيء الممتنع ذاتاً عن المعرفة، والذي ينبغي تعليق الحكم عليه. النتيجة التي ترتَّبت على هذه “المسلَّمة” جاءت على خلاف ما تقتضيه البراءة العلميّة. والنتيجة، تقييد العقل وتعطيل إمكاناته إلى حدِّ إنكار العلّة المظهِّرة لهذا الشيء. وما ذاك إلّا لأنّ العقل الفينومينولوجيّ الغربيّ منذ بداياته التأسيسيّة قرَّر النّظر إلى”النومين” كعلّة تامَّة نشأت من ذاتها بذاتها ولذاتها، ولا حاجة لها إلى علَّةٍ خارجيّةٍ تدفعها إلى الظهور. وبالتالي، سيضطرُّ الناظر إليها أن يتّخذ هذه المسلَّمة دربةً له، كقاعدة ضروريّة لوصف ما هي عليه ظواهر الموجودات في الواقع.
في الميتافيزيقا الحديثة، دارت الأفهام حول النومين مدارات شتَّى من الجدل، إلّا أنّها في خواتيمها لم تفارق ما تداوله حكماء اليونان وفلاسفتهم. هو حيناً نفس الأمر المكمون في الشيء، وهو عصيٌّ على الإدراك، ولا يُعرف إلا حين يبدو لنا في الواقع العيني.. ذلك ما كان أشار إليه هايدغر لما بيَّن أنّ الحداثة أخفقت في ابتكار تعريف للكليات يوازي أو يجاوز ما وضعه الإغريق. وإنّ فلاسفة اليونان مذ حدَّدوا المعالم الأساسيّة لمبادئ فهم الوجود لم تتحقّق خطوةٌ جديدةٌ من خارج الحقل الذي ولجوه أوّل مرّة.
من أجل ذلك، ينبِّه علم النومين (النومينولوجيا) إلى وجوب تصويب خللٍ تكوينيٍّ في الاسم الأنطولوجي للميتافيزيقا. فإذا كانت كلمة الما بعد (ميتا) دالَّةً على ما هو تالٍ للطبيعة أو ما فوقها، فذلك معناه أنّ عالم ما بعد الطبيعة هو امتداد للطبيعة وموصول بها بعروةٍ وثقى. ما يعني أيضاً أنّ كلّ ما بعد الطبيعة هو واقعٌ حقيقيّ بمرتبةٍ وجوديّةٍ مفارقة، وإن تعدّدت ظهوراته كمّاً وكيفاً. مثل هذا الخلل في الاسم الأنطولوجيّ للميتافيزيقا سوف يؤدّي إلى صدعٍ في المبدأ المؤسّس للعقل، والاستفهام عن حقيقته. وهذا ما سيكشف عن أمرٍ بديهيٍّ سها عنه القول الفلسفي الإغريقي ولواحقه. فإذا كانت مهمّة الميتافيزيقا البحث في الوجود بما هو موجود، فإنّ مبتدأها ومنتهاها تمثَّل بحصر معرفتها بالموجود في ظهوره العياني وعدم الاكتراث بما هو عليه في خفائه وكمونه.
* * *
لا نتريَّب لو قلنا أن المسعى إلى تأصيل التعرُّف على “النومين”، ينبغي أن يكون محمولاً على رهانٍ معرفيٍّ يسترجع ما هو مفقود في تاريخ الفلسفة التي تحوّلت إلى فينومينولوجيا مقطّعة الأوصال. وحين يكون سمْتُ العلم بالشيء في ذاته وغايته استشكاف المنسيِّ والمغفول عنه من الوجود، فمما لا ريب فيه حالئذٍ، أنّنا تلقاء مهمّة عظمى تستلزم أوّل ما تستلزم، همّة إيجاد المنهج الموصل إليه. وعلى غالب التصور فإن ما يريده الدكتور العليمي من إضاءاته على مناهج المستشرقين حيال النظام الميتافيزيقي للشيخ الأكبر يعود في تقديري إلى سعيه الدؤوب لكشف المعثرة الأنطولوجية الكبرى للإستشراق. أقصد بذلك قصور المستشرقين عموماً عن فهم ميتافيزيقا التوحيد في عرفان إبن عربي. مرجع الأمر أن المشكلة المعرفية الجوهرية في الاستشراق الغربي هي جهله بـ “الشيء في ذاته” وتقريره باستحالة معرفته. وهذا الجهل هو ما قصدناه بالمعثرة الأنطولوجية التي غاب عنها علم الوجود بوصفه علم بدء العالم أو علم المبدأ الذي عبر عنه إبن عربي بمعرفة “الحق المخلوق به”.
ولذا، فإنّ المهمّة التأسيسيّة لعلم الوجود بالموجود الأول “النومينولوجيا” هي إذاً، استكشاف حقيقة موجودٍ فُطِرَت موجوديّته على وحدة البساطة والتركيب. وبالتالي، إدراك حقيقة هذا الجوهر الوجوديّ الذي حظيت ذاته بفرادة جمع الوحدة إلى الكثرة، هو الشيء الوحيد الذي تقوم طبيعته على الثراء والفقر في آن. أي بين الاحتياج إلى موجده وبين كونه مبدأ مؤسّساً لعالم الممكنات.
لم يكن ما مرَّ معتنا قبل قليل مقطوع الصلة بالجدل الضاري الذي احتدم بين المتلقِّين لفكر ابن عربي من المستشرقين الأميركيين المعاصرين ومنهم تشيتيك وموريس، وبين المستشرقين الكلاسيكيّين مثل نيكيلسون وكوربان وإيزوتسو وعبد اللّه غراب… هذه المنازعات لم تكن تكتفي بمجرَّد الاعتراض على قواعد التّأويل التي فرضها الأوائل للإطار الذي تؤخذ فيه ومنه تلكمُ النُّصوص، بل تتحمَّل مهمَّة فرض أفق تأويليٍّ جديد يقول المؤلف أنَّه أكثر إنصافًا، وأشدُّ وفاء لمتن إبن عربي بالنّظر إلى تجرُّده من الأحكام المسبقة التي ميَّزت أعمال الأوائل، وتلك مهمَّة تتضمَّن ممكنات مترابطة تمفصليًّا من شأنها أن تجيبنا عن طائفة من التطلعات أوردها العليمي بثلاثة:
ـ التَّعرُّف على أُسس الفعل التّأويليِّ الذي حدَّده واضعوه، وكيفيَّة تطبيقه لفهم نصوص ابن عربي من قبل المستشرقين الكلاسيكيّين.
ـ الإصغاء إلى المآخذ والاعتراضات التي يبديها تشيتيك على تلك الأساليب التّأويليَّة، واقتراحه لصفوة بدائل تأويليَّة لا تقتنع بمجرَّد وصف فكر ابن عربي بإخضاعه إلى ما نريد، وإنَّما بجعله يتكلَّم عن نفسه ليقول ما يريد.
ـ محاولة تقييم هذا السِّجال التّأويليِّ في رواق الجدل الاستشراقيِّ الرّاهن من جهة الغرض الأسمى للتَّفكير الفلسفيِّ، المتمثِّل في خلق تقنيَّات فهم جديدة تأبى الانحصار في مهمَّة الانقلاب على مقولات التّأويليَّة التّقليديَّة بالتّضادِّ معها، إلى الانخراط في مهمَّة استصلاح داخليٍّ للاستشراق هدفُه البعيد الانفتاح على ممكنات جديدة تدمج الباحث ضمن علاقة حميميَّة مع نصوص إبن عربي، وتجعله أكثر اقترابًا من مضامينها، فيزامنها على نحو محرج. أي العمل على جلب واقعه الثّقافيِّ والتّاريخيِّ إلى واقع الباحث وجعله أفقًا أساسيًّا للتّلقّي من دون فرضه معلمًا وحيدًا للتّفكير به ومن منطلقه[راجع: م. العليمي: فصلية “علم المبدأ” العدد الثامن – شتاء 2024].
لم تفلح نظرية المعرفة الإستشراقية بفهم “النومين المتعالي” لإبن عربي بسبب وراثتها العمياء لدربة أسلافها. فلقد كفَّت الميتافيزيقا التي عهدناها مع قدماء الإغريق عن أن تكون العلم بإلهيّات ما بعد الطبيعة. جرى هذا من بعد أنسها المتمادي بالمفاهيم، حتى لقد أخلدت إلى دنيا الطبيعة، ودارت مدارها، ولم تكن في مجمل أحوالها ومشاغلها سوى مكوث مديد على ضفاف الكون المرئي. لقد انسحرت الفلسفة الأولى بالبادي الأوّل حتى أشركته مُبديه وبارئه، ثم راحت تخلع عليه ما لا حصر له من ظنون الأسماء: المحرك الأوّل غير المتحرك، “النومين أو الشيء في ذاته”، “العلّة الأولى” و”المادة الأولى أو الهيولى”، وأخيرًا وليس آخراً “القديم والأزلي”.. وجرياً على هذه الحكاية ستنتهي إلى نعته بالموجود الذي أوجد ذاته بذاته من عدم، ولمّا أن وُجدَ لم يكن له من حاجة إلى تلقّي الرعاية من سواه. هو بحسب “ميتافيزيقاهم” كائن مكتفٍ بذاته، ناشطٌ من تلقاء ذاته، ومتروكٌ لأمر ذاته.
أما الفلسفة الحديثة التي ينتسب إليها جلُّ المستشرقين الذين تصدوا لعرفان الشيخ الأكبر، فإنها لم تَبرح هذه المعضلة الموروثة عن السّلَف الإغريقي. لقد ظل مبدأُها المنبسطُ على ثنائيّة “النومين” و”الفينومين” ملازماً لها كما هو في نشأته الأولى. وبسبب من هذا التلازم تجدَّدت ألوان المعضلة وتكثَّرت أنواعها، واستدام الاختصام والفرقة بين جناحي الثنائيّة. ولمَّا لم يكن لهذا المبدأ أن يبلغ مقام الجمع بين الجناحين، أفضت الإثنينيّة في غُلُوِّها الإنشطاريّ إلى وثنيّةٍ صارخةٍ حلَّت ورسخت في قلب الميتافيزيقا، قديمُها ومستحدثُها. من هذا النحو، لم يُفلح النّظام الفلسفيّ الكلاسيكيّ في مجاوزة معضلته الكبرى المتمثّلة بالقطيعة الأنطولوجيّة بين الله والعالم. وهو حين تصدّى إلى مقولة الوجود بذاته، أخفق في إدراك حقيقته. ثم أعرض عنها وأخلد إلى الاستدلال المنطقيّ والتجربة الحسِّية. لهذا ظلّ الموجود الأوّل في هندسة العقل المقيَّد بالمقولات العشر لغزاً يدور مدار الظنّ، ولمَّا يبلغ اليقين. وبسببٍ من قيديَّته سَرَت ظنونُهُ إلى سائر الموجودات ليصير الشكُّ سيّدَ التفلسف منذ اليونان إلى ما بعد الحداثة. من أجل ذلك، سنرى كيف سيُخفقُ التاريخُ الغربيّ رغم احتمائه بهندسات العقل الذكي، في إحداث مسيرة حضاريّة مظفرة نحو النور والسعادة. فلقد تخلَّل ذلك التاريخ انحدار عميق إلى دوَّامة المفاهيم والاستغراق مليّاً في أعراض المرئيَّات الفانية. النتيجة أنّه كلَّما ازدادت محاولة الإنسان فهم دنياه، وعالمه الواقعي ازداد نسيانه ما هو جوهري. والنُّظَّار الذين قالوا بهذا لا يحصرون أحكامهم بتاريخ الحداثة، بل يُرجعِونها إلى مؤثِّرات الإغريق، حيث وُلِدتَ الإرهاصاتُ الأولى لتأوُّلات العقل الأدنى. وهو العقل إيَّاه الذي سترثه الفلسفات اللَّاحقة، لتصبح العقلانيّة العلميّة معها حَكَماً لا ينازِعُه منازعٌ في فهم الوجود وحقائقه المستترة. وكحصيلة لمسارات العقل الأدنى ستأخذ الثورة التقنيّة صورتها الجليِّة، لِتَفْتتِحَ أفقًا تفكيرياً سيعمّق القطيعة مع أصل التكوين وحقيقة الوجود.
مستخلص القول مما مضى إليه الدكتور مصطفى العليمي من مقاصد، ان ثمّة حضوراً لطائفةٍ من الاختلالات في بنية التفكير الفينومينولوجي الإستشراقي. وهي اختلالات تكوينية أفضت إلى صرفها عن أداء وظيفتها المنهجيّة في استقراء الروحانية المعرفية التي تجلَّت في أعمال الشيخ الأكبر. في رأس قائمة الاختلالات هو الانفصال عن المبدأ المؤسِّس لكلّ ظاهرة، ووقوفها على التوصيف البحت، وافتقارها إلى نظريّة كاملة وراسخة في التبرير والتسويغ، وبقاء مفاهيمها الجوهريّة والأساسيّة عامّة وغامضة.
بيروت – شتاء 2025