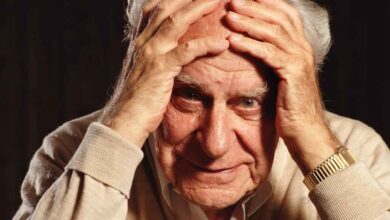خصائص المعرفة العرفانيَّة
د. فادي ناصر
أستاذ الفلسفة والدراسات الإسلامية في جامعة المعارف – لبنان.
إذا كان وجود جهة الاتحاد والاشتراك بين العالم والمعلوم ورجحانها على جهة التغاير والتمايز هي السبب في حصول المعرفة عند العارف، فإنّ هذا الاتّحاد بينهما ليس على نوع واحد، بل هو على نحوَيْن بحسب النشأة الّتي يتحصّل فيها هذا العلم. وهي إمّا مرتبة الظاهر أو الباطن، ولا ثالث لهما. بمعنى أنّ الاتّحاد بين العالِم والمعلوم إمّا أن يقع في مرتبة الظاهر، أو في مرتبة الباطن، وبتبع اختلاف النشأة سوف تختلف الآثار. إذ لكلّ نشأة خصائصها ولوازمها على مستوى الوسائل والآثار، وحتّى علّة الاتّحاد، فعلّة الاتّحاد بين العالِم والمعلوم مختلفة باختلاف الحيثيّة الوجوديّة. فعلّة الاتّحاد بينهما في مرتبة الظاهر هي غيرها في مرتبة الباطن.
إنّ علّة الاتّحاد بين العالِم والمعلوم في مرتبة الظاهر، أو ما يُسمّى أيضا بالعالم الخارجي الموازي للعالم النفسي هو “الوجود”. أي الوجود والتحقّق الخارجي للشيء، مع ما يفرضه هذا النحو من الاتّحاد في عالم الظاهر من التأثّر بأحكام هذا العالم؛ من التعدّد والتغاير والاحتياج إلى الوسائط وغيرها. أمّا علّة وسبب الاتّحاد بينهما في مرتبة الباطن، فهو نفس حصول المناسبة الحقيقيّة بين العالِم والمعلوم، بحيث يؤدي إلى رفع المغايرة والاثنينيّة بينهما.
ففي الرؤية العرفانيّة، الاتّحاد بين العالِم والمعلوم، إما أن يحصل بالوجود الخارجي للشيء، أو بالوجود الباطني، من خلال إيجاد العلقة والمناسبة الباطنيّة معه، وهو ما سوف ينعكس لاحقًا على خصوصيّات المعرفة العرفانيّة وتقسيماتها، والّتي أوّل ما يظهر منها التقسيم المشهور للعلم إلى “علم حصولي” و”علم حضوري”. هذا التقسيم الّذي يوافق عليه العارف ويتبنّاه أيضًا كغيره من علماء المعرفة والفلسفة، مع احتفاظه دائمًا بخصوصيّاته التي يتميّز بها من ناحية رؤيته لحقيقة العلم، وما يتفرّع عن هذه الرؤية من آثار ولوازم وحقائق. فعند العارف، يقودنا النوع الأوّل من الاتّحاد الظاهري بين العالِم والمعلوم إلى ما يسمّى بالعلم الحصولي بالشيء، والنوع الثاني من الاتّحاد يقودنا إلى العلم الحضوري بالشيء كما يقول القونوي:
“سبب الجهل بالشيء هو أثر حكم ما به يمتاز المجهول عمن جهله، وسبب العلم بالشيء هو غلبة حكم به الاتّحاد مع المعلوم، كان المعلوم ما كان والعالم من كان. وعلّة الجمع الظاهر بين الأشياء والموحّد لكثرتها مع امتياز بعضها عن بعض بالحقائق؛ هو الوجود. وعلّة الجمع الباطن هو المناسبة الحقيقيّة الذاتيّة الرافعة للتغاير كما قلنا، سيّما مع انضمام حكم المناسبة في الأوصاف والأحوال أيضًا. فإنّ أحكام الأوصاف والأحوال تسري وتتردّد بين هذين الطرفين، وهما الظهور والبطون. والظهور والبطون وصفان للوجود الحقّ من حيث تعقل وحدته وانفراده من حيث ظهوره فيما اقترن به من الأعيان الّتي هي عبارة عن حقائق العالم، والمرتبة تجمع وتحيط”[i].
إذًا، في الرؤية العرفانيّة بناءً لاختلاف شكل الاتّحاد بين العالِم والمعلوم، وبحسب النشأة والمرتبة الوجوديّة، فإنّ ذلك سوف يترك أثرًا مباشرة على العلم؛ لينقسم إلى أنواع أيضًا بتبع هذا الاختلاف. فإذا كانت مرتبة وعالم الاتحاد هي نشأة الظاهر، عندها سيكون الاتّحاد بين العالِم والمعلوم اتّحادًا متوقّفًا على واسطة هي نفس “الوجود”. وهذا الوجود ليس على نحو واحد وحال واحدة، بل هو على صور وأشكال متعدّدة في هذه النشأة الظاهريّة. فقد تكون هذه الواسطة إما وجودًا حسيًّا، أو خياليًّا، أو عقليًّا ذهنيَّا. والهدف من وجود هذه الوسائط الوجوديّة هو إيجاد العلقة والصلة بين العالِم والمعلوم، بسبب التمايز والتباين الحاصل في مرتبة الظاهر بين العالم الّذي هو وجود نفسي، والمعلوم الّذي هو وجود خارجي. فيقع الاختلاف بين العالم عن المعلوم، فتمسّ الحاجة إلى جامع يجمع بينهما لكي يحصل الاتّحاد بين الوجود النفسي للعالِم والوجود الخارجي للمعلوم، ليتحقق العلم ويصبح منجّزًا. ويسمى هذا النحو من العلم بـ”العلم الحصولي”.
أمّا إذا كان عالم الاتّحاد بين العالِم والمعلوم هو نشأة الباطن أو النفس، عندها لن يكون هناك حاجة إلى توسّط واسطة خارجيّة لعدم وجود الاثنينة والتعدّد في المقام بينهما. ويُسمّى هذا العلم بـ”العلم الحضوري”. والعلم وإن كان – بمعناه العام – يعني حضور المعلوم عند العالِم كما يعرفونه، ولكنّ هذا الحضور في الحقيقة هو على نحوَيْن: حضور مع واسطة وحضور بلا واسطة. والحاجة إلى الواسطة مردّها المسافة أو الثغرة الموجودة بين عالم الخارج والعين، وبين عالم النفس أو الذهن. وهذه الثغرة من السعة بحيث يصعب اجتيازها بسهولة. وقد سعى العديد من الفلاسفة إلى تضييق هذه الثغرة، وحتّى إزالتها، ولكن قلّما نجح أحد منهم في هذه المهمّة الشاقّة والعسيرة إلّا من طرق باب المعرفة الحضوريّة؛ لأنّها الطريق الوحيدة الّتي يمكن أن نضع فيها حدًّا لهذه الاثنيّنة والتغاير بين طرفَيْ العلم، كونها معرفة مباشرة وتعدّ من أنواع الإدراك الشهودي للشيء، “وفي عالم الحضور والشهود يزول الفاصل بين العين والذهن، ويحصل نوع من الاتّحاد بين العالِم والمعلوم. ولا تنفصل العين عن الذهن حتّى في العالم المثالي وعالم المجرّدات، ولا يلاحظ وجود ثغرة بين العالِم والمعلوم”[ii].
يقول الشيخ “مصباح اليزدي” في تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري: “إنّ أول تقسيم يمكن للعلم هو أنّ العلم إمّا أن يتعلّق بذات المعلوم من دون واسطة بحيث إنّ الوجود الواقعي والعيني للمعلوم ينكشف للعالِم والشخص المدرك، وإمّا أن لا يتعلّق شهود العالِم بالوجود الخارجي للمعلوم مباشرة، وإنّما يتعلّق علمه بشي يعكس المعلوم، ويطلق عليه اصطلاحًا اسم الصورة الذهنيّة أو المفهوم. والقسم الأول يسمّى بـ العلم الحضوري، والقسم الثاني يسمّى بـ العلم الحصولي”[iii].
فحضور المعلوم إذا كان بنفسه لدى العالم، بمعنى أنّه يتمّ إداركه والعلم به من خلال الحقيقة المعلومة ذاتها، ومن دون توسّط أي شيء، فهو نحوٌ من العلم “الّذي يكون فيه المعلوم عين الواقع”[iv]، وهذا هو المصطَلح عليه بـ “العلم الحضوري”. وأمّا إذا كان حضور المعلوم عن العالم به من خلال واسطة، بمعنى أنّه لا يدركه من خلال ذاته، ولا يحضر بنفسه لدى العالم، بل عبر واسطة حاكية وكاشفة عنه، فهو نحو من العلم “الّذي لا يكون فيه المعلوم عين الواقع، وإنّما كاشف عن الواقع”[v]، وهو ما يصطلح عليه بـ “العلم الحصولي”.
وهذه الوسائط كثيرة ومختلفة، وتختلف من موجود إلى آخر بحسب الرتبة والمقام. ويمكن تقسيم هذه الوسائط إلى ثلاثة أقسام هي: الحسيّة، الخياليّة والذهنيّة. فما يراه الإنسان من المناظر المرئيّة الخارجيّة لا يحصل العلم به إلّا من خلال حاسّة البصر، حيث تلتقط الصور وتقوم بإرسالها مباشرة إلى النفس فتدركها، فيحصل العلم بها وبخصوصيّاتها المرئيّة فقط؛ مثل الأبعاد الثلاثة واللّون وما إلى ذلك. وهكذا الأمر أيضًا بالنسبة إلى بقيّة الإدراكات الحسيّة التي تحصل بواسطة أجهزة الحسّ.
هذه الوسائط لا تقف عند حدود المحسوسات وأدواتها، بل تتعدّاها أيضًا إلى الصور الخياليّة الّتي هي حضور صورة المادّة المدركة سابقًا بواسطة الحواس لا نفسها، والّتي تستدعيها النفس بعد احتفاظها بها؛ لتكون واسطة مثاليّة بين العالِم والمعلوم بعد انقطاع الإدراك الحسي بشكل مباشر. وتتعدّاها إلى الصور العقليّة والمفاهيم الذهنيّة أيضًا، والّتي هي نوعٌ من الإدراك الكلي للأشياء المجرّدة عن الجسم وعوارضه الماديّة؛ كالعلم بالبراهين والمقدّمات المنطقيّة والمعقولات الفلسفيّة الأوليّة والثانويّة. إذًا، “فالعلم الحصولي هو الّذي يحصل عليه الإنسان عبر وسيط بين المعلوم والنفس الإنسانيّة، من الحواس الظاهرة، أو المفاهيم العقلية، أو غيرها، كما أنّ المعلوم في حقيقة الأمر ليس هو نفس الموجود، بل صورة أو مفهوم منه. وهذا بخلاف النوع الأوّل من العلم، وهو العلم الحضوري، فإنّ العلم فيه بالموجود من خلال نفس الحقيقة الّتي هي عند العالم بها، وشهود النفس لذلك المعلوم مباشرة، ومن دون توسّط حاسّة أو خيال، أو مقدّمات وبراهين”[vi].
ومن مصاديق العلم الحضوري علم الإنسان بنفسه بعنوان كونه موجودًا مدركًا، وهو علم لا يقبل الإنكار ولا الخطأ، ولا التجزئة أيضًا. والمراد من الإنسان هنا هو “الأنا” المدرِك والمفكّر الّذي يعلم بذاته عن طريق الشهود الداخلي البسيط، لا أنّه يعلم بها عن طريق الحسّ والتجربة، وبواسطة الصور الخياليّة والمفاهيم الذهنيّة. وهذا العلم والوعي، خاصيّة ذاتيّة للروح الإنسانيّة، وقد ثبت في محلّه أنّ الروح مجرّدة وليست ماديّة، وكلّ جوهر مجرّد فهو عالم بذاته، “فالعلم الحضوري هو عين المعلوم”[vii]، لذا في هذا النحو من العلم لا يوجد تعدّد وتغيّر بين العلم والعالِم والعلوم. أمّا علم الإنسان بالأمور الخارجيّة، كعلمه بخصائص جسمه من لون وشكل وغيرها، فعالم بها يحصل عن طريق البصر أو اللّمس أو سائر الحواس، وبواسطة الصور الذهنيّة.
ومن مصاديق العلم الحضوري أيضًا علمنا بحالاتنا النفسيّة ومشاعرنا وعواطفنا، فإنّه علمٌ حضوريٌّ أيضًا يتمّ بلا واسطة. فعندما نشعر بالخوف من مسألة ما، فإنّنا ندرك هذه الحالة النفسيّة ونشعر بها مباشرة وبشكل بسيط، ومن دون أيّ واسطة. وكذلك عندما نشعر بالحب في أنفسنا تجاه شخص ما، فإنّنا ندرك في أعماقنا هذا الميل والانجذاب الباطني بشكل يقيني وبسيط، ومن دون الحاجة إلى واسطة في الإدراك أيضًا. فلا يمكن إنكار هذه المشاعر والميول، أو الشكّ بها، أو الاستدلال عليها. ومن مصاديق العلم الحضوري أيضًا علم النفس بقواها المدركة من قوّة التعقل والتفكير والتخيّل، وعلمها بقواها وجوارحها المحرّكة للبدن، فهو أيضًا علم حضوري بسيط ومباشر لا تتعرّف إليه النفس عن طريق الوسائط من أدوات حسّ، أو صور ومفاهيم ذهنيّة أو غيرها.
ومن هنا، فإنّ النفس لا تشكّ بهذه القوى المدركة والمحرّكة، ولا تخطئ في استخدامها عندما تُقرّر ذلك، بل حتّى العلم بالصور نفسها والمفاهيم الذهنيّة الّتي تدركها النفس وتعلم بها علمًا يقينًا، فترتّب عليه الكثير من الآثار، فإنّه لا يحصل عن طريق صور أو مفاهيم أخرى، بل إنّ النفس تدرك هذه الصور المعقولة بالنفس ذاتها، وتعلم بها علمًا حضوريًّا غير قابل للشكّ أيضًا. وبهذا البيان الّذي قدّمناه “للعلم الحضوري والعلم الحصولي وما بينهما من فرق، يعرف لماذا يكون العلم بالنفس والعلم بالحالات النفسيّة وسائر العلوم الحضوريّة مستعصية على الخطأ؛ وذلك لأنّ نفس الواقع العيني في هذه الموارد يكون مورد الشهود، بخلاف موارد العلم الحصولي، فإنّ المفاهيم والصور الذهنيّة تؤدي فيها دور الواسطة، وقد لا تتطابق بشكل كامل مع الأشخاص والأشياء الخارجيّة. وبعبارة أخرى، إنّ الخطأ في الإدراك لا يتصوّر إلّا في حالة ما إذا كانت واسطة بين الشخص المدرِك والذات المدرَكة؛ بحيث إنّ العلم لا يتحقّق إلّا بفضلها”[viii].
ولهذا السبب كان العلم الحضوري من الخصائص الأساسيّة للمعرفة العرفانيّة. ففي المعرفة العرفانيّة، يحضر ذات المعلوم عند العالم وليس صورته، ولذلك فلا يقع فيها الخطأ بخلاف المعارف الأخرى؛ كالفلسفة وغيرها الّتي تحضر فيها صورة المعلوم لا ذاته في النفس والعقل. فالعارف يدرك ذات المعلوم لا صورته، ويحضر لديه نفس المعلوم بوجوده الخارجي العيني من دون توسّط أيّ واسطة. وبناءً عليه، “فإنّ العلم العرفاني هو علم مباشر بالمعلوم من دون توسط صورته، فغاية العارف في المعرفة العرفانية الوصول إلى المعلوم والعلم به نتيجة للوصول. في حين أنّ الأمر على العكس في المعارف العاديّة، حيث يكون العلم هو المراد والوصول إلى المعلوم هو النتيجة، بل نتيجة محتملة وليست حتميّة؛ بمعنى أنّ العلم في المعارف العاديّة لا يعني الوصول للمعلوم حتمًا ولزومًا، في حين أنّ الوصول إلى المعلوم يستتبع العلم به حتمًا”[ix].
2. المعرفة العرفانيّة معرفة يقينيّة
من النتائج المهمّة المترتّبة على كون المعرفة العرفانيّة معرفة حضوريّة، القول بيقينيّة هذه المعرفة، لانتفاء الشكّ فيها لكون المعلوم متّحدًا ذاتًا مع العلم، فهو حاضر عنده بذاته ومن دون أيّ واسطة بينهما، فلا يقع الخطأ والشكّ فيها كما ذكرنا في العنوان السابق. وهذا ما يعطي المعرفة العرفانيّة ميزة مهمّة جدًّا تفتقدها المناهج المعرفيّة الأخرى. فالمعرفة الحسيّة والتجريبيّة لا توصل إلى اليقين بالمنظار والمنهج العقلي والفلسفي، فكيف بالرؤية والفهم العرفاني.
ففي نظر الفيلسوف ما يدركه الإنسان بوساطة الحسّ هو جنبة الإثبات ووجود الأشياء فقط لا اليقين بوجودها. فما يدركه بواسطة الحسّ هو وجود الضوء مثلًا، ولكن هذا المقدار من الثبوت لا يؤدّي إلى اليقين بوجود الضوء؛ لأنّ اليقين بوجود الضوء من وجهة نظر الفلسفة يجب أن يكون مسبوقًا بمبدأ بديهي يدركه الإنسان بالعلم الوجداني والحضوري؛ وهو مسألة استحالة اجتماع النقيضين.
فالعلم بوجود الضوء إنّما يصبح قطعيًّا ويقينيًّا عندما نقبل بمسألة امتناع اجتماع النقيضَيْن كقاعدة عقليّة بديهيّة يدركها الإنسان بالعلم الحضوري، فتشكّل على أساس ذلك قياسًا استثنائيًّا، مفاده أنّ كلّ ما يشاهده الإنسان بواسطة الحس هو موجود، ويستحيل أن يكون معدومًا؛ لأنّ العقل يحكم باستحالة اجتماع الوجود والعدم لشيء واحد في آن واحد، وعليه من المستحيل أن لا يكون ما يشاهده ببصره موجودًا، بل إنّ وجوده يصبح ضروريًّا ويقينيًّا بحكم هذه القاعدة العقليّة الّتي نستعين بها في أبسط المسائل، ومن دونها من المستحيل الجزم اليقيني بوجود الأشياء وثبوتها[x].
والعارف في سلوكه الكشفي، القائم على المعاينة والمشاهدة القلبيّة، إنّما يرمي إلى تحقيق اليقين المعرفي وهو “العلم الّذي لا يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف”[xi]، بما كان قد ثبت لديه من معارف بالدليل والنظر والبرهان.
ويُبنى منهج اليقين عند العارف على أصلَيْن أساسيَّيْن:
الأوّل: أنّ وراء الحسّ والعقل واقعيّات وحقائق خارجيّة.
والثاني: إنّ كلّ إنسان لديه القدرة بحسب ما جهّز به من أدوات خاصّة للمعرفة على درك هذه الحقائق والتعرّف إليها بشكل صحيح.
لذا يقول “القاساني” في تعريف اليقين إنّه: “الوقوف على الحقائق بالكشف”[xii]؛ لأنّ الكشف كما سوف نبيّن لاحقًا هو المنهج المعرفي لإدراك الحقائق واكتشافها على نحو يقيني لا لبث فيه. ففي نظر العارف، العلوم الحقيقيّة هي العلوم الحائزة على اليقين، بل على أعلى درجات ومراتب اليقين. وهي أسمى مرتبة من حيث يقينها عن سائر العلوم التي تعتمد على العقل وبراهينه واستدلالاته. وهذا اليقين الّذي تتميّز به علوم الحقيقة عن سائر العلوم هو يقين كشفي ذوقي، يتحقّق به العبد متى سلك طريق التصفية القلبيّة والروحيّة كما سوف نبيّن لاحقًا.
من هنا، فإنّ المعرفة العرفانيّة لها غاية وحيدة هي الوصول إلى اليقين استجابة للأمر الإلهي: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ﴾[xiii]. فغاية العارف في سلوكه المعرفي والمعنوي أن يصل إلى نور اليقين بعد ظلمات الشكّ، فيتعرّف إلى حقيقة الوجود الّذي يحيط به، وإلى ماهيّته هو كإنسان، وحقيقته ومصيره، معرفة من شأنها أن تلقيَ السكينة في قلبه وتعيد الطمأنينة إلى نفسه وروحه. وهذا اليقين لا يتأتّى إلّا بالاتّصال المباشر بالله عزّ وجل اتّصالًا من شأنه أن يبدّد كلّ ظلمات الشكّ من خلال معرفة كنه الوجود – أي الحق سبحانه وتعالى – وما يتجلّى ويظهر من هذا الوجود المطلق من عوالم أخرى. وهذا لا يتمّ إلّا إذا خلصت النفس من شوائب الحسّ والمادّة، فصفت وأشرقت وارتقت إلى عالم الروح، وهناك تفاض عليها المعارف الإلهيّة والعلوم اللدنيّة، فتنعم بحضرة الجمال وتتمتّع بلذّة الوصال. والمعرفة الحاصلة من هذه الطريق يقينيّة لا تحتمل الشكّ، ووهبيّة لا تكتسب عن طريق أي نوع من الوسائط، سواء أكانت وسائط ماديّة أم روحيّة، أم قوى علويّة كما يقول القونوي في “النفحات”: “فالعلم الحاصل عن هذه الطريق هو الكشف الأوضح الأكمل الّذي لا ريب فيه، ولا يترك إليه احتمال ولا تأويل، ولا يكتسب بعلم ولا عمل، ولا سعي ولا عمل، ولا يتوسّل إلى نيله، ولا يستعان في تحصيله بتوسّط قوى روحانية نفسانيّة، أو بدنيّة مزاجيّة، أو إمداد أرواح علويّة، أو قوى وأشخاص سماويّة، أو أرضيّة، أو شيء غير الحقّ، والمحصّل له والفائز به أعلى العلماء مرتبة في العلم؛ وهو العلم الحقيقي”[xiv].
ولكي يصل العارف إلى هذه المعرفة اليقينيّة، عليه أن يعبر ما يسمّى بالأسفار العرفانيّة الأربعة، ويُقصد بالسفر “هو الحركة من الموطن، متوجّهًا إلى المقصد بطيّ المنازل”[xv]. وهذه الأسفار هي السفر من الخلق إلى الحق، وهو السفر الأوّل الّذي يحصل من خلال رفع الحجب الظلمانيّة والنورانيّة. والسفر الثاني من الحق إلى الحق بالحق، وإنما يكون بالحق؛ لأنّ العارف في هذا السفر يصبح وليًّا ووجوده وجودًا حقّانيًّا، فتفنى ذاته وصفاته وأفعاله في ذات الحق تعالى وصفاته وأفعاله، وفيه يصل إلى مقام الفناء. والسفر الثالث هو السفر من الحقّ إلى الخلق، وفيه يسلك العارف في مراتب الأفعال، ويحصل له الصحو التامّ بعد المحو والفناء الّذي أصابه في السفر الثاني، فيبقى ببقاء الله، ويحصل له حظّ من النبوّة، ولكن من دون تشريع. وعندما ينتهي السفر الثالث، يبدأ السفر الرابع والأخير وهو السفر من الخلق إلى الخلق بالحقّ، حيث يشاهد العارف الخلائق وآثارها ولوازمها فيعلم مضارّها ومنافعها، ويعلم بكيفيّة رجوعها إلى الله، فيكلّف باطّلاع الناس وأخبارهم بهذه الحقائق والموانع التي تحول دون معرفتها والوصول إليها، فيكون رسولًا ونبيًّا بنبوّة التشريع[xvi].
فهذه الأسفار الأربعة هي في المنهج العرفاني الرحلة المعرفيّة والسلوكيّة الّتي يقوم بها العارف ليتمكّن في خلالها بحسب طاقته وقابليّته من الوصول إلى مقام اليقين الّذي هو غاية العارف، كما يقول “الأنصاري” في “منازل السائرين”: “اليقين مركب الآخذ في هذه الطريق، وهو غاية درجات العامة؛ وقيل أول خطوة الخاصّة”[xvii]. ويرى الآملي أنّ مقام اليقين هو أعلى مراتب الإيمان، وأقصى مدارج الإسلام وأنّه “ليس وراء اليقين مرمى، لا للأنبياء ولا للأولياء، ولا للكمّل من تابعيهم؛ لأنّه هو النهاية والمقصود بالذات من السلوك كلّه، ويشهد به قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾[xviii]“[xix].
والعرفاء يقسّمون اليقين إلى ثلاث مراتب مترتّبة على بعضها البعض؛ بحيث إنّه لا يمكن الوصول إلى المرتبة الأعلى إلّا بعد تجاوز المرتبة الأدنى. وهذه المراتب هي: “علم اليقين” وهي أدنى المراتب. “عين اليقين” وهي أوسطها، ولا يمكن تحصيلها من دون “علم اليقين”. ثم “حق اليقين” وهي أعلى المراتب وأكملها، ولا يمكن تحصيلها أيضًا من دون “عين اليقين” و”علم اليقين”. وهذه الأنواع الثلاثة مستنبطة من القرآن الكريم نفسه، وليست من مخترعات العارف ولا اجتهاداته الشخصيّة كما أشار إليها جلّ ذكره في كتابه فقال: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ(5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ(6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ(7) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾[xx]، وقوله تعالى: ﴿وإِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾[xxi].
وقد عرّف العرفاء مراتب اليقين الثلاث، وإن وقع بينها شيء من الاختلاف الطفيف في التعريف. ولكن يمكن أن نجمع بين هذه التعاريف ونستخلص منها؛ أنّ اليقين هو مقام الإدراك والعلم بالحقيقة، وعين اليقين هو مقام مشاهدة الحقيقة، وحقّ اليقين هو مقام الفناء في الحقيقة. وأضاف البعض[xxii] إلى حقّ اليقين مقام البقاء بعد الفناء كما يقول القيصري في شرح كتاب فصوص الحكم: “قسّم أرباب هذه الطريقة المقامات الكليّة إلى علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين. فعلم اليقين: يتصوّر الأمور على ما هو عليه، وعين اليقين شهوده كما هو، وحقّ اليقين بالفناء في الحقّ والبقاء به علمًا وشهودًا وحالًا، لا علمًا فقط، ولا نهاية لكمال الولاية، فمراتب الأولياء غير متناهية”[xxiii].
ويضربون مثالًا على مراتب اليقين الثلاث كشخص ولد في بيت مظلم وهو مكفوف العين لا يرى، وهو غير قادر على الخروج من منزله ليرى طلوع الشمس ويشاهد جرمها وأنوارها المشرقة على الآفاق، مكتفيًا بما سمعه من المبصرين من حوله بشأن أوصافها وكيفيّة طلوعها وغروبها، حتّى إذا قدّر له أن يفتح عينيه وأن يخرج من المنزل، ولكن من دون النظر إلى الأعلى لرؤية الشمس لكي لا يتضرّر بصره الحديث العهد بالنظر، فيشاهد ضوء النهار، الّذي هو علامة ومؤشّر عنده على طلوع الشمس، فيعلم بوجودها، ولا يشكّ بعدمه مطلقًا مع أنّه لم يرَ جرمها لعلمه المسبق بأنّ ضوء النهار من آثار إشراقة أنوار الشمس، وهذا هو علم اليقين. وإذا سمح لهذا الشخص بعد فترة من النظر إلى الأعلى ورؤية جرم الشمس وعينها فهو بمثابة عين اليقين؛ لأنّه شاهد عين الشيء ورآه بذاته، لا أنه علمه أو أدركه بعلم سابق، ولكنّها تبقى معاينة عن بعد، ودون ملامسة أو اتّحاد بذات جرم الشمس. فإذا قدّر لهذا المشاهد أن يصل إلى جرم الشمس، ويتّحد بذاتها، فهو ما يصطلح عليه عند العرفاء بمقام حقّ اليقين[xxiv].
وعلم اليقين، وإن كان مرتبطًا بمقام الإدراك والعلم، ولكن الإدراك في هذه المرتبة لا ينحصر بطريق الفكر والعقل، بل يشمل الإدراكات التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الكشف، وتسمّى بالكشوفات المثاليّة والبرزخيّة، وهي مختلفة كلّ الاختلاف عن الكشوفات القلبيّة العينيّة الّتي تحصل في مرتبة عين اليقين.
فما يدركه الإنسان في مقام علم اليقين يمكن أن يقسّم أيضًا إلى ثلاث درجات. الأولى مرتبطة بإدراك ما ظهر من الحقّ والحقيقة عن طريق الرسالة، وما جاءت به الرسل من الإيمان والإسلام والأحكام، وما أثبتوه بالمعجزات الصادرة من الله تعالى، من أجل الاستدلال والبرهنة على وجوده جلّ وعلا. أمّا الدرجة الثانية فهي مرتبطة بإدراك ما غاب عن الحق والحقيقة، من الأمور المتعلّقة بالدار الآخرة وأحوال القيامة، والجنّة والنار وغيرها من الحقائق الغيبيّة، من أجل تعميق الرابطة والارتباط اليقيني بين الإنسان والحقّ تعالى. أمّا الدرجة الثالثة وهي أعلاها، فهي إدارك ما هو قائم بالحقّ بواسطة الكشوفات المثاليّة والصوريّة؛ كالمنامات الصادقة، والإخبار بالمغيبات والأمور الخارقة للعادة، فإنّها أمور قائمة بالحقّ، يهتدي بها عباد الحق إليه، ليقوّوا يقينهم به. فإنّه تعالى يكشف هذه الأمور على بعض الطالبين، ليزداد يقينهم، فينجذبون إليه[xxv].
بمعنى آخر، إنّ مقام علم اليقين مرتبطٌ دومًا بحدّ الإدراك والعلم الّذي يُكشف للإنسان من وراء حجاب؛ إّما حجاب الفكر والبرهان، أو حجاب الصور المثاليّة والبرزخيّة. ولا يكون حدّ العلم فيه عينيًّا بمعنى أنّه يشاهد العالم ذات المعلوم الخارجي بما هو هو، وعلى ما هو عليه. فإنّ إدراك النار والعلم بها عبر كلام الثقاة من أنبياء الله، أو من خلال البرهان العقلي، أو حتّى الكشف المثالي هو غير رؤية ذات النار مباشرة، أو الاكتواء بنارها في مرحلة أعلى.
وعندما يعبر العارف مقام علم اليقين، ويصل إلى مقام عين اليقين، فهو ينتقل من مرحلة العلم والإدراك للحقائق المعلومة إلى مرحلة المشاهدة لها بواسطة أداة القلب، والّتي تسمّى بـ “البصيرة”. وفي هذه المرتبة، يستغني الإنسان عن الإخبارات والنقل، وعن البراهين والاستدلالات العقليّة، ويخرق حجاب العلم لينعم بالرؤية والمشاهدة العينيّة للحقائق من خلال الكشف. ففي علم اليقين، يكون العلم بالشيء مع الغيبة عنه، من خلال حصول صورة مطابقة له عند العالِم، لذا فهو محجوب عن إدراك حقيقته.
أمّا في مقام عين اليقين، فإنّ العارف يخرق بشهوده وكشفه حجاب العلم، ليصل إلى ذات المعلوم مباشرة، فهو مقام شهود الشيء ومعاينته بذاته، لا بواسطة الصور، سواء أكانت عقليّة أم مثاليّة، فإنها كلّها أمور زائدة على الشيء ومطابقة له، تحجب وتحول دون إدراك حقيقته وعينه على ما هو عليها. أمّا حقّ اليقين فهو مقام التحقّق بحقيقة علم الحقّ والفناء التامّ في المعلوم بعد الاتّحاد به، ومن ثمّ البقاء فيه، وهي آخر المراتب وأعلاها[xxvi].
يقول “القونوي” في بيان هذه المراتب الثلاث لليقين: “علم اليقين يحصل بالإدراك الباطني؛ سواء أكان الإدراك بالفكر الصائب أم بطريق الكشف والإلقاء. وعين اليقين يتوقّف على مشاهدة المعلوم بالقوى المتعلّقة بظاهر البدن أو بالكشف الصوري، ويكون متعلّق الإدراك ظاهرَ الشيء المدرك؛ كما أنّ الشرط أيضًا في علم اليقين أن يكون متعلّق العلم روح الشيء ومعناه أو مثاله المطابق لحقيقته.
وحقّ اليقين هو أن تدرك بأحديّة جمعك؛ أي بحقيقتك المشتملة على مداركك الظاهرة ومشاعرك الباطنة؛ والجامعة بين روحانيّتك وجسمانيّتك وكثرتك وأحديّتك- أحديّة جمع الشيء المدرك- إدراكًا يستوعب معرفة كلّ ما اشتملت عليه حقيقة المدرك من الأمور الظاهرة والباطنة والروحانيّة والجسمانيّة. وهذه صفة من صار قلبه مستوى الحقّ الّذي قد وسع تجلّيه الذاتي الكمالي الجمعي الأحدي؛ المشار إليه بقوله: “ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن”[xxvii].
ويصنف “القشيري” – بعد تعريفه لليقين ومراتبه – أهل اليقين إلى ثلاثة أصناف، بحسب مراتب اليقين الثلاث أيضًا وهم: أرباب العقول، وأصحاب العلوم، وأصحاب المعارف. فيعتبر علم اليقين مخصوص بأرباب العقول، وعين اليقين مخصوص بأصحاب العلوم، وحقّ اليقين مخصوص بأصحاب المعارف.
وهذا التقسيم، وإن كان يخالف ما ذكرناه سابقا حول علاقة العلم بالمعرفة وأفضليّة العلم على المعرفة، وبالتالي شرافة العالم على العارف، لكنّها تبقى في النهاية رؤية تكشف على أنّ اختلاف مقامات العارفين يرجع إلى اختلاف تحقّقهم في مراتب ومقامات اليقين الثلاثة. قال القشيري: “فعلم اليقين على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان، وعين اليقين ما كان بحكم البيان، وحقّ اليقين ما كان بنعت العيان؛ فعلم اليقين لأرباب العقول، وعين اليقين لأصحاب العلوم، وحق اليقين لأصحاب المعارف”[xxviii].
3. المعرفة العرفانيّة معرفة إرثيّة
من الخصائص الأساسيّة والمهمّة في المعرفة العرفانيّة الأصيلة أنّها لا تحصل بالكسب والتعلّم، لكونها معرفة حضوريّة، وليست حصوليّة، كما بينّا سابقًا. وهذا ما أعطى المعرفة العرفانيّة ميزة أخرى لا نجدها في أيّ مدرسة أخرى، وهي أنّ المعرفة الحقيقيّة في مدرسة العرفان النظري والعملي معًا تحصل بواسطة التوارث المعنوي والباطني بين الله تعالى وأوليائه، أو بين أولياء الله والعرفاء، لا بالتعليم والاكتساب الإنساني. لذلك تسمّى المعرفة في العرفان بـ “المعرفة الإرثيّة”.
والإرث من وجهة نظر العارف: “لا يخلو من وجهيْن: إمّا أن يكون صوريًّا وإمّا أن يكون معنويًّا”[xxix]. الأول – أي الصوري- هو الإرث الحاصل بين الأرحام والأقارب بحسب ما ينصّ عليه الشرع الإسلامي. والثاني – المعنوي- هو الإرث الحاصل بين الله تعالى وأنبيائه وأوليائه، وهو مختلِف كلّ الاختلاف عن الإرث الصوري، لكونه غير محصور، ولا مشروط بالعلاقة النسبيّة والرحميّة بين الوارث والموروث كما يحصل في الإرث الصوري، بل له شروط ومعايير مختلفة. وما يتمّ توريثه بالإرث المعنوي ليس أمورًا ماديّة ودنيويّة من قبيل الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وغيرها.
بل ما يورّث بالإرث المعنوي هو “العلم”، والمقصود بالعلم هنا هو العلم الإلهي الغيبي الذي لا يكشف إلّا لمن ارتضى الله له ذلك، وكانت لديه الأهليّة واللياقة التامّة. فيعاين بواسطة هذا العلم الحقائق الإلهيّة المرتبطة بالوجود والكون، وتنكشف له أسرار الخلقة، ويتعرّف إلى إرادة الله المتمثّلة بصورة الشريعة بعد أن تنكشف إليه إجمالًا وتفصيلًا. وهذا النوع من الإرث يحصل من خلال الكشف والمشاهدة القلبيّة التي يتفرّد بها العارف، ويتميز عن بقيّة أقرانه من العلماء.
يقول السيّد “حيدر الآملي” في المقدمات من كتاب “نص النصوص”:” اعلم أنّ العلوم كلّها تنقسم إلى قسمين: رسميّ اكتسابيّ، وإرثيّ إلهيّ. فالعلم الرسميّ الاكتسابيّ يكون بالتعليم الإنسانيّ على التدريج، مع نصب قويّ وتعب شديد في مدّة طويلة. و”العلم” الإرثيّ الإلهيّ يكون تحصيله بالتعليم الربّانيّ بالتدريج وغير التدريج، مع روْح و راحة، في مدّة يسيرة”[xxx].
فالمعرفة، من وجهة نظر العارف، على نحوين: معرفة تحصل بالكسب والتحصيل الشخصي للمتعلّم، وهي المعرفة المشهورة والمتداولة بين أهل العلم، ونحو آخر من المعرفة تحصل من خلال التعليم الإلهي الخاص، والوراثة الربانيّة المعنويّة، إما بشكل مباشر أو بتوسّط أولياء الله وأنبيائه. ولهذا “يسمّونها – أي العلوم الصوفية والعرفانيّة – بالعلوم الإرثيّة؛ لأنّها تصل إليهم من أبيهم المعنوي دون الصوري، بالإرث المعنوي”[xxxi].
أما العلوم الكسبيّة الّتي تحصل من خلال التعلّم والتعليم الإنساني فلا يقال عنها بأنّها إرثيّة؛ لأنّ الأمور الكسبيّة لا تسمّى في العرف والشرع، ولا في اللّغة والاصطلاح إرثًا. وعليه، فكلّ ما يحصل بالكسب والتعلّم لا يصدق عليه أنّه إرثيّ من وجهة نظر العارف؛ “لأنّ المكتسب عبارة عن تحصيل شيء باجتهاد الشخص وسعيه والموروث عبارة عن شيء يصل إلى شخص بلا سعيه واجتهاده. فينتج: أنّ الموروث ليس بمكتسب”[xxxii].
ويستدلّون على هذا النحو من المعرفة الإرثيّة بالعديد من الآيات والروايات، منها الآيات القرآنيّة الّتي تتحدّث عن نوع خاص من العلم يناله الأنبياء والأولياء من الله، عن طريق التوريث الإلهي، ولو لم يكن هذا النوع من العلم واقعيًّا لما قال الله تعالى في حقّهم: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا من عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ الله ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾[xxxiii]. فالآية تبيّن أنّ الله تعالى يورث كتبه وصحفه مع ما تحويه من علوم ومعارف وحقائق لفئة خاصّة من عباده. ومن الأدلّة النقليّة أيضًا قول النبيّ (ص): “العلماء ورثة الأنبياء”[xxxiv]. فعلامة العالم الحقيقيّة أنّ علومه يجب أن تكون كعلوم الأنبياء، أي علومًا إرثية لا كسبيّة، لكي يصحّ أن نقول عنه إنّه ورث علوم الأنبياء؛ لأنّ الأنبياء علومهم وراثيّة وليست كسبيّة. وهذا النوع من العلماء، بحسب رأي العرفاء، محدود وليس شائع وكثير، ودليلهم على ذلك أنّ الألف واللام في كلمة العلماء، هي للعهد لا للجنس والاستغراق، وإلّا لزم أن يكون كلّ عالم وارثًا للنبيّ، والواقع يرفض هذه الادّعاء، إذ ليس كلّ عالم وارثًا لعلوم الأنبياء. فدلّت الرواية على أنّ فئة خاصّة من العلماء هي الّتي تتّصف بهذه الصفة، وهي ليست صفة عامة وشاملة للجميع.
ومن الأدلّة النقليّة التي يستشهد بها العرفاء أيضًا قول النبي (ص): “مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ”[xxxv]. وقوله (ص) أيضًا: “مَنْ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ”[xxxvi].
وإلى مثل هذه العلوم الإرثيّة أيضًا، أشار نبيّ الله عيسى (ع) بقوله: “يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم فى السماء من ينزل به، و لا فى تخوم الأرض من يصعد به، و لا من وراء البحار من يعبر فيأتي به، العلم محصول فى قلوبكم تأدّبوا بين يديّ بأدب الروحانيّين وتخلّقوا بأخلاق الصدّيقين أظهروا العلم من قلوبكم حتّى يغطّيكم”[xxxvii].
ومن الأدلّة أيضًا حديث الإمام الصادق (ع) عن العلم وأنواعه وأقسامه، حيث يقول عليه السلام: ”العلم علمان فعلم عند الله مخزون لم يُطلِع عليه أحدًا من خلقه وعلم علّمه ملائكته ورسله، فما علّمه ملائكته ورسله فإنّه سيكون لا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون يُقدّم منه ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء ويُثْبتُ ما يشاء”[xxxviii].
ومن الأدلّة الّتي يستدلون بها أيضًا قول النبي (ص): “سلمان منّا أهل البيت”[xxxix]، فسلمان عليه السلام كما هو معلوم ليس عربيًّا، ولم يكن في يوم من الأيام من سلالة أهل بيت النبي (ص)، بل هو فارسي ولذلك لقّب بسلمان الفارسي، ولكن لكونه حائزًا على النسبة المعنوية بأهل البيت (ع) دخل فيهم وصار منهم.
وفي المقابل، يحدّثنا القرآن الكريم عن نبي الله نوح وابنه الّذي هو من أهله ووارثه من ناحية النسب، ولكنّه لم يكن جديرًا بوراثته من الناحية المعنويّة والباطنيّة، لعدم وجود المناسبة بينه وبين نبي الله نوح (ع). ومع عدم دخول ابنه في طريقته وشريعته لا ظاهرًا ولا باطنًا، انتفت القرابة المعنويّة بينهما مع بقاء القرابة النسبيّة. وبارتفاع الأهليّة والقرابة المعنويّة ارتفع الميراث المعنوي بين نبي الله نوح (ع) وابنه، فقال الله عزّ وجل: ﴿لَيْسَ من أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ﴾[xl]، فدلّت الآية الكريمة على أنّ النسب الصوري ليس له أيّ دخالة في النسب المعنوي ومراتبه. “فكما لا ينفع الأب الصوريّ ولا النسبة الصوريّة في الآخرة، فكذلك لا تنفع العلاقة الصوريّة مع الأنبياء والرسل من حيث التكاليف. فما بقي إلّا العلاقة المعنويّة، فإنّها تنفع في الدنيا والآخرة، كالأب المعنويّ والعلاقة المعنويّة”[xli].
ومصدر العلوم الإرثيّة والحقيقيّة هو الله سبحانه وتعالى، والرحمن كما سوف نبيّن لاحقًا لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله﴾[xlii]، وقوله عزّ وجل: ﴿الرَّحْمنُ(1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ(2) خَلَقَ الْإِنْسانَ(3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ﴾[xliii]. فكما أنّ أصحاب العلوم الكسبيّة لا بدّ لهم من أستاذ يعلّمهم فنون العلم وطرق تحصيله، كذلك في العلوم الإرثيّة لا بدّ له من أستاذ وهو “الله” سبحانه وتعالى أو “الرحمن”.
ومنبع جميع العلوم الإرثيّة عند العارف بالدليل والحجة القرآنية هو الحضرة الإلهيّة المخصوصة باسم “الله”، وحضرة الرحمن المخصوصة باسم “الرحمن”. وكلّ من أراد العلوم الحقيقيّة الإرثيّة الإلهيّة، يتوجّب عليه التوجه إلى هاتين الحضرتين ليتعلّم منهما على قدر استعداده واستحقاقه[xliv]. ولكنّ “أخذ هذه العلوم والحقائق موقوفٌ على صفاء القلب ورفع الحجاب عن وجهه، والتوجّه الكلّيّ إلى الحضرة الرحمانيّة والجناب الرحيميّ، المشار إليهما في قوله: ﴿تَنْزِيلٌ من الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾[xlv]؛ لأنّه من دون هذا – أي الصفاء القلبيّ والتوجّه الكلّيّ – لا يمكن حصولها – أي الحقائق والعلوم – أي تحصيلها من دون رفع الحجاب عن وجه القلب والاستعداد الكامل والتوجّه التامّ، غير ممكن”[xlvi]. وتفصيل الكلام يأتي لاحقًا. ومن خصائص المعرفة العرفانيّة الأساسيّة أيضًا أنّها معرفة تحصل بواسطة الكشف والشهود القلبي. ولارتباط هذه الخصيصة وتعلّقها بالمنهج المعرفي للعارف، لذا سوف نفرد لها بحثًا مستقلًّا بذاته.
[i]– القونوي، صدر الدين: النفحات الإلهيّة، مرجع مذكور، ص30.
[ii]– الديناني، غلام حسين: العقل والعشق الإلهي، مرجع مذكور، ج1، ص6.
[iii]– المصباح، محمد تقي: المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، مرجع مذكور، ج1، ص160.
[iv]– الآملي، جوادي: نظرية المعرفة في القرآن، دار الصفوة، بيروت، 1417ق/ 1996م، ط1، ص206.
[v]– المرجع نفسه.
[vi]– الحيدريّ، كمال: الراسخون في العلم، دار فراقد، قم، 1429ق/ 2008م، ط1، ص138-139.
[vii]– الآملي، حسن زاده: سرح العيون في شرح العيون، مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، قم، 1421ق/ 1379ش، ط2، ص625.
[viii]– المصباح، محمد تقي: المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، مرجع مذكور، ج1، ص163.
[ix]– الحيدريّ، كمال: العرفان الشيعي، مرجع مذكور، ص208-209.
[x]– انظر: الآملي، جوادي: نظرية المعرفة في القرآن، مرجع مذكور، ص126.
[xi]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص603.
[xii]– الكاشاني، عبد الرزاق: معجم اصطلاحات الصوفيّة، مرجع مذكور، ص274.
[xiii]– سورة الحجر، الآية99.
[xiv]– القونوي، صدر الدين: إعجاز البيان في تفسير أمّ القرآن، مرجع مذكور، ص49.
[xv]– الخميني، روح الله: مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، مرجع مذكور، ص87.
[xvi]– الخميني، روح الله: مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، مرجع مذكور، ص 87-88.
[xvii]– الكاشاني، عبد الرزاق: شرح منازل السائرين، مرجع مذكور، ص449.
[xviii]– سورة الحجر، الآية99.
[xix]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص600
[xx]– سورة التكاثر، الآيات من 5 إلى8.
[xxi]– سورة الواقعة، الآية95.
[xxii] – الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص605.
[xxiii]– القيصري، داود: شرح فصوص الحكم، مرجع مذكور، ج1، ص169-170.
[xxiv]– انظر: الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع سابق، ص606.
[xxv]– انظر: الكاشاني، عبد الرزاق: شرح منازل السائرين، مرجع مذكور، ص450.
[xxvi]– انظر: الكاشاني، عبد الرزاق: شرح منازل السائرين، مرجع مذكور، ص451-452. الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص605.
[xxvii]– القونوي، صدر الدين: النفحات الإلهيّة، مرجع مذكور، ص253.
[xxviii]– القشيريّ، أبو القاسم: الرسالة القشيريّة، مرجع مذكور، ص121.
[xxix]– الآملي، حيدر: المقدّمات من كتاب نصّ النصوص، مرجع مذكور، ص494.
[xxx]– الآملي، حيدر: المقدّمات من كتاب نصّ النصوص، مرجع مذكور، ص472.
[xxxi] – المرجع نفسه، ص492.
[xxxii]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص503.
[xxxiii] – سورة فاطر، الآية32.
[xxxiv] الكلينيّ، محمد بن يعقوب: الكافي، مرجع مذكور، ج1، ص32.
[xxxv] – المجلسيّ، محمد باقر: بحار الأنوار، مرجع مذكور، ج40، ص128.
[xxxvi] – المرجع نفسه، ج53، ص326.
[xxxvii] – الشيرازي، محمد بن إبراهيم: شرح أصول الكافي، مرجع مذكور، ج2، ص213.
[xxxviii] – الكلينيّ، محمد بن يعقوب: الكافي، مرجع مذكور، ج1، ص147.
[xxxix] المجلسيّ، محمد باقر: بحار الأنوار، مرجع مذكور، ج10، ص123.
[xl] سورة هود، الآية46.
[xli] الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص502.
[xlii] سورة البقرة، الآية282.
[xliii] سورة الرحمن، الآيات1إلى4.
[xliv] الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع سابق، ص538.
[xlv] – سورة فصلت، الآية2.
[xlvi]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص570.