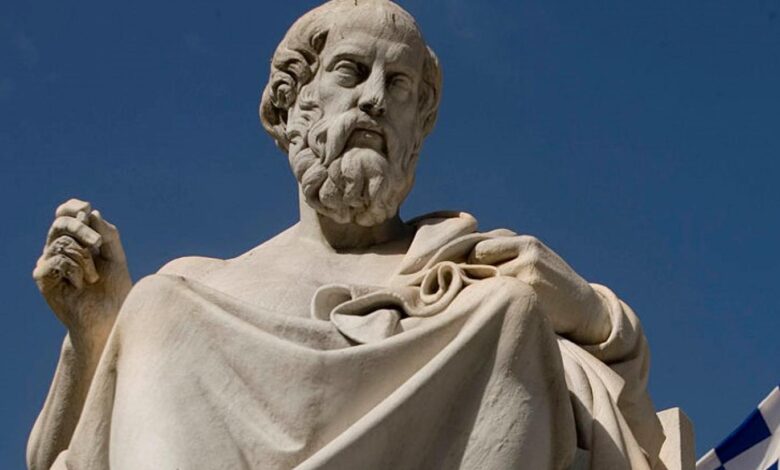
هل الأخلاق مسألة ثقافية ذاتية أم شرعة موضوعية كونية؟
تفكير منهجي يساعدنا في اختيار السبيل الوجودي الذي ينبغي أن ننهجه حتى نحيا حياة تليق بالمعنى الإنساني الأرحب
غالباً ما نسأل أنفسنا عن أصل التفاوت بين المسالك الأخلاقية في المجتمعات الإنسانية، إذ يربكنا أن نعاين الأفراد والمجتمعات يتصرفون على غير ما تقتضيه الأنظومة الأخلاقية السائدة في ديارنا، ولكننا أيضاً غالباً ما ننسى أننا لسنا وحدنا مالكي الأرض البشرية، بل يشاركنا في الملكية أقوام نشأوا على بنى ذهنية مختلفة، وعاشوا في بيئات ثقافية متباينة، وساروا على دروب وجودية متنوعة. ومن ثم، لا بد لنا من الاستعانة بفلسفة الأخلاق التي تساعدنا في تناول أبرز المسائل التي تؤرق الإنسان في سعيه إلى الحياة الصالحة، العادلة، السعيدة.
حقول البحث في فلسفة الأخلاق
قبل معالجة سؤال الاختلاف في التصور الأخلاقي، ينبغي أن نتحرى طبيعة الحقل المعرفي هذا وأسئلته الأساسية ورهاناته الكبرى وآفاقه المنبسطة في تفكير الإنسان. وعليه، يمكن القول إن فلسفة الأخلاق، في مقاصدها العملية، تفكير منهجي يساعدنا في اختيار السبيل الوجودي الذي ينبغي أن ننهجه حتى نحيا حياة تليق بالمعنى الإنساني الأرحب الذي نناصره. ومن ثم، تعالج فلسفة الأخلاق ضمة من الأسئلة الأساسية، منها: ما المبادئ التي يجب أن نعتمدها ونحيا بمقتضاها؟ لماذا يجب علينا أن نعتمد هذه المبادئ عوضاً عن الاستناد إلى مبادئ أخرى؟ ما طبيعة الأحكام الأخلاقية وما منهجيتها الخاصة؟ هل أفعالنا حرة أم خاضعة لنواميس تتخطى إرادتنا الذاتية؟ هل نستطيع أن نفسر طبيعة الكائن الإنساني تفسيراً مادياً سببياً محضاً؟ أم إن هناك بنية أخلاقية يستند إليها الضمير الذاتي تجعل الإنسان كتلة معقدة من العناصر الطبيعية والذهنية والفكرية والأخلاقية والروحية؟
يمكننا أن نستدل على أسئلة فلسفة الأخلاق هذه على قدر ما نستجلي السؤال الثاني الأخلاقي الذي صاغه الفيلسوف الألماني كانط (1724-1804) في سياق أسئلة الفلسفة الأربعة الأساسية: ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا ينبغي لي أن أفعل؟ بماذا يجوز لي أن آمل؟ ما الإنسان؟ ومن ثم، نقسم فلسفة الأخلاق قسمين أو مبحثين: ينظر المبحث الأول في معيارية الأخلاق ويعالج السؤال الفلسفي الآتي: ما المبادئ التي يجب أن نعتمدها ونحيا بمقتضاها؟ أما المبحث الثاني فينظر في تأصيل الأحكام الأخلاقية (الميتاأخلاق كالميتافيزياء) ويتدبر الاستفسار الفلسفي الذي يتقصى طبيعة الأحكام الأخلاقية ومنهجيتها الخاصة؟ لذلك يساعدنا مثل المسعى الفلسفي هذا في الاستفسار عن طبيعة الخير وطبيعة الواجب، وعن إمكان القول بحقائق أخلاقية ثابتة. هذا كله يبين لنا كيف يمكننا أن نسوغ تسويغاً عقلانياً الآراء والمعتقدات المتعلقة بما هو صائب وما هو خاطئ. من أخطر المباحث في هذا السياق النظر في قضيتين: تتعلق الأولى بطبيعة الأحكام الأخلاقية، فنجتهد على سبيل المثال في تعريف ما هو صالح، في حين تعنى الثانية بمنهجية الاستدلال، إذ تدلنا كيف نتخير المبادئ الأخلاقية التي ينبغي أن نسترشدها في حياتنا اليومية.
الاختلاف في تعيين أصل الحكم الأخلاقي
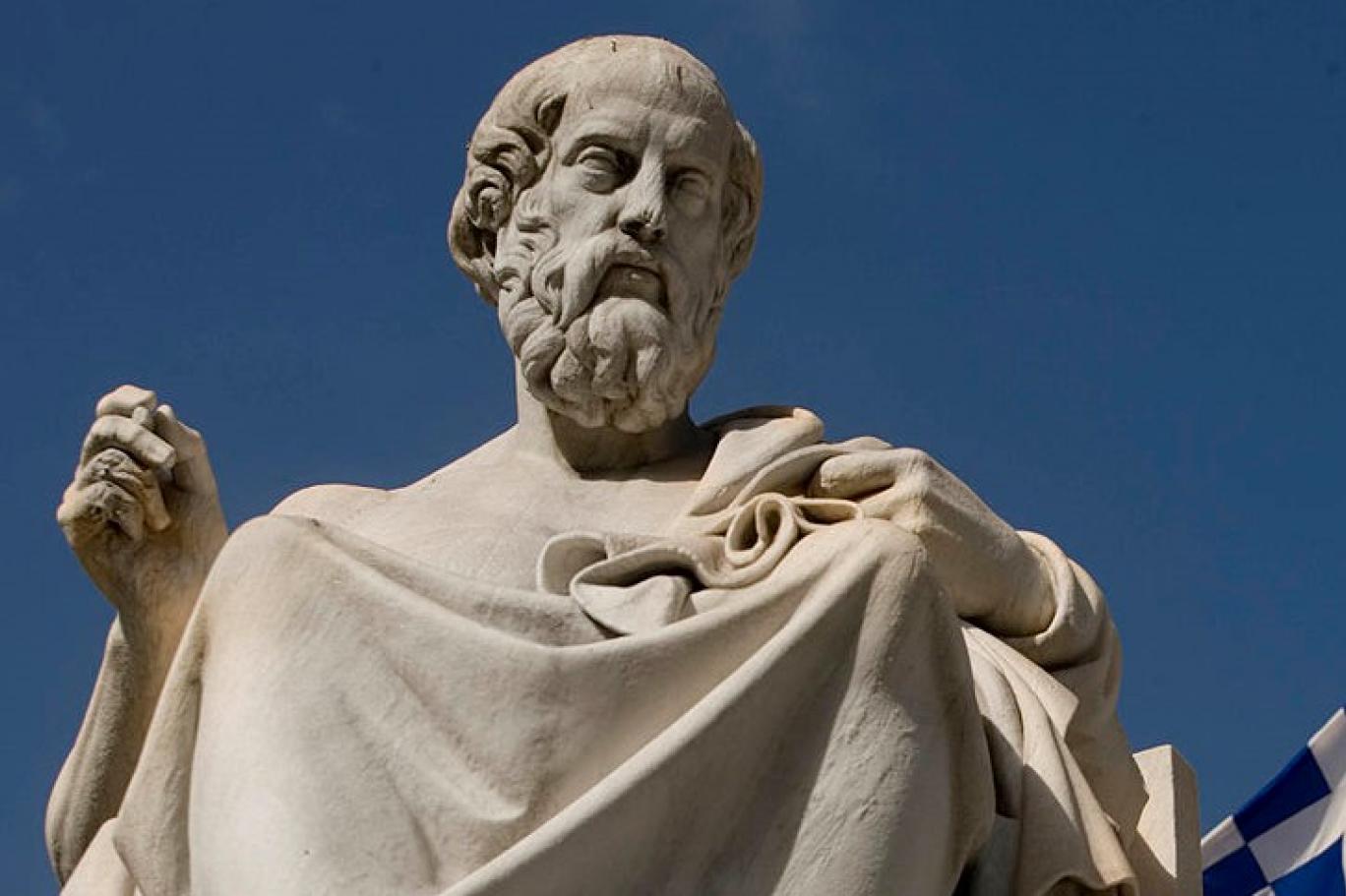
أعود لمسألة الاختلاف الذي ينشط بين القائلين بموضوعية الحكم الأخلاقي، والقائلين بذاتية الحكم الأخلاقي. المعروف أن لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية تصوره الفكري الأرحب الذي ينتسب إليه، ومنه يغترف أحكام مسلك أفراده. ومع أن الأخلاق تنظر في ما هو صالح وما هو سيئ، وما هو صائب وما هو خاطئ في الحياة الإنسانية، غير أن المشكلة تنشأ من صعوبة التمييز بين الأمور في الحياة الواقعية وقياسها بالمقياس الملائم. ذلك بأن نظرنا لا يقع على أمور واضحة، بل يستند إلى قيم ومبادئ ومثل نظرية يختلف الناس في تدبرها وفي تفسيرها.
ومن ثم، ليس من حقائق أخلاقية واضحة، بل مسائل أخلاقية يختلف الناس في تفسيرها. الاختلاف واضح بين موضوعية الحكم الأخلاقي، وذاتية الحكم الأخلاقي. المسألة أخلاقية أساسية. يعود هذا الاختلاف للزمن الإغريقي الأول حين كان أفلاطون (428 ق.م.-347 ق.م.) في محاوراته الفلسفية يناقش على لسان معلمه سقراط المثقفين السوفسطائيين الذين كانوا يؤمنون بالفصل القاطع بين عالم الوقائع وعالم القيم، بين عالم الفيزيس (physis) أي الطبيعة، وعالم النوموس (nomos) أي الناموس والقانون. كان السوفسطائيون يرون أن النقاش الأخلاقي أو الحجاج إنما يستند إلى بلاغة المتكلم، لا إلى أدلة برهانية قاطعة نستخدمها في العلوم الدقيقة. معنى ذلك أن النقاش كله يقوم على قدرة الإقناع، بحيث يصبح الصواب والخطأ مسألة فيها نظر، يبتها الإنسان القادر على الاستعانة بأشد الحجج بلاغة وتأثيراً في مسامع الناس.
أفلاطون يقارع السوفسطائيين في موضوعية الحكم الأخلاقي
في محاورة أوتيفرون الأفلاطونية التي تناولت مسألة التقوى، سأل سقراط: هل الإنسان البار الصديق القديس تحبه الآلهة لأنه بار صديق قديس؟ أم إنه بار صديق قديس لأن الآلهة تحبه؟ على رغم إرباكية السؤال السقراطي هذا، إلا أن أفلاطون كان يصر على القول إن هناك صواباً وخطأ بمعزل عن قدرة الإقناع الكلامية. لذلك يجب علينا أن نكتشف جوهر الصواب وجوهر الخطأ. تقوم وظيفة الفلسفة الأخلاقية إذاً في إرشاد الإنسان ومساعدته في اكتساب القدرة الذهنية التي تكشف له عن هذا الجوهر.

يمكننا أن نلخص المناقشة الحادة بين أفلاطون والسوفسطائيين، فنصفها بالاختلاف الحاد في تصور مبدأ الموضوعية الأخلاقية: هل الأخلاق مسألة حكم موضوعي أم رأي ذاتي محض؟ يعتقد أفلاطون في مثاليته أن الصواب والخطأ، والخير والشر، ناشبان في عمق طبيعة الأشياء والوقائع، ولا يرتبطان، كما يدعي السوفسطائيون، بحكم الفرد الذاتي واختباره وإحساسه وشعوره وتقديره الخاص. وعليه، ابتدأ النقاش الفلسفي في الأخلاق ينشط في الأوساط الغربية بالاستناد إلى الإشكالية الإغريقية الأساسية هذه. فأي الرأيين الرأي الأصوب: موضوعية الحكم الأخلاقي المقترن بطبيعة الأشياء؟ أم ذاتية الحكم الأخلاقي المرتبط باختبارات الفرد وأحاسيسه؟
ذاتية الحكم الأخلاقي وانتسابيته الثقافية
يعتقد بعض الناس أن المسائل الأخلاقية لا تجري عليها الأحكام الموضوعية وليست محل إجماع عالمي كوني، بل إنها نسبية أو انتسابية، أي تنتسب إلى حضارات المجتمعات وثقافاتها المتنوعة. حججهم في ذلك ثلاث: الحجة الأولى أن الناس ينتمون إلى مذاهب أخلاقية متعارضة، إذ منهم على سبيل المثال من يؤيد حكم الإعدام ومنهم من يعارضه، واختلافهم في ذلك كاختلافهم في الإجهاض والاستنساخ والزرع الاصطناعي والموت الرحيم وزواج المثليين، الحجة الثانية أن العقل لا يستطيع بالبرهان أن يسوق الدليل الدامغ على أحقية هذا التصور الأخلاقي أو ذاك، الحجة الثالثة أن الدليل العقلي يستحيل الفوز به، إذ إننا لا نستطيع أن نعاين معاينة موضوعية علمية الوقائع الأخلاقية المحض.
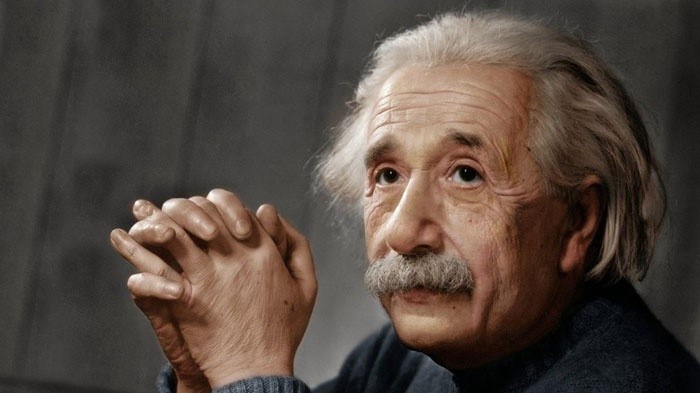
يأثر لنا المؤرخ الإغريقي العظيم هيروذوتوس (القرن الخامس قبل المسيح) أن ملك الفرس ألقى الرعب في نفوس الأقوام الإغريقيه والأقوام الهندية حين فرض عليهم أن يتبادلوا شعائر دفن موتاهم. ذلك بأن الإغريق كانوا يحرقون جثث الموتى، في حين كانت قبيلة الكالاتيين في الهند تأكل هذه الجثث. يدلنا هذا المثل على ما يسمى اليوم النسبوية أو النسبانية الأخلاقية التي تربط الأخلاق بثقافات المجتمعات. إذا كان حرق الجثث السبيل الصحيح في نظر الإغريق، فإن أكلها هو السبيل الصحيح في نظر الكالاتيين. وعليه، ما من حكم أخلاقي موضوعي قائم بحد ذاته بمعزل عن ثقافة المجتمعات. تظهر النسبانية الأخلاقية أيضاً على مستوى الأفراد، إذ يعتقد كل إنسان أن هذا الأمر صحيح، في حين يظن الآخر أنه باطل. من هذه النسبانية يمكننا أن نشتق الذاتية التي تنسب الحكم الأخلاقي إلى اختبار الذاتية الفردية.
تسويغ النسبانية الأخلاقية
يجمع أصحاب النسبانية الثقافية على القول إن الصالح هو ما يعتمده المجتمع الذي أحيا فيه، وما تقره التقاليد التي أنتسب إليها، وما تسوغه الأعراف التي أؤيدها. ذلك بأن مبادئنا الأخلاقية تعبر عن المواضعات والاتفاقات والإجماعات التي تعاهدنا عليها في مجتمعنا وثقافتنا وحضارتنا. لكل مجتمع تقاليده ونواميسه وأحكامه وأعرافه، إذ ليس الحكم الأخلاقي كالحكم الموضوعي على الأشياء المادية، كأن يجمع الناس علمياً على أن لون الثلج أبيض.

حقيقة الأمر أن الأخلاق بناء اجتماعي ثقافي. فالقوانين الأخلاقية كالأساليب اللباسية وقواعد الغذاء المعتمدة في مجتمع من المجتمعات. إذا كان قتل الأطفال محظوراً اليوم، فإنه لم يكن محظوراً عند الأقدمين من عرب ورومان. ومن ثم، فالرأي الأخلاقي صحيح على قدر ما يلائم التصور الثقافي السائد. مثل الحكم الأخلاقي كمثل الجهة حين نقول: على اليسار. ما من يسار على وجه الإطلاق، بل يسار هذا الموقع أو ذاك.
لذلك ما من صواب أو خطأ على الإطلاق، بل صواب بالنسبة إلى، وفي منظور، وبحسب، وعلى سنة، ووفقاً، أي انتساباً إلى مجتمع وبيئة وثقافة وحضارة. حين أعلن أن هذا الأمر صالح، أعني بذلك أنه صالح في نظري ونظر المجتمع الذي أنتمي إليه. لذلك ينبغي الحذر واجتناب القول بالموضوعية المطلقة، كقولنا إن هذا الأمر صالح على الإطلاق في جميع الأزمنة وجميع القرائن. ومع ذلك، لا بد لنا من النظر في الأدلة التي يسوقها أولئك الذين يعدون أن الأخلاق، في جوهرها، انتسابية لا إجماع عليها في العالم.
الرد على الاعتراض الأول: الأخلاق نتاج الثقافة المحلية في زمن من الأزمنة
صحيح أن الأمثلة كثيرة تشير إلى تعارض الأحكام الأخلاقية بين المجتمعات الإنسانية، غير أن هناك إجماعاً مطلقاً في قضايا إنسانية أخرى. لا ريب في أن القانون الأخلاقي المحلي نتاج ثقافة معينة، ولكنه ينطوي على مقصد أخلاقي إنساني كوني. المثال على ذلك واضح، إذ يجمع الناس العاقلون على أن الاحتيال والسرقة والاغتصاب والقتل قضايا سيئة، وأن الصدق والإخلاص والأمانة والكرم أمور صالحة. كذلك ندين جميعنا العبودية، وبيع الأطفال والتعدي عليهم، والاحتيال الماكر والغش الخبيث في الفوز بالمباريات الرياضية. لذلك يمكننا الإجماع على ضمة من المبادئ الأخلاقية الهادية التي تتخطى بعض الاختلافات التفسيرية المقترنة بالانتسابات الثقافية المتنوعة. معنى ذلك أن هناك اختلافاً أخلاقياً زهيداً بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الإنسانية الأساسية التي أخذت الثقافات الإنسانية تعتمدها في إثر مسار طويل من الاستنضاج الحضاري.
الرد على الاعتراض الثاني: ما من دليل قاطع يحسم النقاش الأخلاقي
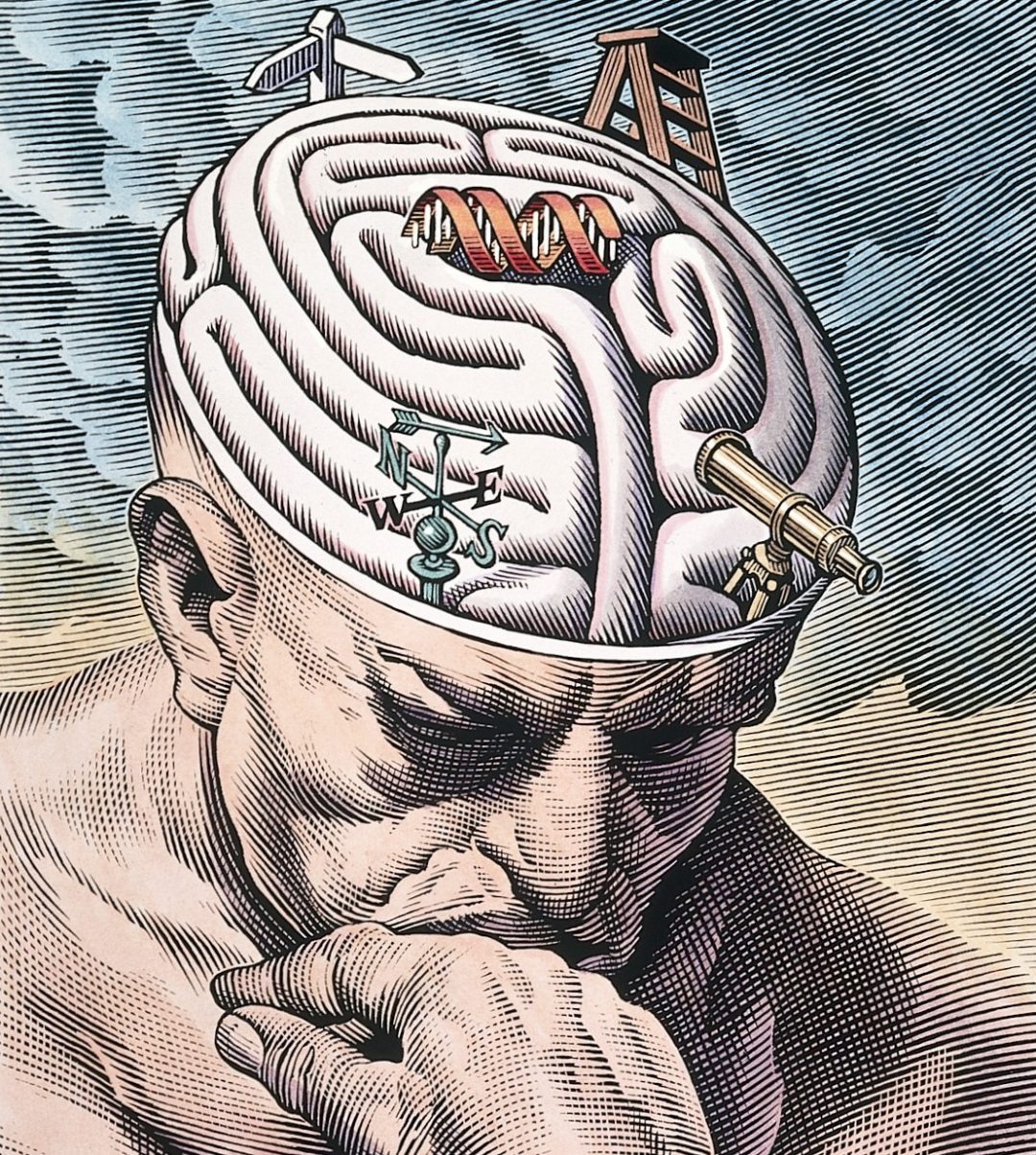
صحيح أيضاً أن الثقافات تختلف اختلافاً صريحاً بشأن تفسير بعض القيم الأخلاقية وإثبات موضوعيتها وتوطيد عالميتها. بيد أن الاختلاف الثقافي ليس دليلاً على انتفاء الحقيقة في مسائل شتى، حتى العلمية منها، إذ لا يمنعنا الاختلاف من أن نتفق على ضمة من المبادئ الأخلاقية العليا المشتركة التي تجرم القتل والسرقة والكذب والتعذيب. الحقيقة أن كثيراً من الاختلافات تقتصر على التباين بشأن تطبيق المبادئ الأخلاقية المشتركة هذه في سياقات اجتماعية معينة. الاختلاف يصيب التطبيق، لا المبدأ. لنأخذ القاعدة الذهبية مثالاً: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، أو افعل للآخرين ما تريد أن يفعله الآخرون لك، أو عامل الآخرين مثلما تريد أن يعاملوك. لكل مجتمع أن يطبق هذه القاعدة بحسب ثقافته وحساسيته ومزاجه.
فضلاً عن ذلك، تجري المقارنة بين طبيعة الفرضية العلمية وطبيعة الفرضية الأخلاقية، فيتبين لنا أننا نستطيع في العلوم أن نبطل الفرضية التي تبنى عليها أية نظرية، في حين أننا لا نستطيع أن نبطل الفرضية التي يبنى عليها الحكم الأخلاقي. في الأخلاق نكتفي بإعلان اتفاق الآراء أو اختلافها. يستند أصحاب المذهب النسباني في الأخلاق إلى هذا الدليل لكي يثبتوا استحالة الإجماع على حكم أخلاقي واحد لجميع الناس. ولكن ينبغي النظر في معنى البرهان أو الدليل بحد ذاته، سواء في الأنظومة العلمية أو في الأنظومة الأخلاقية.
من الثابت أن البراهين العلمية نفسها تحتاج إلى خلفية تنتسب إليها، ومسلمة تنطلق منها، ونموذج معياري (باراديغم) تخضع لأحكامه. ليس من برهان عالق في الهواء، منطلق من الخواء، مستند إلى الفراغ المعرفي. كل برهان، سواء في العلوم أو في الأخلاقيات، يستند إلى مسلمة أولى. في هذا تستوي العلوم والأخلاقيات. قليلة البراهين القاطعة التي لا ترد في العلوم. معظمها في المنطق، وضعفت في الفكر المعاصر وحدته القاهرة وتناثر فتحول إلى أنظومات منطقية شتى. حتى البراهين المنطقية يختلف فيها المناطقة في الزمن الراهن.
أما مسألة الإجماع العلمي، فإنها أشبه بفرضية ضعيفة، إذ إننا نذكر جميعنا المناقشات الحادة التي عصفت بتاريخ العلوم، لاسيما في الأزمنة الحديثة بين فرانسيس بيكون (1561-1626) ونيوتون (1643-1727) وداروين (1809-1882) وأينشتاين (1879-1955) وسواهم. يبين لنا تاريخ العلوم الانقسامات الخطرة التي احتدمت بين العلماء وأصابت النظريات. في العلوم يعجز العلماء عن الإجابة العلمية القاطعة في بعض المسائل الخطرة: ما سبب الخرف الدماغي المبكر؟ ما علة الانفجارات الكونية في المجرات والكواكب؟ ما تسويغ الانقباض الامتدادي في الكون؟ ما أصل الثقوب السود في الفضاء الأرحب؟ ما طبيعة التفاعل اللامتناهي بين مكونات الذرة المفرطة في الصغر؟ من الواضح أن صعوبة الحصول على الأجوبة في المجال العلمي لا تعني أن هذه القضايا غير صحيحة أو لا تستحق النظر.
إذا لم يستطع فلاسفة الأخلاق أن يفصلوا بين البراهين التي تساق من أجل تأييد هذا التصور الأخلاقي أو ذاك، لا يعني ذلك أن جميع الآراء متساوية في القيمة الإنسانية والقدرة الإقناعية. ومن ثم، يجدر الحديث عن الاحتمال الأقوى أو الأرجحية الغالبة في قضية من القضايا. بيد أن الأرجحية لا تعني أن البرهان الأخلاقي باطل أو عقيم أو عاجز عن استقطاب الآراء المؤيدة. حتى لو لم نستطع أن نبرهن برهاناً قاطعاً جازماً أن الرأي الأخلاقي صحيح أو باطل، فإن ذلك لا يعني أنه رأي غير عقلاني على الإطلاق. ومن ثم، فإن غياب البرهان القاطع في النقاش الأخلاقي لا يعني أن ليس هناك من حقائق أخلاقية أساسية.
الرد على الاعتراض الثالث: الأخلاق مسألة غير معرفية لا يمكن البت في قضاياها
يعترض المعترضون أيضاً على صلاحية التصور الأخلاقي حين يصرون على اعتبار المسألة الأخلاقية خارج كل اكتساب معرفي. في ظنهم أن الأخلاق ليست موضوعاً معرفياً، بل مبايعة وجدانية ورأي ضميري وتصور شخصي. ما يعتقده بعضهم صحيحاً يظنه الآخرون خطأ، وكلا الطرفين يحسب أن ما يقوله إنما يصور الواقع على ما هو، أي في صميم حقيقته، ويفوت الجميع أن الواقع لا تدركه عقولنا بسهولة، سواء في الآراء العلمية أو الأخلاقية.
ينتقد الفيلسوف التجريبي البريطاني ديڤيد هيوم (1711-1776) أولئك الذين يجيزون لأنفسهم أن يتجاوزوا مجرد معاينة الوقائع كما هي ووصفها بعبارات الملاحظة، فينتقلون تواً إلى استخدام عبارات الواجب والمسؤولية والإسناد المعنوي، مستخدمين اصطلاحات إسقاطية من مثل: يجب، يتحتم، يتعين، إلخ. والحال أن الوقائع لا تحمل بحد ذاتها دلالات أخلاقية موضوعية. ثمة اختلاف واضح بين العالم كما هو، والعالم كما نظن أنه يجب أن يكون. فالصالح والسيئ ليسا من صفات الواقع، على غرار الصلب واللين في وصف الأشياء. إذا قال أحدهم: هل السعادة أمر حسن؟ فلن يلقى جواباً كجواب من يسأل: هل هذا الجسم صلب؟
كيف يمكننا أن نرد على مثل الاعتراض التشكيكي هذا؟ أعتقد أنه من الممكن أن نتجاوز هذه الاختلافات إذا استخدمنا أصول التحاور العقلاني الفطن المبني على سلامة التفكير. لا بد من أن نتذكر أن حصر الصواب في ما يعتمده مجتمع من المجتمعات لا يعني أن الإنسان لا يمكنه أن يعارض آراء هذا المجتمع الخاطئة. إذا كان المجتمع عنصرياً، فهذا لا يعني أن العنصرية أمر صائب. إذا كان المجتمع إقصائياً عدوانياً عنفياً، لاسيما في تعامله مع المختلفين، فهذا لا يعني أن المجتمع على صواب.
التربية نضال في سبيل تعزيز القيمة الإنسانية العليا
فضلاً عن ذلك، إذا كان المجتمع على صواب، فما مصير التربية؟ هل تعني التربية أن ينشأ جميع الناس على اعتماد الفكرة الواحدة والقانون الواحد والرأي الواحد والتصور الواحد؟ كيف يستطيع الأطفال أن يتلقنوا فن التفكير الأخلاقي الحر المسؤول؟ كيف تستقيم الأخلاق من دون حرية التفكير واستقلال الإرادة؟ جميع هذه الأسئلة تبين لنا أن المجتمع الذي نحيا في كنفه يمكن أن يخطئ في تعيين الصواب والخطأ، والخير والشر، والصلاح والفساد. ليس كل ما تقوله الأنظومة الثقافية السائدة في مجتمعنا عين الصواب في جميع شؤون الحياة الإنسانية.
لو لم يقاوم مارتن لوتر كينغ (1929-1968) العرقية والتعصب في الولايات المتحدة الأميركية، ويخالف أصول التربية السائدة في مجتمعه، لما حصل السود على حقوقهم الأساسية، ولما استقامت العدالة في تلك البلاد. وعليه، يجب القول إن مناهضة التمييز العرقي قيمة أخلاقية موضوعية صالحة في جميع الأزمنة وفي جميع القرائن بمعزل عن آراء الناس فيها. وهذا ما ندعوه الواقعية الأخلاقية.
القيمة الأخلاقية أرفع من الأعراف المسلكية السائدة
لا بد أيضاً من التمييز بين القاعدة الأخلاقية المشتركة، والتدبير المسلكي المحلي. إذا استضافنا قوم تختلف عوائدهم عن عوائدنا، وجب علينا أن نراعي أصول الضيافة. إذا خالفنا ما يأنسون إليه من استعمال الشوكة باليد اليسرى على مائدة الطعام، أظهرنا لهم أننا نهين خصوصيتهم الثقافية. بيد أن الأمر الأخطر ليس التدبير المسلكي المحلي، بل القاعدة الأخلاقية التي تفرض علينا ألا نحتقر الآخرين في أساليب عيشهم الشرعية، شرط ألا تتحول هذه الأساليب إلى مسلك يحتقر إنسانية الإنسان ويناقض شرعة الحقوق الكونية.
إذا حصرنا الصواب في ما يقوله المجتمع، أظهرنا للناس أننا نواطئهم على ما هم فيه من ضلال. في هذه الحال نقع في محنة التطابقية والتلاؤمية والتوافقية العمياء. أسوق مثالاً على ضرورة التمييز بين القاعدة الأخلاقية والتدبير المسلكي العرفي. أعلم أن بعض المجتمعات ليست مقتنعة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. فهل يجب أن أخضع للرأي السائد في مجتمعي ولو كان يظلم المرأة؟ حين يختلف مجتمعان ويحتربان بسبب اختلافهما الثقافي، فهل يجوز لنا أن نسوغ لهما العنف بمجرد تسويغ الاختلاف الأخلاقي بينهما؟ من الفطنة أن نستجلي طرق التأويل التي غالباً ما تجعل الاختلاف يتجاوز حدود التباين الشرعي الخاضع لأحكام شرعة حقوق الإنسان الكونية.
فضائل التشاور الثقافي الكوني
ثمة حقيقة أخلاقية جوهرية تتعلق بطبيعة الإنسان وتفرض علينا أن نصونها في جميع المجتمعات، ولو أن كل مجتمع يؤول هذه الحقيقة بحسب معطيات ثقافته. من أفضل السبل الحضارية أن تتحاور المجتمعات وتتشارور وتتقابس حتى يتضح ما هو صائب وما هو خاطئ في تطبيق الحقيقة الأخلاقية هذه في كل مجتمع على حدة. الشرط الموضوعي في الشورى البينثقافية ألا تبلغ المساومة حدود إبطال القيمة الإنسانية العليا. لا يجوز لي أن أقبل باختلاف تأويلي يفضي إلى تسويغ انتهاك الكرامة الإنسانية في مجتمع من المجتمعات، والحجة الأممية في ذلك أن أصول الشورى بين المجتمعات تقتضي احترام خصوصيات الأقوام وأعرافهم.
رأس الكلام في هذا كله أن الناس، على مختلف مشاربهم، ينبغي أن يعتصموا بشرعة أخلاقية كونية تتعزز فيها قيم الكرامة والحرية والمساواة والعدالة والأخوة. على هذا المستوى ليس من اختلاف جوهري يفضي إلى النسبانية الثقافية والتعددية الصراعية. أما على مستوى التفسير القانوني الظرفي الطارئ، فيجوز لكل مجتمع أن يجتهد اجتهاداً نزيهاً صادقاً من أجل غرس القيم الأخلاقية المشتركة في تربة الاختبار الثقافي المحلي. في هذا السياق، يجدر بنا أن نراعي بعض القواعد المنهجية المفيدة. أولاً، ينبغي النظر في الأحكام الأخلاقية نظر التروي والتأني والاطلاع على مختلف الاعتراضات والردود قبل أن نبت المسألة بتاً متسرعاً متطرفاً. ثانياً، يجب الاعتماد على الفكر المنفتح المستنير في فلسفة الأخلاق، إذ إنه يساعدنا في التصبر على إشكالات الحياة الإنسانية وتعقيداتها المربكة. ثالثاً، يتعين على أهل الحكمة أن ينهجوا منهج الشورى الصابرة في تدبر الاختلافات الأخلاقية. بيد أن الشورى أرحب من مجرد استمزاج الآراء. إنها مسار فكري شامل يفترض التعارف والتحاور والتشاور والتعاون والتضامن والتقابس حتى نغني الحقيقة الأخلاقية الكونية بالإسهامات الجليلة التي تأتيها من مختلف الثقافات الإنسانية. شرط الشروط في هذا كله ألا تتحول القيمة الإنسانية الكونية، في تطبيقاتها الثقافية المحلية، إلى ما يخالفها مخالفة صريحة أو ضمنية. رأس الحكمة إذاً أن نصون وحدة القيمة على رغم اختلاف انغراساتها.







