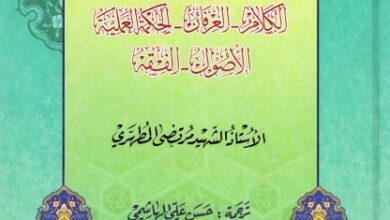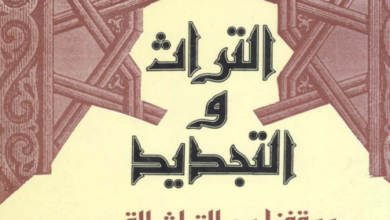أهم الطرق الصوفيَّة في تونس وانتشارها الجغرافي
حاتم الضاوي
سنحاول في هذا البحث المقتضب التعرض لظاهرة اجتماعية انتشرت بين كل مكونات المجتمع التونسي حضرياً كان أو بدويًّا، نخبوياً كان أو عاميًّا . وسنحاول أن نقسمه إلى عدة فقرات نستعرض فيها نشأة التصوف بصفة عامة وظهور الطرق الصوفية وتفرعاتها وأهم الطرق الصوفية التي انتشرت في تونس، وأخيرًا توزعها الجغرافي ونسبة حضورها في كل منطقة .
1 ) نشأة التصوف :
نشأ التفكير الصوفي بفلسفته التي تقوم على قهر النفس و كبتها و تحقير الدنيا و ذمها و الزهد فيها من التلاقح الحضاري الذي حصل إبان التوسع الإسلامي خارج الجزيرة العربية فهو يلتقي في أسسه بالعقائد السائدة في اليونان و الهند أساسا رغم تسجيلنا لتواجد هذا المنهج في الحياة لدى الرعيل الأول من الصحابة . و ظهر التصوف كسلوك في الحياة في المشرق الإسلامي منذ القرنين الأول و الثاني للهجرة و كانت لهذه الحركة صدى في المغرب الإسلامي . و قد عرفت تونس التصوف و هو مازال في مرحلته الأولى المتمثلة في الزهد و الورع مثل البهلول بن راشد تلميذ مالك و تلميذه عبد الخالق القتات الذي عاش في القيروان في القرن 2 هــ . و بدأت تتطور هذه الحركة مع تتطور نسق بناء الرباطات على السواحل في العهد الأغلبي حيث تم تعميرها بالزهاد المجاهدين المرابطين . لكن تعطلت هذه الحركة في العهد الفاطمي فأهملت الرباطات و جرد المرابطين من السلاح خوفا منهم لأنهم كانوا ينكرون على العبيديين عقيدتهم . و بذلك انتقل مفهوم المرابطة من الجهاد إلى الركون إلى الذكر و الاعتزال و التصوف .
2 ) نشأة الطرق الصوفية و تفرعاتها :
و مع تبلور علم جديد يسمى ” علم الباطن “ حيث قسمت الفلسفة الصوفية العقيدة الإسلامية إلى ” ظاهر “ أي الشريعة الباب الذي يدخل منه الجميع، و ” الباطن ” أي الحقيقة التي لا يصل إليها إلا المصطفون الأخيار، تحول التصوف من الزهد و الورع إلى مذهب قائم على أصول و أركان. و الطريقة الصوفية هي المنهج اللازم إتباعه للوصول للحقيقة المطلقة عبر مراحل و مقامات محددة. و يختزل هذا المنهج في أوردة و أذكار و تعاليم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه و سلم و للتدليل على صحتها و شرعيتها اعتمدت كل طريقة سلسلة ( أي سند ) من الصالحين و الأعلام تتصل دائما بالرسول صلى الله عليه و سلم. و لكل طريقة سلسلتها الخاصة بها و إن اختلفت في بعض الشخصيات إلا أنها دائما تتصل بعمر بن الخطاب أو أبي بكر الصديق اللذان تلقيا الطريقة عن علي بن أبي طالب و الذي بدوره تلقاها عن الرسول صلى الله عليه و سلم باستثناء الطريقة الشاذلية و التيجانية التي تتصل سلسلتها بعلي بن أبي طالب عن طريق الحسن البصري . لقي هذا التصوف الجديد معارضة شديدة في الشرق على عكس ما لقيه في المغرب و خاصة في إفريقية في العهد الحفصي بداية من القرن 11 م. فمع ظهور أبي مدين شعيب ( 1116 – 1197 ) الذي تتلمذ على يد عبد القادر الجيلاني في المشرق و عاد ليستقر ببجاية حيث ذاع صيته و تخرج على يده عدة صلحاء توزعوا في كامل المغارب لاستتابة الناس و نشر تعاليم الدين و المذهب المالكي السني بين الناس في فترة اتسمت بتدهور الأوضاع الأمنية و الفكرية و الدينية ، و كذلك ظهور أبو الحسن الشاذلي انتشرت الطرق الصوفية و تفرعت عن بعضها البعض ، فتنطلق الفروع من الزاوية الأم و تنتشر على مجموع البلاد. و تعتبر القادرية من أقدم الطرق الصوفية نسبة إلى مؤسسها الأول عبد القادر الجيلاني البغدادي ( ت 1097م ) و تفرعت عن هذه الطريقة كل من الشاذلية و هي النسخة المغربية للقادرية نشأت على يد أبي الحسن الشاذلي و تسمت باسمه و تفرعت بدورها إلى عدة طرق مثل المدنيّة التي تفرعت بدورها إلى الدرقاوية و من الطرق المتفرعة عن الشاذلية نذكر كذلك الطريقة الشابية التي أصبحت تسمى بـ ” بيت الشريعة ” في الجريد و العروسية نسبة إلى أحمد بن عروس و التي أصبحت تسمى بالسّلاميّة و العيساوية كلها منبثقة من الشاذلية. كما برزت الطريقة الرحمانية المنحدرة من الطريقة الأم الخلواتية ( ظهرت بالشام على يد أحمد الخلواتي توفي سنة 1398 ) و التي تفرعت منها العزوزية. كما ظهرت الطريقة البوعليّة نسبة إلى أبو علي النفطي ( ت 1213 ) و كذلك السنوسية نسبة إلى محمد بن علي السنوسي الجزائري ( ت 1855 ) بطرابلس و التباسية و المدنيّة بتفرعاتها ( الإسماعلية و القاسمية ) و الكرّابية و الحفناوية و المحواشية و الحسينية و العمارية ( المنبثقة ثلاثتهم من القادرية النفطية ) و العلوية… و في الجملة تقاسمت قرابة 19 طريقة جزءا هاما من السكان قدروا بــ 700 ألف نسمة في بداية القرن العشرين انتموا إلى قرابة 505 زاوية . يعود هذا الانتشار إلى تشجيع السلاطين الحفصيين لهذه الطرق التي أوكلت لها القيام بالمهام الاجتماعية و التعليمية التي كانت السلطة عاجزة على القيام بها و تواصل الدعم و التشجيع مع الأتراك العثمانيين و خاصة الأسرة الحسينية الذين اعترفوا بالطرق الصوفية قانونيا.
3 ) أهم الطرق الصوفية في تونس :
كغيرها من دول المغرب الكبير ضمت تونس مجموعة كبيرة من الطرق الصوفية سنحاول التعريف بالبعض منها
_ القادرية : تعتبر من أهم الطرق الصوفية و سميت القادرية نسبة إلى مؤسسها الأول عبد القادر الجيلاني البغدادي توفي سنة 1097. تسربت إلى تونس من الشرق محافظة على تسميتها على يد علي بن عمار الشايب. و رغم قدم هذه الطريقة إلا أنها بقيت بلا زاوية حتى ظهور الشيخ محمد الإمام المنزلي ( ت 1832 ) الذي أسس أول زاوية لها بمنزل بوزلفة بمساعدة حمودة باشا الحسيني حوالي سنة 1776 لتنشر في بقية البلاد فتأسست زاوية العالية حوالي 1778 و زاوية باجة سنة 1780 كما أسس سيدي الحاج ميلود زاوية ثانية بباجة سنة 1816 و بلغت الفراشيش و ماجر منذ سنة 1816 على يد سيدي بوبكر بن شريك أصيل توزر و تعود الزاوية القائمة على سفوح المغيلة إلى سنة 1899 و تأسس فرع الكاف حوالي سنة 1824 من قبل الميزوني الغربي أصيل المغرب و الذي تتلمذ على يد الحاج ميلود ثم أقام زاوية ببلاد ونيفة و خلفه ابنه قدور الميزوني سنة 1865 و من القبائل التي انضوت تحت نفوذ زاوية الكاف نذكر الزغالمة و شارن و أولاد بوغانم و الحنانشة و أولاد مومن و ماجر و الفراشيش و بالنسبة لزاوية نفطة فقد أسسها سيدي إبراهيم بن أحمد الكبير من تلامذة سيدي بوبكر بن شريك و امتد تأثير هذه الزاوية من غدامس إلى وادي سوف علاوة على الوسط التونسي و نمامشة تبسة كما تعلق بها الشعانبة و الطوارق و نذكر أيضا زاوية توزر الذي أسسها الشيخ المولدي بوعرقية . و قد ساعد انضمام مجموعة من النخبة إلى هذه الطريقة و من أبرزهم حمودة باشا الحسيني على انتشارها في كامل ربوع البلاد و خارجها.
_ الرحمانية : و هي طريقة منحدرة من الطريقة الأم الخلواتية بالشام و هي منسوبة إلى محمد بن عبد الرحمان الجزائري تسربت هذه الطريقة إلى تونس عبر منفذين الأول عن طريق يوسف بوحجر الذي أسس الزاوية الرحمانية بالكاف و الثاني عن طريق الشيخ محمد بن عزوز شيخ الطريقة الرحمانية ببسكرة الذي غادر الجزائر بعد احتلال موطنه سنة 1843 و استقر بنفطة أين أسس زاوية رحمانية و شهدت هذه الطريقة انتشارا واسعا في البلاد لاسيما زمن شيخها مصطفى بن عزوز ( ت 1866 )
_ التيجانية : تنسب إلى مؤسسها أحمد التيجاني ( 1738 – 1814 ) دفين مدينة فاس و الذي تنقل في الصحراء لنشر طريقته ثم التجأ إلى فاس و كان أول من تلقى الطريقة التيجانية في تونس هو الشيخ إبراهيم الرياحي ( ت 1850 ) الذي كان شاذلي الطريقة في بداياته ، التقى بأحمد التيجاني بفاس على هامش زيارة رسمية إلى المغرب الأقصى سنة 1805 فتعلق بطريقته و عند عودته أنشأ زاوية قرب حوانيت عاشور و هي أول زاوية تيجانية بتونس و سرعان ما انتشرت في كامل أرجاء البلاد .
_ الشاذلية : و هي متفرعة عن الطريقة الأم القادرية تنسب إلى علي بن عبد الجبار المعروف بأبي الحسن الشاذلي و كما رأينا أن القادرية تسربت إلى تونس من الشرق على يد علي بن عمار الشايب محافظة على تسميتها المشرقية فإن النسخة المغربية لهذه الطريقة تسربت على يد أبي الحسن الشاذلي و لم تحافظ على تسميتها الأصلية و هو التسرب الأقدم للقادرية بتونس. و للشاذلية أدعية و أذكار تخصها مثل حزب البحر و حزب الفتح لا تزال تردد إلى يومنا هذا. و تعد الشاذلية طريقة مدينيّة أساسا و ذات طابع نخبوي مما جعل أعداد منتسبيها قليلا نسبيا.
_ العيساوية : قد يكون تسربها سابقا لظهور القادرية ( و لا نقصد هنا الشاذلية ) و يعود ذلك إلى منتصف القرن 16 بعد وفاة مؤسسها الشيخ محمد بن عيسى الفهدي المغربي الشريف دفين مدينة مكناس سنة 1518 المنتمي للطريقة الشاذلية إلا أنه بعد عودته من الحج أنشأ طريقة حملت اسمه. و لهذه الطريقة انتشار واسع بكامل المغرب الكبير و لها مدائح و أذكار و طقوس خروج احتفالية تميزها عن باقي الطرق . انتشرت العيساوية أولا بالوطن القبلي منذ سنة 1646 ثم بالشمال الشرقي و خاصة منطقة بنزرت بداية من سنة 1712 كما انتشرت في جهة الساحل و سوسة بداية من سنة 1711 و أخيرا تأسس لها فرع في جرجيس و قصر أولاد محمد سنة 1902 . كما تتواجد العيساوية في صفاقس و القيروان و مطماطة و جربة و الحامة. لها ما يقارب 144 زاوية
_ السّلاميّة : نسبة إلى الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري ( ت 1573 ) و هو تلميذ أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الهواري المعروف بأحمد بن عروس المكنى بأبي الصراير المتوفي سنة 1463 م ، تولى الشيخ عبد السلام نشر الطريقة العروسية في طرابلس و أسس زاوية بزليطن سنة 1537 . و لشهرته تسميت الطريقة باسمه و أصبحت تسمى السّلاميّة مستفيدة من هياكل و مؤسسات العروسية. و لهذه الطريقة امتداد و أتباع بكل من تونس و ليبيا. تمكنت هذه الطريقة من امتلاك زاوية بمدنين سنة 1895 و لكنها ظلت معزولة وسط ورغمة كما آوت جرجيس 3 زوايا للسلامية و انتشرت في قبلي و قابس و جربة و قفصة و سوسة و تونس و بنزرت و توزر و لم يكن لها تواجد في مكثر و سوق الأربعاء و الكاف و طبرقة و باجة و تبرسق و مطماطة. و تمتلك السلامية قرابة 87 زاوية .
_ المدنية : المنسوبة إلى مؤسسها ظافر المدني ( ت 1852 ) و المتفرعة عن الدرقاوية انخفض عدد منتسبيها إلى 500 سنة 1925 و كانت مراكز اشعاعها منطقة الساحل و تونس و زغوان و صفاقس و مكثر و أولاد عيار القبالة و أولاد عون . و رغم قلة منتسبيها خلال النصف الأول من القرن العشرين إلا أنه تفرع عنها الإسماعلية و القاسمية و تعد هذه الأخيرة ( أي القاسمية ) أكثر الطرق انتشارا بالبلاد التونسية حاضرا لها ما لا يقل عن 400 زاوية تستقطب قرابة 250 ألف مريد لوحدها سواء بداخل البلاد أو خارجها .
_ البوعليّة : أو طريقة أبو علي النفطي المشهور بالسني لنصرته مذهب أهل السنة ضد الخوارج توفي سنة 1213 . هيمنت هذه الطريقة على الجنوب التونسي و مركزها نفطة توزعت فروعها على تونس و القيروان و توزر و المطوية و وذرف و جارة و المنزل و طبلبو و صفاقس و لم تسجل حضورها في المهدية و بنزرت و سوق الأربعاء و قرمبالية و قبلي و جرجيس و مطماطة . و تمتلك هذه الطريقة حوالي 19 زاوية .
و هناك عدة طرق صوفية أخرى مثل التباسية نسبة إلى أحمد الغوث التباسي و السنوسية المنسوبة إلى محمد بن علي السنوسي الجزائري ( ت 1855 ) و العزوزية نسبة إلى سيدي علي عزوز شيخ زغوان المتوفي سنة 1710 غيرها …
4 ) التوزع القبلي و الجغرافي للطرق الصوفية :
سنعتمد في هذه الفقرة ما تركه لنا ضباط الشؤون المحلية و المراقبة المدنية لسلطة الاحتلال الفرنسي في بداية القرن العشرين و التي نقلها باحتراز الدكتور توفيق بشروش وفيها نسب انتماء المنخرطين في الطرق الصوفية هي كالتالي :
_ تالة : الرحمانية 50 % القادرية 40 %
_ تبرسق : القادرية 65 % الرحمانية 27 %
_ القيروان : القادرية 64 % الرحمانية 20 %
_ الكاف : الرحمانية 38 % القادرية 34 % العيساوية 18 %
_ قفصة : القادرية 37 % العيساوية 30 % الرحمانية 15 % السلامية 15 %
_ تطاوين : التيجانية 39 % القادرية 34 % الرحمانية 27 %
_ طبرقة : القادرية 48 % الرحمانية 36 % العيساوية 16 %
_ سوسة : العيساوية 56 % السلامية 19 % العلوية 12 % العمارية 11 %
_ تونس : الرحمانية 57 % القادرية 18 % السلامية 10 %
_ قرمبالية : العيساوية 80 % القادرية 12 %
_ باجة : القادرية 56 % الرحمانية 36 %
_ بنزرت : الرحمانية 40 % العيساوية 35 % القادرية 10 %
_ توزر : الرحمانية 34 % القادرية 25 % البوعليّة 23 %
_ سوق الأربعاء : الرحمانية 63 % القادرية 17 % العيساوية 16 %
_ مدنين : الرحمانية 77 % القادرية 18 %
_ مكثر : الرحمانية 77 % القادرية 14 %
_ صفاقس : العيساوية 59 % العمارية 21 %
_ قبلي : القادرية 37 % الرحمانية 33 % العيساوية 21 %
_ قابس : العيساوية 32 % السلامية 24 % البوعلية 21 % القادرية 10 % التيجانية 10 %
_ مجاز الباب : المحواشية 47 % الرحمانية 46 %
_ جربة : العيساوية 49 % السلامية 11 % و كل من الطيبية و الحسينية و الكراتية حظيت كل واحدة منها قرابة 10 %
_ مطماطة : العيساوية 55 % العمارية 21 % الرحمانية 14 %
_ زغوان : الرحمانية 62 % العزوزية 17 % القادرية 11 %
_ جرجيس : التيجانية 51 % الرحمانية 24 % العيساوية 22 %
و ما يمكن أن نستخلصه من هذا الجرد هو أن طريقتين سيطرتا على البلاد و هما الرحمانية و القادرية و كانتا الأكثر انتشارا و تأتي بعدهما العيساوية ثم التيجانية و السلامية و هي الطرق الرئيسية أما الطرق الثانوية فهي البوعلية و العمارية و العلوية و العزوزية و الطيبية و المدنية و الحسينية و الكرّابية و السنوسية و الحفناوية و التباسية . و من الملاحظات الهامة التي يمكن أن نخرج بها هي أن كل من العيساوية و السلامية وضعتا أيدهما على المدن في حين أن الرحمانية و القادرية نشرتا نفوذهما في الأرياف و نأخد منطقة الحامة كمثال فقد انتمى سكان الحامة إلى العيساوية بينما انحاز البدو إلى القادرية . و بالنسبة للتوزع القبلي فقد انخرط ثلاثة أخماس الخمامسة و الدوفان في طريقة معينة مثل القادرية و زاويتهم الأم زاوية سيدي الميزوني بالكاف و العيساوية و الرحمانية و زاويتهم سيدي يوسف بوحجر أما أولاد عيار فكانوا في غالبيتهم رحمانيون و يعودون بالنظر إلى زاوية سيدي علي بن عيسى بالكاف أما السوالم و أولاد علي الڨراوة و سكان الباز فيتبعون الطريقة القادرية و هم قلة . بينما أولاد يعقوب في غالبيتهم ينتمون للقادرية مع تواجد البعض من الرحمانيين و تتوزع الزغالمة بالتساوي تقريبا بين القادرية و الرحمانية أما التيجانية و العامرية فهم قلة . و غالبية أولاد ايدير من الرحمانية و الجدير بالملاحظة هنا عدم انخراط عرش السواسي في أية طريقة و ربما يعود ذلك لزوال مريدي الطريقة المدنية التي كانت منتشرة في أوساطهم .
المراجع :
_ في تاريخ المغارب المقارن_ الأزمة و الدولة و الانتماء : لطفي عيسى
_ الولي الصالح و الأمير في البلاد التونسية : توفيق بشروش
_ الطرق الصوفية و الاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية ( 1881 – 1939 ) : التليلي العجيلي
_ الولاية و المجتمع _ مساهمة في التاريخ الاجتماعي و الديني لافريقية في العهد الحفصي : نللي سلامة العامري.