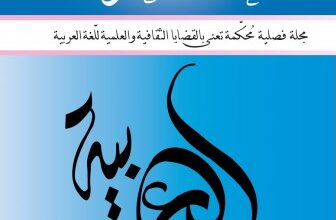منزلة الشريعة ودورها في المنهج المعرفي العرفاني
د. فادي ناصر
أستاذ الفلسفة والدراسات الإسلامية في جامعة المعارف – لبنان.
من الإشكاليّات المعرفيّة الأساسيّة المتعلّقة بالعرفان بشقّيْه النظري والعملي هي علاقته بالشريعة. والسبب في ذلك ما ظهر في سلوكيّات بعض العرفاء وأقوالهم، وحتّى اعتقاداتهم ما يوحي بأنّ العرفان على طرف نقيض من الشريعة؛ والّتي هي أحكام الدين وقوانينه، المستلّة من كتاب الله وسنّة نبيّه، والّتي تنّظم حياة الإنسان مع ربّه ومع نفسه ومجتمعه. وهذه الفئة على الرغم من اعتقادها مثل سائر العرفاء الأصيلين بأنّ للدّين ظاهرًا وباطنًا، إلّا أنّهم انتهجوا نهجًا خاصًّا بهم لناحية فصل الظاهر عن الباطن، والاعتقاد بأنّ طريق العرفان هو طريق الباطن فقط دون الظاهر. بل توهّموا أنّ الظاهر يشكّل عائقًا بحسب زعمهم أمام الإشراقات القلبيّة والفيوضات الربانيّة، وهذا المنهج هو امتداد لمنهج فصل العرفان عن العقل. فعندما نفصل بين العقل والقلب، ستكون النتيجة التالية الفصل ما بين الظاهر والباطن؛ لأنّ العقل عندهم يشكل امتدادًا للبعد الظاهري المحدود والمقيّد. فبحسب زعمهم أنّ العقل هو لسان الظاهر والذوق والقلب هو لسان الباطن. ولكن عندما نراجع مناهج أهل المعرفة، والتحقيق من العرفاء؛ نجد أنّ هذا الطرح لا يعارض فقط العرفان الأصيل، بل يعارض الفهم الصحيح والواقعي لحقيقة الدين الإسلامي.
العارف يرى الوجود برمّته، سواء أكان تحقّقًا تكوينيًّا أو أنفسيًّا أو قرآنيًّا؛ ذا بعدين وطورين هما: الظاهر والباطن. فما من شيء في الرؤية العرفانيّة للوجود إلا وله وجه إلى الباطن، وهي الوجهة الغيبيّة والملكوتيّة للموجود، ووجه آخر إلى الظاهر، وهي وجهته الخلقيّة الماديّة. والعارف يستند في رؤيته هذه إلى القرآن الكريم، فلفظا الظاهر والباطن لفظان قرآنيّان بامتياز، وقد ورد ذكرهما في العديد من المواضع المتفرّقة من كتاب الله العزيز. منها قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ﴾[i]، ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَة﴾[ii]، ﴿يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُون﴾[iii]،﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن﴾[iv]، ﴿قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ﴾[v]، ﴿وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ﴾[vi]، ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذاب﴾[vii]، ﴿فَلا تُمارِ فيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدا﴾[viii]، وغيرها من الآيات القرآنيّة. والمعنى المستفاد من هذه الآيات الشريفة جميعًا أنّ لهذا الكون ولحقائق الموجودات والأعمال ظاهرًا وباطنًا، بل إنّ الحقّ تعالى قد سمّى نفسه بـ”الظاهر” و”الباطن”، وعدّهما من أسمائه الإلهيّة الحسنى. وهذا الاستنتاج يقودنا إلى القول إنّ حديث العرفاء عن علم الباطن هو حديث له عماد وأساس قويّ يمتد إلى الوحي المنزل من قبل الله عزّ وجل.
بالإضافة إلى الآيات القرآنيّة الكريمة، هناك العديد من الأحاديث والروايات الشريفة الزاخرة ببيان هذه الحقيقة الّتي يؤمن بها العارف أشدّ الإيمان، ويراها أصلًا حاكمًا على كلّ رؤيته الوجوديّة، والّتي من دونها يصبح علم العرفان برمّته علمًا غير ذي جدوى وفائدة؛ لأنّ علم العرفان قائمٌ على أساس هذين البعدين؛ الظاهر والباطن، لناحية العلاقة الخفيّة القائمة بينهما، والّتي يسعى العارف على الدوام إلى سبر أغوارها واكتشاف مكنوناتها مستعينًا بالعقل والكشف والشرع أيضًا. من هذه الروايات الشريفة على سبيل المثال، قول الرسول الأكرم (ص): “إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم”[ix]. حيث يرى العارف في هذا الحديث دلالة واضحة على وجود نحوين من المعرفة، الأولى سهلة وسطحية، والثانية صعبة وعميقة. وحديث الرسول (ص) وعباراته التي استخدمها حين قال: “نكلّم” ولم يقل “نقول”، أو “نبيّن” أو نذكر”؛ تكشف عن وجود درجة من المعرفة لا يبلغها فهم السامعين لصعوبتها وعمقها. لذا كان كلام الأنبياء دائمًا على قدر عقول أممهم، رفقًا بهم، ومراعاة لحالهم، ولكن دون أن يعنيَ اعتمادهم على اللّغة البسيطة والسهلة أحيانًا إلى إلغاء المعرفة الأرفع والأعمق.
فمعارف الأنبياء عليهم السلام حقيقتها وراء طور العقول الإنسانية العادية التي تعتمد في تحصيل معرفتها على الحواس وعلى البرهان والجدال، ولكن على الرغم من ذلك فقد بيّنوا للناس هذه الحقائق وشرحوها لهم بما يتلاءم مع طريقتهم. من هنا يعلم أنّ لكلام الأنبياء (عليهم السلام) “مرتبة فوق مرتبة البيان اللّفظي، لو نزلت إلى مرتبة البيان دفعتها العقول العاديّة، إمّا لكونها خلاف الضرورة عندهم، أو لكونها منافية للبيان الّذي بيّنت لهم به وقبلته عقولهم. ومن هنا يظهر أنّ نحو إدراك هذه المعارف بحقائقها غير نحو إدراك العقول، وهو الإدراك الفكري”[x].
ومن الروايات الشريفة أيضًا الّتي يظهر فيها كلا البعدين؛ الظاهر والباطن، الأحاديث المرويّة عن أهل بيت النبي (عليهم السلام)، كما في هذه الرواية المروية عن الإمام الصادق (ع) حيث يقول: “إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا صُدُورٌ مُنِيرَةٌ أَوْ قُلُوبٌ سَلِيمَةٌ أَوْ أَخْلَاقٌ حَسَنَة”[xi]. ويظهر من هذه الرواية الشريفة أنّ كلامهم (عليهم السلام) ذو مراتب ودرجات، وأنّه ليس على مستوى واحد ودرجة واحدة، بل لكلامهم شؤون وأحوال متفاوتة بحسب تفاوت قابليّات الناس. فكلّ يغرف من معين كلامهم المبارك على قدر سعة إنائه الوجودي واستعداده. وكلّما توسّع إناء الإنسان العقلي والقلبي أكثر، كلما تزوّد من رحيق علومهم القدسيّة، وفيض معارفهم النبويّة أكثر فأكثر، إلى أن يصل إلى المرتبة التي يصبح فيها فهم كلام أهل البيت (عليهم السلام) فيها أمرًا صعبًا، إلّا على ثلاثة أصناف من البشر بحسب تصنيف الإمام الصادق (ع): “إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَان”[xii].
وفي رواية أخرى يظهر فيها بشكل أوضح هذا التقسيم وهذا التفاوت في كلامهم، وتدرّجه بين مراتب الظاهر والباطن، حيث يقول الإمام الصادق (ع): “إِنَّ أَمْرَنَا هُوَ الْحَقُ وَحَقُّ الْحَقِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَبَاطِنُ الظَّاهِرِ وَبَاطِنُ الْبَاطِنِ وَهُوَ السِّرُّ وَسِرُّ السِّرِّ وَسِرُّ الْمُسْتَسِرِّ وَسِرٌّ مُقَنَّعٌ بِالسِّرِّ”[xiii].
وهذا التفاوت قد وصلت آثاره إلى أصحاب النبي محمد (ص) المقرّبين، بل وإلى الدائرة الأضيق والأقرب إليه من غيرهم. فنجد أنّه حتى عند هذه الدائرة الأقرب إلى النبي قد تفاوتوا فيما بينهم في تلقّي العلوم والمعارف القرآنيّة والنبويّة، حتّى اضطرّ بعض الأصحاب إلى إخفاء حقيقة ما وعاه عقله وشاهده قلبه أمام الآخرين، وهو ما يفهم من هذه الرواية المرويّة أيضًا عن الإمام الصادق (ع) التي تشرح لنا المطلب بشكل أوضح وأجلى، فقد أجاب الإمام (ع) سائلًا يسأله عن التقيّة فقال له: “ذُكِرَتِ التَّقِيَّةُ يَوْمًا عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَبُو ذَرٍّ مَا فِي قَلْبِ سَلْمَانَ لَقَتَلَهُ، وَلَقَدْ آخَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَهُمَا فَمَا ظَنُّكُمْ بِسَائِرِ الْخَلْقِ إِنَّ عِلْمَ الْعُلَمَاءِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْعَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، فَقَالَ وَإِنَّمَا صَارَ سَلْمَانُ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ امْرُؤٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلِذَلِكَ نَسَبْتُهُ إِلَى الْعُلَمَاءِ”[xiv].
وفي رواية أخرى عنه (ع) يبيّن فيها حقيقة القرآن الكريم ومراتبه، كاشفًا أنّ للقرآن ظاهرًا وباطنًا، وأنّ فهمه أيضًا ليس على مستوى واحد. قال الإمام الصادق (ع): “يَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْنًا وَلِلْبَطْنِ ظَهْرًا وَلَيْسَ شَيْءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْهُ إِنَّ الْآيَةَ لَيَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِي شَيْءٍ وَأَوْسَطُهَا فِي شَيْءٍ وَآخِرُهَا فِي شَيْءٍ وَهُوَ كَلَامٌ مُتَصَرِّفٌ عَلَى وُجُوهٍ”[xv].
ونختم الكلام بهذه الرواية عن الإمام الباقر (ع) التي يبيّن فيها أنّ ما أخفوه للناس هو أكثر ممّا أظهروه لهم، وفي ذلك دلالة واضحة أيضًا على وجود بعد آخر غير البعد الظاهري المتعارف والمأنوس به من قبل أكثر الناس، وهو بعد خفيّ وباطني وغير ظاهر إلّا لفئة خاصّة من الناس. قال (ع): “يَا جَابِرُ مَا سَتَرْنَا عَنْكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا أَظْهَرْنَا لَكُمْ”[xvi].
وعلى حدّ قول العلامة الطباطبائي، إنّ “متفرّقات الأخبار في هذه المعاني أكثر من أن تحصى، وقد عدّوا جمعًا من أصحاب النبي (ص) وأئمّة أهل البيت من أصحاب الأسرار، كسلمان الفارسي، وأيس القرني، وكميل من زياد النخعي، وميثم التمار الكوفي، ورُشيد الهجري، وجابر الجعفي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين”[xvii]. وفي المحصّلة النهائية يمكن أن نستخلص من مجموع الآيات والروايات أنّ الإسلام كدين قائم على أساس هذه الثنائيّة المتجانسة والمتماهية ما بين الظاهر والباطن، ففي الإسلام كما يقول السراج الطوسي: “العلم ظاهر وباطن، والقرآن ظاهر وباطن، وحديث رسول الله (ص) ظاهر وباطن، والإسلام ظاهر وباطن”[xviii].
وعندما نتحدّث عن الإسلام، فإنّ مدار البحث يدور حول الشريعة بأحكامها المختلفة وحدودها، إضافة إلى الكتاب والسنّة بطبيعة الحال؛ لأنّ كلّ الأحكام الشرعيّة مستقاة من هذين المصدرين الشرعيّين. ومن وجهة نظر العارف، كلّ الأحكام والحدود الشرعيّة؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغيرها؛ كلها لها بعدان: بعد ظاهري جليّ، وبعد باطني خفيّ.
في مقدّمة كتاب “الآداب المعنويّة للصلاة”، يشير الإمام الخميني (قده) إلى هذا الأصل الحاكم في رؤية العرفاء، كاشفًا عن أنّ للصلاة آدابًا ظاهريّة وباطنيّة، وأنّه بمراعاة الآداب الظاهريّة يسقط الواجب عن المكلّف، وبمراعاة الآداب الباطنيّة يعرج المصلّي نحو عالم الملكوت والأفق الأعلى، كما قال: “اعلم أنّ للصلاة غير هذه الصورة معنى ولها دون هذا الظاهر باطنًا، وكما أنّ لظاهرها آدابًا يؤدي عدم رعايتها إلى بطلان الصلاة الصورية أو نقصانها، فإنّ لباطنها آدابًا قلبيّة باطنيّة يلزم من عدم رعايتها بطلان أو نقص في الصلاة المعنوية، كما برعاية تلك الآداب تكون الصلاة ذات روح ملكوتي”[xix].
بعد ثبوت البعد الباطني للدين الإسلامي وتشريعاته الظاهريّة عند العارف، ينتقل الكلام مباشرة إلى بيان ماهيّة هذا الباطن وأحكامه، وعلاقته بالشريعة الّتي تمثّل عنده البعد الظاهري والأحكام المرتبطة بأفعال المكلّفين، والمستنبطة من الكتاب والسنّة. والعارف عندما يريد أن يتحدّث عن هذا البعد الباطني، فإنّ مدار بحثه يدور حول أمرين أساسيّين يصطلح عليهما بـ “الطريقة” و”الحقيقة”، وهما سويًّا يشكلان جوهر عالم المعنى والباطن عنده، ولكن على نحو ترتيبي كما سوف نبيّن لاحقًا. والسؤال الأساس الّذي يطرح في هذه الحالة هو حول ماهيّة علاقة الباطن بالظاهر، بمعنى آخر حول علاقة الشريعة بكلّ من الطريقة والحقيقة.
حقيقة الشريعة في الرؤية العرفانية النظرية
أ. الشريعة حقيقة واحدة ذات أبعاد عند العارف:
قبل أن ندخل لبيان العلاقة بين البعد الظاهري للدين؛ أي “الشريعة”، بالبعد الباطني؛ أي “الطريقة والحقيقة”، علينا أن نقف عند تعريف العارف لهذه الأركان الثلاثة؛ لتتّضح لاحقًا حقيقة الرابطة الوجوديّة بينها. الشريعة “في اللغة عبارة عن البيان والإظهار. يقال شرع الله كذا أي جعله طريقًا ومذهبًا، ومنه الشِرْعة، والشريعة، والشرع، والدين، والملّة، والناموس، كلّها بمعنى واحد. والطريقة هي السيرة المختصّة بالسالكين إلى الله تعالى مع قطع المنازل والترقّي في المقامات”[xx]. والشريعة عند العارف هي “السنّة الظاهرة الّتي جاءت بها الرسل عن أمر الله والسنن الّتي ابتدعت على طريق القربة إلى الله”[xxi]، وهي مظهر الأوامر والنواهي الإلهيّة الّتي بيّنت بواسطة الأحكام الفقهيّة المتّصلة بأفعال المكلّفين من أجل تنظيم علاقتهم مع ربّهم، وأنفسهم ومجتمعهم. أمّا الطريقة فهي البعد العملي المتّصل بالسير والسلوك المعنوي الّذي من خلاله يخرج العارف من سلطان النفس والهوى ليفنى في الحقّ تعالى ذاتًا وصفة وفعلًا.
أمّا الحقيقة فلها معنى أعمق وأشمل لتلامس جوهر التوحيد وحقيقته على مستوى الشهود والمعاينة القلبيّة. الحقيقة عند العارف هي المشاهدة الكشفيّة لحقائق الوجود الخاضعة لحاكميّة التوحيد الإلهي وحيطته المطلقة. وقد صوّر لنا العديد من العرفاء والمتصوّفة وعرّفوا هذه المراتب الثلاث، ونحن سنكتفي بعرض رأييْن منها.
يقول السيد حيدر الآملي في تعريف الشريعة والطريقة والحقيقة: “الشريعة اسم موضوع للسبل الإلهيّة، مشتمل على أصولها وفروعها، ورخصها وعزايمها، وحسنها وأحسنها. والطريقة هي الأخذ بأحوطها وأحسنها وأقومها، وكلّ مسلك يسلك الإنسان أحسنه وأقومه يسمّى طريقة، قولًا كان أو فعلًا أو صفة أو حالًا. وأمّا الحقيقة فهي إثبات الشيء كشفًا أو عيانًا أو حالة ووجدانًا. ولهذا قيل: الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تحضره، والحقيقة أن تشهده. وقيل: الشريعة أن تقيم أمره، والطريقة أن تقوم بأمره، والحقيقة أن تقوم به”[xxii].
وبيّن القشيري في رسالته أيضًا العلاقة بين الشريعة والحقيقة فقال: “الشريعة أمر بالتزام العبوديّة، والحقيقة مشاهدة الربوبيّة، فكلّ شريعة غير مؤيّدة بالحقيقة فغير مقبول، وكلّ حقيقة غير مقيّدة بالشريعة فغير محصور، الشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة إنباء عن تصريف الحقّ، فالشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده، والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقد وأخفى وأظهر”[xxiii].
ومن خلال هذا التعريف المختصر، يظهر لنا وجه الاختلاف بين الفقيه والعارف في رؤيتهما للدين الإسلامي وأحكامه. فالفقيه يقسّم الأحكام الإسلاميّة إلى ثلاثة أقسام هي:
علم العقيدة: هي أصول الدين الّتي ينبغي الاعتقاد بها عن طريق العقل والبرهان.
علم الأخلاق: هو العلم بالفضائل والرذائل النفسيّة وكيفية التحلّي بها والتخلّي عنها.
علم الفقه: هي الأحكام المرتبطة بأفعال المكلّف وسلوكيّاته الخارجيّة من خلال حواسه وجوراحه.
وهذه الأقسام عند الفقيه منفصلة عن بعضها البعض، وغير مترابطة في منظومة واحدة متكاملة، بل كلّ قسم يمكن أن يعمل أو أن يؤدّيَ وظيفته بشكل منفصل عن القسم الآخر، فلا يتوقّف علم من هذه العلوم على علم آخر، من جهة لتنوّع الأدوات المعرفيّة لكلّ من هذه العلوم الثلاثة واختلافها عن بعضها. فقسم العقائد مرتبط بالعقل والتفكير، وقسم الأخلاق مرتبط بالنفس والملكات النفسيّة وسجاياها، وقسم الأحكام الفقهيّة مرتبط بالأعضاء والجوارح الحسيّة. ومن جهة أخرى لأنّ الفقيه لا ينظر إلى الأقسام الثلاثة كمنظومة واحدة كاملة ومترابطة فيما بينهما بنحو من الترابط الّذي يهدف في نهاية المطاف إلى صناعة إنسان جامع لهذه الأبعاد الثلاثة، وهو ما يتفرّد به العارف في نظرته للإنسان والأحكام الإسلاميّة معًا.
فالعارف في نظرته للعلوم العقليّة لا يكتفي بالبحث حول الوجود الذهني، بل يرى ضرورة الوصول إلى أوج المعرفة العقليّة بالوجود، حتّى ترفع الحجب بينه وبين حقائقه من خلال الاتّصال بالنور القدسي والعقل الفعّال؛ ليكون منطلقا ومقدّمة أساسيّة وضروريّة للسير بقدم راسخة وقويّة، وبشكل صحيح وسليم في برنامج السير والسلوك العرفاني، والّذي يراه العارف بديلًا ضروريًّا لعلم الأخلاق التقليدي. فهو يرى أنّ علم الأخلاق الّذي يؤمن به الفقيه وبرنامج التخلّي والتحلّي عنده، ليس أكثر من معرفة نظريّة تفتقد إلى مقوّمات السلوك العملي ضمن برنامج واضح ومركّز. أمّا الأخلاق عند العارف فهي عبارة عن السير الأنفسي التكاملي على نحو تدريجي، بواسطة المجاهدة النفسيّة، وفق الضوابط الّتي يحدّدها الشرع الأنور، والعقل المنوّر، ليكون هذا السلوك المعنوي مقدّمة لورود عالم الحقيقة المطلقة، الّتي يعجز عن بيانها اللّسان وتحار فيها العقول والأفهام.
فكما أنّ الإنسان لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام منفصلة عن بعضها، هي الجسم والنفس والروح، بل هي متّحدة في الإنسان في عين اختلافها وتنوّعها فيه، ومجتمعة تشكّل هوية واحدة هي الإنسان الواحد بالذات، المتعدّد والمتنوّع بالأبعاد والصفات والخصائص. كذلك فإنّ النسبة بين الظاهر والباطن عند العارف ليست مباينة لبعضها البعض، مثل أنّ أبعاد الإنسان ليست مباينة لبعضها البعض، مع المحافظة على خصوصيّة كلّ بعد من هذه الأبعاد؛ بحيث لا يلغي أيّ بعد وجود ودور بعد آخر، لتشكّل مجتمعة حقيقة واحدة اسمها “الإنسان”.
والعارف ينظر إلى الدين وأحكامه بنفس هذه النظرة، فهو يرى الدين حقيقة واحدة ذات أبعاد مختلفة شكلًا، متّحدة مضمونًا وجوهرًا على مستوى الوظيفة والدور والغاية. فالشريعة والطريقة والحقيقة عنده حقيقة واحدة ذات أبعاد ثلاثة، ولهذه الحقيقة الواحدة مسمّيات عديدة منها “الشرع” أو “علم الشرع” أو حتّى “الشريعة الإسلامية” ومراده من الشرع الأعم من الأحكام الفقهيّة الخاصة بالفقهاء أو حتّى مصطلح “الشريعة” الّذي يطلقه العارف على علم الفقه. عند العارف “علم الشريعة علم واحد، وهو اسم واحد يجمع معنيين، الرواية والدراية، فإذا جمعتهما فهو علم الشريعة الداعية إلى الأعمال الظاهرة والباطنة”[xxiv].
فالشريعة والطريقة والحقيقة أسماء مترادفة صادقة على حقيقة واحدة ولكن باعتبارات مختلفة، وليس فيها خلاف في الجوهر ونفس الأمر، بل كما يقول السيد حيدر الآملي: “الشرع الإلهيّ والوضع النبويّ حقيقة واحدة، مشتملة على هذه المراتب، أي الشريعة والطريقة والحقيقة. وهذه الأسماء صادقة عليها على سبيل الترادف باعتبارات مختلفة. وأمثال ذلك في غير هذه الصورة كثيرة، كاسم العقل والعالَم والنور، فإنّها صادقة على حقيقة واحدة الّتي هي حقيقة “الإنسان الكبير” مثلًا، بما ورد في الخبر “أوّل ما خلق الله تعالى العقل”[xxv] و”أوّل ما خلق الله نوري”[xxvi]. وكاسم الفؤاد والقلب والصدر، فإنّها دالّة أيضًا على حقيقة واحدة التي هي حقيقة “الإنسان الصغير” لقوله تعالى: ﴿ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى﴾[xxvii] ولقوله: ﴿نَزَلَ به الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ﴾[xxviii] ولقوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾[xxix] وغير ذلك من الاستشهادات والأمثلة”[xxx].
وعليه، فالشرع الإلهي بمعناه العام عند العارف شامل للمراتب الثلاثة، وهو كاللّوزة الكاملة المشتملة على القشر، واللّب، والدهن. فاللوزة بأسرها هي الشرع الإلهي الأنور، والقشر هو علم الفقه أو ما يصطلح عليه بالشريعة أيضًا، ولكن بمعناها الخاص لا العام، واللّب هو علم الطريقة، أما الدهن فهو علم الحقيقة. ولكن على الرغم من أنّ هذه الأقسام الثلاثة متّحدة فيما بينها تحت عنوان جامع ولكنّها مختلفة أيضًا ومتفاوتة من حيث الرتبة والدرجة. فالشريعة عند العارف هي اسم للوضع الإلهي والشرع النبوي، وهي مرتبة العوام ومن حيث البداية. أمّا الطريقة فهي المرتبة الوسطى وهي درجة الخواص من أهل السير والسلوك العملي إلى الله. وأمّا الحقيقة فيه المرتبة النهائية، هي درجة خاصّة الخاصّة من عباد الله العارفين الجامعين للمراتب الثلاث كلّها بعنوان جامع اسمه الشرع الإلهي، المتحقّقين فيها ظاهرًا وباطنًا من دون أيّ انحراف عن جادة الحقّ والصراط المستقيم. وجميع مراتب الناس، عوامّهم وخواصّهم وخواصّ خواصّهم، لا تخلو من هذه المراتب الثلاث، أي الابتداء والوسط والنهاية، فهي متاحة لجميع الناس ولكن كلّ ينال منها بحسب مقامه وقابليته واستعداده.
والشريعة والطريقة والحقيقة، وإن كانت بحسب الواقع الحقيقة واحدة، “لكنّ الطريقة أعلى من الشريعة رفعة وقدرًا، والحقيقة أعلى منهما مرتبة وشرفًا. وكذلك أهلها؛ لأنّ الشريعة مرتبة أوّليّة، والطريقة مرتبة وسطيّة، والحقيقة مرتبة نهائية. فكما أنّ الوسط يكون كمالًا للبداية ولا يمكن حصوله من دونها، فكذلك النهاية تكون كمالًا للوسط ولا يمكن حصولها من دونه. أعني لا يصحّ ما فوقها بخلاف ما دونها، ويصحّ بالعكس، أعني تصحّ الشريعة بخلاف الطريقة، لكن لا تصحّ الطريقة بخلافها، والطريقة تصحّ بخلاف الحقيقة، لكن لا تصحّ الحقيقة بخلافها؛ لأنّ كلّ واحد منهما كمال بالنسبة إلى غيرها التي تكون تحتها. فالكامل المكمّل هو الجامع للمراتب كلّها؛ لأنّ الجامع بين شيئين أو بين مقامين لا يكون كالموصوف بواحد منها فقط. ولهذا صار هؤلاء القوم أعلى مرتبة من غيرهم، وأعظم قدرًا منهم”[xxxi].
فالشريعة على سبيل المثال تبيّن الأحكام الظاهريّة للصلاة، أمّا الطريقة فتتولّى بيان كيفيّة حصول حضور القلب في الصلاة وشروط كمال الصلاة، أما الحقيقة فتكشف للسالك العارف أسرار الصلاة وأبعادها الغيبيّة. الشريعة أيضًا تؤكّد على ضرورة أداء الواجبات من أجل النجاة من العذاب والفوز بالجنّة، أما الطريقة فتؤكّد بالإضافة إلى ذلك، على ضرورة تخليص النيّة لله أثناء أداء فروض الطاعة والعبوديّة، حتى تكشف له حجب النور فتصل روحه إلى حقيقة العظمة ومعدنها.
وهذه المراتب الثلاث عند العارف هي في الواقع من مقتضيات مراتب أخرى أيضًا هي: الرسالة والنبوة والولاية. فالشريعة عنده من لوازم ومقتضيات الرسالة، والطريقة من لوازم النبوة، والحقيقة من لوزام الولاية. “لأنّ الرسالة عبارة عن تبليغ ما حصل للشخص من طرف النبوّة، من الأحكام والسياسة والتأديب بالأخلاق والتعليم بالحكمة، وهذا عين الشريعة. والنبوّة عبارة عن إظهار ما حصل له من طرف الولاية، من الاطّلاع على معرفة ذات الحقّ وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه لعباده، ليتّصفوا بصفاته ويتخلّقوا بأخلاقه، وهذا عين الطريقة. والولاية عبارة عن مشاهدة ذاته وصفاته وأفعاله في مظاهر كمالاته ومجال تعيّناته أزلًا وأبدًا، وهذا عين الحقيقة. والكلّ راجع إلى حقيقة واحدة الّتي هي حقيقة الإنسان المتّصف بها، أو إلى شخص واحد كأولي العزم من الرسل، لأنّهم كذلك”[xxxii].
لأنه في الرؤية العرفانيّة، الإنسان الكامل هو الّذي يكون جامعًا بين الظاهر والباطن، فتكون له مرتبة الجامعيّة بين الشريعة والطريقة والحقيقة، وهي من أعلى مقامات ومراتب الكمال الإنساني، وهي في آخر الزمان من مختصّات الشريعة المحمديّة التي تتميّز عن بقية الشرائع بأنّها مجمع البحرين: الظاهر والباطن. فإذا كانت شريعة موسى (ع) قد جاءت من أجل تكميل الظاهر بشكل أساسي والباطن بشكل ثانوي، وشريعة عيسى (ع) قد جاءت من أجل تكميل الباطن أوّلًا، ثمّ الظاهر لاحقًا، فإنّ شريعة محمد (ص) جمعت بين الظاهر والباطن، بل جاءت من أجل تكميل كلا المرتبتين معًا.
فشريعة محمد (ص) هي مصداق لقوله تعالى: ﴿لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ﴾[xxxiii]، أي “لست – أنت يا محمّد – من أهل عالم الظاهر أو الأجسام الصرفة، الّذي هو المغرب، ولا من أهل عالم الباطن أو الأرواح الصرفة، الّذي هو المشرق، بل أنت جامع بينهما، وقس على هذا أهل التحقيق، لأنّهم ليسوا من أرباب الشريعة الصرفة، ولا من أهل الطريقة المحضة، بل هم جامعون بينهما”[xxxiv]. فالفقهاء من أمّة محمّد (ص) وعلماؤها مشبّهون بموسى (ع)، والحكماء الإلهيّون وأمثالهم من علماء النفس والأخلاق مشبّهون بعيسى (ع)، أمّا العارفون المحقّقون فمشبّهون بمحمّد (ص). ويشهد بذلك قول أمير المؤمنين (ع): “العلم نهر والحكمة بحر والعلماء حول النهر يطوفون والحكماء في وسط البحر يغوصون والعارفون في سفن النجاة يخوضون”[xxxv].
ب- الشريعة عين الحقيقة عند العارف:
نشير إلى مسألة مهمّة قد بيّنها العرفاء المحقّقون في كتبهم، وأشار إليها ابن عربي في كتابه “الفتوحات المكيّة”؛ وهي حقيقة الرابطة بين الشريعة والحقيقة. فبعد ثبوت جامعيّة الشريعة وعينيّة الأبعاد كلّها مع بعضها بعضًا، وبيان أنّ الانفكاك بينها ليس انفكاكًا عزليًّا؛ يصرّح ابن عربي بأنّ الشريعة وإن كانت هي البعد الظاهري للدين بحسب رؤية العارف وفهمه، ولكنّ هذا الظاهر في الواقع ليس فقط أنّه لا يعارض الباطن، وأنّه طريق إلى الباطن أيضًا، بل يرى العارف أنّ الشريعة هي حقيقة أيضًا ومن جملة الحقائق. أي أنّها في الواقع مقام الحقيقة نفسه أيضًا، ولكنّها تسمّى شريعة؛ لأنّها البعد الظاهري لهذه الحقيقة، كما قال: “الشريعة من جملة الحقائق فهي حقيقة لكن تسمّى شريعة وهي حقّ كلها والحاكم بها حاكم بحقّ مثاب عند الله لأنّه حكم بما كلّف أن يحكم به”[xxxvi].
أمّا السرّ في كون الشريعة هي عين الحقيقة من وجهة نظر العارف، فلأنّ كلّ شيء عنده في هذا الوجود هو حقيقة. فلا وجود ولا ظهور ولا تشخّص لغيرها. والحقيقة عنده ليست سوى التوحيد، وليس أيّ توحيد بل التوحيد الحقيقي الّذي لا يفصل بين الوحدة والكثرة، بل يرى الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. بمعنى آخر، يرى الباطن في عين الظاهر والظاهر في عين الباطن. وهو أعلى مراتب التوحيد الّذي لا يمكن أن يصل إليه إلا الأوحدي من العرفاء، “فالحقيقة الّتي هي أحديّة الكثرة لا يعثر عليها كلّ أحد”[xxxvii].
فإذا كانت الحقيقة هي التوحيد، والوحدة في الدين الإسلامي الحنيف حاكمة على كلّ هذا الوجود، فلا يخرج عن قيوميّتها وإحاطتها أي وجود وموجود، وكان اسما الظاهر والباطن من جملة الحقائق الأسمائيّة المحكومة بدورها لنظام التوحيد الوجودي؛ من هنا غدا الظاهر في الرؤية التوحيديّة العرفانيّة عين الباطن، والباطن عين الظاهر، فلا تقابل بينهما على الإطلاق، كما يقول ابن عربي:
“اعلم أيّدنا الله وإيّاك بروح منه أنّ الحقيقة هي ما هو عليه الوجود بما فيه من الخلاف والتماثل والتقابل، إن لم تعرف الحقيقة هكذا وإلا فما عرفت، فعين الشريعة عين الحقيقة. والشريعة حقّ ولكلّ حقّ حقيقة فحقّ الشريعة وجود عينها، وحقيقتها ما تنزّل في الشهود منزلة شهود عينها في باطن الأمر، فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد حتّى إذا كشف الغطاء لم يختلّ الأمر على الناظر… الحقيقة تطلب الحقّ لا تخالفه، فما ثمّ حقيقة تخالف شريعة، لأنّ الشريعة من جملة الحقائق والحقائق أمثال وأشباه، فالشرع ينفي ويثبت فيقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾[xxxviii] فنفى وأثبت معًا كما يقول: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾[xxxix]، وهذا هو قول الحقيقة بعينه فالشريعة هي الحقيقة”[xl].
أمّا السبب في كون الشائع بين الناس وبعض العلماء أنّ الشريعة هي غير الحقيقة؛ فمرجعه إلى أنّ إدراك هذه الحقيقة أمر يعسر على أكثر الناس، لدقة المعرفة التوحيديّة وعمقها وبعد غورها عن أفهام أكثر الناس. لذا كان من الطبيعي أن يحصل هذا الفصل بين الظاهر والباطن لعدم معرفتهم بحقيقة الباطن وحاكميّته في هذا الوجود، وواقع علاقته وارتباطه بالظاهر الّذي لا يتعارض مع الباطن، بل هو نفسه ولكن بتنزّل وتجلٍّ آخر. ولهذا فرّق أتباع المنهج التفكيكي بين كلا البعدين، فجعلوا الشريعة من مختصّات البعد الظاهري، والحقيقة من مختصّات البعد الباطني؛ مع أنّ الحقيقة مغايرة لذلك تمامًا كما يقول ابن عربي:
” فالحقيقة الّتي هي أحديّة الكثرة لا يعثر عليها كلّ أحد. ولمّا رأوا أنّهم عاملون بالشريعة خصوصًا وعمومًا، ورأوا أنّ الحقيقة لا يعلمها إلّا الخصوص، فرّقوا بين الشريعة والحقيقة، فجعلوا الشريعة لما ظهر من أحكام الحقيقة، وجعلوا الحقيقة لما بطن من أحكامها، لمّا كان الشارع الّذي هو الحقّ قد تسمّى بالظاهر والباطن، وهذان الاسمان لهما حقيقة، فالحقيقة ظهور صفة حقّ خلف حجاب صفة عبد، فإذا ارتفع حجاب الجهل عن عين البصيرة رأى أنّ صفة العبد هي عين صفة الحقّ عندهم، وعندنا إنّ صفة العبد هي عين الحقّ لا صفة الحقّ. فالظاهر خلق والباطن حقّ، والباطن منشأ الظاهر، فإنّ الجوارح تابعة منقادة لما تريد بها النفس، والنفس باطنة العين طاهرة الحكم، والجارحة ظاهرة الحكم لا باطن لها لأنّه لا حكم لها”[xli].
ج. الشريعة باب الباطن وسرّه:
مع أنّ الحقيقة أعلى رتبة ومقامًا من الطريقة، والطريقة بدورها أعلى من الشريعة، إلّا أنّه عند العرفاء المحقّقين، لا يمكن عبور الطريقة والوصول من خلالها إلى الحقيقة إلّا بقدم الشريعة. فالشريعة عند العارف باب طيّ مراتب الطريقة، وسرّ الوصول إلى الحقيقة. وكلّ من سعى للوصول إلى مقام القرب من الحقّ ومعدن العظمة، وإلى مشاهدة آياته التوحيديّة الكبرى، عليه أن يبدأ أوّلًا من أحكام الشريعة، وبذلك يصل إلى مقام الحقيقة من خلال السير والسلوك في طيّات مراتب الطريقة والعمل بمقتضياتها، حتّى يفتح له باب الوصول فيشاهد التوحيد الإلهي في كلّ عوالم الوجود.
فعند المحقّقين من العرفاء لا معنى لأن يخطوَ الإنسان في مراتب السير والسلوك من دون الالتزام بأوامر الشريعة ونواهيها، بشكل كامل وتام، بحيث لا يبقى في النفس شائبة هوى أو أنا؛ لأنّ مقام القرب من الحقّ لا يتحقّق من خلال معصيته ومخالفة أوامره ونواهيه الشرعيّة. أمّا إذا سلك الإنسان طريق السير والسلوك من دون مراعاة أحكام الشريعة، فإنّ سيره وسلوكه لن يكون سيرًا من النفس إلى الله، بل سيغدو سيرًا من النفس إلى النفس، وهو عين الأنا والشرك. وعليه، فإنّ مراعاة التدرّج والترتيب بين المراتب الثلاثة شرط لازم لصحة السلوك والشهود. فكلّ مرتبة من المراتب الثلاث هي بمثابة الضامن للمرتبة الأخرى، وهي مترابطة فيما بينها بنحو طولي وعلاقتها مع بعضها هي علاقة الظاهر بالباطن.
والكاشاني يرى أنّ اتّباع الشريعة في جميع المراحل هو السبب الأساس الّذي يحول دون انحراف السالك عن صراط السير والسلوك المستقيم، والوقوع في فخ المكاشفات النفسيّة والشيطانيّة، التي لا تزيد السالك سوى تيهًا وضياعًا وهو يحسب أنّه يحسن صنعًا. في المقابل فإنّ التزام السالك إلى الله بالقواعد والقوانين الشرعية بأدقّ تفاصيلها يجعله في حصن حصين من الوقوع في المزلات التي عادة ما يقع فيها أتباع الطرق الصوفية والعرفانية الذين لا يعتبرون الشريعة شرطًا حصريًّا لصحّة السلوك والوصول، مستعيضين عنها بمبتكرات نفسيّة لا علاقة للشرع فيها من قريب ولا من بعيد، ليبتدعوا لاحقًا منهجًا خاصًّا بهم مليئًا بالطقوس الغريبة التي لم نسمع بها ولم نلاحظها يومًا في حياة النبي محمد (ص) وأهل بيته (عليهم السلام).
يقول الكاشاني في اصطلاحاته: “كلّ علم ظاهر يصون العلم الباطن الّذي هو لبّه عن الفساد، كالشريعة للطريقة والطريقة للحقيقة، فإنّ من لم يصن حاله وطريقته بالشريعة فسد حاله وآلت طريقته هوسًا وهوى ووسوسة، ومن لم يتوسل بالطريقة إلى الحقيقة ولم يحفظها بها فسدت حقيقته وآلت إلى الزندقة والإلحاد”[xlii]. ويروى عن أبي يزيد البسطامي أنّه قال: “لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتّى تربّع في الهواء، فلا تغترّوا به حتّى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة”[xliii].
إذًا، أهميّة الشريعة لدى العارف تصل إلى حدٍّ يرى فيه أنّه مع عدم اتّباع الشريعة لا صحة للسلوك ولا إمكانيّة للوصول إلى مقام الشهود الحقيقي. وهذا الاتّباع للشريعة ليس شرطًا في أوّل الطريق فقط، بل إنّ اتّباع الشريعة من الشروط اللّازمة للوصول إلى مقام الفناء، بل وإلى مقام البقاء بعد الفناء والثبات عليه أيضًا؛ لأنّ الثبات على التوحيد بعد الصحو من المحو متعذّر ومستحيل من دون الشريعة وأحكامها. “فالفناء لا يقود إلى تذويب المركّب الإنساني، إذ إن أعضاء الإنسان وجوارحه تبقى خاضعة للأمر الشرعي والتكليف دائماً”[xliv].
ويرى العرفاء الإلهيّون فساد رأي وعقيدة من يرى أنّ العارف يصل إلى مرحلة في سيره وسلوكه يستغني فيها عن الشريعة. بل يرون في التكاليف الإلهيّة والأوامر والنواهي الربانيّة روح العبوديّة الحقيقيّة للإله، وهذه الروح هي من أهم النتائج الّتي يصل إليها العرفاء في مقام التوحيد وأكثرها لذّة.
ويرى هؤلاء أنّ الأحكام والقوانين الفقهيّة الظاهريّة كافة تمتلك بعدًا روحيًّا وباطنيَّا عميقًا. ففي كلّ حكم شرعي تكمن روح التوحيد، ولا يمكن الوصول إليه إلّا من خلال اتّباع هذا الحكم والالتزام التامّ به. لذا يرى العارف أنّ اتباع الحدود الإلهيّة بعد طيّ مراتب السلوك والتحقّق بمقام الشهود، أمرٌ ضروري في النهاية أيضًا كما كان شرطًا في البداية.
ويضع الإمام الخميني (قده) قانونًا عامًّا ومعيارًا واضحًا، من خلاله يتبيّن الإنسان أنّه من أهل الحقّ والكرامات الحقّانيّة، أو من أهل الباطل والكرامات النفسيّة والشيطانيّة؛ عندما جعل مراعاة الظاهر والالتزام بالشريعة الغرّاء ميزانًا وضابطةً لتمييز المقامات والكرامات المعنويّة الإلهيّة عن غيرها، فقال:
“إنّ طيّ أيّ طريق في المعارف الإلهيّة لا يمكن إلّا بالبدء بظاهر الشريعة، وما لم يتأدّب الإنسان بآداب الشريعة الحقّة، لا يحصل له شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة، كما لا يمكن أن يتجلّى في قلبه نور المعرفة وتتكشّف له العلوم الباطنيّة وأسرار الشريعة. وبعد انكشاف الحقيقة وظهور أنوار المعارف في قلبه لا بدّ من الاستمرار في التأدّب بالآداب الشرعيّة الظاهريّة أيضًا. ومن هنا نعرف بطلان دعوى من يقول: إنّ الوصول إلى العلم الباطن يكون بترك العلم الظاهر، أو يقول: لا حاجة إلى الآداب الظاهريّة بعد الوصول إلى العلم الباطن. فهذه الدعوى ترجع إلى جهل من يقول بها، وجهله بمقامات العبادة ودرجات الإنسانيّة”[xlv].
الشريعة ميزان المعرفة الباطنيّة
يؤكّد العرفاء الأصيلون على امتداد التاريخ على كذب المناهج العرفانيّة التي تدّعي وجود تباين وتعارض بين البعد الظاهري والباطني في الدين الإسلامي، وأحكامه وتشريعاته، وعلى كذب المشاهدات والمكاشفات العرفانيّة إذا كانت منطلقاتها مخالفة للشريعة الإسلاميّة وغير مطابقة لها.
بل يرى العرفاء أنّ الشريعة مع أنّها تشكّل البعد الظاهري للدين، فهي كالعقل تعتبر ميزانًا عامًّا، من خلاله يمكن للعارف أن يتبيّن الحقّ من الباطل، والصواب من الخطأ عند تقييمه للحقائق والمشاهدات العرفانيّة. فكما أنّ للحكماء موازين يفرّقون من خلالها بين الصواب والخطأ، فإنّ للعرفاء أيضًا ميزانهم العام الّذي من خلاله يفرّقون ما بين الأمور الحقيقيّة والأمور الاعتباريّة، وهذا الميزان العام “هو القرآن والحديث المنبئ كلّ منهما عن الكشف التامّ المحمدي (ص)”[xlvi]، كما يقول الجنيد: “علمنا هذا[xlvii] مقيّد بالكتاب والسنة وهما الأصلان الفاعلان”[xlviii].
فعلوم العرفاء على حدّ قول الجنيد مقيّدة دائمًا بالكتاب والسنة ولا يمكن أن تخرج عن دائرتهما وإلّا لبطل العلم، وما ينسب إليه من مسائل. بل يرى ابن عربي أيضًا أنّ الشريعة هي الفارق الأساسي بين المنهج الإلهي في كشف الحقائق، والمنهج الروحي. ويعتبر أنّ المنهج الروحي على الرغم من كلّ ما يمكن أن يتوصل إليه، لا قيمة له أمام الحقائق التي يمكن أن يكشفها المنهج الإلهي الّذي يعتمد على الشريعة كأصل حاكم وميزان ثابت دائمًا.
فابن عربي يعتقد أنّ أصحاب الرياضات الروحيّة والمجاهدات النفسيّة الذين لا إيمان لهم ولا اعتقاد بالشرائع السماويّة المنزّلة من الله تعالى، من الممكن أن يتّصلوا هم أيضًا بعالم الباطن والغيب مثل المؤمنين بالله والعاملين بشريعته. وبسبب وقوع هذا التشابه والتداخل بينهما، كان لا بدّ من تحديد المائز والفاصل الأساس بين كلا المنهجين؛ وهو بنظره ليس سوى الشريعة كما يقول: “فأصل رياضتنا ومجاهدتنا وأعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم والآثار الظاهرة علينا إنّما كان من عملنا على الكتاب والسنّة، فهذا معنى قوله – الجنيد – علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنّة. وتتميّز يوم القيامة عن أولئك[xlix] بهذا القدر، فإنّهم ليس لهم في الإلهيّات ذوق، فإنّ فيضهم روحاني وفيضنا روحاني وإلهي، لكوننا سلكنا على طريقة إلهيّة تسمى شريعة فأوصلتنا إلى المشرّع وهو الله تعالى؛ لأنّه جعلها طريقًا إليه فاعلم ذلك”[l]. وعليه، فإنّ علم الباطن عند العرفاء مستمدّ من الشريعة، وغاية ما في الأمر أنّ علم الباطن علم ذوقي تنطوي عليه الشريعة. ومتى تحقّق العبد بأحكام الشريعة، وعمل بالكتاب والسنّة، واتّجه بقلبه نحو الله وسلك طريق الذوق، فقد حصل على ذلك العلم، فالحقيقة ثمرة الشريعة.
وعليه لا يوجد أي تعارض بين معارف الشريعة وبين الحقائق المشاهدة لدى العارف، بل على العكس، لأن العارف يعتبر الشريعة ميزانًا عامًا ومعيارًا ضروريًّا لقياس وتقيبم المشاهدات والمكاشفات العرفانيّة؛ لأنّ العارف في منهجه المعرفي يرى ضرورة لوجود هذا المقياس العام في السير المعرفي النظري والسلوك العملي للعرفان، لكي لا يخرج العارف عن صراط التوحيد المستقيم قيد أنملة، هذا الصراط الذي رسمت الشريعة الإلهية حدوده وقوانينه الكفيلة بإيصال الإنسان الخليفة إلى الهدف النهائي من خلقه فيما لو التزم بأحكامها وأوامرها الظاهرة والباطنة، وترك العمل بأوامر النفس الأمارة التي تعتبر العدو الأوّل والعائق الأساس الذي يحول دون بلوغ الإنسان أوج المعرفة الإلهية وكمال الإنسانية.
لذا يعتبر القيصري الشريعة ميزانًا أساسيًّا للعرفان النظري، ويسمّيه بـ”الميزان العام” الذي على أساسه تقاس كل منظومة علم العرفان النظري بكل قواعدها وأصولها ومنهجها المعرفي، ويميّز على أساسها بين الأمور الحقيقيّة والوهميّة، كما يصرّح في مقدّمته على كتاب شرح فصوص الحكم عند حديثه عن كيفية التمييز بين الأمور الحقيقيّة والخياليّة فيقول: “وعبور الحقيقة عن صورتها الأصليّة، إنّما هو للمناسبات التي بين الصوّر الظاهرة هي فيها وبين الحقيقة، ولظهورها فيها أسباب كلّها راجعة إلى أحوال الرائي وتفصيله يؤدّي إلى التطويل. وأمّا إذا لم يكن كذلك، فللفرق بينها (أي الحقيقة) وبين الخياليّة الصرفة موازين، يعرفها أرباب الذوق والشهود بحسب مكاشفاتهم، كما أنّ للحكماء ميزانًا يفرّق بين الصواب والخطأ، وهو المنطق. منها ما هو ميزان عامّ، وهو القرآن والحديث المُنْبئ كلّ منهما عن الكشف التّأم المحمّدي. ومنها ما هو خاصّ، وهو يتعلّق بحال كل منهم، الفائق عليه من الاسم الحاكم، والصّفة الغالبة عليه”[li].
ومن المهم في الختام أن نلفت النظر إلى مسألة مهمّة وهي أن جعل العقل والشرع ميزانين أساسيين لعلم العرفان النظري، لا يحوّلان علم العرفان النظري إلى علم عقلي أو نقلي، بل يؤكّد العرفاء على أنّهم يعتمدون طريقة الشهود كمنهج مستقلّ للعرفان لأجل الوصول إلى الحقائق، ومن ثمّ، ولأجل الاطمئنان، يقارنون هذه الحقائق مع المعايير الدينية الشرعية؛ من عقل وشرع.
[i]– سورة الحديد،الآية3.
[ii]– سورة لقمان،الآية20.
[iii]– سورة الروم،الآية7.
[iv]– سورة الأنعام، الآية151.
[v]– سورة الأعراف، الآية33.
[vi]– سورة الأنعام،الآية120.
[vii] سورة الحديد، الآية13.
[viii]– سورة الكهف،الآية22.
[ix]– الكلينيّ، محمد بن يعقوب: الكافي، مرجع مذكور، ج1، ص23.
[x]– الطباطبائي، محمد حسين: رسالة الولاية، مرجع مذكور، ص17.
[xi]– الكلينيّ، محمد بن يعقوب: الكافي، مرجع مذكور، ج1، ص401.
[xii]– المجلسيّ، محمد باقر: بحار الأنوار، مرجع مذكور، ج2، ص183.
[xiii]– المجلسيّ، محمد باقر: بحار الأنوار، مرجع مذكور، ج2، ص71.
[xiv]– الكلينيّ، محمد بن يعقوب: الكافي، مرجع مذكور، ج1، ص401.
[xv]– الحرّ العاملي، محمد بن حسن: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مرجع مذكور، ج27، ص204.
[xvi]– المجلسيّ، محمد باقر: بحار الأنوار، مرجع مذكور، ج46، ص240.
[xvii]– الطباطبائي، محمد حسين: رسالة الولاية، مرجع مذكور، ص21.
[xviii]– الطوسّي، أبو نصر السرّاج: اللّمع، مرجع مذكور، ص44.
[xix]– الخميني، روح الله: معراج السالكين، ترجمة: عباس نورالدين، بيت الكاتب للطباعة والنشر، بيروت، 2009م، ط1، ص16.
[xx]– العجم، رفيق: موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي، مرجع مذكور، ص497.
[xxi]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج2، ص562.
22- الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص344.
[xxiii]– القشيري، أبو القاسم: الرسالة القشيرية، مرجع مذكور، ص118.
[xxiv]– الطوسّي، أبو نصر السرّاج: اللّمع، مرجع مذكور، ص43.
[xxv]– المجلسيّ، محمد باقر: بحار الأنوار، مرجع مذكور، ج1، ص97.
[xxvi]– المرجع نفسه، ج1، ص97.
[xxvii]– سورة النجم، الآية11.
[xxviii]– سورة الشعراء، الآية193.
[xxix]– سورة الشرح، الآية1.
[xxx]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص347.
[xxxi]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص354.
[xxxii]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص346.
[xxxiii]– سورة النور، الآية35.
[xxxiv]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع سابق، ص357.
[xxxv]– المازندراني، محمد صالح: شرح الكافي: الأصول والروضة، المكتبة الإسلاميّة، طهران، 1424ق، ط1، ج2، ص70.
[xxxvi]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج2، ص562.
[xxxvii]– المرجع نفسه، ص563.
[xxxviii]– سورة الشورى، الآية11.
[xxxix]– سورة الشورى، الآية11.
[xl]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج2، ص563.
[xli]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج2، ص563.
[xlii]الكاشاني، عبد الرزاق: اصطلاحات الصوفيّة، مرجع مذكور، ص161.
[xliii] العجم، رفيق: موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي، مرجع مذكور، ص784.
[xliv]– راجع:
Chodkiewicz, m, un ocean sans ravage, ibn arabi, le livre et la loi, la librairie du 20 siecle, seuil, 1992, p159.
[xlv]– الخميني، روح الله: الأربعون حديثًا، مرجع مذكور، ص30.
[xlvi]– القيصري، داود: شرح فصوص الحكم، مرجع مذكور، ج1، ص124.
[xlvii]– أي علم العرفان والتصوّف.
[xlviii]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج2، ص162.
[xlix]– الذين لا يعتقدون برسالات السماء، والتشريعات الإلهيّة.
[l]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج2، ص162.
[li]– القيصري، داود: شرح فصوص الحكم، مرجع مذكور، ج1، 123-124.