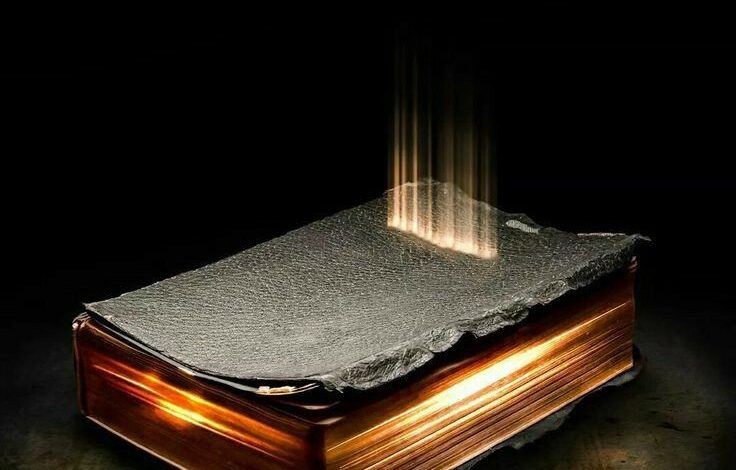
العلم والمعرفة في العرفان النظري
د. فادي ناصر
أستاذ الفلسفة والدراسات الإسلاميَّة في جامعة المعارف – لبنان.
1. مكانة المعرفة عند العارف
الإنسان كائنٌ عاقلٌ ومفكّرٌ، يدرك بوجوده الذهني الأمور الخارجيّة المنفصلة عنه إدراكًا حقيقيًّا وواقعيّاً، لا وهميًّا واعتباريًّا، فتترتّب عليه الآثار الواقعيّة في الخارج. هذا النشاط الفكري الّذي يتفرّد به الإنسان، والّذي ولد معه ورافقه عبر الأزمنة والعصور، دفعه مع الوقت ليتأمّل أكثر فأكثر، ويبحث في خصائص هذه القدرة الفريدة الّتي بواسطتها استطاع أن يعرف الموجودات الخارجيّة من حوله، وتمكّن من الاستفادة منها وتسخيرها والحكم عليها. وما زاد من سعي الإنسان لمعرفة خصائص هذه القدرة هو وقوعه في الأخطاء، وعدم الاهتداء دائمًا إلى الواقع الصحيح. فبدأ بطرح الأسئلة حول حقيقة هذه القوّة المفكّرة والعاقلة، وحول الوجود الذهني الّذي من خلاله يدرك ويعرف ويميّز ويحكم. وحول العناصر الّتي تتألّف منها، والّتي تمكنّه من أداء دورها بشكل سليم، والموازين الصحيحة الّتي تمنعها من الانحراف عن جادة المعرفة الواقعيّة. ومن لوازم البحث حول هذه القوة العاقلة والمفكّرة عند الإنسان، كان لا بدّ من البحث أيضاً حول نتائج هذا النشاط الذهني المتميّز وما يتولّد عنه، وهو ما يُسمّى بـ “المعرفة”.
إذًا، يمكن أن نقول إنّ الحراك العقلي والفكري عند الإنسان دفعه على مرّ التاريخ ليبحث حول هذه الأداة المعرفيّة وما ينتج عنها من معارف وعلوم. ثم توسّع البحث لاحقًا وأخذ النقاش يدور حول أدوات المعرفة الإنسانيّة الأخرى، ليسأل أكثر عن طبيعة هذه الأدوات، ليعرف ما إذا كانت محصورة بهذه القوّة العاقلة أم أنّه هناك أدواتٌ أبعادٌ أخرى. ومن ثمّ انسحب السؤال مجدّدًا حول النتاج المعرفي لهذه الأدوات المعرفيّة، ليسأل أيضًا عن طبيعتها وحدودها وقدرتها على كشف الواقع ومعرفة الحقيقة.
إذن الإنسان بطبعه وأصل خلقته ووجدانه الذاتي يميل على الدوام للبحث عن المعرفة والحقيقة. وحبّه للعلم حبّ جبلّي نابع من أصل خلقته وهندسته الوجوديّة. فقولنا إنسان يعني كائن ومخلوق باحث عن المعرفة، لا بل محبّ ومتعطّش للعلم والمعرفة. وهذا أمرٌ بديهيٌّ يدركه كلّ إنسان ويمارسه عن وعي أو غير وعي. وما هذا التطوّر البشري المذهل في كافّة المجالات والحقول، منذ الإنسان الأوّل وإلى يومنا هذا، إلّا مؤشرًا على هذا الحبّ والميل والسعي الدؤوب عنده نحو تحصيل المعرفة والعلم أكثر فأكثر. ويشرح الإمام الخميني (قده) حقيقة هذه التوجّهات الإنسانيّة الفطريّة نحو العلم والمعرفة فيقول: “يتَّضح هذا بالرجوع إلى فطرة الإنسان حيث إنّ البشر يعشقون الكمال المطلق كما ذكرنا سابقًا، وينفرون من النقص. وحيث إنّ العلم متساوٍ مع الكمال المطلق، فالعشق للكمال عشق للعلم، وهكذا الجهل توأم للنقصان. بالإضافة أيضًا إلى أنّ العلم نفسه بشكله العام، مورد تعلّق الفطرة، والجهل مورد نفورها كما يظهر من الرجوع إلى فطرة البشر. غاية الأمر وجود اختلاف في تشخيص العلوم، وهذا الاختلاف في تشخيص العلوم هذا الاختلاف أيضاً من احتجاب الفطرة، وإلا فالعلم المطلق مورد عشق الفطرة وتعلّقها”[i]. فالإنسان بحسب الرؤية العرفانيّة طالب للمعرفة بالفطرة وأصل الخلقة الإنسانيّة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال سلب هذه الخاصّيّة عنه، إلا إذا وقعت الفطرة في الاحتجاب، عندئذ يسود الجهل كما يقول الإمام الخميني(قده): “إن العلم من لوازم الفطرة، بمعنى أنّ الفطرة إن لم تكن محجوبة، ولم تدخل في حجاب الطبيعة، فستتوجّه إلى المعرفة المطلقة، وإذا احتجبت، فبمقدار احتجابها، تتأخر عن المعرفة، إلى أن تصل إلى مقام تكون فيه جهولة مطلقاً”[ii].
المعرفة كما يُعرّفها الجرجاني في تعريفاته هي” إدراك الشيء على ما هو عليه”[iii]. وقد ذُكِرت لها أيضًا معانٍ واستعمالاتٌ عديدة تعود بمجملها إلى الإدراك؛ سواء أكان إداركًا مطلقًا أم مقيّدًا. فقد تطلق المعرفة ويراد منها العلم، أي الإدراك مطلقًا؛ تصوّرًا كان أم تصديقًا. وقد تُطلَق ويُراد منها الإدراك البسيط؛ سواء أكان تصوّرًا للماهيّة أم تصديقًا لها. وبهذا المعنى يصبح متعلّق المعرفة هو الأمر البسيط الواحد، ومتعلّق العلم هو المركّب المتعدّد. وقد تُستخدَم المعرفة أيضًا بمعنى الإدراك الجزئي؛ سواء أكان مفهومًا جزئيًّا أم حكمًا جزئيًّا، والإدراك الكلي؛ سواء أكان أيضًا مفهومًا كليًّا أم حكمًا وتصديقًا كليَّيْن.
ومن معاني المعرفة واستخداماتها أيضًا الإدراك الأخير من الإدراكَيْن لشيء واحد، إذا تخلّل بينهما عدم، بأنْ أدرك أوّلًا، ثمّ ذهل عنه، ثمّ أدرك ثانيًا. ومن معانيها أيضًا الإدراك الّذي يلي الجهل، ويعبّر عنه بالإدراك المسبوق بالعدم. ومن معانيها أيضًا العلم الّذي لا يقبل الشك، وهو المعنى المستخدم عند المتصوّفة. ومن معاني المعرفة المستخدَمة؛ الإدراك الحاصل بواسطة الحواس. وتُستعمَل أيضًا بمعنى الذكر والتذكّر المقابل للغفلة، والعلم المطابق للواقع، والعلم الحاصل من الاستدلال والبرهان، والعلم الحاصل من الكشف والشهود. وتُستعمَل بمعنى الظهور؛ أي ظهور الشيء للنفس، وغيرها من المعاني والاستخدامات الّتي ذكرت للمعرفة[iv].
هذا التنوّع والاختلاف في معاني المعرفة يرجع إلى الاختلاف في استعمالاتها. لذا يعتبر صاحب كشاف اصطلاحات الفنون أنّ الاستعمال، وليس الوضع، هو السبب في تعدّد معاني المعرفة، وأنّ المعنى الأساس للمعرفة هو؛ الإدراك المطلق من أيّ قيد، حيث قال: “اعلم أنّ الجمهور على أنّ المعتبَر في المعرفة التعيين عند الاستعمال دون الوضع، فعرّفوا المعرفة بما وُضع ليُستعمل في شيء بعينه، أي متلبَّس بعينه أي في شيء معيّن من حيث أنّه معيّن”[v].
وذكر أيضًا أنّ كل التعبيرات الّتي تذكر على أساس أنّها تعريف للمعرفة، إنّما هي من قبيل شرح الاسم، أو تعيين لبعض مصاديق المعرفة الّتي يتناولها أحد العلوم، كما قال: “وليست المعرفة موضوعة لواحد منها وإلّا لكانت في غيره مجازًا، ولا لكلّ واحد منها وإلّا لكانت مشتركة موضوعة أوضاعًا بعدد الأفراد. وأيضًا لا قدرة على وضعها لأمور متعيّنة لا يمكن ضبطها وملاحظتها حين الوضع، فوجب أن تكون موضوعة لمفهوم كلّي شامل لكلّ الأفراد، ويكون الغرض من وضعها له استعمالها في أفراده المعيّنة دونه، فما سوى العلم معارف استعماليّة لا وضعيّة، فالشيء المذكور في التعريف أعمّ ممّا وضع اللفظ المستعمل فيه له”[vi].
وبالعودة إلى المعرفة الّتي هي موضوع علم المعرفة، فقد تؤخذ بأيّ معنى من المعاني المذكورة، وذلك تابع للتعيين والاستعمال. ولكن لمّا كانت دراسة مسائل المعرفة غير مختصّة بنوع خاص منها، لذا كان من الأفضل أن يكون المقصود هو المعنى الأعمّ المساويَ لمطلق العلم. وبناءً عليه، يمكن أن نعرّف علم المعرفة بأنّه؛ “ذلك العلم الّذي يبحث حول معارف الإنسان، ويقيّم ألوانها، ويعيّن الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها”[vii].
أما في علم العرفان، فالعرفان كما ذكرنا سابقاً ليس مجرّد سلوك عملي يعتمد على المجاهدات الروحيّة والعبادات، والبرامج المعنويّة الخاصّة من أجل الوصول إلى المعرفة بالحقّ تعالى، بل العرفان أطروحة علميّة ومعرفيّة كاملة أيضًا. هو سلوكٌ فرديٌّ واجتماعيٌّ ورؤية معرفيّة في آن.
والعرفاء كغيرهم من روّاد المعرفة، يسعون بدورهم إلى تكوين رؤية معرفيّة خاصّة بهم حول الوجود والكون والإنسان، وبالتّالي تقديم أطروحة لحلّ المعضلات والمشكلات العلميّة الّتي تعاني منها الإنسانيّة، وتعترض طريقها نحو اكتشاف هويّة الوجود والعالم، ومعرفة علّة الخلق الحقيقيّة والتامّة، وأهداف هذه العلّة وصفاتها، وبالتالي الوصول إلى برّ الأمان والطمأنينة على المستويَيْن العقلي والقلبي معًا.
لقد أوْلى العرفاء اهتمامًا خاصًّا بالعلم والمعرفة، وهذا ظاهر للعيان في كتبهم العرفانيّة، خصوصًا النظريّة منها. فإذا عدنا إلى أمّهات كتب العرفان النظري، وجدناها قد أفردت بحوثًا مستقلّة حول العلم والمعرفة، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على محوريّتهما وأهميّتهما الفائقة في بنيان المدرسة العرفانيّة.
وهنا ندخل لنسأل بشكل مباشر عن مسألة مُهمّة في طريق بحثنا حول المعرفة العرفانيّة، وهي قيمة المعرفة في مدرسة العرفان النظري. ومعنى البحث عن قيمة المعرفة هو البحث عن اعتبارها أو عدم اعتبارها من الناحيتَيْن النظريّة والعمليّة.
أما البحث عن قيمتها النظريّة فبمعنى كاشفيّتها عن الواقع، وأنّها ليست خيالات وأوهام كاذبة من قبل العقل والنفس، وبالتّالي يصح الاعتقاد بها والتعويل عليها، ممّا يفتح الباب على مصراعَيْه أمام البحث النظري العلمي، وأمام عمليّة التعلّم والتعليم. أمّا البحث عن قيمتها العمليّة فبمعنى كشفها عن الحسن والقبح، وترتيب الأثر العملي عليها، وبالتالي تشييد صرح القوانين والنظم العمليّة الفرديّة والاجتماعيّة.
وعند الحديث عن المنظومة المعرفيّة لعلم العرفان النظري، هنالك سؤالٌ يُطرَح حول سبب الاعتماد على كلمة “المعرفة” بدل “العلم” في مُسمّى وعنوان هذا العلم. فالعرفان – كما ذكرنا سابقًا على المستوى اللّغوي – استقى اسمه من المعرفة؛ حيث تبيّن أنّ العرفان من المعرفة، والمعرفة من الإدراك والعلم. فأُطلِق لفظ العارِف على كلّ من يطلب هذا النوع الخاصّ من العلم، ويتحقّق به، ولم يُطلَق عليه اسم العالِم. ومن المهمّ أيضًا قبل البحث في خصائص المعرفة العرفانيّة، أن نفهم إن كان هنالك مائزٌ وفارقٌ بين العلم والمعرفة في مدرسة العرفان النظري، لنسأل عن معنى المعرفة والعلم بالمنظور النظري للعرفان، وعن حقيقة الفرق بينهما؟ وهل يختلف رأي العارف عن اللّغوي والنحوي في هذا الشأن؟ وما هو مصدر كلٍّ من العلم والمعرفة في حال تمايزهما عن بعضهما؟ وهل أحدهما أعلى منزلة وأشرف رتبة من الآخر؟ أم أنّ الاختلاف بينهما مجرّد اختلاف شكلي ولفظي؟
العلم الّذي يختصّ به العارف مشتقٌّ من المعرفة لا العلم، والعرفاء خصّوا أنفسهم بنعت المعرفة، ونسبوا العلم إلى ما عداهم من الناس. وقد وقع الاختلاف اللّفظي في بيان الفرق بين العلم والمعرفة، وهما عند اللّغويّين غيرهما عند المتصوّفة والعرفاء.
وقد بينّا في الباب الأوّل من هذا البحث معنى العلم والمعرفة من منظور أهل اللّغة. أمّا العرفاء فقد تحدّثوا في كتبهم عن العلم والمعرفة ضمن العديد من المواضيع وتحت عناوين مختلفة، وميّز كثيرٌ من المحقّقين بين المعرفة والعلم، على الرغم من وجود تقارب كبير بينهما من حيث المعنى، فاتّفقوا أحيانًا واختلفوا أخرى في بيان الفارق بينهما، وإن كان الجميع قد أجمع على أنّ المعرفة من العلم، وأنّها أخصّ منه. وبناءً على هذا التمييز، اختلفت مكانة كلٍّ من “المعرفة” و”العلم”، ومنزلتهما عند العرفاء. ففي الوقت نفسه الّذي نجد فيه من يفاضل المعرفة على العلم، نلاحظ فئة أخرى منهم تفاضل العلم على المعرفة، وتعتبره أشرف رتبة.
2. أقوال العرفاء في العلم والمعرفة
فيما يلي سوف نذكر نبذة من أقوال العرفاء بشأن العلم والمعرفة، والفوارق الأساسيّة بينهما، وقد اقتصرنا على بعضهم منعًا للإطالة والإسهاب.
أ. المعرفة عند محي الدّين بن عربي:
تحدّث محي الدّين بن عربي عن حقيقة العلم والمعرفة، والعلاقة بينهما، في العديد من كتبه، خصوصًا في كتاب “الفتوحات المكيّة”، وكتاب “مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم”. حيث بيّن مكانة ومنزلة كلّ من العلم والمعرفة، وقال بوجود فوارق عديدة وجوهريّة بينهما منها: أنّ المعرفة من أسماء العلم، ولكنها تختصّ بالأحديّة، والأحديّة من أشرف صفات الواحد، بينما يتعلّق العلم، بالأحديّة أحيانًا، وبغيرها أحيانًا أخرى.
فالمعرفة متعلّقها الحقيقي والأساسي هو الوحدة والأحاديّة، أمّا العلم فمتعلّقه يشمل الأحديّة وغيرها، لذا كانت المعرفة أخصّ من العلم. كما قال في الفتوحات المكّية: “وخصّه (الشارع) باسم “عرفة” لشرف لفظة المعرفة الّتي هي العلم. لأن المعرفة في اللّسان الّذي بعث به نبيّنا (ص) تتعدّى إلى مفعول واحد: فلها الأحديّة. فهي اسم شريف سمّى الله به العلم. فكانت المعرفة علمًا بالأحديّة. والعلم قد يكون تعلّقه بالأحديّة وغيرها بخلاف لفظ المعرفة”[viii].
ونراه في موضع آخر من الكتاب، وخلال ذكره لمقام المعرفة، يصف المعرفة بأنّها نعتٌ إلهيٌّ ليس للفظها عين في الأسماء الإلهيّة، وأنّها “أحديّة المكانة”، ولا تطلب غير الواحد والتوحيد كما قال: “اعلم أنّ المعرفة نعتٌ إلهيٌّ، لا عين لها في الأسماء الإلهيّة من لفظها، وهي أحديّة المكانة، لا تطلب إلّا الواحد”[ix].
وكمثالٍ على هذا الفارق والمائز بين العلم والمعرفة، إدراكنا لقضية “زيد قائم”. حيث يمكن أن يتصوّر الموضوع والمحمول في هذه القضيّة على نحوَيْن: الأوّل ندرك فيه “زيدًا” لوحده و”قائمًا” لوحده، والثاني ندرك النسبة بين زيد وقائم؛ أي نسبة القيام. فتعلّق العلم بزيد والقيام كلٌّ على حدة هو غير تعلّقه بنسبة القيام إلى زيد. ويُسمّى الأوّل عند ابن عربي “معرفة” لتعلّقه بأمر شخصي وواحد، والثاني “علمًا” لتعلّقه بأمر نسبيّ، إضافة إلى الأمر الشخصي[x].
كما ميّز ابن عربي أيضًا بين العلم والمعرفة، فجعل مقام المعرفة ربانيًّا، ومقام العلم إلهيًّا. وإذا حصل تداخل أو خلط بينهما، فالنزاع والاختلاف لفظيٌّ لا أكثر. فالقائل بمقام المعرفة إذا سئل عنه، أجاب بما يجيب به المخالف في مقام العلم، فوقع الخلاف في التسمية لا في المعنى. واستدلّ على ذلك بالعديد من الشواهد القرآنيّة، فقال في معرض استدلاله: “وعمدتنا[xi] قول الله تعالى: ﴿وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ من الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من الْحَقِّ﴾[xii]، فسمّاهم عارفين وما سمّاهم علماء. ثمّ ذكر ذكرهم فقال: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنا﴾، ولم يقولوا إلهنا آمَنَّا، ولم يقولوا علّمنا، ولا شاهدنا، فأقرّوا بالاتّباع: ﴿فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾، وما قالوا نحن من الشاهدين، وقالوا: ﴿وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَما جاءَنا من الْحَقِّ وَنَطْمَعُ﴾، ولم يقولوا ونقطع، ﴿أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا﴾ ولم يقولوا إلهنا، ﴿مع القوم﴾ ولم يقولوا مع عبادك الصالحين، كما قال الأنبياء. فقال الله لهذه الطائفة الّتي تكون صفتهم هذه: ﴿فَأَثابَهُمُ الله بِما قالُوا جَنَّاتٍ﴾[xiii]، محل شهوات النفوس فأنزلناهم حيث أنزلهم الله”[xiv].
ويطلق ابن عربي – مثله مثل سائر العرفاء – على العلم الخاص بأهل العرفان اسم “المعرفة”، ويعدّها طريقًا واضحة وممهّدة للكشف، ويؤكد أنّ هذا النوع من العلم لا يرقى إليه شكّ ولا شبهة. ويسلم دليله من القدح وصاحبه من الحيرة. ويحصل بفعل العمل والتقوى والسير والسلوك. وهو طريق صحيح وواضح ومحلّ ثقة واطمئنان، على عكس طريق الفكر الّتي لا يسلم من الخطأ كما يقول: “المعرفة عند القوم محجّة، فكل علم لا يحصل إلّا عن عمل وتقوى وسلوك فهو معرفة؛ لأنه عن كشف محقّق لا يدخله الشبه، بخلاف العلم الحاصل عن النظر الفكري، لا يسلم أبدًا من دخول الشبه عليه والحيرة فيه والقدح في الأمر الموصل إليه”[xv].
ب. المعرفة عند الكاشاني:
الكاشاني – في شرحه لكتاب “منازل السائرين” – يشرح معنى المعرفة والعلم من منظوره المعرفي والعرفاني، ويميّز بينهما على أساس إدراك الشيء من خلال ذاته، وإدراكه من خلال أمر زائد على ذاته. فيقول في تعريف المعرفة أنّها إدراك الشيء من خلال الإحاطة بعينه وذاته، لا بصورة زائدة عليه تتوسّط بينه وبين العلم به. أمّا العلم فهو إدراك الشيء من خلال صورة زائدة عليه، لا بنفس ذاته. فالمعرفة عنده حالة جزئيّة إن صحّ التعبير، يدرك بواسطتها الإنسان أمرًا واحدًا متعيّنًا بذاته، فيتّحد كلا طرفَيْ الإدراك في المقام – أي المدرِك والمدرَك – اتّحادًا اندماجيًّا، فيدرك بشكل أحادي وشخصي، بخلاف العلم الّذي هو إدراك بتوسط وسائط مختلفة، وبالتّالي فإنّ جهة الأحاديّة والشخصيّة غير متحقّقة فيها.
قال: “المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو، أي إدراك لحقيقة الشيء بذاته وصفاته على ما هو عليه بعينه، لا بصورة زائدة مثله. هذا إدراك العرفان، واحترز عن إدراك العلم بقوله: بعين الشيء، فإنّ العلم إدراك الشيء بصورة زائدة مثله في ذات المدرِك، كما رسمه الحكماء بأنّه حصول صورة الشيء في النفس. فالمعرفة اتّحاد العارف بالمعروف، بكونهما شيئًا واحدًا، أو كون ذات المعروف في العارف، فلا تعرف الشيء إلّا بما فيك منه أو بما فيه منك، فالمعرفة ذوقٌ، والعلم حجابٌ”[xvi].
ج. المعرفة عند حيدر الآملي:
يرى الآملي أنّ السبب في تمايز العلم عن المعرفة مرجعه إلى أنّ المعرفة لا تحصل إلّا بالعلم، لأنّ صاحب المعرفة إذا أراد أن يعرف أمرًا ما فإنّما يعرفه بحكم من أحكام العلم وصفة من صفاته، فيكون القدر الحاصل من المعرفة إنّما حصل بالعلم لا بغيره[xvii]. فالمعرفة تُطلَق على معنيَيْن، كلّ واحد منهما نوعٌ من العلم، والعلم جنسٌ لهما؛ أحدهما العلم بأمر باطن يستدلّ عليه بأمر ظاهر، وثانيهما العلم بأمر كان مشهورًا ومعروفًا لديك في السابق. كما إذا رأيت شخصًا كنت قد رأيتَه من قبل، فعلمتَ أنّه هو نفسه ذلك الشخص الّذي عرفته سابقًا. فهو نوع من التذكّر لمعرفة سابقة منسيّة أو مغفول عنها. يقول الآملي:
“وقد عبّر عن الفرق بين العلم والمعرفة، وبين العالم والعارف بعض العارفين بعبارة لطيفة، وهي قوله: المعرفة أخصّ من العلم لأنّها تطلق على معنيين كلّ منهما نوع من العلم: أحدهما: العلم بأمر باطن يستدلّ عليه بأثر ظاهر، كما إذا توسّمتَ شخصًا فعلمت باطن أمره بعلامة ظاهرة منه. ومن ذلك ما خوطب به رسول الثقلَيْن عليه أفضل الصلوات في قوله تعالى: ﴿فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ﴾[xviii]. وثانيهما: العلم بمشهود سبق به عهد، كما إذا رأيت شخصًا كنتَ رأيتَه قبل ذلك بمدّة، فعلمت أنّه ذلك المعهود فقلت: عرفته بعد كذا سنة عهدته. فالمعروف، على المعنى الأوّل غائب، والمعروف على المعنى الثاني، شاهد”[xix].
فالمعنى الأوّل للمعرفة يشير إلى الجنبة الباطنيّة للإدراك، والّتي يُستدلّ عليها من خلال الجنبة الظاهريّة. والمعنى الثاني يشير إلى التذكّر بعد النسيان والغفلة، وهذا ما يحدث بعد حصول اليقظة عند الإنسان. وبناءً على هذا الفهم، سُمِّي العارف عارفًا لأنّه عرف ربّه بعد نسيان وغفلة عنه، لا بعد جهل به.
فالمعرفة في العرفان هي نوعٌ من الرجوع واليقظة والتذكر، لحقيقة ثابتة، ولعلم سابق بعد الغفلة عنه، أو غيبته عن الذهن. وهذا العلم عندهم هو التوحيد الّذي فطر الإنسان عليه، كما ورد في تفسير الإمام الصّادق (ع) لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى﴾[xx]، قلت: “معاينة كان هذا؟ قال: نعم، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف، وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه، فمنهم من أقرّ بلسانه في الذرّ ولم يؤمن بقلبه، فقال الله: ﴿فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾”[xxi].
وبهذا يتّضح أنّ تلك المعرفة الأولى الحقّة المعبّر عنها بالعلم البسيط، ليست من نتاج الإنسان وإبداعه، وإنّما هي فيض وعطاء إلهيّ خالص. لذا قال الإمام الصّادق (ع): “ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه”، فهي معرفة مخلوقة مودعة في قلب الإنسان. وعليه، تكون المعرفة بالمعنى الثاني هي تذكّر العلم السابق بعد غيبته عن الذهن، أو لنَقُل هي إدراك الشيء ثانيًا بعد توسّط نسيانه. فالمعرفة هي تجلّي العلم السابق بالخروج من عالم الغفلة، والدخول في عالم اليقظة. فيكون محصّل المعرفة هو حصول اليقظة بعد الغفلة والنسيان.
2. علاقة العلم بالمعرفة
أ. المعرفة سرّ العلم:
بعد جملة الآراء الّتي أوردناها حول أقوال العرفاء بشأن المعرفة والعلم، يمكن أن نستنتج بشكل واضح أنّ عمدة الفرق بينهما مع أنّ كليهما من أنواع الإدراك، أنّ أحدهما أخصّ من الآخر. فالمعرفة أخصّ من العلم، مع أنّ كليهما من أفراد ومصاديق الإدراك. والمعرفة علمٌ بعين الشيء مفصّلٌ عمّا سواه، أمّا العلم فالعلم به مجملٌ ومفصّلٌ. ومعنى معرفته مفصّلٌ أي مميَّزٌ عمّا سواه، أو متميّزٌ عن غيره. فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فكلّ معرفة هي علم، وليس كل علم معرفة. وإنّما بعض العلم معرفة، فعلم الله تعالى ليس معرفة، ولذا لا يُسمّى الله تعالى عارفًا وإنّما يُسمّى عالمًا.
فالمعرفة لأنّها علم بالجزئيّات، والعلم هو إحاطة بالجزئيّات والكليّات، لأنّ المعرفة أيضًا كما بيّنا سابقًا هي تذكّر علم سابق بعد نسيانه والغفلة عنه، والعلم بأمر باطن يستدلّ به على أمر ظاهر. ولأنّ المعرفة هي في الحقيقة علم بالأحديّة والتوحيد، وما يتعلّق بهذه المعرفة التوحيديّة من مسائل، ويتفرّع عنها من لوازم؛ من العلم بالحقائق والأسماء الإلهيّة، والعلم بتجلّي الحقّ في الأشياء، والعلم بالخطاب الإلهي لعباده بلغة الشرائع، والعلم بالكمال والنقص في الوجود، والعلم بحقيقة النفس الإنسانيّة، وبأمراضها وعللها، وكيفيّة مداواتها، وغيرها من المعارف والعلوم المرتبطة بالنظرة التوحيديّة للوجود والعالم الّتي يعتقد بها العارف، ويؤمن بها، ويسعى إلى مشاهدتها والاستدلال عليها، وترسيخ قواعدها وأسسها في فكره وعقله وقلبه وسرّه، والتي تُدرَك عند العارف من خلال ما يُسمّى عنده بالمعرفة، وهي التي يكون موضوعها هو التوحيد ولوازم التوحيد.
فلهذه الأسباب وغيرها كانت المعرفة عند العارف بمثابة “سرّ العلم”، ومراده بسرّ العلم أي أسرار المعرفة بالتوحيد كما يصرّح القونوي: “وسرّ العلم هو معرفة وحدته في مرتبة الغيب، فيطّلع المشاهد – الموصوف بالعلم بعد المشاهدة بنور ربّه- على العلم ومرتبة وحدته بصفة وحدة أيضًا كما مرّ، فيدرك بهذا التجلّي النوري العلمي من الحقائق المجرّدة ما شاء الحقّ سبحانه أن يريَه منها ممّا هي في مرتبته أو تحت حيطته”[xxii]. وهذا ليس تقليلًا من شأن العلم، على العكس، فالمعرفة لا تحصل بالأصل من دون العلم، والعارف “إنّما يعرف بحكم من أحكام العلم، وصفة من صفاته، حكمًا آخر أو صفة أخرى من أحكام العلم أيضًا وصفاته، فيكون القدر الحاصل من المعرفة بالعلم إنّما حصل به – أي بالعلم – لا بغيره”[xxiii]. وإنّما من باب إعطاء كلّ ذي حق حقّه، ومجاله المعرفي إن صحّ التعبير، ولكون العلم أعمّ من المعرفة كما بينّا.
وفي المحصّلة، كلّ ما يصل إليه المرء بالمعرفه سوف يكون للعلم فيه نصيبٌ حتمًا. فالتوحيد الذي يقع من خلال المعرفة هو أيضًا من نصيب العلم. فالعالم إذا أصبح موحّدًا إنّما يصبح موحّدًا من جهة المعرفة، ومن حيث هو عارف، كما يقول ابن عربي:” واعلم أنّ العارفين هم الموحّدون والعلماء، وإن كانوا (العلماء) موحّدين فمن حيث هم عارفون، إلّا أنّ لهم – أي العلماء – علم النسب، فهم يعلمون علم أحديّة الكثرة وأحديّة التمييز، وليس هذا لغيرهم”[xxiv].
فالعارف هو صاحب المعرفة، والمعرفة في المدرسة العرفانيّة هي صفة من عرف الحقّ بأسمائه وصفاته، فوحّده وصار فانيًا فيه. وهذه الحال هي الّتي تُسمّى “معرفة” كما يقول القشيري في رسالته: “المعرفة على لسان العلماء هي العلم، فكلّ علم معرفة، وكلّ معرفة علم، وكلّ عالم بالله تعالى عارف، وكل عارف عالم. وعند هؤلاء القوم – العرفاء والصوفية – المعرفة صفة من عرف الحقّ سبحانه بأسمائه وصفاته، ثمّ طال بالباب وقوفه، ودام بالقلب اعتكافه، فحظي من الله تعالى بجميل إقباله، وصدق الله تعالى في جميع أحواله، وانقطعت عنه هواجس نفسه، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره، فإذا صار من الخلق أجنبيًّا، ومن آفاق نفسه بريًّا، ومن المساكنات والملاحظات نقيًّا، ودامت في السرّ مع الله تعالى مناجاته، وحقّ في كلّ لحظة إليه رجوعه، وصار محدّثًا من قبل الحقّ سبحانه بتعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره، ويُسمّى عند ذلك عارفًا، وتُسمّى حالته معرفة”[xxv].
إذًا، في مدرسة العرفان النظري، لا تصحّ المعرفة إلّا بالتوحيد[xxvi]. فالمعرفة في العرفان هي نحو خاص من العلم الّذي يوصل إلى المعرفة التوحيديّة بالحقّ تعالى. والعلم هنا هو نور من أنوار الله تعالى، يقذفه في قلب من أراد من عباده. قال الله تعالى: ﴿أَوَ مَنْ كانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُورًا يَمْشي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها﴾[xxvii]. وهو معنى قائم بنفس العبد، يطلعه من خلاله على حقائق الأشياء، وهو للبصيرة كنور الشمس للبصر، بل أتمّ وأشرف.
فهذا النحو من العلم في المدرسة العرفانيّة هو عين النور الّذي لا يدرك شيء إلّا به، ولا يوجد أمر من دونه، ولشدّة ظهوره لا يمكن تعريفه؛ إذ من شروط المعرِّف أن يكون أجلى من المعرَّف وسابقًا عليه، وما ثمّة ما هو أجلى من العلم ولا سابق عليه إلّا غيب الذات، الّتي لا يحيط بها علم أحد غير الحق تعالى. وحصول هذا النور الّذي هو المعرفة بالتوحيد، لا يحصل للإنسان إلّا من خلال العود والرجوع إلى الله تعالى. “ولهذا أمر تعالى عباده أن يقولوا: ﴿رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا﴾[xxviii]، وقال في جوابه لهم: ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾[xxix]، ليعرفوا أنّ حصول هذا النور موقوفٌ على عودهم ورجوعهم إلى ما ورائهم، الّذي هو المبدأ الحقيقيّ والمعاد الأصليّ”[xxx]. وهذا النور الهدف الأساسي منه معرفة الحقّ ورؤيته على مستوى التوحيد. وهو وإن لم يكن عند البعض على نوع واحد ومرتبة واحدة، لكن تبقى خصوصيّة هذا النور أنّه يُري الحق ويوصل إليه مباشرة. ففي “قلب المؤمن ثلاثة أنوار: نور المعرفة ونور العقل ونور العلم. فنور المعرفة كالشمس، ونور العقل كالقمر، ونور العلم كالكوكب. فنور المعرفة يستر الهوى، ونور العقل يستر الشهوة، ونور العلم يستر الجهل. فبنور المعرفة يرى الحقّ، وبنور العقل يقبل الحقّ، وبنور العلم يعمل بالحقّ”[xxxi].
ب. شرافة توحيد العالم على توحيد العارف:
في النظرة الأوليّة، عندما نتفحّص الواقع من حولنا، نلاحظ بشكل ملفت تقدّم مقام العارف على مقام العالم في أذهان الناس وعقولهم. فأكثرهم يعتقد أنّ العارف أعلى مقامًا وأشرف رتبة من العالم. وهذه الرؤية، وهذا الفهم، سائدٌ حتى في أوساط البيئة العلميّة والفكريّة، وليس عند عوام الناس فقط. والسؤال الّذي يَطرح نفسه بعد بيان الفوارق الأساسيّة بين العلم والمعرفة: هل هذه الرؤية السائدة صحيحة أم إنّ فيها نقصًا ما ينبغي تداركه كي لا نقع في المحذور؟ ومرادنا بالمحذور هنا تقديم الفاضل على المفضول، وبالتّالي ضياع الأولويّات، وتشويه المسار المنهجي والهدفي لطريق العلم والتعلّم، والّذي يوصل إلى المعرفة الواقعيّة التي يريدها الله حقًّا ولا يريد سواها.
فالدخول في إرداة الله ومعاينة ما يريده حقًّا ليس بالأمر السهل أو البسيط، بل يحتاج إلى بصيرة خاصّة، ومعرفة دقيقة بالتشريع الإلهي، وبغايات التشريع ومقاصده الحقيقيّة. وهذا لا يتيسّر إلّا لمن طوى كشحًا عن نفسه، وفني بالكامل في إرادة ربّه، فلا يعاين ولا يشاهد إلّا ذاته المقدّسة وأسماءه وصفاته، فلا يرى إلّا حقًّا، وإذا رأى خلقًا فإنّما يراه من حيث هو تجلٍّ ومظهر للحقّ، ولا يراه مستقلًّا بنفسه، ولا بنحو منقطع عن ربّه.
من هنا، وبعد بياننا للفوارق الأساسيّة بين العلم والمعرفة، ندخل لنبحث أكثر في عمق المسألة، لكي نعرف أي نوع من نوعَيْ الإدراك أعلى شأنًا ومنزلة من الآخر من وجهة الرؤية والمنهجيّة العرفانيّة نفسها. ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال، سوف نعتمد بالدرجة الأولى على القرآن الكريم، من جهة لتعذّر تناول كلّ المصادر منعًا للإطالة، ومن جهة أخرى لكون القرآن هو المصدر الأوّل الّذي إذا استدلّ به وتكشّفت بواسطته الحقائق، أصبح كلّ ما عداه ثانويًّا وهامشيًّا.
من خلال تتبّعنا للآيات الكريمة الورادة في القرآن الكريم، نلاحظ أنّ الله تعالى قد فرّق بين العارفين والعلماء بما وصفهم به، وميّز بعضهم عن بعض. فالعلم صفة الله في القرآن، والمعرفة ليست صفته. فيقال في الحقّ إنّه عالم ولا يقال فيه عارف. وقد أثنى الله تعالى بالعلم على من اختصّه من عباده أكثر ممّا أثنى به على العارفين، ومدح من قامت بهم صفة العلم ووصف بها عباده كما وصف بها نفسه في أكثر من موضع من الكتاب العزيز كقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ﴾[xxxii]، فأخبر تعالى أنّ العلماء هم الموحّدون حقيقة، والتوحيد أشرف مقام ينتهي إليه الإنسان، وليس وراءه مقام.
وقال جلّ ثناؤه في صاحب موسى (ع): ﴿آتَيْناهُ رَحْمَةً من عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ من لَدُنَّا عِلْمًا﴾[xxxiii] ولم يقل عرّفناه. وما صدر من لدنه كان علمًا لا معرفة، وهو صادر من مقام الرحمة أيضًا. والعالم كما يقول الله تعالى صاحب خشية: ﴿إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ﴾[xxxiv]، وهو عند الله أيضًا صاحب الفهم بآيات الله وتفاصيلها لقوله: ﴿وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُون﴾[xxxv]، وقوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم﴾[xxxvi].
فالعالم هو ذو المعرفة الراسخ الثابت، الّذي لا تزيله الشبهات، ولا تزلزله الشكوك، لتحقّقه بما شاهد من الحقائق بالعلم. والعلماء هم الذين علموا بحقائق الأمور قبل وجودها، وأخبروا بها قبل حصول أعيانها، كما قال تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَني إِسْرائيلَ﴾[xxxvii].
والعلم هو الصفة الشريفة الّتي أخبر الله تعالى نبيّه محمّدًا (ص) بالزيادة منها، فقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْني عِلْمًا﴾[xxxviii]، ولم يقل له ذلك في غيرها من الصفات. وعندما شاء الله تعالى أن يربّيَ الإنسان الكامل بعلمه الخاصّ المسمّى بعلم الأسماء والصفات الإلهيّة قال: ﴿وَعَلَّم آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها﴾[xxxix]، ولم يقل عرّف. ولصفة العالم شرفٌ كبير وعظيم، حيث إنّ الله تعالى مدح بها أهل خاصّته من أنبيائه، ثم منّ سبحانه تعالى على العلماء ولم يزل مانًّا، بأنْ جعلهم ورثة الأنبياء، كما روي عن النبي الأكرم محمّد (ص) أنّه قال: “العلماء ورثة الأنبياء”[xl]، ولم يقل العرفاء ورثة الأنبياء.
هذه الشواهد من الآيات والروايات وغيرها أيضًا تكشف عن علوّ مكانة العلم وشرافته، بل ويذهب ابن عربي في كتاب “الفتوحات المكيّة” وكتاب “مواقع النجوم” إلى اعتبار المعرفة أقلّ رتبة من العلم، وأنّ مقام العارف أدنى من مقام العالم. فهو يرى أنّ العارف في سيره المعنوي والمعرفي يبقى لديه نوع من الاثنينة الخفيّة، ولا يصل إلى التوحيد الخالص والمجرّد عن كلّ تعيّن نفسي إلّا إذا كان متحقّقًا بمقام العلم الحقيقي، فيصبح بالتالي عالمًا حقيقيًّا. ويستدلّ على ذلك بالعديد من الشواهد القرآنيّة، مستنتجًا منها بقاء شيء من محوريّة النفس وأحوالها عند العارف الموحّد بخلاف العالم الموحّد الّذي يصفه بالصدّيق، ويعتبر توحيده أعلى مقامًا من توحيد العارف.
ويستشهد ابن عربي بآية من القرآن الكريم نزلت في حقّ من تحقّقوا بمقام المعرفة؛ أي معرفة الحق، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ من الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من الْحَقِّ﴾[xli] ولم يقل علموا، فوصفهم الله تعالى بوصف المعرفة، وفيه إشارة واضحة إلى أنّ المخاطبين في هذه الآية هم أهل المعرفة لا العلم. وتظهر الآية – بحسب رأي ابن عربي – أنّ الله تعالى ما سمّى عارفًا إلّا من كان له حظّه من الأحوال؛ البكاء، ومن المقامات؛ الإيمان بالسماع لا بالأعيان، ومن الأعمال؛ الرغبة إليه سبحانه والطمع في اللحوق بالصالحين، وأن يكتب مع الشاهدين وطلب الثواب كما في قوله تعالى: ﴿رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدين(83) وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحين(84) فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنين﴾[xlii]. وطلب هذه الأحوال والمقامات والأعمال عند أهل التوحيد ينافي التوحيد الحقيقيّ الصرف، ويتعارض مع مقام الفناء الوجودي والنفسي التامّ في الحقّ. فأحوال النفس كالبكاء، وطلب الثواب، والطمع في أن يكون المرء مع الشهداء والصالحين، كلّها مقامات أدنى من مقام الصدّيقين الّذي يكون عنوانه التحقّق بالشيء لا مجرّد الإيمان به، وترك الرغبة، وطلب العوض والأجر على العمل، وعدم الطمع بأيّ شيء سوى وجه الله الكريم وذاته المقدّسة. وقد ورد ترتيبهم في القرآن الكريم بعد النبيّين مباشرة، كما في قوله تعالى: ﴿فَأُولئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفيقًا﴾[xliii].
أمّا الشهداء الذين طلب أهل المعرفة أن يلحقوا بهم ﴿رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدين﴾[xliv]، فهم أقلّ درجة من مقام الصدّيقين؛ لأنهم يطلبون العوض عن أعمالهم. وهذا يعدّ من السيّئات عند الصدّيقين على قاعدة: “حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين”[xlv]، كما يقول ابن عربي: “ثمّ لتعلم أنّ الشهداء الذين رغب العارف أن يلحق بهم، هم العاملون على الأجرة وتحصيل الثواب، وأنّ الله عزّ وجل قد برّأ الصدّيقين من الأعواض وطلب الثواب، إذ لم يقم بنفوسهم ذلك، لعلمهم أنّ أفعالهم ليست لهم أن يطلبوا عوضًا، بل هم العبيد على الحقيقة والأجراء مجازًا. قال عزّ وجل: ﴿وَالَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُون﴾[xlvi]، ولم يذكر لهم عوضًا عن عملهم إذ لم يقم لهم به خاطر أصلًا لتبرئتهم من الدعوى. ثمّ قال: ﴿وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُم﴾[xlvii]، وهم الرجال الذين رغب العارف أن يلحق بهم، ويرسم في ديوانهم، وقد جعلهم تعالى في حضرة الربوبيّة، ولم يشترط في إيمان الصدّيقين السماع كما فعل بالعارفين، حكمة منه سبحانه أن نتعلّم الأدب”[xlviii]. ويصل ابن عربي في تقديمه لمقام العلم على المعرفة إلى وصف العارف بوصف غريب، ولكنّه بالغ الدلالة على عمق الفكرة التي يريد أن يكشف اللّثام عنها، والّتي يعدّ اكتشافها لطفًا إلهيًّا خاصًّا به، فيصف العارف الموحّد بأنّه ساحة شهوة، ولكنّها نوع من الشهوة المحمودة. أمّا العالم الموّحد فهو منزّه عن هذه الشهوة لفنائه التامّ في الحقّ وذهوله بالكامل عن نفسه. قال: “ثمّ انظر بعين البصيرة أدب رسول الله (ص) أين جعل العارف حيث جعله الحقّ فقال: “من عرف نفسه عرف ربه”، ولم يقل علم. فلم ينزله عن حضرة الربوبيّة، ولا عن حضرة نفسه الّتي هي صاحبة الجنّة. كما قال: ﴿وَفيها ما تَشْتَهيهِ الْأَنْفُس﴾[xlix]، فالعارف صاحب الشهوة المحمودة، تربيه بين يديّ العالم الصدّيق”[l]. فالعالم عند ابن عربي إلهي والعارف رباني.
وعلوّ درجة العلم عند ابن عربي لا يعني سقوط المعرفة عن مقامها الشامخ، وهي الّتي ارتبطت على الدوام بأشرف الموضوعات والغايات، من التوحيد بشكل أساسي، إلى معرفة الحقّ والتحقّق بأسمائه وصفاته ومشاهدة تجلّياته، وغيرها من الموضوعات العرفانيّة الّتي لا نجد لها حيّزًا ووجودًا سوى في مدرسة المعرفة العرفانيّة. بل يشير ابن عربي إلى مسألة مُهمّة وملفتة جدًّا عندما يفرّق بين توحيد العالم وتوحيد العارف، فيعتبر مقام التوحيد وإن كان هدفًا أساسيًّا للعارف، لكنّه في الحقيقة لن يصل إلى أعلى درجات التوحيد الحقيقي إلّا من بوابة العالم المتألّه، الّذي يرى أنّ علامته الأساسيّة هي أنّه يرى الوحدة في عين الكثرة، والكثرة في عين الوحدة؛ أي يرى المجمل والمفصّل والكلّي والجزئي معًا. ليكون العالم الموحّد؛ عارفًا في نهاية المطاف، وليس كلّ عارف موحّدًا؛ عالمًا. وإذا تحقّق عارف ما من هذا المقام التوحيدي الشامخ، فجمع بين الوحدة والكثرة، فهو قد تمكّن من ذلك من حيث هو عالم لا من حيث هو عارف، كما يقول ابن عربي:
“اعلم أنّ العارفين هم الموحّدون والعلماء، وإن كانوا – العلماء – موحّدين فمن حيث هم عارفون، إلّا أنّ لهم – أي العلماء – علم النسب، فهم يعلمون علم أحديّة الكثرة وأحديّة التمييز، وليس هذا لغيرهم. وبتوحيد العلماء، وحّد الله نفسه، إذ عرف خلقه بذلك. ولمّا أراد الله سبحانه أن يصف نفسه لنا بما وصف به العارفين من حيث هم عارفون، جاء بالعلم، والمراد به – أي بالعلم – المعرفة، حتّى لا يكون لإطلاق المعرفة عليه تعالى حكم في الظاهر، فقال: ﴿لا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ﴾[li]. فالعلم هنا بمعنى المعرفة لا غير. فالعارف لا يرى إلا حقًّا وخلقًا، والعالم يرى حقًّا وخلقًا في خلق، فيرى ثلاثة؛ لأنّ الله وتر يحبّ الوتر. فهو مع الله على ما يحبّه الله مع الكثرة، كما ورد أنّ لله تسعة وتسعين اسمًا، مئة إلّا واحد. فإنّ الله وتر يحبّ الوتر فما تسمّى إلّا بالواحد الكثير لا بالواحد الأحد”[lii].
أمّا عن سبب تقديم البعض في عرفهم العامي وحتّى العلمي أحيانًا للمعرفة على العلم، وفي استخدام عنوان العارف على الموحّد وليس العالم، فيرجع إلى أمرَيْن أساسيّيْن:
الأوّل: الغيرة. فالعرفاء غلبت عليهم الغيرة على طريق الله، لمّا شاعت صفة العلم، وأطلقت على طائفة من العلماء المنكبّين على الدنيا وشهواتها، والمتورّط بعضهم في الشبهات، بل المحرّمات أحيانًا باتّباعهم للأهواء وسلاطين الجور والحكام، فغدوا بعيدين كلّ البعد عن صفات العالم الأساسيّة، ليس لديهم منها إلّا صورتها وشكلها الخارجي، فناقضت أفعالهم أقوالهم، وعمّروا بذلك دنياهم، وخرّبوا آخرتهم. فلمّا رأى العرفاء “أنّ المقام العالي الّذي حصل لهم ولساداتهم، كان أولى باسم العلم وصاحبه بالعلم كما سمّاه الحقّ، فأدركتهم الغيرة أن يشاركهم البطّال في اسم واحد فلا يتميّز المقام، ولا يقدرون على إزالته من البطال لإشاعته في الناس، فلا يتمكّن لهم ذلك، فأدّاهم الأمر إلى تسمية المقام معرفة وصاحبه عارفًا، إذ العلم والمعرفة في الحدّ والحقيقة على السواء، ففرّقوا بين المقامَيْن بهذا القدر، فاجتمعا والحمد لله في المعنى، واختلفا في اللفظ”[liii].
والثاني: الجهل بمقام العلم؛ فالجهل بحقيقة مقام العلم وعظمته وعلوّ شأنه عند الله تعالى، كان سببًا أساسيًّا لتقديم المعرفة على العلم عند البعض، متمسّكين بمقولة إنّ العلم هو الحجاب الأكبر. ولكن لابن عربي تفسير آخر لهذه المقولة، فيوافق عليها، ولكن يعدّها حجابًا يحجب القلب عن الغفلة، والجهل عن أضداده، مستغربًا في المحصّلة النهائية من هذه الرؤية غير المنصفة لمقام العلم والعلماء، متسائلًا: “فلأيّ شيء يا قوم ننتقل من اسم سمّانا الله تعالى به ونبيّه إلى غيره، ونرجّحه عليه ونقول فيه عارف وغير ذلك. والله ما ذاك إلّا من المخالفة الّتي في طبع النفس، حتّى لا نوافق الله تعالى فيما سمّاها به، ورضيت أن تقول فيه عارف، ولا تقول عالم. نعوذ بالله من حرمان المخالفة”[liv].
[i]– الخميني، روح الله: جنود العقل والجهل، تعريب: أحمد الفهري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1422ق/2001م، ط1، ص257.
[ii]– المرجع نفسه، ص258.
[iii]– الجرجانيّ، عليّ بن محمّد: معجم التعريفات، مرجع مذكور، ص185.
[iv]– التهانوي، محمد علي: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف: رفيق عجم، تحقيق: علي دحروج، ترجمة: جورج زيناتي، مكتبة لبنان، بيروت، 1996م، ط1، ج2، ص1583.
[v]– المرجع نفسه، ص1586.
[vi]– التهانوي، محمد علي: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مرجع مذكور، ج2، ص1587.
[vii]– المصباح، محمد تقي: المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، مرجع مذكور، ج1، ص141.
[viii]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج1، ص636.
[ix]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج1، ص297.
[x]– المرجع نفسه، ص636.
[xi]– في أن مقام المعرفة ربانيّ، ومقام العلم إلهيّ.
[xii]– سورة المائدة، الآية83.
[xiii]– سورة المائدة، الآية85.
[xiv]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع سابق، ج2، ص 318-319.
[xv]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج2، ص297.
[xvi]– الكاشاني، عبد الرزاق: شرح منازل السائرين، تحقيق: محسن بيدارفر، منشورات بيدار، قم، 1385ش/1427ق، ط3، ص762.
[xvii]– انظر: القونوي، صدر الدين: إعجاز البيان في تفسير أمّ القرآن، تقديم وتصحيح: جلال الدين الآشتياني، مؤسسة بوستان كتاب، قم، 1423ق/1381ش، ط1، ص50.
[xviii]– سورة محمد، الآية30.
[xix]– الآملي، حيدر: المقدّمات من كتاب نصّ النصوص، مرجع مذكور، ص269.
[xx]– سورة الأعرارف، الآية172.
[xxi]– المجلسيّ، محمد باقر: بحار الأنوار، مرجع مذكور، ج5، ص237.
[xxii]– القونوي، صدر الدين: إعجاز البيان في تفسير أمّ القرآن، مرجع مذكور، ص54.
[xxiii]– القونوي، صدر الدين: إعجاز البيان في تفسير أمّ القرآن، مرجع مذكور، ص50.
[xxiv]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج4، ص55.
[xxv]– القشيريّ، أبو القاسم: الرسالة القشيريّة، مرجع مذكور، ص342.
[xxvi]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص582.
[xxvii]– سورة الأنعام، الآية122.
[xxviii]– سورة التحريم، الآية8.
[xxix]– سورة الحديد، الآية13.
[xxx]– الآملي، حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار، مرجع مذكور، ص580.
[xxxi]– المرجع نفسه، ص584.
[xxxii]– سورة آل عمران، الآية18.
[xxxiii]– سورة الكهف، الآية65.
[xxxiv]– سورة فاطر، الآية28.
[xxxv]– سورة العنكبوت، الآية43.
[xxxvi]– سورة آل عمران، الآية7.
[xxxvii]– سورة الشعراء، الآية197.
[xxxviii]– سورة طه، الآية 114.
[xxxix]– سورة البقرة، الآية31.
[xl]– الكلينيّ، محمد بن يعقوب: الكافي، مرجع مذكور، ج1، ص32.
[xli]– سورة المائدة، الآية83.
[xlii]– سورة المائدة، الآيات 83-85.
[xliii]– سورة النساء،الآية 69.
[xliv]– سورة المائدة،الآية83.
[xlv]– المجلسيّ، محمد باقر: بحار الأنوار، مرجع مذكور، ج25، ص205.
[xlvi]– سورة الحديد، الآية19.
[xlvii]– سورة الحديد، الآية 19.
[xlviii]– ابن عربي، محي الدين: مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم، المكتبة العصرية، بيروت،لاتا، لاط، ص33.
[xlix]– سورة الزخرف، الآية 71.
[l]– ابن عربي، محي الدين: مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم، مرجع سابق، ص33-34.
[li] – سورة الأنفال، الآية60.
[lii]– ابن عربي، محي الدين: الفتوحات المكيّة، مرجع مذكور، ج4، ص55.
[liii]– ابن عربي، محي الدين: مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم، مرجع مذكور، ص33-34.
[liv]– المرجع نفسه، ص28-29.





