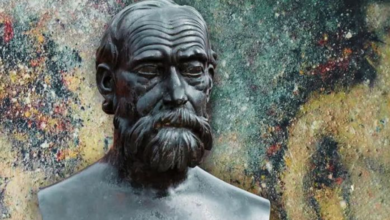هل يحتاجُ العلم إلى الدين؟
روجر تريغ
السؤال عن احتياج العلم إلى الدين يبدو مدهشاً وشاقَّاً إشكاليَّاً في الوقت نفسه، فهو سؤالٌ غير مألوفٍ ضمن مناخٍ معرفيٍّ وثقافيٍّ يتموضع العلمُ فيه مكانةً مرجعيَّة. فقد بات يشكِّل منظومةً مُغلقةً ويَفترضُ أنّ كلَّ الواقع يقعُ ضمن قبضته؟
بما أنّ العلم ـ حسب البروفسور روجر تريغ أستاذ الفلسفة في جامعة وارويك ـ ينأى عن الاستقلاليَّة ويتولَّى منهجُه تعريفَ العقلانيَّة، فإنَّه يستندُ إلى فرضيَّاتٍ كُبرى. يُمكننا أن نُسلِّم جدلاً بوجود الطبيعة المنظّمة في العالم المادِّيّ، وقدرة العقل البشريِّ على إدراكها، إلاَّ أنَّ الإيمان بالله يُوضِّحُ هذه الطبيعة وذلك من خلال الاحتجاج بعقل الخالق.
هذه المقالة تضيء على جملة إشكاليَّاتٍ في هذا الصدد.
المحرِّر
قد يبدو المفهوم الذي يُفيدُ أنَّ العلم ليس وافياً، وأنَّه ليس المثال الأسمى للعقل البشريِّ، غريباً في عيون كثيرٍ من الناس في مطلع القرن الحادي والعشرين. يعتقدُ هؤلاء أنَّ العلم بحدِّ ذاته هو مصدرُ المعرفة، وأنَّه المحدِّدُ لما يُمكن قبوله عقليَّاً، وبالتالي فهم يصرفون النَّظر تلقائيّاً عن إمكانيَّة ترجمة: هبة ناصر. احتياجه لتبريرٍ إضافيٍّ خصوصاً إذا كان هذا التبريرُ دينيّاً. لهذا السبب، غالباً ما يبدو العلم متيناً ومؤكَّداً، بينما يبدو أنَّ الإيمان الدينيَّ قد أخذ بالتراجع تزامناً مع نموِّ المعرفة العلميَّة. في بعض الأحيان، قام المؤمنون، وبالتعويل على عجزٍ مؤقّت للعلم، بتقديم تفسيرات لظواهر معيَّنة، ولكنّ هذه الاستراتيجيَّة تحفلُ بالمخاطر، حيث إنَّنا إذا لم نعرف السبب الكامن وراء شيءٍ محدَّد فهذا لا يعني أنَّ علينا الرجوع إلى الله باعتباره السبب الجليَّ له، فقد تكونُ المشكلة ناتجةً من جهلٍ مؤقّت من جهتنا، وهو ما أنتج فجوات عدَّة في الإيمان، وفي الحين الذي قام التقدُّم العلمي فيه بملء هذه الفجوات في معرفتنا ساهم في زوال هذه الأسباب التي أصبحت ركائز الإيمان، بالتالي، فإنَّ ما يُسمَّى بـ«إله الفراغات» هو إلهٌ في غاية التزعزُع ويُمكن التخلُّص بسرعةٍ من الحاجة إليه.
*نقلاً عن فصليَّة “الاستغراب” – العدد 13 – السنة الرابعة – خريف 2018.
قام ماثيو أرنولد بشكلٍ بارزٍ بتصوير تراجع الإيمان في قصيدته المشهورة تحت عنوان «شاطئ دوفر»، وذلك في منتصف القرن التاسع عشر (الذي نعتبره في وقتنا الحالي عصراً دينيّاً). يُشاهدُ الشاعرُ انحسارَ التيَّار فيصفه بـ«بحر الإيمان» مع «صوت هديره الكئيب، المتَّصل، المنسحِب». كثيراً ما تُقتَبَسُ هذه العبارة وما زال يتردَّدُ صداها. من السهل أن نعتقد بأنَّ العلمَ هو أحد العوامل الرئيسيَّة التي تسبَّبتْ بهبوطٍ قاسٍ ومتوقِّع في الإيمان الدينيِّ كانحسار البحر بعد ذروة المدّ. في الواقع، تحملُ الفكرة الاجتماعيَّة المتمثِّلة بالعَلْمَنة الدلالات نفسها، وتُفيدُ وجودَ ابتعادٍ «شبه قانونيٍّ» عن الإيمان والتوجُّه نحو النظر إلى العالَم بطريقةٍ تستغني عن الدين. وعليه، يبدو أنَّ العمليَّة التي تعني أنَّ الدين محكومٌ عليه بالتراجع إلى حدِّ الاندثار هي حتميَّة. من المؤكَّد أنَّ الانطباق الظاهريَّ لهذه الملاحظة على الوضع الحالي في أوروبا الغربيَّة لا يعني أنّه يعكسُ الواقع الاجتماعيَّ في أماكن أخرى من العالم حتَّى في الولايات المتَّحدة نفسها حيث يتمتَّعُ العلم الحديث بالتأثير.
هل يأخذُ العلمُ الفعلَ الإلهيَّ بعين الاعتبار، أو يعترفُ بجرَيان الإرادة الإلهيَّة؟ كثيراً ما يُعتقَد بأنَّ فهم العلم يكون وفق الشروط الخاصَّة به وأنّه لا يعتمدُ على أيِّ شيءٍ خارج ذاته. وفقاً لهذا الرأي، فإنَّ العلم هو أنقى تعبيرٍ عن العقل البشريِّ وتكمنُ وظيفتُه في إبعاد الخرافات والإيمان الأعمى عن الفرد. يُمثِّلُ هذا الاعتقاد تراثَ عصر التنوير الذي شهده القرن الثامن عشر، والذي يتّجهُ إلى رؤية العالَم كآليةٍ ماديَّةٍ مستقلّة، والعقل البشريِّ كمفتاحٍ لفهم طريقة عمل هذه الآليَّة. كانت أيُّ إشارة إلى الله تُعتبر أمراً فائضاً عن الحاجة في أفضل الأحوال، وهبوطاً إلى اللاَّعقلانيَّة في أسوأها، وقد سلّمتْ الحركةُ التنويريَّة جدلاً بقوّة العقل البشريِّ. رغم ذلك، لا يُمكن أن نفترض بسهولةٍ إمكانيَّة وجود العقل والحقيقة أو النظام والانسجام في العالَم الذي يستكشفُه العلم الطبيعيّْ. كثيراً ما اعتُبرت العقلانيَّة حقيقةً قُصوى، وفي بعض الأحيان كان الناس على وشك تأليهها كما حدث بعد الثورة الفرنسيَّة حينما تمَّ تحويل الكنائس إلى “معابد للعقل”، وقد بدا أنَّ العقلانيَّة والماديَّة مُتلازمتان إلى درجةٍ تقتربُ فيها «العقلانيَّة» من أن تكون مرادفاً للإلحاد.
ورغم نظرتهم إلى العالَم من الناحية الميكانيكيَّة، استطاع البشر الوقوف خارج الآليَّة لفهمها. في النهاية، إذا كان العقلُ بحدِّ ذاته نتيجةً لآليَّةٍ عرضيَّة – كآليَّة الساعة المعقَّدة – فلا يُمكننا ضمان أنَّ ما تمَّ اقتيادنا للاعتقاد به هو الحقيقة الحتميَّة. نحن نعتقدُ ببساطةٍ بما يتمُّ دفعُنا إلى الإيمان به سواءً وُجدت أسبابٌ وجيهةً لهذا الاعتقاد أم لا. إذا أخذنا نظريَّة التطوُّر على سبيل المثال، فإنَّه بالإمكان وفق مبدأ الانتقاء الطبيعيِّ أن نتطوَّر على نحوٍ يُخوِّلنا أن نحمل اعتقاداتٍ معيَّنة بشكلٍ طبيعيّْ. قد تكون بعض المعلومات مفيدةً وتُساعدنا في البقاء على قيد الحياة وتكثير النسل، ويحتجُّ بعضُ الناس بأنَّ المعتقدات الدينيَّة تندرجُ ضمن هذه الخانة. يكمنُ مقصد هذه الجدليَّة غالباً في التوضيح المنطقيِّ لسبب انتشار بعض المعتقدات رغم كونها باطلة، ويتطلّبُ التوضيح وضعَ الثقة في القوَّة المستقلّة للعقل البشريّْ.
شاع الإيمان بالعقلانيَّة العامَّة في ما يُسمَّى بـعصر الحداثة، ولكنَّها خضعتْ في السنوات الأخيرة لتحدِّي حركة «ما بعد الحداثة». كيف يُمكننا التيقُّن من امتلاكنا جميعاً القدرة نفسها على التعقُّل وإمكانيَّة الوصول معاً إلى حقيقةٍ ثابتةٍ لدى الجميع؟ تُنكرُ حركة «ما بعد الحداثة» هذه الفكرة، وتؤكِّد بدلاً من ذلك على وجود الاختلافات في التعاليم والحقبات. ما يعتبره الناس صحيحاً بنحوٍ جليٍّ في زمانٍ ومكانٍ معيَّن قد يختلفُ بشكلٍ جذريٍّ عن الفرضيَّات المثارة في زمنٍ آخر. لا وجود لعقلانيَّةٍ جامعة، أو محورٍ استدلاليٍّ مشترك لدى جميع البشر، أو حقيقةٍ موضوعيَّةٍ تثبُتُ من جيلٍ إلى آخر. تُساهمُ هذه التأكيدات (التي يبدو أنَّها بنفسها دعاوى على الحقيقة الموضوعيَّة) في تقويض الأساس المنطقيِّ التامِّ للعلم الطبيعيِّ. وعليه، لا يُمكن أن يُعتبر العلم بعد ذلك تطبيقاً منهجيَّاً للعقل البشريِّ بل مجرد نتيجة للآراء غير العقلانيَّة التابعة لتقليدٍ معيَّن. بالتالي، يُمكننا التطرُّق إلى العلم «الغربيِّ» أو العلم «الحديث» والاكتشافات التي ليست هي اكتشافاتٍ على الإطلاق بل مجردُ تطويرٍ للفرضيَّات المشروطة تاريخيّاً.
رحَّب البعض بطريقة قيام حركة ما بعد الحداثة بإفراغ ادِّعاءات العلم لأنَّهم اعتقدوا بأنَّ ذلك يفتحُ المجال أمام سير عمل الدين. إذا لم يستطع العلم ادِّعاء الحقيقة، فلا يُمكنه استبعاد الدين على أساس أنَّه باطل. يأتي هذا الاستنتاج بثمنٍ فادحٍ حيث لا يُعَدُّ العلم الطبيعيُّ عاجزاً فحسب بل أيضاً لا يُمكن للاعتقاد الدينيِّ حينئذٍ أن يدَّعي الحقيقة. إذا انتفى سبب الانشغال بالعلم، ينتفي كذلك سبب الالتزام الدينيِّ. وفقاً لهذا الرأي، ومع تدمير «العقل»، تتمثَّلُ النتيجة الوحيدة بالنظر إلى العلم والدِّين كحقلين إيمانيَّيْن مُختلفين ومُوجودَيْن في مقصورتين مستقلَّتين. لا يُمكن لأيٍّ منهما أن يُهاجم الآخر أو يدعمه أو يُصرِّح بشيءٍ يتّصلُ به، وعلى كلٍّ منهما أن يدع الآخر لشأنه.
قد يُرحَّب في بعض المواضع بهذا الانفصال بين الحقلين. يوجد عددٌ كبيرٌ من العلماء المستعدِّين للقبول بنصف القصَّة – أي أنَّ الدين والعلم لا يتعلَّقان بعضهما ببعض على الإطلاق – ويتردَّدون حيال الموافقة على فكرة ما بعد الحداثة التي تُفيدُ أنَّ العلم ليس نتاج العقل ولا يُمكنه ادِّعاء الحقيقة. تتمثَّل إحدى فرضيَّات العلم المثمَّنة في أنَّه إذا صحَّت ادِّعاءاتُ العلم، فإنَّها تصحُّ على الدوام، ويجري هذا الأمر سواءً كُنتَ في واشنطن أم بكين. تتعلَّقُ هذه الادِّعاءات بالقوانين المادِّيَّة التي تنطبقُ بالتساوي على هذا المكان والزمان، وسواءً كنتَ في طرف الكون أم في بداية الزمان.
الفصل بين العلم والدين
تبنَّى العالِم المتخصِّص في التطوُّر البيولوجيِّ ستيفن جاي غولد الفكرة التي سمَّاها «النطاقات غير المتداخلة» والتي تعني أنَّ الدين والعلم لديهما مجالات اهتمامٍ خاصَّة بهما، وأنّهما يختلفان ولا يتحاوران. بتعبيرٍ آخر، فإنَّ اللُّغة الدينيَّة لا تصفُ المعلومات كما يفعلُ العلم؛ فالعلم يُصرِّح بما يحدث وأمَّا الدين فيقومُ بشرح سبب حدوثه. لا يندرج العلم والدين في دائرة الكلام نفسها، ولا يُمكنهما أصلاً أن يتشاجرا بسبب اختلاف وظيفتيهما.
ينجذبُ إلى صورة الانفصال التامِّ بين العلم والدين أولئك الذين يودُّون إيقاف الدِّين عن التدخُّل بالعلم، ولكنّهم يحترمون حريَّة عمله في ميدانه الخاصِّ به. بهذه الطريقة، يتحرَّر العلم من الادِّعاءات المتسلِّطة التي تصدرُ عن أيِّ تسلسلٍ هرميٍ كنسيٍّ أو تفسيرٍ للإنجيل، ويبقى المنطق العلمي نائياً عن جميع الاعتبارات اللاَّهوتيَّة ويسلَم من الحاجة للخوض في مجابهاتٍ فوضويَّة مع الإيمان الدينيّْ. وعليه، يُمكن أن يذهب كلٌّ من العلم والدين في طريقه الخاصِّ. يتطابقُ هذا الأمر مع المحاولات الراهنة التي لا ترمي إلى الفصل بين الكنيسة والدولة فحسب، بل أيضاً لجعْل الدين مسألةً شخصيَّةً وخاصَّة وبعيدةً عن الدور الاجتماعيِّ العام الذي يلعبه العلم.
لا يحول فصلُ العلم عن الدين دون مشاجرتهما سوى نصف القصَّة. وفقاً لمفهوم ما بعد الحداثة، لا يُمكن لأيٍّ منهما أن يدّعي الأفضليَّة ولكنّ الكثير من العلماء لا يعتقدون بهذا المفهوم، ويعتبرون أنّ العلم يُمكنه أن يدَّعي الحقيقة من ناحيةٍ موضوعيَّة، وأن يُظهر الحقَّ لجميع الناس في كلِّ الأزمنة. ما زال العلم يُمثِّلُ التعبيرَ عن العقلانيَّة الإنسانيَّة، وبالتالي حتّى لو تمّ إبعاد الدين عن اتِّهامات البطلان الصريحة الموجَّهة إليه، ينبغي أن يُنظَر إليه على أنّه يجري في نطاقٍ لا تثبتُ فيه الحقيقة اللفظيَّة التي يدّعيها العلم الطبيعيّْ. يتحدَّث الدين عن «القيم» التي تتميَّز عن «المعلومات»، ويهتمُّ بالمعنى والهدف الَّلذين نُضفِيَهما على حياتنا، ولكن لا يُمكن فهمه على أنّه يضع نفسَه في موضع الخصام مع العلم. يُخبرنا العلم بالحقيقة وأمَّا الدين فإنّه يتعاملُ مع القضايا الشخصيَّة. بتعبيرٍ آخر، فإنَّ العلم موضوعيٌّ والدِّين ذاتيٌّ، والعلم نتاج العقل بينما الدين نتاج قدرةٍ غامضةٍ تُسمَّى «الإيمان». يُخبرنا العلم عن العالَم بينما يسمحُ الدين لكلِّ فردٍ منّا أبن يتوصَّل شخصيّاً إلى ما يهمُّه. يستطيعُ العلمُ أن يأخذ مكانَه في العالَم عموماً ولكنَّ الدين يُمثِّلُ مسألةً خاصَّة.
إذا كان العلمُ حاكماً على الحقيقة ولا يتعاملُ مع الحوادث غير الماديَّة، فإنّه يستبعدُ بطبيعته أيَّ إمكانيّةٍ لوجود التدخُّل الغيبيِّ والإلهيِّ في العالم المادِّيِّ (وبالتالي فإنَّه يستبعد الادِّعاءات الأساسيَّة للعقيدة المسيحيَّة المتمثِّلة بالتجسيد والقيامة). وعليه، فإنّ امتناع العلم عن التعاون مع الدِّين يؤدّي بشكلٍ حتميٍّ إلى الفكرة التي تُفيدُ بأنَّ الدين لا يُضيفُ شيئاً إلى فهمنا لعمليَّات العالم التي يستكشفها العلم. وفقاً لهذا الرأي، ينبغي أن تخضع المعرفة المقبولة لمعايير الاختبار العامَّة أي الملاحظة والقياس والتجربة، وقد جُعل العلم حاكماً على المعرفة المقبولة، واعتُبرت مناهجه مُحدِّدة للحقيقة. وعليه، فقد اعتقد مناصرو هذا المفهوم أنّ أيَّ أمرٍ يقعُ خارج نطاق العلم هو غير قابلٍ للإثبات.
يبعدُ هذا المفهوم قيد أُنملة عن النظرة الوضعيَّة التي تُفيدُ أنّ ما لا يمكن اختباره وإثباته علميّاً يفتقدُ للمعنى. كما عبّر آ.ج.آير في كتابه «اللُّغة والحقيقة والمنطق» فإنَّ «جميع القضايا التي تتضمَّن محتوى واقعيّاً هي فرضياتٌ تجريبية». وقد أسهب حول هذه النقطة مُصرِّحاً بأنَّ «كلَّ فرضيّةٍ تجريبيّة ينبغي أن تتَّصل بتجربةٍ واقعيّة أو ممكنة». وعليه، فإنّ العبارات الميتافيزيقيَّة التي تتجاوزُ التجربة هي خاليةٌ من المعنى حصراً، ولا تحظى بأيِّ محتوى. تمَّ التخلِّي عن مذهب “الوضعيَّة المنطقيَّة” منذ أمدٍ بعيد، ويعودُ ذلك جزئيّاً إلى عجز هذا المذهب عن التعامل حتَّى مع الوحدات النظريَّة في الفيزياء. رغم ذلك، ما زال تأثيره قائماً وخصوصاً حين التمييز بشكلٍ بسيطٍ بين المعلومات العلميَّة والعالم الضبابيِّ لردَّات الفعل الشخصيَّة تجاهها. يتعاملُ العلم مع ما هو «واقعيٌّ»، وبالتالي ينبغي استثناء الدين. وعليه، يجب ألاَّ يتعدَّى كلٌّ من العلم والدين حدودَ الآخر، وتُفيدُ الفرضيَّة غير المصرَّح بها بأنَّ الادِّعاءات العلميَّة تعتمدُ على المنطق بينما ينتمي الدين إلى مملكة اللاَّعقلانيَّة.
إنَّ العلم بطبيعته حقلٌ تجريبيٌّ ومنهجه هو المنهج التجريبيُّ من دون منازع. لم يكن العلم ليتقدَّم قط لو افترض الناسُ ببساطةٍ مفرطة أنَّه مع عدم توفُّر التفسير التجريبيِّ لأمرٍ محدَّدٍ، ينبغي أن يلجأ الفردُ إلى السِّحر أو ما وراء الطبيعة. يُركِّزُ العلمُ على العالَم المادِّيِّ، ويتوقَّع العثور على تفاسيرٍ ماديةٍ ولكن قد يعني هذا أنّه ينظرُ إلى العالم كمنظومةٍ مُغلَقة ومستقلّة. مع ظهور فيزياء الكم، أدرك البشر أنّ هذا المفهوم هو تبسيطيٌ وأنّ هناك ثغرات أنطولوجيَّة على المستوى المجهريّْ. ولكن مع ذلك، يُعتَقَد ببساطةٍ أنَّ الحوادث غير المعلَّلة هي عشوائيَّةٌ على الدوام، ولا يُمكن تفسيرُها على ضوء أيِّ فاعلٍ خارجيّْ.
لقد حقّق المنهج العلميُّ بعض النتائج، وتراكمتْ معرفتنا بالعالم المادِّيِّ وعمليَّاته. وعليه، يبدو أنّ أيَّ لجوءٍ إلى الفاعل الغيبيِّ هو «غير علميّْ». ولكن ماذا نستنتجُ من ذلك؟ يفترضُ كثيرون أنَّ الحديث عن الله غير منطقيٍّ لأنَّ العقلانيَّة بتمامها تقعُ ضمن نطاق العلم. ولكنَّه مع ذلك قد يُظهرُ بالتوازي المحدوديَّات الداخليَّة للعلم لدى مواجهته لأبعاد الواقع التي تتجاوزُ العالم المادِّيَّ الطبيعيّْ.
قد يكونُ الامتناع عن افتراض وجود الكائنات غير الطبيعيَّة طريقاً لإحراز التقدُّم في العلم، ولكنَّ ذلك لا يعني عدم وجود تلك الكائنات أو انعدام التدخُّل الإلهيِّ في بعض الأحيان. لا ينبغي أن يلجأ أيُّ عالِمٍ إلى الخرافات، ولكنَّ ذلك لا يقتضي أن يكون العالَم المادِّيُّ قابلاً للتفسير وفق شروطه الخاصَّة فحسب من دون الإمكانيَّة المنطقيَّة المتمثِّلة بفاعلٍ خارجيّْ. حينما نظنُّ أنَّ العلم يستطيعُ تفسيرَ كلِّ شيء، فإنَّ أيَّ أمرٍ يقع خارج نطاقه يكون غير واقعيّْ. لا يستطيعُ العلم أن يتعامل مع الحوادث والكائنات غير المادِّيَّة. من المفارقات أن يكون العلم نتيجةً للعقل البشريِّ ولكنّه يتعاملُ مع مفهوم الذهن فحسب عبر اختزاله في أصوله المادِّيَّة. يُظهر هذا الأمر الحدود المحتملة للعلم كأسلوبٍ لاكتساب المعرفة، ولا يحولُ دون طرح مسألةٍ ما يُمكن أن يكون حقيقيّاً. من الأهميَّة بمكان أن نَفصل أسئلة الإبستمولوجيا (التي تعني الكيفيَّة التي نكتسب من خلالها المعرفة) عن الميتافيزيقا (التي تعني وجودَ ما يُمكن معرفته). لا ينبغي أن نفترض أبداً – من دون حجج إضافيَّة – أنَّ ما لا يستطيعُ العلمُ تفسيرَه لا يُمكن أن يكون موجوداً.
هل يحتاجُ العلم إلى الله؟
لا يُمكن للعلم أن يفرَّ من الفرضيَّات الفلسفيَّة التي تتناولُ الإطار الذي يضمُّ نشاطه الخاصَّ به. على سبيل المثال، يتحتَّم عليه افتراضَ وجودِ عالَمٍ واقعيٍّ يتمتَّع بطابعٍ معيَّنٍ، والعلم ليس منظومةً خياليَّةً مفصَّلة. مع ذلك، فإنَّ الفكرة التي تُفيدُ ضرورةَ عزله عن الفروع الأخرى من المعارف المشهورة ليست منطقيَّةً إلاَّ إذا أطلق الفردُ حكماً بأنَّ العلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، وأنّه لا تقع أيُّ حقيقةٍ خارج نطاقه. في اللُّغة الإنكليزيَّة، تمَّ تضييق نطاق الكلمة اللاَّتينيَّة الدالّة على المعرفة (Scientia) لتعني المعرفة التجريبيَّة فحسب، ويُرجّح أنَّ هذا يعكسُ افتراضاً عامّاً.
يُسلِّم كثيرون جدلاً بوظيفة العلم ولكنَّهم لا يُتعبون أنفسهم في التفكير بالافتراضات اللاَّزمة لتحقُّق هذه الوظيفة. ولكن ما الذي يُبرِّر افتراضنا بأنَّ الملاحظة، والتجربة، والهيكليَّة التامَّة للمعرفة الاختباريَّة تستندُ إلى أساسٍ صحيح؟ ما يُثير الدهشة هو أنَّ بعض الملاحظات أو الاختبارات هنا أو هناك تُعمَّم لتنال تطبيقاً عالميّاً. لا يُمكن للعلم أن يسير إلاَّ وفق الافتراض الذي يُفيدُ بأنَّ كلّ جزءٍ من الطبيعة يُمثِّلُ أجزاءً أخرى حتّى في أماكنٍ أخرى من الكون. كذلك، لا يُمكن للعلم أن يكتشف ما يُسمّى بـ«اطِّراد الطبيعة» لأنَّنا لا نستطيعُ الوصول إلاَّ إلى جزءٍ صغير من العالم المادِّيّْ. ولكن، رغم ذلك، نفترضُ أنَّ القوانين المادِّيَّة واسعةُ النطاق، وأنَّها تستطيعُ مساعدتنا في توقُّع ما لم يتحقَّق إلى حدِّ الآن. من خلال الاستقراء، نظنُّ على الدوام أنَّ باستطاعتنا الانتقال ممَّا اختبرناه إلى ما لم نختبره بعد، ومن المعلوم إلى المجهول.
لم يظهر العلم في العصر الحديث من فراغ. لماذا حلَّ التأكيد المعاصر على الاستدلال التجريبيِّ مكانَ الاتِّجاه السابق المتمثِّل بالاستدلال التخمينيّْ؟ بدلاً من تفسير الكيفيَّة التي ينبغي أن يكون عليها العالَم – ربَّما عبر علم الهندسة- أدرك العلماء أنَّ عليهم التحرِّي عن حقيقته الفعليَّة حيث تنامى الاعتراف بحدوث العالَم المادِّيّْ. نفى البعض أن تكون هناك حاجة لكي يخلق الله العالم بطريقةٍ معيَّنة. على سبيل المثال، اعتقد روبرت بويل أنَّ قوانين الطبيعة تعتمدُ كليّاً على إرادة الله الذي لا يُقيِّده أيّ شيءٍ خارج ذاته. استتبع ذلك ضرورة استخدام العقل البشريِّ لاكتشاف الكيفيَّة الفعليَّة لخلق الكون. ولكن هل تستطيعُ عقولنا فهم ذلك؟ يبدو أنَّه ليس هناك الكثير من المجال لكي نفترض أنَّ عقولنا الضعيفة هي مؤهَّلةٌ للشروع في هذه المهمَّة، ولن يكون هناك إذاً أيُّ يقينٍ بأنَّ العالَم يسيرُ بطريقةٍ مُنتظَمةٍ قابلة للفهم من حيث المبدأ.
لكي يكون العلم ممكناً، ينبغي أن يكون العالم مُنظَّماً للجرَيان بطريقةٍ دوريّةٍ وواضحةٍ ومفهومةٍ من قِبل الذهن البشريِّ على وجه الخصوص. لا ينبغي الإستهانة بهذه الأمور. في القرن السابع عشر، في عصر نيوتن وبويل، كان يُعتبر أنّ وجود الأنماط الأساسيَّة والنظام في العالم المادِّيِّ يعودُ إلى العقل الإلهيِّ، وأنّ الله هو مصدر وأساس كلّ أمرٍ عقليٍّ، لأنّ العالم قد خُلِق من قِبل عقلٍ إلهيٍّ، فإنّ النظام يُشكِّل أساسه. بالتالي فإنّ العالم يسري وفق إرادة الله على نحوٍ متوقَّعٍ ومُنتَظَم. بالفعل، فإنّ ورودَ ذِكر (Logos) في بداية إنجيل يوحنَّا وتحديد كون الله هو «لوغوس» يُشيرُ إلى أمرٍ أبعد من “الكلام والخطاب”. في الفلسفة اليونانيَّة، تُشيرُ كلمة “لوغوس” بحدِّ ذاتها إلى العقلانيَّة وإلى الوضوح الكامن في كلِّ شيء. وعليه، يُمكننا أن نتحدَّث عن البيولوجيا أي «اللوغوس» المتعلِّق بالحياة، وحتّى اللاَّهوت أي “اللوغوس” المتعلِّق بالله. اعتبر الناس أنَّ العقلانيَّة الكامنة في الأشياء والتي تعكسُ عقلَ الخالق تُساهِمُ أيضاً في جعل التأمُّل والاستكشاف العقليِّ أمراً ممكناً. يمتلكُ البشر القدرة على الاستدلال العقليِّ بسبب وجود بُنيةٍ منطقيّةٍ في العالَم، بالإضافة إلى ما اعتُقِد من أنّهم قد خُلقوا على صورة الله، وبالتالي فهم يشتركون بقدرٍ قليلٍ في عقلانيَّته.
نشأتْ بداياتُ العلم الحديث من الاعتقاد بوجود منطقٍ كامنٍ في الكون المادِّيِّ لأنّ خلقَه قد انبثق من مصدر المنطق برمَّته. إذا كان المنطق متغلغلاً في الكون ووُهبنا قسماً من ذاك المنطق، يُمكننا أن نفهم طريقة عمل الكون ولو بمقدارٍ ضئيلٍ. يُجيبُ الإطار اللاَّهوتيُّ عن سؤالين مهمَّين: لماذا نستطيع افتراضَ وجود النظام في العمليَّات الفيزيائيَّة – سواءً كانت مُحدَّدة بشكلٍ كليّ أم لا- وكيف يُمكن لأذهاننا أن تُدرك هذه العمليَّات؟ تَمثّلَ شعارُ مدرسة الفلاسفة وعلماء اللاَّهوت المعروفين باسم «أفلاطونيّي كامبريدج» – والذين كانوا مؤثِّرين في زمن تأسيس” الجمعيَّة الملكيَّة” بعد عصر عودة الملكيَّة- في أنّ «العقل شمعةُ الرب». لم يكن هناك مجالٌ لإعجاب الإنسان بذاته واعتبار نفسه سيّدَ الخلق، فعقلُه باهتٌ ومتأرجح ٌكالشمعة بالمقارنة مع نور حكمة الله. رغم ذلك، فإنَّ العقل يكفينا لكي نكتسب بعض المعرفة. اعتُبر أنَّه يوجدُ مجالٌ واسعٌ للخطأ والمعرفة الجزئيَّة، ولكنّ الإنسان قد خُلق على صورة الله، ويستطيعُ إحراز وميضٍ من الفهم عبر العلم والعمليَّات الأخرى التي يُجريها العقل البشريّْ. استناداً إلى هذا الرأي الذي يعتبرُ أنّ مصدر المنطق هو الله، فإنَّ العقل البشريَّ يلقى الدعم. بشكلٍ عام، اعتُبر أنَّ العقل يكشفُ عن أهداف الله كما الوحي الخاص الذي تتحدَّث عنه تعاليمُ الدين المسيحيّْ.
لقد استطاعت الحركة الأفلاطونيَّة في جامعة “كامبريدج” التعامل مع التعارض بين المعرفة المتذبذبة غير اليقينيَّة في الزمن والوقت الحالي، وبين المعرفة الكاملة في عالمٍ آخر. تنعكسُ تلك الحقيقة الأسمى في عالمنا المادِّيِّ، وبالتالي فإنَّ هذا العالَم ببُنيته ونظامه يستندُ في معناه إلى شكلٍ أعلى من الوجود.
على خلاف المفكِّرين في القرن التالي، فإنَّ الأفراد الذين مهَّدوا الطريق للعلم الحديث كانوا يحترمون العقل ويعتقدون أنَّ أهميَّته تكمنُ في صلته بعقل الخالق. قد لا يستطيعُ المنطق الإجابة عن جميع الأسئلة، ولكنّنا نستطيعُ الإعتمادَ عليه إلى حدٍّ ما لأنَّه قدرةٌ موهوبةٌ من الله. يُناقضُ هذا الرأي قطعاً أيّ إنكارٍ لقوّةِ العقل في مرحلة ما بعد الحداثة، ويُعارضُ أيضاً النظرة التي ظهرت في أواخر عصر التنوير والتي تُفيدُ لزومَ ربط العقل بالتجربة على نحوٍ يستبعدُ الغيب. على خلاف المعادلة التي تجمعُ بين المادِّيَّة والعقلانيَّة، اعتبر مؤسِّسو العلم الحديث أنّ التعقُّل بحدِّ ذاته يحتاجُ إلى إطارٍ خارقٍ للطبيعة، وقد منحهم إيمانهم بالله الثقة بإمكانيَّة فهم العالم الماديِّ بكلِّ تعقيداته ومداه الواسع. لا يقومُ العلم بتلخيص تجاربنا الماضية فحسب ولكنّه يهدف أيضاً إلى لفت أنظارنا إلى ما يُحتمل أن نختبره. بالتالي، فإنّ العلم يتولَّى التوقُّع بالإضافة إلى الوصف.
يُفيدُ الواقع التاريخيُّ بأنَّ العلم الحديث قد تطوَّر من عملية فهم العالم كخلق الله المنظَّم الذي يمتلكُ منطقاً متأصِّلاً، ولكنّ السؤال هو: هل يستطيعُ العلم أن يسير بثقةٍ بعد نبذه لجميع الفرضيَّات الإلهيَّة؟ لماذا يسيرُ العالَم بشكلٍ منتظَمٍ يسمحُ للعلم بإجراء تعميماتٍ وادِّعاءاتٍ عامّة حول طبيعة الواقع المادِّيّْ؟ لماذا يحظى العالم بمنطقٍ متأصّلٍ تستطيعُ عقولُنا إدراكه؟ كيف تستطيع الرموز الرياضيَّة المجرَّدة التي صنعها العقل البشريُّ أن تُعبِّر عن طريقة عمل العالم من دون اللُّجوء إلى الله باعتباره مصدر العقل وأساسه وخالق العالم بطريقةٍ منطقيَّة؟ يبدو أنّه ليس هناك مجالٌ لتقديم تعليلٍ خارجيٍّ للعلم، ولكن إذا تطلَّب الأمر القبول بهذا اللُّجوء وفق الشروط الخاصة به أو عدم القبول به كلياً، سوف يقومُ العديد من الناس برفضه تماماً، ولن يبدو أكثر من تحيُّزاتٍ ثقافيّةٍ لمجتمعٍ معيَّن في وقتٍ مُحدَّد.
هذا لا يُقيِّدُ فكرةَ العقلانيَّة وما هو متاحٌ للمنهج العلميِّ فحسب، بل ينزع أيضاً أيّ ثقةٍ بقدرة عقولنا على حلّ الألغاز الكامنة في العالم المادِّيِّ. يؤدِّي الفصل بين العلم والدِّين إلى إنكار تعاملهما مع العالَم نفسه، ولعلّه يُشيرُ أيضاً إلى أنّ الدين لا يصف الواقع على الإطلاق ولا يمتلكُ القدرة نفسها التي يمتلكها العلم على ادِّعاء الحقيقة.
إذا لم نأخذ العلم وفق تقييمه الخاصِّ (المفرط في ثقته)، ولم نسترسل في أيّ اهتماماتٍ فلسفيَّة حول أساسه المنطقيِّ، ينبغي أن نتلقَّف بجديّةٍ الحقيقة التي تُفيدُ بأنَّ الإيمان بالله الخالق قد قدَّم في الماضي قاعدةً راسخةً للإدراك العلميِّ، وأنَّ الرغبة بفهم آثار الله كانت حافزاً أساسيّاً للعلم.
لقد احتاج العلم إلى اللاَّهوت في القرن السابع عشر في زمن نيوتن وبويل إلاَّ أنَّ القرن الثامن عشر شهد اعتقاداً متنامياً بأنَّه يستطيعُ الاستمرار لوحده. بيد أنَّ الهجمات المعاصرة على فكرة العقلانيَّة «الحديثة» تشير إلى أنَّه لن يستمرَّ في الازدهار إذا افتقد إلى قاعدةٍ حقّة.