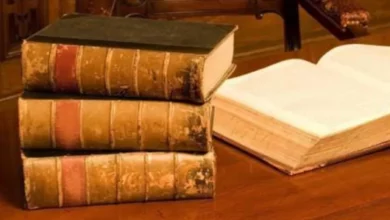تفسير صدر المتألهين لسورة (النور)
تفسير صدر المتألهين لسورة (النور)
تمهيد:
الإشارة في تحقيق هذه الآية يتمهد بأن لفظ “النور” ليس موضوعاً – كما فهمه المحجوبون من علماء اللسان وأصحاب الكلام – للعرض الذي يقوم بالأجسام، وهو الذي عرفوه بأنه “لا بقاء له زمانين” وهو من الحوادث الناقصة الوجود، بل هذا النور أحد أسماء الله تعالى، وهو منوِّر الأنوار، ومحقق الحقائق، ومظهر الهويَّات، وموجد الماهيات.
ومطلق “النّور” يحمل عند الجمهور على معاني كثيرة، بعضها بالاشتراك وبعضها بالحقيقة والمجاز، كنور الشمس، ونور القمر، ونور السراج، ونور العقل، ونور الإيمان، ونور التقوى، ونور الياقوت، ونور الذهب، ونور الفيروزج.
وأما عند الإشراقيين ومن تبعهم – كالشيخ المقتول شهاب الدين، الكاشف لرموزهم، والمخرج لكنوزهم، والمدون لعلومهم، والمبين لفهومهم، والمبرز لمقاماتهم، والشارح لإشاراتهم – فهو حقيقة بسيطة ظاهرة لذاتها مظهرة لغيرها، فعلى هذا يجب أن لا يكون لها جنس ولا فصل، لعدم تركبها من الأجزاء، فلا لها معرِّف حَدِّي، ولا لها كاشف رسمي، لعدم خفائها في نفسها، بل هي أظهر الأشياء، لكونها تقابل الظلمة والخفاء – تقابل السلب والإيجاب – فلا برهان عليه، بل هو البرهان على كل شيء.
لكن الخفاء والحجاب إنما يطرءان بحسب المراتب، كمرتبة النّور القيُّومي، لغاية ظهورها وبروزها، فإن شدة الظهور وغلبة التجلي ربما صارتا منشأي الخفاء للمتجلي لفرط الظهور، وعلى المتجلّي له لغاية القصور، كما يشاهد من حال عيون الخفافيش عند تجلي النور الشديد الحسي الشمسي على أحداقها، فإذا كان الحال هكذا في النور المحسوس، فما ظنك بالنور العقلي البالغ حدّ النهاية في الشدة والقوة.
وكان النور عند أكابر الصوفية أيضاً عبارة عن هذا المعنى – كما يستفاد من مصنّفاتهم ومرموزاتهم – إلاَّ أنّ الفرق بين مذهبهم ومذهب الحكماء الإشراقيين أنَّ النور وإن كان عند أولئك الأكابر حقيقة بسيطة، إلاَّ أنها مما يعرض لها بحسب ذاتها التفاوت بالشدة والضعف، والتعدد والكثرة بحسب الهيآت والتشخصات، والاختلاف بالواجبية والممكنية، والجوهرية والعرضيّة، والغنى والافتقار.
وأمّا عند هؤلاء الأعلام من الكرام، فلا يعرض لها في حدّ ذاتها هذه الأحكام، بل بحسب تجلِّياتها، وتعيناتها، وشؤوناتها، واعتباراتها، فالحقيقة واحدة، والتعدد إنَّما يعرض بحسب اختلاف المظاهر، والمرائي، والقوابل، ولا يبعد أن يكون الاختلاف بين المذهبين راجعاً إلى التفاوت في الاصطلاحات وأنحاء الإشارات، والتفنن في التصريح والتعريض منهم، والإجمال والتفصيل مع الاتفاق بينهم في الدعائم والأصول.
وما ذكره الشيخ محمد الغزالي في مشكاة الأنوار موافق أيضاً لقول أئمة الحكمة وهو قوله: “النور عبارة عمّا به تظهر الأشياء”.
تذكرة تفصيلية
إنَّ لقوله تعالى: {ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ} وجوهاً كثيراً من المعاني:
الأول: ما ذكره أكثر مفسري الإسلام وعلماء العربية والكلام – ومستندهم قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث يروى أنّه قرأ {ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ} – بصيغة الماضي – يعني: ذو نور السماوات وصاحب نور السموات – على مجاز الحذف، أو الحقُّ نورهما على سبيل التشبيه.
قال صاحب الكشاف: “شبهه بالنور في ظهوره وبيانه، كقوله تعالى: { { ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ } [البقرة:257] أي: من الباطل إلى الحق، وأضاف النّور إلى السماوات والأرض لأحد معنيين: إمّا للدلالة على سعة إشراقه، وفشوّ إضاءته حتى تضيء له السماوات والأرض، وإمّا أن يراد “أهل السماوات والأرض” وأنّهم يستضيئون به” – انتهى قوله -.
فعلى هذا يكون معنى قراءة صيغة الماضي: إن الله نشر الحق وبسطه في السماوات والأرض، أو نوَّر قلوب أهلها بنور الحق.
وفي هذا الوجه يكون المراد من “مثل نوره” صفة الحق العجيبة الشأن التي بثها الله في العالم، وهدى الخلق بها إلى طريق الخير، وتكون التشيبهات التي وقعت بـ “المشكوة” و “المصباح” و “الزجاجة” و “الزيت”، كلها لإثبات ظهور صفة الحق ووضوحها، كأنه قيل: الحق الذي به هدى النار كنور في سراج، اشتعل مصباحه بزيت صاف، كان في قنديل زجاجي شفَّاف في غاية اللطافة، بحيث يكون في لطافته وزهرته شبيهاً بإحدى الدراري المشهورة، كالمشتري والزهرة، وكانت الزجاجة، في كوَّة غائرة في جدار غير نافذة، حتى لا ينشر نور المصباح، فلا محالة يكون النور في غاية الإضاءة والظهور، فكذلك الحق المنبث في العالم المنتشر في الخلائق.
ولا يبعد أن يراد بالنور – في هذا الوجه – القرآن، لأنّه يبيّن الحق، يعني هدى الله الخلق بكلامه المتين الذي هو حق مبين، وقد سماه الله “نوراً” حيث قال: { وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً } [النساء:174]. لأنَّ القرآن مظهر نور الحق والعرفان، ومنوِّر قلوب أهل الإيمان، فيكون الحق نوراً والقرآن مثله، وقد شبه بـ “المصباح” فالمصباح كلام الله، و “الزجاجة” قلب العارف بأنوار معانيه، و “المشكوة” صدره، و “زيته” إمداد الفيض الإلهي الحاصل من الشجرة المباركة النبوية، والنشأة المقدسة المصطفوية، التي لكمال اعتدالها وجامعيتها للنشأتين، وتجردها عن العالمين، غير مخصوصة بشرق عالم الأرواح، ولا بغرب عالم الأشباح، بل جامعة للطّرفين ومرتفعة عن الأفقين، وإمداده وتنويره للقلوب بحيث يكاد أن ينوّرها ويكمّلها قبل أن يستنبطوا المعارف من الكتاب بدقّة عقولهم، ويقتبسوا أنوار العلوم من مشكاة صدور المعلمين والمذكرين، فلغاية بسط فيض الحق، وشدة إنارته لقلوب السالكين المجذوبين، ينور قلوبهم، ويضيء أرواحهم، وإن لم تمسسه نار التعليم البشري، أو نار الدهن المتوقد من زند الطبع الزكي، ومقدحه الفكر.
الوجه الثاني: ما يوافق طريقه قدماء الصوفي، وأئمّة السلوك والتصفية، وهو المفهوم من فحوى الآية الكريمة، ومستندهم قراءة عبد الله بن مسعود كما ذكره الواحدي في الوسيط رواية عنه أنه قرأ: “الله نور السموات والأرض مثل نوره في قلب المؤمن”.
وعلى هذا الوجه يكون المراد من النور المذكور “ما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه لمَّا نزلت آية: {أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} [الزمر:22]. وسئل عنه: ما معنى هذا النور؟ فقال (صلّى الله عليه وآله): إنَّ النور إذا قذف في قلب المؤمن، انشرح له الصدر وانفسخ قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله” .
فعلى هذا شبّه الله نور قلب المؤمن بالمصباح، لأنّ المصباح قد حصل واستنار من نور آخر، فكذا هذا النور قذف في قلبه، وحصل واستنار من النور المطلق الإلهي والوجود القيّومي، والقلب بمنزلة المشكاة، والأحوال والمقامات الواردة فيه بإلهام الله المحصلة الممدة لهذا النور بمنزلة الزيت، والأعمال والمعاملات الكثيرة البركات بمنزلة الشجرة المباركة، ولكونها حاصلة بين شرق القلب وغرب البدن غير مختصة بأحدهما – والغضبية – فلا يكون شرقية ولا غربية، والروح النفساني بمثابة الزجاجة.
فيكون نظم هذا الوجه: مثل نور هداية الله في قلب المؤمن كمصباح واقع في زجاجة روحه النفساني، الواقع في مشكاة قلبه، يضيء المصباح من زيت الأحوال والمقامات، التي تكاد تضيء في باطن وجود السالك، وإن لم تمسسه نار التجلي، وهي منبعثة من شجرة الأعمال الصالحة المباركة، وهذا النور الأخير الذي هو نتيجة الأعمال الصالحة، وميراث المعاملات الخالصة، مضاعف من النور الأول الذي هو نور الهداية، الواقع في البداية الداعي إلى العبودية والطاعة، فإذا ضمّ نور النهاية إلى نور البداية يكون نوراً على نور.
الوجه الثالث: ما ذكر متأخروا الصوفية موافقاً لأصحاب المكاشفات، وأرباب الأذواق والإشراقات، وهو مبني على قواعد الإشراقيين، وحكماء الفرس والأقدمين، ويطابقه الحديث النبوي (صلّى الله عليه وآله) حكاية عن معراجه حيث سئل عن “الرؤية” فقال “نور أنّى أراه” أي هو تعالى نور فيمتنع تعلق الرؤية به تعالى، فأطلق النور عليه تعالى.
وقد أشرنا إلى تحقيق مذهبهم في النور وتوضيحه: أن النور المحسوس إنما يطلق عليه هذا اللفظ لكونه ظاهراً بذاته ومظهراً لغيره، وأما خصوص كونه محسوساً بالحسّ البصري، وكونه مظهراً للمبصرات فلا مدخلية له فيما يوضع له لفظ “النور” فليس نفس النور المحسوس معنى هذا اللفظ ومفهومه، بل هو أحد موضوعات هذا اللفظ، حتى أنَّه لو وجد في هذا العالم شيء آخر له هذه الخاصية يطلق عليه اللّفظ، ونظيره ما ذكر في معنى الميزان من أنّ معناه “ما يوزن به الشيء” سواء كان له عمود وكفتان أم لا، لكن غلب استعماله في هذا العالم على ما له عمود وكتفان.
فعلى ذلك يكون إطلاق “النور” عليه تعالى من جهة أنّه مصداق معناه وموضوع مسمّاه، لأنَّ ذاته ظاهر بذاته مظهر لغيره مطلقاً، ولهذا اصطلح الإشراقيون على إطلاق نور الأنوار عليه تعالى.
و “النور” مع أنه أمر ذاتي غير خارج عن ذوات الأنوار المجرّدة الواجبية، والعقلية، والنفسية، إلاَّ أنه متفاوت في الكمال والنقص متدرّج في الشدّة والضعف وإطلاقه على الذوات النوريّة على سبيل التشكيك، إذ لم يقم برهان على استحالة كون الذاتي مقولاً على أفرادها بالتشكيك، وهكذا حقيقة النور لها مراتب متفاوتة في القوة والضعف، والكمال والنقص، وغاية كمال النور الإلهي – وهو النور الغني – ثم الأنوار العالية المنقسمة إلى العقلية والنفسية، ثم الأنوار السافلة المنقسمة إلى الأنوار الكوكبية والعنصرية.
والحقّ أنَّ حقيقة “النور” و “الوجود” شيء واحد، ووجود كل شيء هو ظهوره، فعلى هذا يكون وجود الأجسام أيضاً من مراتب النور، لكن الإشراقيين زعموا أنَّ الأجسام غير ظاهرة بذواتها، بل بالنور المحسوس العارض، ولعلّ السرَّ فيه أنَّ الموجود من الأجسام هو خصوصيات صورها النوعية، ونفوسها، وهيأتها التي هي من باب الوجود لها تأمّل فيه وسيأتيك مزيد توضيح، وتحقيق هذه المباحث يحتاج إلى مجال أوسع ولا يعلمها إلاّ البارعون في الحكمتين مع زوائد ألهمهم الله بها.
فعلى هذه القواعد يكون معنى قوله: {ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ} بمنزلة معنى قولهم: “نور الأنورا” و “وجود الوجودات” لِمَا علمت أنَّ حقيقة كل شيء هو وجوده الذي هو نوريته، فـ “زيد” مثلاً في الحقيقة هو وجوده الخاص، ونور هويته الذي به يكون ظاهراً بذاته مظهراً لغيره.
لا يقال: إنَّه كيف يكون النور الممكني ظاهراً بذاته، مع أنَّه يحتاج في وجوده إلى موجد يفيد له الوجود والنورية؟
لأنَّا نقول: على قاعدة الإشراقيين تكون الأنوار الجوهريّة والعرضيّة مجعولة بالجعل البسيط الإبداعي، فالجاعل لا يجعل “النور” نوراً – عندهم – ولا يفيد النورية لما ليس بحسب جوهره وذاته نور، بل يفيد نفس الأنوار وينشئها، فقولنا “زيد موجود” عندهم بمنزلة قولنا: “زيد زيد” في أن القضية ضرورية، إلا أنّ الفرق بينه وبين قولنا: “الواجب موجود” أن هذه ضرورة أزلية، وهي ضرورة ذاتيّة – وبين الضرورتين قد تبيّن الفرق في علم الميزان – والإمكان في الوجودات معناه سلب الضرورة الأزلية – لا سلب الضرورة الذاتية – فلا ينافي هذه الضرورة الافتقار إلى العلّة الجاعلة.
– وبالجملة – السماوات والأرض عبارة عن وجوداتها الخاصة وأنوارها المتعينة، فهي بالحقيقة أنوار متفاوتة المراتب، والله تعالى أشد مراتب النور وأجلُّ درجاتها، فيكون نور السماوات والأرض بمنزلة نور الأنوار، وفلك الأفلاك.
وإذا سيق الكلام على طورهم يكون المشبه بـ “المصباح” هو النور المتجلي على جميع الحقائق الإمكانية، وبـ “المشكاة” هي الماهيات السفلية، وبـ “الزجاجة” الماهيات العلوية وبـ “الزيت” النفس الرحماني الذي هو الوجود المنبسط عن الحق على الخلق، والضوء الفائض منه على قوالب الأشياء وهياكل الأرض والسماء في سلسلة البدو الإبداعي، المسمى بـ “الفيض الأقدس”، وبـ “الشجر المباركة” الوجود والنور الفائض منه على المركبات والممتزجات حسب أوعية القابليات، وقامة (فاقة – ن) الاستعدادات في سلسلة الرجوع الاستعدادي، المسمى بـ “الفيض المقدّس” ووجه تشبيهه بالشجرة واضح، لأنّه ذو شعب وجهات مختلفة، وشجون وأفنان متكثّرة، وهذا الفيض غير مختصّ بشرق الأحدية المحضة، ولا بغرب الأعيان والماهيات.
فنظم الآية على هذا الوجه: صفة نور الوجود الفائض من نور الأنوار والموجود الحقيقي – الفائض على الممكنات – كمصباح مشتعل في زجاجة حقائق الأرواح العالية، والجواهر النورية العقلية، التي تتنور به مشكاة الجواهر السفلية والبرازخ الجسمية، واشتعال ذلك المصباح من زيت النفس الرحماني المنبسط على مراتب الموجودات، وهو لغاية لطافته وقربه من منبع الخير والجود ومعدن النور والوجود، يكاد يفيض الوجود والنورية على الأشياء، وإن لم تمسسه نار الفيض الأقدس والمقدس.
والزيت المتوقّد من شجرة مباركة – هي الفيض المقدس – الغير المختص بشرق الأحدية، ولا بغرب الأعيان، وهذا النور المتجلّي على حقائق الأشياء نور على نور، لأنّه نور عالي واجبي مفيض للنور السافل الممكني، يهدي الله لنوره – أي لتجلّي وجوده القيومي – من يشاء، فيتجلّى له، ويخرجه من ظلمة العدم البحت إلى نور الوجود الصرف.
وللآية وجوه نفيسة أخرى، سيرد عليك بيانه إن شاء الله عند تحقيق معاني ألفاظها مفصلة، فانتظرها مقتبساً لأنوارها، مجتنباً لثمارها.
تفريع:
فعلى الوجهين الأخيرين من هذه الوجوه الثلاثة، لا يكون إطلاق النور على الواجب تعالى على سبيل التجوز والتشبيه – كما ذكره متكلموا الإسلاميّين، وجمهور المفسرين، من أنه شبه الحق بالنور، أو أُريد بالنور هاهنا المنور.
على أنهم لو تفطنوا بمعنى هذا المشتق لحكموا أنّ كونه تعالى منوراً بالحقيقة مما يستلزم كونه نوراً بالحقيقة، وذلك لأنَّ كل فاعل بالذات لمعنى كمالي وجودي، لا بد وأن يوجد فيه ذلك المعنى الكمالي – إذ المعطي للكمال لا يكون قاصراً عنه كما حكم به الوجدان وطابقه البرهان – فإذا وجد فيه معنى النور، فإمّا أن يكون عين ذاته أو زائداً على ذاته.
والثاني يوجب افتقاره تعالى إلى سبب يفيض عليه معنى النور، لأنّ الاتصاف بمعنى زائد إنّما يكون بجهة القبول والاستفادة، وهو غير جهة الإيجاد والإفادة، فلو كانت ذاته منوراً لذاته لزم أن تكون ذاته قابلاً وفاعلاً فلا يكون بسيطاً حقيقياً – وقد ثبت بساطته، وأحديته، وتقدسه عن شوائب التركيب كلها – وهذا خلف، وأيضاً يلزم أن تكون ذاته أنور من ذاته وهو محال. وإن كان مبدأ نورانيته غير ذاتية – وغير ذاته يكون ممكناً من الممكنات – فيلزم افتقار الواجب إلى الممكن في صفة كمالية.
ومن أنكر كون النور كمالاً للموجود بما هو موجود، فليداو عقله إن كان متوفقاً، وإن كان مكابراً فالله يجزيه جهنم خالداً فيها. على أن من تأمل علم أن الوجود والنور متحدان في المعنى والحقيقة، ومتغايران في اللفظ، ولا شك أن الوجود خير وكمال لكل موجود من حيث هو موجود، والواجب بحت الوجود فيكون محض النور.
فقد ثبت وتحقق أنّ النور نفس حقيقة الواجب الوجود جلَّ مجده.
فصل
وأمَّا معنى إضافته إلى السماوات والأرض فهو بمنزلة قولك: “نور الأنوار” و “وجود الوجودات” فإنَّ وجود كل شيء عبارة عن نور به تظهر ماهية ذلك الشيء وذاته، فالله منشىء الأنوار بنفس ذاته النورية وجاعلها جعلاً بسيطاً، مفاده ترتب ذات المجعول وهويته التي هي عين إنيّته، فعلى هذا كما أنَّ ذاته موجد الموجودات، فكذلك مشيِّىء الأشياء، ومذوِّت الذوات.
ثم لما كانت ذاته – موجد ذات كل ممكن – ليست إلاَّ وجوداً خاصاً به يوجد الماهية، وبه يطرد العدم عنها، ويتصف بالموجودية المصدرية عند العقل – لما حقق في مظانه أنَّ المتأصل في التحقق هو وجود كل شيء الذي هو حقيقته، والماهية حالة انتزاعية عقلية منصبغة بصبغ الوجود، منورة بنوره – فموجد الأشياء بالحقيقة موجد لوجداتها، ومنشئها، وجاعلها إنشاءً بسيطاً، وجعلاً مقدساً عن التركيب غير مستدع لأمرين: مجعول ومجعول إليه.
ثم إذا كانت موجودة الأشياء – كما علمت – ليست باتّصاف الماهية بالوجود بل بإبداع المبدإ تعالى وجوداتها، وتأييسه إياها – على النحو الذي مرّ ذكره – فيكون الله تعالى وجود الوجودات فإذا كان الله وجود الوجودات فلا يكون للموجودات تحصّل إلاّ به، ولا هوية لها إلاَّ بهويته.
ثم ليست هوية الباري متقومة بها، وإلاَّ لزم الدور وافتقار الواجب إلى الممكن – وكلاهما محالان – فيكون الموجود بالحقيقة هو الحق تعالى لا غير، ويكون موجودية غيره باعتبار أخذها معه، فتكون من قبيل الأظلال والأشباح التي يتراءى في المرائي الصيقلية بتبعية الشخص الخارجي، فالماهيات كلها بمنزلة المرائي التي تتراءى فيها صورة الوجود الحقيقي – لعدميتها كعديمة لون المرآة -.
ولهذا المعنى قال الحلاج: “الله مصدر الموجودات” وقال بعضهم: “الله وجود السماوات والأرض” وإليه يرجع قول الشبلي: “ما في الجنة أحد سوى الله تعالى” كأنه أراد بالجنة هاهنا الوجود المتأصل الحقيقي، لأنه الخير المحض يؤثر عند الكل، وإليه يشير قول أبي العباس: “ليس في الدارين إلاَّ ربي، وأنَّ الموجودات كلها معدومة إلاَّ وجوده تعالى”.
ويؤيد ذلك قول أمير المؤمنين وإمام الموحّدين (عليه السلام):”لا أعبد ربّاً لم أره” ويقوي ذلك قول خاتم الأنبياء (صلّى الله عليه وآله): “لا راحة للمؤمن من دون لقاء الله”.
حكمة عرشية:
كما أنَّ الموجود حسبما قرع سمعك في الحكمة المشهورة – إمَّا جوهر، وإمَّا عرض، وهما الجوهر والعرض المشهوران، فاعلم أنَّ في الوجود جوهراً وعرضاً حقيقيين غير ذينك المشهورين، فإنَّ ذينك المفهومين من أقسام الماهيات والأعيان الثابتة التي ما شمّت رائحة الوجود، وهذان من أقسام الوجود.
فـ “الجوهر” بحسب المشهور ماهية غير الوجود، حقها في أن تكون موجودة – أي: متحدة مع مفهوم الوجود العقلي الذي من المفهومات العامة الشاملة – أن لا تكون في موضوع. أي معناه ليس نعتاً لمعنى آخر، و “العرض” هو الماهية التي تكون بحسب وجودها العيني، وعند موجوديتها العينية نعتاً لشيء آخر، فهما مفهومان عامان وموضوعاهما ماهيتان عقليتان.
وأما الجوهر والعرض الحقيقيان: فـ “الجوهر الحقيقي” هو الموجود المستقل، الذي هو بذاته وهويته موجود وواجب لذاته من غير علاقة على شيء آخر في كونه هو هو – وهو الله تعالى – و “العرض الحقيقي” هو الذي يكون بحسب ذاته وهويته متعلقاً بغيره، ومفتقراً في تجوهره إلى غيره، ويكون تجوهره وتذوته بغيره، فلا يكون في نفسه مع قطع النظر عن ما يقوم به متصوراً – فضلاً عن أن يكون موجوداً – فذاته عبارة عن “المتقوم بالغير” لا أن له معنى يكون ذلك المعنى مما يوصف بالافتقار إلى الغير مطلقاً – كما كان في العرض بالمعنى المشهور – أو مادة – كما في الصورة الجوهرية بالمعنى الأول – أو صورة – كما في المادة – أو هما جميعاً – كما في المركب منهما – أو فاعلاً أو غاية – كما في سائر الأقسام -.
فالواجب جل ذكره جوهر بهذا المعنى حقيقة، وإن لم يطلق عليه اسمه تسمية (لتسميته – ن) بحسب التوقيف، حيث لم يرد إطلاق هذا اللفظ عليه تعالى في الشرع الأنور، وهو مفاد ما ذكرناه من المعنى وإن كان بعبارة أخرى.
والعرض – بالمعنى الحقيقي الذي ذكرناه – هو وجودات الممكنات كلها سواء كان الممكن بحسب الماهية جوهراً بالمعنى المشهور أو عرضاً، فإن تلك الوجودات كلها أعراض قائمة بوجود الحق، لا بمعنى قيام معنى العرض بالجوهر – حسبما هو المتعارف المشهور بين الجمهور – ليلزم كونه تعالى محل الحوادث – كما ذهب إليه بعض المتكلمين – أو محل الصور العلمية – كما ذهب إليه جمهور المشائين من الحكماء – بل هذا معنى آخر من القيام غير ما قيل أو يقال، والعبارة قاصرة عن بيانه، والأمثلة الدائرة في لسان العرفاء غير واردة على مضربها في شأنه. وجملة القول فيه إنَّ معنى “قيام الأشياء به تعالى” عبارة عن قيوميته لها، فافهم، وتثبت، وتفطن، بمفاد ما روي عن كعب الأحبار في تفسير لفظة “الله” حيث قال “إنه عبارة عن وجوده ولوازمه” ولوازمه أسماؤه الحسنى ومظاهرها، أعني الماهيات، وأعيان الممكنات التي وقعت على هياكلها رشحات وجود الحق، ولمعات نوره وظلاله، المعبر عنهما بالسماوات والأرض.
وقريب من هذا المعنى ما رأيت في مرموزات أهل الله، أنَّ أصل السماء والأرض وحقيقتهما عبارة عن نور محمد (صلّى الله عليه وآله) ونار إبليس لعنه الله وسيجيء شرح هذا المعنى إن شاء الله.
لمعة إشراقية
قد دريت أنَّ النور حقيقة بسيطة معناها بحسب شرح الاسم: “الظاهر بذاته المظهر لغيره” ودريت مما ذكرناه أنَّ حقيقة النور مما لا يظهر لأحد إلاَّ بالمشاهدة الحضورية، دون حصول صورة منها في الذهن، لأنَّ كل صورة ذهنية فهي تكون كلية أبداً – ولو تخصصت بألف مخصص -فيكون مبهماً، والمبهم لا يكون متعيناً ظاهراً في نفسه، وعلى فرض تخصصه يحتاج في ظهوره وتعينه إلى ذلك المخصص، فلا يكون ظهوره عين ذاته، فلا يكون ظاهراً بذاته مظهراً لغيره هذا خلف.
وأيضاً كل ما هو غير النور فهو خفي في ذاته، مظلم في جوهره، ظاهر بالنور مستضيء به، فكيف يكون هو مظهراً للنور ومعرفاً كاشفاً له؟
فتيقن أنَّ الله تعالى هو ظاهر بذاته، إذ ذاته عين ظهور ذاته لذاته، وعين ظهور جميع الأشياء له، كما أنَّه مظهرها من مكمن الخفاء وموجدها من كتم العدم إلى عالم الوجود، فبذاته النيرة يتنور غسق الماهيات المظلمة الذوات، وينتشر به النور في أهوية الهويات، وتطلع شمس عظمته على آفاق حقائق الممكنات، ويطرد العدم والظلمة عن إقليم المعاني والمعقولات، فلو لم يكن طلوع ذاته النيرة في آفاق هويات الممكنات، وإشراق نوره على السماوات والأرض وما فيهما لم يكن لذرّة من الذرّات وجود، ولا لأحد من الموجودات حصول – لا في العقل ولا في العين -.
وفي الحديث النبوي المصطفوي – على قائله وآله كرائم تسليمات الله -: “إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رشّ عليهم من نوره” وبهذا في الحقيقة ينكشف معنى قوله سبحانه: { يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ } [السجدة:5]. وقوله: { { وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلاَّمُ ٱلْغُيُوبِ } [التوبة:78]. فإنّ التدبير من الله عين إشراق نور الوجود منه في إبداعه للأشياء على وجه الحكمة والمصلحة، وكذا عالميته بالغيوب عين إيجاده للأشياء المستورة في ذاتها المعقولة له، بنفس الإيجاد الذي هو ضرب من التعقل في حقه – كما رآه الإشراقيون – إذ ليست وجودات الأشياء عنه متراخية عن إرادته لها، ولا إرادته للأشياء التي هي عين علمه التفصيلي لوجودها متأخرة عن وجودها، بل أوجد الموجودات مقعولة إياه، وعقل المعقولات موجودة له تعالى، وهذا معنى كون “علمه فعلياً” عندهم.
فالحاصل أنَّ علمه الذي هو عين ذاته سبب لوجودات الأشياء التي هي عبارة عن معلوميتها له وإشراق نوره عليها، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن هذا أيضاً انكشف معنى قوله تعالى: (ٱللَّهُ نُورُ).
تأييد استكشافي
قال مشايخ هذا الطريق: “النور” هو الذي نوَّر قلوب العارفين بتوحيده، وأنار أسرار المحبين بتأييده.
وقيل: هو الذي كون الأشياء بالتصوير، والأسرار بالتنوير.
وقيل: هو الذي يهدي القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه، ويهدي الأسرار إلى مناجاته واجتبائه.
وإليه الإشارة بقوله سبحانه: { ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ } [البقرة:257]. أي: من الباطل إلى الحق، ومن العبد إلى الرب، ومن البعد إلى القرب، ومن الأسفل إلى الأعلى، ومن الهاوية إلى الجنان.
كشف استناري:
إعلم أنَّ للحق تعالى أسماء متقابلة لازمة لذاته كالأول والآخر، والظهر والباطن، والهادي والمضلّ، والمعزّ والمذلّ، فله بحسب أحدية وجوده الواجبي من كل صفتين متقابلتين أشرفهما بحسب جمال ذاته وزينة وجهه، وإنما يصدق الطرف المقابل عليه بحسب مقايسة عظمة ذاته وجلاله إلى من دونه، وقهره على من سواه، فالأسماء والصفات الجمالية إنما تثبت له أولاً وبالذات، والأسماء والصفات الجلالية تصدق عليه ثانياً وبالعرض من باب الضروري، الذي يذكر في بحث العلل الغائية التي هي الفاعل لفاعلية الفاعل.
وبذلك الأصل تنحفظ قاعدة استحالة كون الخير الحقيقي مبدأ للشرور، وبه أزاح أستاد الحكماء ومقدم المشائين أرسطاطاليس شبهة الثنوية القائلة بتعدد الفاعل الأول للكل، فكل ممكن مزدوج الحقيقة من جهة كمالية نورية ناشئة من الصفات الجمالية النورية، ومن جهة نقصانية عدمية ظلمانية ناشئة من الصفات القهرية الجلالية النارية، فمن هذين الأصلين نشأ النور المحمدي والنار الإبليسسي، الساريتين في سماوات الأرواح والروحانيات، وأرض الأجسام والجسمانيات.
والله تعالى منور الكل بنور وجوده وجماله، وبنار هيبته وجلاله، كما أشار إليه بقوله: { ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ } [البقرة:257]. فالله نور السماوات والأرض بأنوار كواكب أسمائه النورية الجمالية، المشرقة في سماء حقيقة ذاته، وأشعة نيران الجواهر النيرة في آفاق ملكوته وجبروته، فالموجودات كلها مسخرة لهاتين الصفتين، متقلبة بين الإصبعين، فالعرش وما حواه بين صفتين من صفات السبحان، والقلب وما يهواه بين إصبعين من أصابع الرحمان اللتين كانتا في مرتبتي صفتي لطف وقهر، وفي مقام آخر جوهري عقل ونفس، وفي درجة أخرى حالتي بسط وقبض.
وظلاهما في العالم: سماء وأرض، وفي الكواكب: سعود ونحوس: وفي الآفاق شرق وغرب، وفي الحيوان ذكر وأنثى، وفي الطعوم حلاوة ومرارة، وفي اللون سواد وبياض، وفي الكم متّصل ومنفصل، وفي المقدار قار وغير قار، وفي الخط مستقيم ومعوج، وفي السطح مستوٍ ومنحنٍ، وفي العدد منطق وأصم، وفي المذهب هداية وضلال، وفي الاعتقاد حق وباطل، وفي النفس إقبال، وإدبار، وفي القلب بصيرة وعمى، وفي الآخرة نعيم وجحيم، وفي الدنيا دولة ونكبة، وفي الباطن إلهام ووسوسة، إلى غير ذلك من المتزاوجات السارية في جميع الذراري، النازلة من سماء عالم الوحدة، إلى أرض عالم الكثرة والهيولى، لقوله تعالى: { وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } [الذاريات:49].
وقلّ من العلماء من لم تزلّ قدمه شرح تفاصيل هذه المراتب المزدوجة، المتنزّلة من شرف سماء العظمة والكبرياء إلى المبهط الأدنى، وحضيض الأرض السفلى، ثم المرتقية إلى عالم الأسماء والقيامة العظمى، التي تحشر فيها الأشياء إلى الرب الأعلى: { وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْداً [(مريم:95).
فصل:
في قوله جلّ اسمه: (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ)
حبّذا عبد بلغ في عبوديّته وسلوكه طريق الإنابة إلى مقام شاهد بالمشاهدة القلبيّة نور وجه الله، ورآه كما رأى بالمشاهدة البصريّة نور المصباح من وراء زجاجة واقعة في مشكاة، فما هو بمنزلة زجاجة هذا النور هو محمد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، إذ لا يمكن مشاهدة النور الأحدي لغاية شدته وقوته، التي تقهر البصائر وتبهر الألباب، إلاَّ خلف حجاب الزجاج المحمدي، إذ به يعرف مصباح نوره سبحانه قبل صباح ظهوره.
وإن أردت بيان نسبة المصباح إلى النور، والصباح إلى الظهور، فقل: “هو الله أحد” فقولك “هو الله” لفظان: موضوع ومحمول، والحمل نحو من الاتحاد في الذات والوجود، لكن لو نظرت نظراً عقلياً في مصداق هذا الحمل، وجدت “هو الله” شيئاً واحداً وذاتاً واحدة، يعبّر عنهما تارة بالوجود الواجبي والذات الأحديّة، وتارة بالمستجمع بجميع الصفات الكماليّة والأسماء الحسنى.
ومصداق الحيثيّتين المذكورتين حقيقة بسيطة واحدة تكون بإحدى الحيثيتين هويّة، وبالأخرى إلهيّة، كما أنَّه بأحد الاعتبارين وجود، وبالاعتبار الآخر اسم وصفة، وكما أنَّ “المصباح” في عالم المشاهدة البصريّة شيء واحد ومحسوس واحد، لكنه عند التميّز ينحل إلى أمرين، منه نور هو بمنزلة الوجود المطلق، وحامل صنوبريّ هو بمنزلة معنى اسم الله في الواجب تعالى.
هذا إذا كان الممثّل له في “المصباح” هو “الله تعالى” وأما إذا كان ذاتاً إمكانيّة – كذات الرسول (صلّى الله عليه وآله) – فأحد الأمرين فيه بمنزلة الوجود، والثاني بمنزلة الماهية في الممكن.
والفرق بين المواضع الثلاثة أنَّ الصفة والمومصوف في المصباح – أي النور والصنوبرة – متحدان حسّاً ووضعاً، متغايران وجوداً وعقلاً، وما بأزائهما في الممكن – أي الماهية والوجود – متحدان وجوداً وعيناً متغايران عقلاً وتسمية، وفي الواجب تعالى ما هو بمنزلة الوجود وعيناً متغايران عقلاً وتسمية، وفي الواجب تعالى ما هو بمنزلة الوجود في الممكن، والنورية في المصباح – وهو المسمّى بالهوية – عين ما هو بمنزلة الماهية والحامل وهو المسمّى باسم “الله” لا فرق إلاَّ في العبارة، فالمصباح مثال لله، ونوره مثال للهوية الأحدية.
فلو لم يكن للنور المصباحي حامل ذو تعيّن وضعي، لما تشخص منه جهة قرب وبعد في الهواء الذي يستنير منه شدّة وضعفاً، فلم يقع منه نور على شيء من هواء البيت وجدرانه وسقفه، لعدم النسبة بالرجحان وعدمه، والأوليّة وعدمها، ولاستحالة الترجيح من غير مرجح.
فكذلك لو لم يكن للحق أسماء يقع منها آثار مخصوصة على المظاهر والمجالي – بحسب ما يقتضيه تعيّن كل اسم عن اسم آخر – لم يصدر عنه في عالم الإيجاد شيء من الممكنات، إذ لا أولوية لممكن مّا، ولا رجحان له على ممكن آخر بحسب الجهة الإمكانية، فإنَّ الماهيّات الإمكانيّة والمعاني الكلية، التي هي غير الوجود في درجة واحدة بحسب الذات في قبول نور الوجود وعدم قبوله، بل المعيّن لكل منها في مقام خاص ودرجة معينة إنّما هو ذات الواجب بما يلزمها من الأسماء والصفات، المنبعثة عن حاقّ هويّته الإلهيّة وشمس حقيقة الواجبيّة، النافذ نورها في جميع هياكل الممكنات، الباسط فيضها على بساط جميع الماهيات.
ثم لمَّا كان أول من قرع باب الاستنارة بنور الله، وأول من نطق بـ “لا إله إلاَّ الله” هو العبد الأعلى، والعقل الأول، والممكن الأشرف، والحقيقة المحمدية، فهو مصباح نور الله، وبتوسطه يقبل الاستضاءة والاستنارة جميع الماهيّات الواقعة في فضاء قابليّة الوجود والهويّات، الساكنة في هواء بيوت أهل المحبة والعبوديّة، لمبدع الوجود الفائض لنور الخير والجود، فذات النبي صلّى الله عليه وآله كالمرآة المصقولة، التي يحاذي بها وجه النيّر الأعظم، وتوازي شطر الحق، فتجلّى لها وجه ربّك ذو الجلال والإكرام.
تفريع:
فكل من صحّت نسبته إليه من فقراء اُمّته ولاحقاً انعكس نور الحق منه (صلّى الله عليه وآله) إليه، وهذا معنى “الشفاعة” التي يكون جميع الناس محتاجين إليها يوم القيامة حتى الأنبياء والأولياء سلفاً وخلفاً { { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } [القيامة:22 – 23].
واعلم أنَّ الغرض الأصلي من العبادات والرياضات، هو تصفية وجه الذات والمحاذات بالقلوب الصافية شطر نور الحق الأحد خلف زجاجة محمد (صلّى الله عليه وآله) ليشاهد نور الله، ويقع عليه ضوء معرفة الله، وهذا معنى ما قاله أويس القرني (رضي الله عنه): “للعبد أن يكون عيشه كعيش الرب” وإلى ما ذكرنا يرجع حاصل معنى العبوديّة التامّة.
وقد سئل بعض أصحاب القلوب: “ما العبودية التامّة؟” فقال: “إذا صرت حرّاً فأنت عبد” معناه أنَّك إذا تجرَّدت وخلصت عن التعلّقات، وتصفّي قلبك عن الكدورات، فصرت عبداً لله، ملَكاً مقرّباً وملكاً ومالكاً لجميع الأشياء، بعزّة الله وقدرته وملكه { لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ } [آل عمران:164].
ومما “ورد في هذا المعنى عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في خبر أهل الجنة: أنّه يأتي إليهم الملك بعد أن يستأذن منهم للدخول عليهم، فإذا دخل ناولهم كتاباً من عند الله، فإذا في الكتاب لكل إنسان يخاطبه به: من الحيّ القيّوم إلى الحي القيّوم، أما بعد فإنّي أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك اليوم تقول للشيء كن فيكون فقال (صلّى الله عليه وآله): فلا يقول أحد من أهل الجنّة لشيء: كن إلاَّ ويكون” .
تنبيه:
ولكنك يا مسكين يجب أن تعلم التمييز بين المرآة والشخص، وتفرّق الظلّ من الأصل، وقد نبّهناك عكليه قبل ذلك لئلا تقع فيما وقع فيه كثير من أهل الضلال والنكال، وأصحاب الحلول والاتحاد، فما للتراب وربّ الأرباب { { وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ } [الأنفال:17]. فإذا خوطب سيّد الأبرار وقائد الأخيار (صلّى الله عليه وآله) بقوله تعالى: { إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ } [القصص:56]. فما يكون لأمثالك ونظرائك.
ثم في التعبير عن تلك المرتبة بالأمانة في قوله عزّ جلاله: { إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً } [الأحزاب:72]. إشعار لطيف بما ذكر، فإنّ الأمانة مردودة إلى صاحبها، بل كل صفة وجوديّة وكمال نوري أفاضه الله على ممكن من الممكنات، وماهيّة من الماهيات، فهو أمانة من الله عنده، وليس له إلاَّ الانصباغ بنوره والمجاورة معه والاحتفاف به، لا الاتصاف بالحقيقة، ولهذا ينخلع عنه عن أداء الأمانات، ورجوع الكل إليه { أَلاَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلأُمُورُ } [الشورى:53].
وإلى هذا المعنى أشار أبو سعيد الخراز حيث قال: “علامة المريد في الفناء ذهاب حظّه عن الدنيا والآخرة إلاَّ من الله سبحانه، ثم يبدو باد أيضاً، فيريه ذهاب وجود نفسه وحظ رؤيته من الله، ويبقى من رؤيته ما كان لله من الله فينفرد العبد من فرديّته، فإذا كان كذلك فلا يكون مع الله غير الله، فبقي الله الواحد الصمد في الأبديّة” كما كان في الأزلية هذا كلامه وهو تام في فحواه لمن كان له سمع يسمع آياته، وعقل يفهم توحيده، وبصر يرى قدرته ونفوذ أمره في عالم الملك والملكوت والغيب والشهادة.
طريق آخر:
روي عن بعض السالفين من المفسّرين: “إن المشكاة هو الصدر والزجاجة هو القلب، والمصباح هو الروح” وهذا إدراكه جلي واضح، لكن ينبغي أن يعلم، أنَّ لكل من هذه الثلاثة – أي: الصدر، والقلب، والروح – مراتب ثلاثة:
أولها: ظاهرة مكشوفة لكل أحد، لكونها من عالم الحسّ الظاهري.
وثانيها: مستورة عن الحسّ الظاهر، مكشوفة للحسّ الباطن.
وثالثها: مستورة عنها جميعاً، مكشوفة للعقل النظري، ولها مراتب أخرى ليس هاهنا موضع بيانها.
فالمرتبة الأولى: أما من الصدر، فهي هذا المركب من العظام والأغشية والرباطات المحيطة بجرم الكبد، وكأنّ المراد به هو الكبد، لكونه محل الروح الطبيعي، وأمّا من القلب فهو اللحم الصنوبري، وأما من الروح، فهو جسم لطيف حار، هو مركب النفس الحيوانيّة المدركة للجزئيّات لأجل الحركت الشهوية والغضبية.
وأمّا المرتبة الثانية: من كل منها: فمن الصدر الروح الطبيعي، ومن القلب الروح الحيواني المذكورة، ومن الروح الروح النفساني البشري الذي تيعلق به، وتستعمله النفس الإنسانية المتفكرة في المقاصد الحيوانيّة، والرويّة في التدابير البشريّة، بحسب المعاش والمعاد والدنيا والآخرة، على ما يقتضيه العقل العملي، المشترك فيه بين الناس، المتفق عليه العام والخاص، عند تخليته عن العوائق والوساوس، وسلامته عن القواطع والنوازع.
فهذه الأرواح الثلاثة – أي الطبيعي، والحيواني، والنفساني – هي التي يبحث عنها الأطباء، وتسمّى عندهم بالأرواح، وتتميّز عندهم بالقيود الثلاثة، وبتفاوت جسميّتها في اللطافة شدّة وضعفاً، وفي كمال الاعتدال ونقصه.
ولكل منها مولد ومنشأ خاصّ: فمنبع الروح النفساني الدماغ – وهو أعدل الأرواح – ومنشأ الروح الحيواني القلب الصّنوبري – وهو متوسّط في كمال الاعتدال – ومولد الروح الطبيعي الكبد – وهو أخرجها عن الاعتدال -.
وهذه الأرواح الثلاثة أشرف الأجسام العنصريّة، حتى كادت أن تشبه الأفلاك، وأما عند العرفاء فأساميها ما ذكرنا – من الصدر، والقلب، والروح – بحسب هذا الاستعمال في المرتبة المتوسطة.
وأما المرتبة الثالثة: فالصدر بحسب هذه المرتبة هي النفس الحيوانية التي يستعملها القلب الإنساني، وهو في هذا المقام عبارة عن النفس الناطقة المذكورة، والعقل العمليّ المذكور، والروح عبارة عن العقل المستفاد المشاهد للمعقولات عند اتصالها بالعقل الفعّال، وهو الملك المقدَّس، وهو قلم الحق، كتب في ألواح قلوبنا حقائق الإيمان لقوله تعالى: { ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ * ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ * عَلَّمَ ٱلإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } [العلق:3 – 5].
فهذه الثلاثة في هذه المرتبة تكون من عالم الآخرة، وعالم الغيب، وعالم الملكوت، وفي المرتبة الأولى كانت من عالم الدنيا، وعالم الشهادة، وعالم الملك، وفي المرتبة المتوسطة يقع متوسّطاً بين العالمين، برزخاً بين النشأتين، بمنزلة عالم الأفلاك الذي قيل: “إنّه الأعراف”.
والقلب بهذا المعنى الأخير هو الذي يقال: “إنه عرش الله” و “مستوى اسم الرحمن” لكونه محلّ معرفة الله وملكوته على سبيل الاستقامة، من غير اعوجاج ولا إلحاد في عظمة ذاته، وصفاته، وأسمائه، وأفعاله، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، الذي هو يوم مراجعة الخلائق إليه، وإعادة الأرواح ومثولها بين يديه.
والصدر هو الكرسي، ونسبة العرش إلى الكرسي كنسبة العقل إلى النفس، والقضاء إلى القدر، إذ المعقولات كلها مجملة في القضاء، مفصّلة في القدر، وكذا الأنوار الكوكبيّة، متّصلة واحدة في العرش – لغاية صفائه، ولطافته، وكونه مصاقباً لأفق عالم المعنى والملكوت، وهي منفصلة متجزئة في الكرسي – لكون الكواكب في اللطافة دون فلك العرش -.
فصل:
في قوله عزَّ اسمه: (يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ)
إعلم أنَّ هذه الشجرة ليست من أشجار الدنيا وعالم الحسّ – كما ظنّه المحجوبون – وإلاَّ لكانت في جانب من جوانب الدنيا، قابلة للإشارة الحسّية وأنها ليست كذلك، فليست في الدنيا، ولا في الآخرة أيضاً – كما ذهب إليه قوم آخرون -.
قال الحسن البصري: “لو كانت هذه الشجرة في الدنيا لكانت إمّا شرقية وإمّا غربية: ولكن والله ما في الدنيا ولا في الجنة، إنما مثل ضرب الله لنوره”.
وكثيراً ما يكون لشيء واحد أسامي كثيرة باعتبارات متعددة، يكون المقصود من الكل معنى واحد وإن تعددت الألفاظ وتكثّرت الحيثيات، وربما يكون لحقيقة واحدة درجات متفاوتة في العوالم المتطابقة المتحاذية، بعضها فوق بعض، كالقلب الذي ظاهره جسم مركب من العناصر الأربعة، ثم من الأخلاط الأربعة، ثم من الأمشاج مثل الشحم، واللحم، والعصب، والعروق، وما شاكلها.
وظاهر ظاهره شكل صنوبري أحمر محسوس. وباطن ظاهره تجويف ظلماني أسود، وباطنه روح بخاري حاصل من لطافة الأخلاط وبخاريتها، كما أنَّ هذا الظاهر حاصل من كثافة الأخلاط وأرضيتها، ونسبة هذا إلى ذلك كنسبة الأرض إلى السماء.
ولباطنه باطن – هو النفس الحيوانية – وهو قشر ظاهر للنّفس الإنسانية الناطقة، ونسبته إلى هذه النفس كنسبة البدن إليه، ثم لباطن باطنه باطن آخر، يكون جميع ما سبق ذكرها قشوراً بالقياس إليه، وهو محيط بها إحاطة العرش بما فيه من السماء والفرش، وهو الجوهر العقلي الذي كان مفاضاً على النفس من المبدإ الفعَّال، وهو في أول تكونه كان بمنزلة المعاني الذهنيّة، والمفهومات الكليّة الهيولانية، ونسبته إلى العقل بالفعل (الفعال – ن) نسبة المنيّ إلى الرجال.
ثم يتدرج في قوة الوجود العقلي إلى درجة بالعقل بالملكة، التي يدرك بها المقدمات الأوليات، ويتفطن للمشاركات والمباينات، ويتنبه للتصورات والتصديقات المأخوذة من الحسيات، ثم إلى درجة العقل بالفعل، الذي يدرك به النظريات، وحدود الماهيات، وبراهين الموجودات، ثم إلى درجة العقل المستفاد المشاهد لصور المعقولات في القلم الأعلى واللوح المحفوظ، ثم ينخرط في سلك الملائكة المقرّبين، والاتّحاد معهم اتّحاداً نورياً مقدساً من شوائب القصور والنقص فهذه كلها من جملة مراتب القلب الإنساني في الصعود من أرض الجسمية إلى السماء اللاَّهوتية.
فعلى هذا قياس غيره من الحقائق المستعملة ألفاظها عند أهل الشريعة والحقيقة مطلقاً، وفي هذه الآية خاصة، فالشجرة الزيتونة عند المحجوبين – المقتصرين على أول الدرجات للحقائق وأدنى العوالم للمعاني – هي شجرة منبتها الشام وغيرها – وأجود الزيتون زيتون الشام وهي مباركة لأنّها كثيرة المنافع، أو لأنها تثبت في الأرض التي بوركت للعالمين أو بوركت فيها، حيث دفن فيها أجساد سبعين نبيّاً منهم إبراهيم (عليه السلام).
وعن النبي (صلّى الله عليه وآله): “عليكم بهذه الشجرة، زيت الزيتونة فتداووا به، فإنّه مَصْحَحَة من الباسور” .
ومنبتها لا شرقية ولا غربية، لأنّ الشام متوسط بين شرق العالم وغربه، أي: الربع المعمور للأرض، المكشوف من البحر الذي أحد جانبيه في الطول – وهو نصف دائرة عظيمة في الأرض – الجزائر الخالدات، الواقعة في جانب الغرب، وكانت مكشوفة في قديم الزمان من البحر والآن مغمورة فيه والجانب الآخر منتهى العمارة عند ساحل الحبر في جانب الشرق.
وقيل: لا في مضحى ولا في مقنأة، ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليها وذلك أجود لحملها وأصفى لدهنها، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): “لا خير في شجرة في مقنأة، ولا نبات في مقنأة، ولا خير فيهما في مضحى” .
ويستفاد من هذين القولين أنها شجرة واقعة في أُفق قبة الأرض، وهو في اصطلاح أهل الهيئة والنجوم، موضع من الأرض طوله تسعون درجة، وعرضه عرض وسط الأقاليم، أو منتصف الربع للدور – أعني خمسة وأربعين – إذ القول الأول مشعر بتوسط موضعها في الطول بين مطلع الشمس ومغيبها في الأرض المعمورة، والقول الثاني مشعر بكونه متوسطاً في العرض، واقعاً بين ارتفاع الشمس في نصف النهار الأطول، وغاية انحطاطها فيه في المواضع المعمورة، أو يكون النهار فيه متوسطاً بين غاية الطول وغاية القصر في جميع السنة، كمواضع خط الاستواء وما يليه.
فهذا بيان معنى “الشجرة الزيتونة” حسبما وصل إليه أفهام الجمهور بحسب ظهورها في مظاهر هذا العالم، ووجودها في مهوى كدورة الأجرام، ومعدن الظلام، وأما تحقيقها بحسب نشأة أخرى غير هذه النشأة، فوقع إليه إشارات قرآنية، ورموز نبوية متفاوتة حسب مقامات العارفين، ودرجات المتذكرين، فتارة يعبّر عنها بـ “شجرة طوبى” وتارة بـ “سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى”. وتارة بمقام “أبيت عند ربي يطعمني ويسقين”. وتارة بـ “شجرة موسى”. { وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِيِنَ } [المؤمنون:20]. وهو دهن المطالب العلمية البرهانية النورانية، وصبغ الخطابيات والمواعظ الحسنة المقبولة للعقول المتعارفة.
تظليل فرشي فيه تنوير عرشي
قد تبين لك بما قرع سمعك، أنَّ للقوة الإنسانية التي تكونت أول نشأتها في القلب اللَّحمي الصنوبري الشكل، المخروطي الوضع، درجات متفاوتة في الارتقاء إلى الكمال، ولها تطورات في الأحوال، وإنَّما ينكشف ذلك بأن تعتبر أولاً القلب وأحواله، وهو بالحقيقة أول عضو يتكون في البدن ويتحرّك، وآخر عضو يفسد ويسكن، بل هو بالحقيقة البدن الحيواني الذي تستعمله النفس بواسطة ما ينبعث عنه من البخار اللطيف، وباقي الأعضاء يزاد لأجله، ويولد لصيانته، لأنّها بمنزلة الغلافات والقشور الصائنة للبّ القلب، والآلات الخادمة له، الحافظة إيّاه، ولذلك يكون واقعاً في وسط البدن، وهو إن كان في الصورة محاطاً لها، وفي الكمية أصغر منها إلاَّ أنّه في القوة والمعنى محيط بها، مستعمل إياها، غاية لوجودها، وفاعل معط لقواها.
ثم يتولد منه بخار لطيف هو “الروح الحيواني” عند الأطباء، ثم يتولد منه روح آخر بخاري ألطف منه، وهو “الروح النفساني” ثم يتولد منه النفس النباتية – وهي قوة ومبدأ للتغذية، والتنمية، والتوليد – ثم النفس الحيوانية.
وأول مراتبها القوة اللَّمسية، كما في الدود والحلزونات ونظائرها من الحيوانات العديمة الرؤوس ثم تتولد النفوس الحسية على طباقاتها، ثم النفوس الخيالية على طبقاتها، ثم النفوس الوهمانية، وكذلك وهذه أقصى درجات النفس الحيوانية بما هي حيوانية، ثم تتكون النفس الناطفة الملكية وهي نور من أنوار الله المعنوية قد طلع عن أُفق عالم الآخرة، وهي أول من قرع باب الملكوت، فأول درجاتها العقل اليهولاني، وهو بذر شجرة العقل والعرفان وحبة ثمرة المعرفة والإيمان، ثم يتكون منه العقل الاستعدادي، ثم العقل بالفعل، ثم المستفاد المضيء في المعاد، ثم العقل الفعَّال للمعقولات والأنوار، والفياض لوجد الحقائق والأسرار.
فإذا علمت هذا في مراتب الإنسان، وسفره وسلوكه في درجات الأبدان والنفوس والعقول إلى أن بلغ في الارتقاء إلى أقصى الغايات التي نزل منها. فاعلم هذا في مراتب ما يتغذى به ويتقوى منه، ويستكمل ويترقى، فله في كل مقام أدوية وأغذية خاصة، وقرائن معينة، وأزواج معلومة بعضها من باب الأجسام والجسمانيات، وبعضها من باب الحواس والمحسوسات، وبعضها من باب الأوهام والخيالات، والظنون والاعتقادات، وبعضها من باب العقول والمعقولات وبعضها من باب الشهود والمشاهدات.
فما دام الإنسان في عالم الدنيا والجسمية، فلا بدَّ له من غذاء يشبه المغتذي صورة، ومادة، وقوة، فتتغذى الصورة بالصورة، والمادة بالمادة، والقوة بالقوة والحسّ بالمحسوس، ثم لكل عضو حصة من الغذاء يشابهه ويشاكله بعد مراتب النضج والاستحالات بالقوة الغاذية، التي هي في البدن بمنزلة القوة العاقلة في النفس، فلا بدَّ له أيضاً في تجوهر نفسه وذاته من أغذية علمية ومواد عقلية.
أوَ لا ترى أنَّ مادة الغذاء إذا وردت البدن وحضرت عند تصرف الغاذية، فتصرفت فيها وأحالها الهضم بقواه المسخّرة لهذا الأمر، وصيّرتها صافية عن الفضلات بصنعة طبيعية تشبه صنعة الكيمياء، فيجعلها خالصة عن شوائب الغش والغلّ، ومصفاة عن القشور في مراتب أربعة للهضوم والإحالات:
إحداها: في المعدة، فيتخلص ويتجرّد في ذنوب بعض الفضلات والغشاوات، بهذا التعذيب، وهذه الرياضة بحرارة جهنم المعدة، التي قيل لها: “هل امتلأت؟” فتقول: “هل من مزيد؟” بيد زبانية القوى التي عليها تسعة عشر، ويتوب عن خروجها قبل ذلك عن طاعة الله، وبُعدها عن عالم الاعتدال والوحدة، وانحرافها عن جادة الصراط المستقيم، ومروقها عن شريعة الطبيعة المدبرة للأجسام على نهج الحكمة.
ثم إذا فرغت هذه القوى في خدمتها التي يخصّها لهذا المسافر الغيبي في هذا المنزل، وارتقى قليلاً من هذه الهاوية المظلمة إلى طبقة أخرى فوقها، وقع بيد قوى أخرى من هذا الصنف فعملوا فيه ما أُمروا به، فانهضم في الكبد مرة أخرى، وسقط منه بعض ما بقي فيه من الفضول، فصار أخلاطاً أربعة، خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، لخروجها عن تمام التعصي عن الطاعة، وقربها من الصلاح والعبودية لأمر الله، المستعمل لها في عمارة بيت الله المعمور.
ثم إنَّ أصلح هذه الرفقاء الأربعة هو الجوهر المسمى بالدّم، فإذا وقع في العروق، وخرج منه العرق وارتاض وسلك سبيل الطاعة للنّفس. واشتغل في بيت القلب للنسك الطبيعي، ومكث قدراً صالحاً من الزمان للعابدة البدنية، صلح لأن يلبس كسوة الصورة البدنية بيد القوّة المصوّرة، مؤديّاً لشكر هذه النعمة الجسيمة فضلة من الزائد عن الحاجة بيد القوة المولدة؛ لتصير مادة البدن آخر مثله في النوع.
فإذا علمت حال استكمال البدن بما يكمله، ويزيده في المقدار والقوة إلى أقصى ما له من الكمال، فاعلم أنَّ حال استكمال النفس في أغذيتها النفسانية والعقلانية بهذا المنوال، فإنَّ النفس بقوتها الإدراكية أحضرت عندها صورة محسوسة، فأول ما تصرفت فيها بقوتها المتصرفة هو أن نزعتها عن كدر المادة التي هي كالفضلة الأولى للغذاء، والهاوية لأهل العقوبة والجزاء، فسمي هذا الفعل من النفس بـ “الإحساس” وهو تصرف فعلي من النفس، وهو كمال انفعالي للحواس.
ثم وقع منها تصرف آخر في تلك الصورة وهو تقشيرها مرة أخرى تقشيراً أتم، حتى خلعت عنها الأغشية المادية، وهذا هو “التخييل” و “التصوير” والصورة عند ذلك كمال للخيال وغذاء له، ونسبتها إليه نسبة المحسوس إلى الحسّ.
ثم فعلت فعلاً آخر بحيث انتزعت منها المادة وعوراضها بالكلية، إلاَّ أنه بقي لها علاقة إلى المادة، بحيث تضاف إلى مادة مخصوصة وهو “التوهم”.
ثم إذا عملت فيها عملاً آخر، نفضت عنها آثار المادة وعوارضها، وعلائقها وشواغلها، فصارت لبّاً خالصاً سائغاً للبيب العقل، الذي هو ملك من ملائكة الله؛ لأنها تخلصت من الذنوب والجرائم المادية، والمعاصي الجرمانية بالكلية، واستغفرت، وتابت، وأنابت، ورجعت، وآبت “والتائب من الذنب كمن لا ذنب له”.
فانظر إلى حكمة الصانع كيف أبدع قوة عاقلة، تعمل في المحسوس عملاً يجعله معقولاً وعاقلاً.
فعلم مما ذكرنا أنَّ لكل الأشياء سلوكاً طبيعياً خاصاً نحو الخير الأقصى، والمقصد الأسنى، فلكل سافل سلوك نحو العالي، ولكل عال رحمة وعناية بالسافل، تشبّهاً بالمبدإ الأول في إفاضة الخيرات كلها، وعلم أنَّ الغذاء – مثلاً – كالمغتذي يتطور بالأطوار، ويتسمى في كل طور وعالم باسم خاص يناسبه.
فأدون المنازل وأدناها عنصر، ثم بعد الاستحالات جسم مركب جمادي، كالحنطة، والخبز، والزيت، ثم بعد مراتب التصرفات، دم، وخلط صالح، ثم لحم، وغضروف، وعصب، ثم بخار لطيف حار، ثم صورة حاسة ومحسوسة، ثم صورة خيالية، ثم صورة وهمية أو عقلية، وهلمّ إلى درجة مشاهدة الأنوار الإلهية، ومعاينة الصفات اللاَّهوتية والأسماء الربانية.
فيكون لها في كل مرتبة من المراتب الخلقية والأمرية، وبحسب كل كسوة وخلقة من الأكسية والخلع النوارنية والظلمانية اسم خاص.
فضرب الله مثلاً للذين آمنوا منك ودرجاتك في العرفان والارتقاء إليه – إلى أن يصير نوراً على نور – بشجرة الزيت، وارتقائها إلى غاية الكمال، وسلوكها إلى سبيل الاهتداء بعالم النور المحسوس، ووصولها إليه حتى تصير نوراً على نور.
فالشجرة الزيتونة بمنزلة نبات يثمر غذاء وطعاماً لطيفاً للإنسان الكامل، الذي هو أشرف خلق الله وعبده الذاهب إل ربّه كالخليل (عليه السلام) حيث قال: { إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ } [الصافات:99] وكموسى (عليه السلام) حيث قال: { { إِنِّيۤ آنَسْتُ نَاراً } [طه:10] وكنبينا (صلّى الله عليه وآله) حيث قال تعالى: { { سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ } [الإسراء:1]. “والزيتونة” بمنزلة الأطعمة والأغذية التي يتناولها الإنسان ويدخلها في جوفه.
و “المشكاة” بمنزلة البدن الإنساني لكونها مطلمة في ذاتها، قابلة للنور لا على التساوي؛ لاختلاف السطوح والثُقب فيها، وهكذا حكم الجسد الإنساني في قبوله لأنوار الحسّ والحركة لا على التساوي.
“والزجاجة” القلب باعتبار تجويفه الذي يكون مكاناً للروح الحيواني، الذي بمثابة دهن الزّيت.
“والمصباح” هو الروح النفساني المنور بنور النفس الإنسانية.
وتلك الروح لغاية قربها من عالم الغيب والملكوت، يكاد زيتها يضيء ولو تمسه نار من الخارج، لأنَّ العلل الذاتية ليست أموراً خارجة عن ذوات المعلولات، فالقابل لنور النّفس وإن كان مفتقراً في الاستنارة بها إلى العقل الفعّال، لكنّه غير مفتقر إلى سبب خارج عن ذاته، فكأنه مكتف بذاته عن السبب.
وأمّا وصف “الزجاجة” بأنها “كوكب دريّ” فذلك لكون القلب في الحقيقة، هو تجويفه الذي يملتئ بنور الروح الحيواني ويتنوّر به.
وأمّا كونه “متوقّداً من شجرة مباركة” فلكون مادة روحه من الأشجار والنباتات الغذائية الكثيرة البركات؛ لحصول الأرواح، ونفوسها، وعقولها منها ومن موادها بعد استحالات وحركات كثيرة، كما أنَّ الزيت إنَّما هو يحصل من شجرة الزيتونة بعد تعصيرات شديدة.
وأمّا وصف الشجرة بأنّها “لا شرقية ولا غربية” فإنَّ ألطف الأغذية، وأعدل الأمزجة؛ إنَّما يتكون في البلاد والبقاع التي كان في أوساط الربع المكشوف من الأرض كما مرّ.
فصل تقديسي
هذا تأويل الآية في العالم الإنساني البدني – هو عالم صغير جسماني – ولها تأويلان آخران أحدهما: في عالم الآفاق، والثاني: في عالم الأنفس:
أما الأول: فالمشكاة عالم الأجسام، والزجاجة: العرش، والمصباح: الروح الأعظم، والشجرة: هي الهيولى الكلية التي هي مادة حقائق الأجسام وصورها المختلفة؛ التي هي بمنزلة الأغصان والأوراق، وهي في نفسها أمر ملكوتي عقلي، إلاَّ أنها أخس الجواهر الملكوتية وأدناها، وهي نهاية عالم الأرواح وبداية عالم الأجسام، فتكون غير منسوبة إلى شرق عالم العقول والأرواح، ولا إلى غرب عالم الأجسام والأشباح.
يكاد زيتها – وهو عالم الأرواح النفسانية – يضيء بأنوار العقول الفعّالة، ولو لم تمسسه نار نور القدرة الأزلية، وذلك لقرب طبيعتها من الوجود، نور على نور، فالأول: نور الرحمة الإلهية، والمعرفة الربانية، والثاني: نورالروح الأعظم والعقل الفعَّال، إذ الأول نور العقل الفعَّال، والثاني نور النفس الكلية، التي هي نور العرش، وهو مستوى نور الرحمة الرحمانية العقلية، التي هي كصورة الرحمن، فيكون نوراً على نور، كقوله تعالى: { { ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ } [طه:5]. وفي قوله تعالى: {يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ} إشارة إلى أن فيض نور الرحمانية ينقسم على كل من يريد الله إيجاده من العرش إلى الثرى.
فصل:
وأما التأويل الآخر فهو الذي أفاده الشيخ أبو علي ابن سينا، وأوضحه شارح إشاراته وموضح تنبيهاته (قدّس سرّهما) منزلاً على مراتب النفس الناطقة في ارتقائها إلى عالم الربوبية.
فكانت المشكاة العقل الهيولاني لكونها مظلمة الذات، قابلة للأنوار العقلية على تفاوت استعداداتها قرباً وبعداً، والزجاجة هي العقل بالملكة؛ لأنها شفَّافة في ذاتها، قابلة للنور أتمّ قبول كالكوكب الدريّ.
و “الشجرة الزيتونة” هي القوة الفكرية والفكر؛ لأنها مستعدة لأن تصير قابلة للنور بذاتها، لكن بعد حركة كثيرة وتعب. وكونها مباركة لِمَا يترتّب عليها، ويحصل لها من حدود الأشياء، ونتائج البراهين الحقة، وكونها لا شرقية ولا غربية لكون الفكر يجري في المعاني الكلية، والمفهومات الذهنية – والقضايا المعقولة ليست من غرب الموجودات الحسية الهيولانية، ولا من شرق العقول الفعَّالة القائمة بأنفسها -.
و “الزيت” هو الحدس لكونه أقرب إلى ذلك من الزيتونة، والذي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار القوة القدسية، لأنّها تكاد تعقل بالفعل و [لو] لم يكن شيء يخرجها من القوة إلى الفعل.
و “نور على نور” هو العقل المستفاد، فإنَّ الصور المعقولة “نور” والنفس القابلة لها “نور آخر”.
والمصباح: العقل بالفعل، لأنَّه منير بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه. و “النار” هو العقل الفعَّال لأنّ المصباح يشتعل منها.
كشف إشراقي
إعلم أنَّ قوله تعالى: {لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ} إذا حمل “الشجرة الزيتونة” على الأمر العقلي، يكون معناه أنّها خارجة عن جنس الأمكنة والأحياز، كما يقال للفلك: إنَّه لا حار ولا بارد – أي: يكون خارجاً عن جنس هذه الكيفيات الملموسة.
وأما إذا حمل على الأمر الجسماني كالشجرة التي يحصل منها الزيت، والقلب الصنوبري، فيكون معناه الأمر المتوسط مكانه بينهما، كما يقال للماء الفاتر: إنه لا حار ولا بارد.
ويمكن حمل “الشرق” و “الغرب” على الآخرة والدنيا عند ما يراد من “الشجرة” القوة الفكرية أو الهيولى، ومعنى سلب الطرفين عنهما حينئذٍ يحتمل الوجهين:
إمَّا التوسط بين هذين الضدين، أو الخروج عن جنسهما.
ويمكن حمل “الشرق” و “الغرب” على الوجوب والإمكان، فإنَّ ذات الباري سبحانه مطلع أنوار الوجودات، وعالم الإمكان مغيب تلك الأنوار، وفيه أفول كواكب الحقائق الأسمائية، فحينئذٍ ينبغي أن يراد بـ “المشكاة” الطبيعة الكلية السارية المختلفة في الأجسام، و “الزجاجة” النفس الكلية المشفّة في ذاتها، القابلة للنور العقلي أتمَّ قبول، و “الشجرة الزيتونة” هي القدرة الإلهية المتشعبة إلى فنون إيجادات الحقائق المختلفة حسب اقتضاء الأسماء الحسنى، وصور علم الله المتقدمة على مظاهرها المختلفة، وموجوداتها المفصلة، والقدرة الإلهية لكونها أمراً نسبياً لازمة للذات الأحدية، ليست شرقية ولا غربية بالمعنى المذكورة، و “الزيت” هو إرادة الله، الموجبة للإضاءة والإشراق من غير افتقار إلى انضمام الداعي إليه؛ لكونه تعالى تام الفاعلية والإيجاد، مستقل القوة والقدرة لإشراق نور الوجود منه على العالم، وإن لم تمسسه نار العلة الغائية، والمصلحة الخارجية.
و “المصباح” العقل الكلي – أي عالم العقول – لكونه نيراً بذاته لتقدسه عن شوب القوة والاستعداد، ومتنوراً بالنور الفائض عن الحق الجواد على ذاته، عند مشاهدته للحق سبحانه، وشروق نور الله عليه، فكان نوراً على نور، يهدي الله لنوره من يشاء من عباده، وهو جميع الموجودات الممكنة الذوات، المهتدية بنور الوجود إلى غاياتها الذاتية بتوسط النور الأول الإبداعي العقلي، الذي هو غاية عالم الإمكان.
نكتة عرشية
يمكن أن يرد بـ “الشجرة الزيتونة” مجموع عالم الأجسام، فإنّه كشجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية؛ لأنّ مجموع “المحدد للجهات وما حواه” من حيث المجموع ليس واقعاً في مكان ولا جهة.
و “زيتها” قوة الوجود المطلق والطبيعة السارية فيه، إذ لها الاستعداد لقبول الاشتعال، والاستضاءة بمراتب الأنوار قوة وضعفاً، حسب تفاوت زيت المواد، وعظم الفتيلة وصغرها من الصور الجسمية، الفلكية والعنصرية.
و “المشكاة” هي الهيولى الكلية، أي مجموع الهيوليات.
و “المصباح” هو النفس الكلية، أي مجموع عالم النفوس المتعلقة بالأجسام المختلفة في الاشتعال والنورية، و “نوره” العقل الكلي، أي: جملة العقول المقدسة المنورة بنور المعرفة الإلهية – على تفاوت مراتبها -.
وكما أنَّ أجزاء المصباح ومواضعها متفاوتة في الإنارة والإضاءة، وفي وسط أجزاءه المتصلة موضع جزء هو أقوى الجميع قوة ونورية فكذلك في العقول القادسة عقل أول هو أشرف الممكنات وجوداً، وأقواها نورية وإشراقاً، وهو الحقيقة المحمدية المنورة بنور معرفة الله بلا واسطة، فيكون نوراً على نور، ولا يتنور من سواه بنور الحق وشهوده إلاَّ بتوسطه، فصح قوله (صلّى الله عليه وآله): “لو كان موسى في زمني ما وسعه إلاَّ اتّباعي” .
فصل:
في قوله تعالى: (يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ)
هذه النور هو النّور المحمدي الكاشف لحقائق الأشياء كما هي، والغاية المترتبة على وجود السابقين الأولين من الأنبياء، لأنه بذر طوبى عالم الإمكان، الذي غرسه يد الرحمن، والثمرة الحاصلة من شجرة وجود الأرض والسماء، والصراط المستقيم إلى حضرة الرّب تعالى، وفطرة الله التي فطر الناس عليها، فالخلق مفطورون بقبول النور المحمدي، والنفوس مجبولة على طاعة الشريعة النبوية للوصول إلى المقام المحمود، إذا لم يطرأ الضلال على سلوك الطريق، والغواية عن الذهاب إلى الغاية المقصودة.
وفي الحديث عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) “أول ما خلق الله نوري” .
وعنه أيضاً: “إن الله خلق آدم على صورة الرحمن” أي الحقيقة المحمدية خلقها على صورة اسم “الرحمن” كما خلق إبليس من صورة الاسم “المنتقم”.
وعنه أيضاً: “إن الله خلق نوري من نور عزّته، وخلق نور إبليس من نار عزّته” ، وللإشعار بأنّ الرّوح النبوي الختمي (صلّى الله عليه وآله) ليس من جنس سائر الأرواح قوله (صلّى الله عليه وآله): “لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني” .
فانظر يا مسكين وتنبّه، إنَّ من كانت أدنى أحواله وأنزلها كالبيتوتة والطعم والشرب، واقعة منه عند الرب تعالى، كيف يكون من جنس من لا يكون أشرف أحواله مثل المعرفة والفكر حاصلة عنده؟ فإنَّ الجسمانيات والنفوس الأرضية، بل النفوس السماوية أيضاً بمراحل عن أن يصعد أعمالها إلى عالم الإلهية.
وأمّا الروحانيات العقلية فهي متفاوتة في القرب والبعد، وما يصل إلى الله ويقع مقبولاً عنده تعالى بلا واسطة لا يكون إلاّ الطاعات المحمدية، والعبودية الأحمدية من أنوار المعارف الإلهية، الفائضة على ذاته النيرة من غير وساطة أحد، فلا يكون طاعة غيره (صلّى الله عليه وآله) مثل طاعته إلاَّ بنور متابعته ووساطته { لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً } [النور:63].
تذكرة:
قال سهل بن عبد الله التستري وشيبان الراعي: إنا سمعنا من الخضر (عليه السلام) أنَّه قال:”خلق الله نور محمد (صلّى الله عليه وآله) من نوره، فصوَّره وصدره على يده، يبقى ذلك النور بين يديه تعالى مائة ألف عام، فكان يلاحظ في كل يوم وليلة سبعين ألف لحظة ونظرة، يكسوه في كل نظرة نوراً جديداً وكرامة جديدة، ثم خلق منه الموجودات كلها” – انتهى.
وفيه إشارة إلى صدور الكائنات وصورها وآثارها كل لحظة عدداً غير محصور بتوسط نور وجود الإمكان الأشرف، والجهة المحمدية، والفيض الأقدس، الذي هو بذر الموجودات، وسببها الذاتي الفاعلي المتقدم، وثمرة شجرة الممكنات، وسببها الغائي المتأخّر، فهو الأول والآخر لكونه لبّ الألباب، وللوجود خاتمة الكتاب.
تمثيل عرشي
فانظر أيها العارف في حكمة الصانع البديع، وجود النافع المنيع الرفيع، كيف بدأ بالعقل وختم بالعاقل، وبينهما أمور متفاضلة متواصلة.
فالعقل الأول بذر العقلاء ومبدأ الفضلاء، وما عداه من العقول المتقدمة على الأجسام سيقانه، والنفس الكلية أغصانه، والأجرام الفلكية عروقه وأفنانه، والبسائط العنصريّة أوراقه، والنفوس الأرضيّة أزهاره، والنفوس الآدميّة نفائس أثماره، والعقول المستفادة لبوب حبوبه وأنواره، والروح المحمدي لبّ لبابه ودهنه وضوء سراجه.
فاعلم ما ذكر، وتحقق ما تلي عليك، وتدبّر ولا تحمله على المجاز الشعري، بل على التحقيق السرِّي، واتل قوله تعالى: { { يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ } [السجدة:5]. وامتثل أمره فيما يقول: { كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ } [آل عمران:79]. وإن لم تقدر على ذلك بنفسك، فاستفده من غيرك فإن المؤمن مرآة المؤمن.
قال بعض العرفاء في مناجاته: “إلهي ما الحكمة في خلقي؟” فألهمه الله في الجواب بقوله: “إن الحكمة في خلقك رؤيتي في مرآة روحك، ومحبتي في قلبك”. فما أعظم رتبة العبد المؤمن وما أجلّها حيث تصير صفحة قلبه مرآة لوجه الحق، متى أراد أن يتجلّى ذاته لذاته نظر إلى قلب المؤمن.
وقد ورد في الخبر: “إن الله في كل يوم وليلة ثلاث مائة وستين نظرة إلى قلب المؤمن” ويؤيد ذلك قوله (صلّى الله عليه وآله): “إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونيّاتكم” وقوله تعالى: { أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ } [العلق:14].
وقد ورد في الحديث القدسي أنه قال تعالى: “كنت كنزاً مخفياً، فخلقت الخلق لكي أُعرف” .
وهذه الثمرة للخلق والإيجاد – وهي معرفة الله – إنّما تتحقق في العبد المؤمن – أي العارف – لقوله تعالى: { وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات:56]. أي: ليعرفون. وقد ثبت أنَّ الإنسان العارف غاية إيجاد الأفلاك، والعناصر، والمركّبات، لقوله تعالى في الحديث القدسي “لولاك لما خلقت الأفلاك” ويؤيد ذلك قوله سبحانه: { لاَّ تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَارَ } [الأنعام:103].
وقوله: { أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ } [فصلت:54].
تنبيه وإشارة
لك أن تفهم من هذه الأسرار، أنَّ إدراك ذات الحق تعالى بعلم مستأنف لا يمكن لأحد إلاَّ في مرآة قلب المؤمن المتقي (التقي – النقي – ن)، ولهذا بني العالم، وخلق الكون، وأبدع النظام لقوله تعالى: { { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي ٱلآفَاقِ وَفِيۤ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } [فصلت:53]. وقوله تعالى: { { وَفِيۤ أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } [الذاريات:21].
ومما ينور أيضاً ما ذكرناه قوله (صلّى الله عليه وآله): “من رآني فقد رأى الحق” وقوله سبحانه: { { مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ } [النساء:80]. وفي الحديث عنه (صلّى الله عليه وآله): “واشوقاه إلى لقاء اخواني من بعدي” وفيما رواه كميل بن زياد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثل ذلك في كلام طويل وقول النبي (صلّى الله عليه وآله): “أدّبني ربّي فأحسن تأديبي” يشير إلى ذلك، وفي قوله سبحانه: { { وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي } [الحجر:29]. تنبيه بليغ عليه، وكذا في قوله تعالى: { { وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ } [الأحزاب:72].
وفي رموز بعض أصحاب القلوب في تفسير قوله تعالى: كنت كنزاً مخفياً – الحديث -: “العبودية بغير الربوبية نقصان وزوال، والربوبيّة بغير العبودية محال” .
ومن الإشارات إلى هذا المقصد قوله تعالى: { وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوۤاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا } [الفتح:26]. ومنها قوله تعالى: { { إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلّجَنَّةَ } [التوبة:111]. ومن التأييدات اللّطيفة لهذه الدعوى قوله تعالى: { إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً } [الأحزاب:72] وقوله: { إِنَّ ٱلإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ * إِلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ } [العصر:2 – 3]. إذ قد علم من جميع ذلك، أنَّ اللاَّئق بنظر الحق وشهوده إنَّما هو معرفة الحق، لا الإنسان ولا غيره من موجودات عالم الإمكان، وإلاَّ فما للتراب وربّ الأرباب.
وقريب من هذا ما قاله بعض المحققين من الحكماء: “إن القائل بأن الواجب موجود والعاقد لهذه القضية من عالم الإمكان ليس هو ذهن من الأذهان، بل نحو من أنحاء البرهان، فانظر إلى قوله: { وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ } [النجم:1- 5] وقوله: { { فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَىٰ * مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ } [النجم:10 – 11].
كشف حال لتحقيق مقال
يا وليي أنظر إلى التفاوت بين مرتبة موسى (عليه السلام)، وبين مرتبة سيدنا ونبينا (صلّى الله عليه وآله)، فإنَّه خرّ مغشياً عليه عند ملاحظة التجلي الواقع على الجبل، { فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَىٰ صَعِقاً } [الأعراف:143]. ثمّ تاب واستغفر من طلب ما لا يسع له درجته ووقته، وأن النبي (صلّى الله عليه وآله) حكى أنَّه في ليلة المعراج وضع الله يده بين كتفي، فوجدت برد أنامله بين ثديي.
وهذا الحديث مما يدلّ دلالة واضحة على عشقه تعالى لحبيبه، وإن كنت في ريب مما ذكرنا فاضمم إليه ما سمعته من حديث “أبيت عند ربي” وحديث “من رآني” وسائر ما نقلناه في هذا الباب؛ ليظهر لك حقيقة كلام أخيه وابن عمه، ومساهمة في همه وغمه، ومشاركه في حظه وقسمه، ووارث حوضه، وباب مدنية علمه، حيث قال سلام الله عليهما وآلهما: “رأى قلبي ربي”. وقوله أيضاً: “ما نظرت إلى شيء إلاّ ورأيت الله فيه” امتثالاً لقوله تعالى: { { أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ } [الفرقان:45].
إشارة:
إعلم أيّها الحبيب أنّه لا يعرف قدر النور إلاَّ النور، بل كل مرتبة منه لا يعرفها إلاَّ الواقع في جنس تلك المرتبة، فالنور الحسي يدرك النور الحسي، والنفسي النفسي، والعقلي العقلي، فلا يدرك نور الكواكب إلاَّ نور البصر، ولا أنوار المحسوسات إلاَّ أنوار الحواس بشرط فنائها عن كفياتها المختصة بها.
فالقوة اللَّمسية من جنس الكيفيات الأربعة، التي هي أوائل الملموسات، إلاَّ أنها معتدل متوسط بينها، وقد علمت أنَّ المتوسط بين الأطراف، بمنزلة الخالي عنها، فلذلك تقبلها، وتدركها، وتحسّ بها، وكذا الرطوبة اللّعابيّة الفائضة في جرم اللّسان ممّا لا طعم له في نفسه، لكن من شأنها أن يتكيّف بكيفية ذي الطعوم، فيدركها القوة الذوقية المساوية نسبة حاملها إلى الطعوم، مع كونه واقعة في جنس الكيفيّات الطعميّة، وقس عليه الحواس والمدارك، وهلمَّ إلى عالم العقل والمعقول وما فوقه، وفي المثل: “لا يحمل عطايا الملوك إلاَّ مطايا الملوك” لا يعرف الله غير الله (إلاّ الله – ن)”.
وقد سئل بعض المشايخ: “ما الدليل على الله؟” فقال: “دليه هو الله” وسأل العلاّمة الرازي فخر الدين الشيخ العارف نجم الدين: “بم عرفت ربك؟” فقال: “بواردات ترد على القلوب فتعجز النفوس عن تكذيبها”.
ثم وراء العقل علم، يدق عن مدارك غايات العقول السليمة.
وقال بعض المحققين: “دليل معرفة الله للمبتدئ عشقه وإرادته، إذ هما ينبعثان عن معرفة مّا وإن كانت قليلة ضعيفة، نسبتها إلى المشاهدة التامة نسبة البذر إلى الثمرة، فالمحرك للقلوب إلى الحق تعالى هو ذاته تعالى “لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك”.
قال بعض المشايخ إن الله تعالى أوحى إلى رسول الله في ليلة المعراج، يا محمّد كنت دائم الأوقات ناظراً ومستمعاً، فأنا الله سامع وناظر، وأنت القابل، والمنظور إليه { فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَىٰ } [النجم:10].
فصل
في شرح ماهية الإنسان الكامل والعالم الصغير ومظهر اسم الله، الجامع لمظاهر الأسماء كلها
وهو خليفة الله في أرضه، ومثال نور الله في سمائه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال سبحانه: { وَعَلَّمَ آدَمَ ٱلأَسْمَآءَ كُلَّهَا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰؤُلاۤءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ } [البقرة:31 – 32].
ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد
واعلم أنّ كل موجود من الموجودات التفصيليّة، التي هي أجزاء هذا العالم مظهر اسم خاص من أسماء الله تعالى، فكما أنّ أجزاء هذا العالم فيها أجناس، وأنواع، وأشخاص، وجواهر وأعراض والأغراض كمّ، وكيف، ومتى، وأين، ووضع، وإضافة، وفعل، وانفعال، وملك، فكذلك في الأسماء الإلهيّة أسماء جنسيّة ونوعيّة، وجوهرية وعرضيّة، كميّة وكيفيّة، وغيرها حذو القذ بالقذ، وكذلك في الإنسان الكامل، والمظهر الجامع، يوجد جميع ما يوجد في عالم الأسماء ومظاهر الآفاقية.
فكما أنَّ الأسماء كلها، بحسب معانيها التفصيليّة، مندمجة في معنى اسم “الله” مجملة، فكذلك حقائق مظاهرها، التي هي أجزاء العالم الكبير الآفاقية مجتمعة (محققة – ن) في مظهر اسم الله الذي هو “الإنسان الكامل” والعالم الصغير باعتبار، والكبير بل الأكبر باعتبار آخر – وهو اعتبار إحاطته العلميّة، المنبعثة عن معدن علم الله بجميع الموجودات، ومبادئها، وأسبابها، وصورها، وغاياتها، كما أشار إليه أمير المؤمنين وإما العارفين ورئيس الموحّدين (عليه السلام :
وأنت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المضمر
وتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
فنقول في تبيين ما ذكرناه من المقدّمات وتوضيح ما ادّعيناه من الحكايات:
أما أنَّ كل ممكن من الممكنات مظهر اسم خاص، فلأنّ المناسبة يجب أن تكون ثابتة بين المفيض والمفاض عليه، فتعدد الكمالات وكثرة صور المعلومات يدلّ على تحقق تلك المعاني الكلية (الكمالية – ن) والخيرات في أسبابها، وعللها على وجه أعلى وأتمّ، من غير لزوم تكثّر وتجسّم في علتها الأولى – كما ثبت في الحكمة المتعالية -.
وليس المراد من كل اسم من أسماء الله إلاَّ ذاته تعالى مأخوذة مع صفة خاصّة من الصفات الكمالية، أو السلبية، أو الإضافية، كالحيّ، والقادر، والقدوس، فذاته تعالى متّصفة بجميع الصفات الحسنة الكمالية، ومنزّهة عن جميع النقائص، والمثالب، والعيوب، وله الإضافة القيوميّة إلى كل ما سواه.
فبملاحظة اتصافها بما هو قبيل الأول منشأ الأسماء الجمالية اللطفيّة الثبوتيّة، وبملاحظة تقدسها عما هو به من قبيل الثاني منشأ الأسماء الجلاليّة القهريّة السلبيّة، وبملاحظة إشراق نوره وشهوده وإفاضة جود وجوده على الموجودات منشأ الإضافية التعقليّة، ولمَّا وجب تحقق المناسبة بين المفيض والمفاض عليه، فكل ما كان أشدّ مناسبة كان أقرب في درجة المعلولية.
وكل فاعل حقيقي للممكنات فهو علّة غائية أيضاً – كما حقق في موضعه – فيجب أن يكون الصادر منه في سلسلة بحسب القرب والبعد النزولي، صاعداً إليه في سلسلة أخرى بحسب القرب والبعد الصعودي.
وهذا أمر ظاهر بحسب الاستقراء التام في كل جملة إمكانية، صادرة عن فاعل طباعي لأجل غاية ذاتية، وله بين تفصيلي يحتاج إلى استقصاء مباحث العلّة والمعلول، وأحكام العلّة الغائية، التي مرجعها إلى تحقق العلّة الفاعلية على الوجه الأكمل الأتمِّ، سواء كانت العلة الغائية متأخرة في الوجود عن العلّة الفاعلية – كما فيما تحت الكون – أم تكونان ذاتاً واحدة – كما فيما فوق الكون.
فإذا تقرر هذا فأشرف الموجودات الصادرة عنه تعالى في سلسلة الابتداء هو “العقل الأول” والممكن الأشرف، ثم الأشرف فالأشرف إلى الأخسّ فالأخسّ حتى انتهت نوبة الوجود إلى الأجسام – وهي مواد الصنائع الإلهيّة بمنزلة قطع الخشب للنجار – ثم يبتدئ منه الاستكمال بالصور، والارتقاء إلى غاية الكمال، فيتصور بصورة بعد صورة، وبهيئة بعد هيئة كالصور والهيئات المترادفة على الخشب، بفعل التشكيلات، والتخطيطات، المتواردة عليه من صنع النجار، فيتعاقب الصور على المواد بحسب تكامل الاستعداد، من الأخس فالأخس إلى الأشرف فالأشرف، والبراءة عن النقص والفتور، والتجرّد عن الدثور والقصور، إلى العقل المستفاد المتصل بالعقل الفعّال، وهو أعلى مرتبة الوجود في العالم الإمكاني؛ لكونه مشتملاً على صور جميع الموجودات عقلية وحسيّة، من حيث ذاته، ونفسه، وجسمه، كما سنشير إليه.
فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى المبدإ الذي ابتدأ منه، وارتقى إلى ذروة الكمال بعد أن هبط منها { كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ } [الأنبياء:104].
وكما أنَّ العقل الأول مشتمل على جميع ما صدر منه – من الخيرات، والوجودات والصور، والهيئات، بحسب الفطرة الأولى – فهكذا العقل الذي وقع بأزائه، بل يكون عينه بوجه – كما أدّى إليه نظر الواغلين في الرياضة، والبرهان، والممعنين في التجرّد والإيمان – مشتمل على جميع ذلك بحسب التحصيل والاكتساب للفطرة الثانية الوجودية، المطابقة للفطرة الأولى العلمية القضائية.
وهذا مفاد قول فاضل الفلاسفة أرسطاطاليس: “من أراد الحكمة فليستحدث لنفسه فطرة ثانية” فإنَّ الحكمة عندهم هي التشبّه بالإله بحسب الطاقة البشرية، وهي إنما تحصل بحصول العقل الفعَّال.
دقيقة إلهامية:
وهاهنا دقيقة أخرى لا تقدر جماهير الفضلاء أن تدركها – فضلاً عن غيرهم من أسراء الوهم والخيال – وهو أنَّ العقل الفعّال مع أنَّه فاعل متقدم على غيره من الممكنات، فهو بعينه ثمرة حاصلة من وجوداتها المترتّبة في الاستكمال والارتقاء إلى الكمال، وهذا من أعجب العجائب مع أنَّه حق لا مرية فيه لهذا الفقير المنكسر البال، المشوش الحال.
إنارة تذكرية:
إنَّ أسماء الله تعالى مشتملة على جميع المعاني المنطقيّة والعينيّة، وجميع الحقائق الجوهرية والعرضية، وكما أنّك إذا نظرت في حقائق الأشياء وجدت بعضها متبوعة مكتنفة بالعوارض، وبعضها تابعة، فنقول على المتبوعة إنها “الجواهر” وعلى التابعة إنها “الأعراض” فاعلم أنَّ معنى “الجوهريّة” باعتبار اشتراك الجواهر فيه واتّحادها في عين جمعه مظهر للذات (الذات – ن) الإلهية من حيث قيّوميّتها، وتحققها بذاتها، وأنَّ الأعراض حسب اختلافها واشتراكها في مفهوم العرضيّة العارضة لها مظاهر للصفات التابعة للذات، مع اشتراكها في كونها صفة تابعة لها من حيث المفهوم والمعنى، وإن كان الوجود واحداً للذات والصفات.
ثمّ كما أنَّ حقيقة الجواهر لا تزال مكتنفة بالأعراض، فكذلك الذات الإلهية محتجبة عن غيره بالأسماء والصفات، وكما أنَّ الجوهر مع انضمام صفة من الصفات، يصير جوهراً خاصاً مظهراً لاسم خاص، فكذلك الذات الإلهية مع اعتبار صفة خاصة اسم خاص من الأسماء الكلية والجزئية.
وكما أنّ الصفات المخصصة للجواهر – كالفصول وغيرها – بعضها أعمّ وبعضها أخصّ كالفصول القريبة والبعيدة وتوابعها، حتى يصير الجوهر بتضمينها، أو انضمامها جنساً خاصاً، أو نوعاً، فكذلك من الصفات الإلهية ما هي أعم وأكثر حيطة، ومنها ما هي أخص وأقل حيطة، فيكون الاسم الحاصل من انضمام ما هي أعمّ، بمنزلة الجنس للاسم الحاصل من انضمام ما هي أخص، وهذا بمنزلة النوع، مثال ما هو بمنزلة الجنس لمَا هو بمنزلة النوع “العالم” بالقياس إلى “السميع” و “البصير”.
وكما أنَّ من اجتماع الجواهر البسيطة يتولّد جواهر أخر مركبة، كذلك يتولد من اجتماع الأسماء الكلية أسماء أخر.
وكما أن الجوهر قد يكون نوعاً بسيطاً في الخارج مركباً في العقل بحسب التحليل الذهني كالعقل والنفس وغيرهما – وقد يكون مركباً خارجياً من أجزاء معنوية وجودية – كالمادة والصورة – أو أجزاء متخالفة الطبائع – كالمركبات المعدنية، والنباتية، والحيوانية – فكذلك في أنواع الأسماء ما هو بسيط عيني ذا حدٍّ تفصيلي كـ “الحي” فإنَّ مفهومه مركب من “الدرك الفعّال” وما هو مركب كـ “الحي القيوم”.
وكما أن كليات الجواهر والأنواع منحصرة فكذلك كليات الأسماء منحصرة.
وكما أنّ أشخاص الجواهر غير متناهية، فكذلك فروع الأسماء غير متناهية، وكما أنَّ الجملة مشتركة في طبيعة واحدة وجودية – لأنّ الوجود الممكن حقيقة واحدة وهي المسمى بالنفس الرحماني، والهيولى العقلية الكلية الحاملة لصور الجواهر العقلية والحسية وحقائقها – كذلك الأسماء الكلية تشملها ذات واحدة إلهية جامعة لجميع الأسماء على اختلاف معانيها.
ثمّ لمَّا كانت التجليات الإلهية المظهرة للصفات المتكثرة بحكم: { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } [الرحمن:29]. غير متناهية – مع تناهي ضوابطها المتكررة الوقوع – صارت الأعراض متكثرة غير متناهية، وإن كانت الأمهات متناهية، وكما أنَّ أمهات الأعراض منحصرة في تسع مقولات، كذلك في أمهات الصفات وكلياتها توجد معان تناسبها تلك المقولات.
فكل ما في الوجود دليل وآية على ما في الغيب فـ “القيوم” مناسب للجوهر، و “القدوس” للأنواع المجرّدة منه، و “المصور” للصور الجوهرية، و “الأول والآخر” يناسب مقولة متى، و “الرافع والخافض” يناسب مقولة أين، و “المتقدّم والمتأخّر” لمقولة وضع، و “المحصي” للكم المنفصل، و “الكبير والعظيم والباسط” للكم المتصل، و “السميع والبصير” للكيف النفساني، و “العلي الأعلى” للإضافة، و “مالك الملك” للجدة، و “المبدع” للفعل، و “قابل التوب” للانفعال.
وعند الاستقصاء يظهر أنَّ كل معنى من المعاني الموجودة في عالم الشهادة، يكون ظلاً دالاًّ على ما في غيب عالم الأسماء، ثم في غيب عالم القضاء الإلهي، – أعني القلم العقلي – ثم في عالم القدر النفساني- أعني لوح العلوم القضائية، المسمى بـ “اُم الكتاب” – ثم في عالم الألواح السماوية، ونفوسها الانطباعية، الخيالية، المسمى بـ “كتاب المحو والإثبات” و “الدفتين الزمردتين”. لقوله تعالى: { يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ } [الرعد:39].
هداية:
قد انكشف لك، ودريت مما سرد عليك أنَّ هذه العوالم كلها كتب إلهية، وصحائف رحمانية، لإحاطتها بصورة الحقائق والمعاني، واشتمالها على الأرقام والخطوط الدالّة على المحامد السبحانية، والأثنية الربانية، يتلوها القارئ العارف، بقوة فكره، وصفاء سرّه، وسلامة طبعه عن كدورات هذه التعلقات، وتجرد ذهنه، وجلاء عنيه عن علوق هذه الغشاوات، فيطالع ما فيها، ويتدبر في معانيها، ويرتقي من بعضها إلى بعض، حتى يصل إلى منشئها، وراقمها، وممليها، وناظمها، قائلاً: { { سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ٱلأَقْصَى ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلبَصِيرُ } [الإسراء:1].
كلمة جامعة:
الإنسان الكامل كتاب جامع لآيات ربّه القدوس، وسجل مطوي فيه حقائق العقول والنفوس، وكلمة كاملة مملوءة من فنون العلم والشجون، ونسخة مكتوبة من مثال “كن فيكون”، بل أمر وارد من “الكاف والنون” لكونه مظهر اسم الله الأعظم الجامع لجميع الأسماء.
فمن حيث روحه وعقله، قلم مقدس مسمّى بـ “أُم الكتاب”، لكونه مشتملاً على معظم الحقائق العقلية الكلية على الوجه المقدس العقلي، ومن حيث قلبه الحقيقي – أعني نفسه الناطقة – “كتاب اللواح المحفوظ” لكونه نقوشه محفوظة أبداً بحفظ قلم الكاتب لهذه الأرقام، الفعال للمعقولات التفصيلية في لوح قلبه، ومن حيث نفسه الحيوانية الممثلة للصورة المثالية “كتاب المحو والإثبات”. ومن حيث طبعه الجسماني القائم باللطيفة البخارية، المشابه لجرم السماء، القابل لأنوار الحواس والضياء “دفتر جسماني” و “سجل هيولاني”.
والغرض في إيجاده وتكوينه لمجرد المشق والحساب، كالتخت والتراب، لفائدة التمرن لطفل النفس قبل أن يبلغ مقام الرجال، مثل لوح الأطفال، ولهذا يمحو ما فيه وينطوي سريعاً، لكونه من جنس كتاب الفجار، الملقى في النار، وأما ما سواه من الكتب الأربعة الأصول، فهي كلها صحف مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بررة، باقية إلى يوم الدين، ولا يمسها إلاَّ المطهرون، من الحجب الجسمانية، لكونها في عليين { وَمَآ أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ } [المطففين:19 – 21].
وهذا الكتاب الأخير المحاذي لصورة السماء، محترقة أوراقها بنار الطبيعة، كما أنّ سجل دورات السماء مطوية يوم القيامة، لقوله تعالى: { يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ } [الأنبياء:104]. ولكن بمقتضى { كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ } [الأنبياء:104] يعاد مثله يوم القيامة ويحشر، وهو البدن الأخروي، المنبعث من هذا البدن الداثر الدنيوي، المقبور بعد الموت، ويبقى كتابه يوم القيامة، وهو الكتاب الذي أشير إليه بقوله: { { وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً * ٱقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً } [الإسراء:14].
وهو الكتاب المنقسم إلى كتاب الفجار – الذي يلقى في النار – وإلى كتاب الأبرار، الذي يأتي آمناً يوم القيامة لقوله: { أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيۤ آمِناً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ } [فصلت:40]. وهما المشار إليهما بقوله تعالى: { { إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ } [المطففين:7]. وقوله: { إِنَّ كِتَابَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ } [المطففين:18].
نور جمعي ومظهر جامع إلهي
قد وقعت الإشارة إلى أن الإنسان الكامل كلمة جامعة، وأنموذج مشتمل على ما في الكتب الإلهية، التي كلها أنوار مكتوبة بيد الرحمن، منقوشة على صحائف الأكوان، مستورة عن أعين العميان، كما أنَّ الروح الأعظم جامع لجميع ما في العالم الكبير، لكونه مبدأ الكل، وصورة الكل، وغاية الكل، وبذر العقول والنفوس، وثمرة شجرة الأفلاك، وما فيها من أنوار المعقول والمحسوس.
فالآن نريد أن نشرح لك مراتب العالم الإنساني وأسماءه، ونبين أنَّ الروح الإنساني، والعقل الأخير الربّاني، في درجة القرب عند الله في عالم العود، والصمود، مماثل للروح الأعظم، والعقل الأول القرآني في عالم البدو والنزول، وسلطانه يوم القيامة ويوم العمل كسلطان الروح الأعظم يوم الأزل، لاشتمال كل منهما على جميع المراتب الموجودية.
بل العقل الأول والروح الأخير – وهو الحقيقة المحمدية – ذات واحدة ظهرات مرتين، مرّة في الإدبار إلى الخلق لتكميل الخلائق، ومرة في الإقبال إلى الحق تعالى، لشفاعتهم، لقوله (صلّى الله عليه وآله): “أول ما خلق الله نوري” وقوله: “أول ما خلق الله العقل، قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، قال: فبعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعظم منك، بك أُعطي وبك آخذ، وبك أُثيب، وبك أُعاقب” ورواه الشيخ الجليل أمين الإسلام، ثقة المحدثين محمد بن يعقوب الكليني في أول كتاب العقل من كتب الكافي، وهو حديث متفق على صحته الجميع.
فكما أنَّ الروح الأعظم مشتمل على جميع الممكنات علماً وعيناً، فكذا هذا الإنسان الكامل وخليفة الله في السماوات والأرض.
أما اشتمال الروح الأعظم عليها علماً: فلما مرّ من أنه قلم الحق الأول، الناقش لصور الحقائق على وجه مقدّس عن الكثرة والتفصيل، ثم الكاتب لأرقام الأسرار على ألواح الأقدار، ولأنّ اللوح المحفوظ بما فيه من الأرقام والنقوش صادر عنه، وحاضر لديه، فهو مطالع لما فيه – مطالعة العقل للأفكار الناشئة منه، المرتسمة في لوح النفس، ثم في لوح الخيال والحسّ.
وكذلك حكم سائر المشاعر الكليّة، والمدارك الفلكية، الأرواح القدريّة، بما فيها من الأرقام المثالية، والنفوس الجزئية الخيالية، الحاصلة في النفوس المنطبعة السماوية، وكذا الصور الأرضية، المنقوشة على الألواح الهيولية إذ كلّها صادرة منه بإذن ربّه، حاضرة عنده، يشاهدها بنور ربّه، الذي ينوّر به السماوات والأرض.
وأيضاً كل واحد من الجواهر العقلية والنفسية، والصور السماوية الحسية، والأنوار القمرية والشمسية عيون ناظرة، ومدارك ساطعة، ومرائي مجلوة، يدرك بها الأشياء، وينال بها ما في عالم الأرض والسماء.
وأما اشتماله عليها عيناً: فلأنّ ذاته صورة الكل، كما أنه فاعلها وغايتها. والصورة في كل حقيقة تركيبية وماهية نوعية هي تمام تلك الماهية، أوَ لا ترى أن “السرير” سرير بهيئته المخصوصة، لا بمادته الخشبية الإبهاميّة، والحيوان بنفسه وحسّه حيوان لا ببدنه وجسمه، وكذا العلة الفاعلية تمام حقيقة المعلول، إذ المعلول رشح وفيض من وجوده، وهو من العلّة كالشعاع من الشمس، والحرارة من النار، والنداوة من البحر، كما أوضحة الإلهيون في علومهم الربانية، وأما الغاية فهو تمام الفاعل بما هو فاعل وكماله.
وأما اشتمال الروح العقلي للإنسان الكامل على جميع الممكنات، فلأنه كتاب مبين مشتمل على أنموذجات العوالم، وحصصها، وجزئياتها، وأفرادها، وذلك قبل اتصاله بالملإ الأعلى، والروح الأعظم، وأما عند الوصول، فلا فرق بينه وبين قلم الحق الأول في اشتماله على الكلّ.
حكمة إلهية في كلمة آدمية:
إنَّ من عجائب صنع الله وبدائع فطرته خلقة الإنسان الذي فطره الله عالماً، مضاهياً للعالم الرباني، وأنشأه الله نشأة جامعة لجميع ما في سائر العوالم والنشآت، بل ذاتاً موصوفة بجميع نظائر ما وصف به ذاته الإلهية، من النعوت الجمالية والجلالية، والأفعال والآثار، والعوالم والنشآت، والخلائق، والقلم، واللوح، والقضاء والقدر، والملائكة والأفلاك، والعناصر والمركبات، والجنة والنار، والرضوان والمالك.
وبالجملة أبدع الإنسان الكامل مثالاً له تعالى ذاتاً ووصفاً وفعلاً، ومعرفة هذه الفطرة البديعة، والنظم اللطيف، والعلم بهذه الحكمة الأنيقة، والأسرار المكنونة فيها، سرٌّ عظيم من معرفة الله، بل لا يمكن معرفته تعالى إلاَّ بمعرفة الإنسان الكامل، وهو باب الله الأعظم والعِروة الوثقى، والحبل المتين الذي به يرتقي إلى العالم الأعلى، والصراط المستقيم، إلى الله العليم الحكيم والكتاب الكريم الوارد من الرحمن الرحيم، فيجب على كل أحد معرفة ما في هذا الكتاب المكنون، وفهم هذا السرّ المخزون.
وهذا معنى وجوب معرفة النبي، ومعرفة الإمام (عليهم السلام) “من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية” لأنَّ حياة الإنسان في النشأة الدائمة، إنما هي بمعارف الحكمة الإلهية، والإنسان الكامل تنطوي فيه الحكمة كلها، وهو مفاد قوله (صلّى الله عليه وآله): “من أطاعني فقد أطاع الله” وقوله أيضاً: “من عرف نفسه فقد عرف ربّه” .
والمراد به نفس النبي تحقيقاً لقوله تعالى: { ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } [الأحزاب:6]. وذلك لأنّ الحقيقة النبوية، بنور هدايتها كملت نفوس المؤمنين، ونور عقول الآدميين، وأخرجهم من القوة إلى الفعل، وأفاض عليهم العلم النوري، وأفادهم الوجود الأخروي، فتكون ذاته علّة لتحقق الحكمة والإيمان فيهم، ومحصل ذواتهم بحسب الوجود البقائي، والثبوت السرمدي، والعلة الفاعلية للشيء، أولى به من نفسه، لأنّ الشيء مع نفسه بالإمكان، ومع علته ومكمله بالوجوب، والوجوب والكمال أولى بالشيء من الإمكان والنقصان.
فافهم وتأمل في ما أفدناك، من معنى وجوب اتّباع النبي والإمام، وكونهما مقوِّمين لذات المؤمن بما هو مؤمن، فإنه يتيمة الوقت، لا تجده في غير هذا المقام، والله الهادي إلى دار السلام.
مرآة آدمية فيها آيات ربانية وأنوار رحمانية:
ولنذكر أنموذجاً من كتاب الحكمة الإلهية، ولباباً من المعاني القرآنية المسطورة في هذه النسخة الآدمية، المكتوبة بخط معجز إلهي، وهو الكتاب المبين، واللَّوح المنقوش بنقوش كرام الكاتبين، ليكون دستوراً لك في دراسة هذا الكتاب، الذي نالك الحق الأول فهم مقاصده، وهذا المزبور المسطور المهدى إليك من جانب الربّ الغفور، وفيه تحقيق المسائل الإلهية، وتبيين المعارف الربوبية المستنبطة من أرقامه ومبانيه، فنقول:
إعلم أنَّ الإنسان الكلي بحسب أصل ذاته التي بها هو هو موجود، بل وجوده قائم بنفسه، مجرّد عن الزمان والمكان، مقدس عن الحلول والإشارة الحسية والانقسام، نور من أنوار الله المعنوية، وسرّ من أسراره العقلية، ووجه من وجوه قدرته، وآية من آيات حكمته، وعين من عيون إلهيته، وكلمة من كلمات علمه وإرادته، وهذه الصفات الذاتية له كلها مأخوذة من الصفات الذاتية الإلهية، والنعوت الجلالية الكبريائية، وقد ظهرت في عبد من عباده.
وأما بحسب أحواله وصفاته اللازمة والعارضة، فهو عالم، قادر مريد، سميع بصير حي متكلم – إلى غير ذلك من الأوصاف – وهذه كلها تضاهي صفات الله الجلالية (الكمالية – ن) والجمالية، لأنها كلها من كمال الموجود بما هو موجود، فإذا وجد في المعلول، فلا بدَّ وأن يوجد في العلّة المفيضة على وجه أعلى وأشرف.
وأمّا بحسب أفعاله: فأفعاله كأفعال الباري جلّ ذكره، وكما أنّ أفعاله تعالى منقسمة إلى ما يدخل فيه الزمان، والمكان، والحركات، والمواد – وهي المسماة بالكائنات – وإلى ما يدخل فيه الأمكنة والمواد، دون الأزمنة والحركات – وهي الاختراعيات – وإلى ما يرتفع عنهما بالكلية – وهي المسماة بالابداعيات – فكذلك الفعل الصارد عن جوهر ذات الإنسان، بعضه يشبه الابداع – وهو ما لا يفتقر فيه إلى آله وحركة، كإدراكه المعارف الحقيقية والأحكام الحقّة اليقينية، وكإيمانه بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وإذعانه ليوم الآخرة، ورجوع الخلائق إلى الخالق وذلك عند صيرورته عقلاً مستفاداً عقيب تكرار الإدراكات وتكثر المشاهدات، حتى صار مستغنياً في إحضار مخزوناته، وإفادة معقولاته عن الآلات، والحركات الفكرية، بل كلَّما توجه إلى معقول حضر ذلك المعقول عنده ممثلاً (ماثلاً – ن) بين يدي ذاته المجردة.
وبعضه يشبه الاختراع كالحال عند تمثل الصور له في الخيال، فإن إفادة العقليات تشبه الإبداع، والخياليات تشبه الاختراع، وكذلك أفاعيله الطباعية، الواقعة منه في البدن من غير فكر وروية كحفظ المزاج، وجذب الغذاء، ودفعه، وتصوير الأعضاء وتشكيلها، بإذن الله وكلمته وتأييد من عند الله بجنود لم تروها.
وبعضه يشبه التكوين وهو أفعاله الظاهر الحاصلة بإرادته، وقصده، وحركته، كالكتابة، والأكل، والشرب، وسائر أفعاله البدنية، والنفسية، التي فيها مصلحة أعضائه، وقواه، وجنوده الظاهرة، بحسب معاشه ودنياه، بحيث يؤدي أولاه إلى إصلاح معاده، وأخراه يستعد بذلك للسعادة القصوى.
وأما من حيث مملكته، وعماله، وإجراء أوامره في عباده وبلاده، فعالمه الصغير، أعني بدنه وما يرتبط به، يضاهي مجموع العالم الكبير، أعني السماوات والأرض، وما يتعلق بهما، وأمره في أفراد عالمه يضاهي أمر الحق في أفراد العالم، فكما أنّ لأفعال الله سبحانه من لدن صدورها من مكامن غيبها إلى مظاهر شهادتها أربع مراتب – وهي العناية، والقضاء، واللوح، والقدر الخارجي – كما أشرنا إليه فكذلك لأفعال خليفة الله وصدورها أربع مراتب.
لأنّ كلما يصدر عنه فقد وجد أولاً في مكمن سرّه الذي هو غيب غيوبه، وعقله الإجمالي، وكتابه القرآني، ثم ينزل إلى حيّز قلبه الباطني، ونفسه الناطقة، عند استحضاره بالفكر، وإخطاره بالبال، كإحضار التصورات الكلية، والقضايا الكلية، أو كبريات القياس بمدد بعض ملائكة الله العلوية، عند الطلب للأمر الجزئي، وتحصيله خارجاً، وإحضاره من حدّ العلم إلى حدّ العين، فينبعث عنه العزم على الفعل.
ثم ينزل على مخزن خياله متشخصة جزئية، وهو موطن التصورات الجزئية وصغريات القياس، بيد بعض الملائكة المدبرة السفلية، ليحصل بانضمامها إلى تلك الكبريات رأي جزئي ينبعث عنه القصد الجازم للفعل، ثم تتحرك أعضاؤه عند إرادة إظهارها بيد بعض جنود الله المحركة، فيظهر ذلك الفعل المقدر على وفق الإرادة التابعة للتصوّر والتفكّر.
فالفعل (فالعقل – فالتعقل – ن) الأول بمنزلة العناية والقضاء الإجمالي، – ومحله وهو الروح العقلاني بمثابة القلم – والصورة الثانية بمنزلة نقش اللوح المحفوظ، والثالثة بمثابة الصورة في السماء، فإنَّ الروح الدماغي بمنزلة السماء، وجوهر الدماغ ومخّه بمنزلة هيولاها، والقوة الخيالية بمثابة نفس الفلك المنطبعة، والصور الخيالية بمنزلة صور الأشياء في عالم السماء قبل وجودها في المواد الخارجية، والرابعة بمثابة الصور الحادثة في المواد الخارجية العنصرية.
وعند ذلك تحرك الأعضاء بمنزلة حركة السماء، ووجود الكتابة وغيرها من الإنسان في مادة خارجية عنه، موضوعة لفعله، وصناعته بمنزلة وجود الأكوان الخارجية في المواد العنصرية، وسلطان العقل الإنساني في الدماغ كسلطان الروح الأعظم في العرش، وظهور قلبه الحقيقي الذي هو نفسه الناطقة في القلب الصنوبري، كظهور النفس الكلية الفلكية في الشمس التي هي مثال نور الله تعالى في عالم الأجرام، لأنّها نور السماوات والأرض في عالمنا.
فيكون على هذا نور الشمس بمنزلة “المصباح” و “زيتها” صورتها النوعية التي تكاد تضيء ولو لم تمسسه نار النفس المجرّدة الشمسية، والفلك كالزجاجة والهيولى كالمشكاة، والقوة الطبيعية السارية في العالم الجسماني هي الشجرة المباركة، وهي ليست من شرق الجواهر العقلية، ولا من غرب الأبعاد المادية “يكاد زيتها يضيء” وينوّر الأنوار الجسمية “وإن لم تمسسه” نار النفس الكلية المقومة لها، لكونها خليفة النفس في عالم الطبائع، كما أنَّ النفوس والعقول خلفاء الله في عالم الأرواح، و “نور على نور” هو النور الحسي من الشمس، المنضم إلى نور نفسه المجرّدة، أو نورها النفسي المقوِّم لنورها الحسّي العالمي عليه.
فعلى هذا التأويل يكون النّور الحسّي للجرم الشمسي مثالاً للنّور الواجبي، الذي هو بمثابة شمس الأنوار العقليّة، وأمَّا في سائر التأويلات الحقيقية التي ذكرناها، فهي بمعزل عن أن يكون نورها الحسّي معدوداً من نور السماوات والأرض، بل يكون معدوداً من جملة الضلال، والرماد، والمداد لكلمات الله المكتوبة من القلم العقلي، على الألواح النّفسانية، أو الأقدار الخارجيّة، كما ورد في النّظم الفارسي:
دوده كندم دبير أنجم از دود جراغ جرخ جارم.
إشراقات وإشارات:
قد انكشف لك ممّا فتحنا على قلبك بإذن الله أبوابه، وقرأنا عليك من كتاب الحكمة لبابه، أسرار لطيفة في مسائل معرفة الله، وآيات عظيمة من صحائف ملكوته، وبدائع فطرته وجوده، ونتائج رحمته، وأشعّة شمس وجوده، ولو أخذت الفطانة بيدك عند ملاحظة مملكة الآدميّ، ونفوذ أمره في قواه وآلاته، وإحاطة علمه بما هو في عالمه وطبقات مومجوداته، وسراية نوره في صوره العلميّة، ونقوشه الإدراكيّة الحاصلة في مرآة ذاته، ثم المرتسمة في ألواح تصوراته التي هي بمنزلة عالم سماواته، ثم الحالَّة في محالِّ جرمياته ومادياته، التي هي بمنزلة عالم أرضه وكائناته، لرأيت بعين هذا الإشراق، أنَّ هويّته الروحيّة هي مظهر الهوية الغيبيّة اللاَّهوتية، وأنَّ هويّته النفسية هي مظهر إسم الله، ومثال نوره النافذ في سمائه وأرضه، فتحققت بمعنى آية النور على أحكم طريق وأتقنه، وعلمت علماً شهودياً نوريّاً، وإشراقاً كشفيّاً حضورياً، أنَّ الله نور السماوات والأرض.
فإنَّ جميع ما يوجد في مملكة الآدمي وعالمه، إنّما وجودها وظهورها بنور هويته المستورة عن الخلق لغاية ظهور آثارها، وكثرة أفاعيلها وأنوارها، فصارت أفعالها وآثارها حجباً للخق عن رؤية ذاتها، ومشاهدة جمالها وجلالها، كما أنَّ ظهور العالم الكبير ومظاهر أسمائه تعالى، حجب الخلق عن مشاهدة الرب تعالى وجماله وجلاله، وبه أشرقت الأرض والسماء، وهو النور الذي ظهرت به مظاهر الأسماء.
وكما أنَّ بذاتك النّيرة العقليّة، حصلت وانكشفت وتنورّت الصور الإدراكيّة، العقليّة، والنفسيّة، والخياليةّ، والحسيّة في مراتب مداركك القضائيّة، والقدريّة، واللَّوحيّة، والقلميّة، فبذات القيّوم الإلهي تقوم وتنوّر كل ما في العوالم والنشآت، والألواح والأقدار، والأراضي والسماوات تقوماً ظهورياً شهودياً، وتنوراً تحصليّاً وجودياً.
فاشكر ربّك سبحانه في إعطائه لك مفتاحاً لخزائن الرحمة والجود، { وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ } [الأنعام:59]. – الآية – بل كنزاً مخفياً يحصل منه كل بغية ومقصود { { وَفِيۤ أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } [الذاريات:21] ودراً ثميناً يسهل به الوصول إلى كل موجود، ومرقاة للصعود إلى معارج الحق المعبود { وَفِيۤ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ } [فصلت:53].
فما من مطلب إلاَّ ويوجد فيه، وما من بغية إلاَّ ويتيسّر منه حصوله لمتأمليه، فهو الطلسم الأعظم، والترياق الدافع للسُّم، والفاروق الأكبر، وباب حكمة الله الأنور، والكتاب المبين، والسرّ المكتوم، والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ومعنى حرفيْ الكاف والنون، والقرآن المبين، والعروة الوثقى، والحبل المتين، مطردة الشياطين، وليلة القدر، والاسم الأعظم، ويوم الجمعة والمسجد الأقصى، والكعبة والحرم، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، والرقّ المنشور إلى غير لك من أسمائه وصفاته التي لا تعدّ ولا تحصى.
حكمة محمدية:
إعلم أيها السالك، وتدّبر، وتفكر، وانظر، ما سطر في هذا المسطور، ونوّر بصرك بسواد أرقام هذا المزبور، وتيقّن أنَّ الصراط المستقيم، والسبيل إلى الله الكريم ليس في الأرض ولا في السماء، ولا في البرّ ولا في البحر، ولا في الدنيا ولا في الآخرة، بل في ذات السالك الذاهب منه فيه إلى ربّه { قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِيۤ أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي } [يوسف:108].
دواؤك فيك ولا تشعر وداؤك منك ولا تبصر
وهو قلم الحق الأول، المعلم للإنسان ما لم يعلم { وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ } [النساء:113]. – الآية وهو لوح الله المأخوذ بيد الأنبياء والأوصياء، لقوله تعالى: { أَخَذَ ٱلأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى } [الأعراف:154]. { وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ } [الحشر:7]. وهو القرآن المبين وحبل الله المتين، فإنَّ القرآن خلق الإنسان الكامل، كما “وري عن بعض أزواجه (صلّى الله عليه وآله)، أنّها قالت حين سئلت عن خُلُقه (صلّى الله عليه وآله):كان خُلُقه القرآن” .
وكل ما في الأرض والسماء فهو في هذا المسمّى بجيمع الأسماء، لأنه كتاب مبين، لا رطب، ولا يابس، إلاّ فيه، ففيه النعيم ولذّاته، ومنه الجحيم وآفاته، فيك الموت والحياة، ولك الثواب والعقاب، وفيك روضة من رياض الجنان، وفيك حفرة من حفرة النيران، كما قال في المثنوي:
درونى بود روضهء از بهشت درونى بود حفرهء از كنشت
بود سنيهء كش عمارت كنند بهر دم عزيزان زيارت كنند
دكر سينهء همجو قبر يهود بر از لعنت ووحشت وجرك ودود
بر از فحش ووسواس وحرص ودروغ نكيرد زانوار حكمت فروغ
يكى لوحى از مكتب علم غيب يكى نامهء بر زوسواس وريب
بر اين ينسخه مكتوب حقه شد رقم بر آن دست ابليس درزد قلم
اللهم إني أعوذ بك من القبر، ومنشأ عذاب القبر، وباعثه هي البشرية التي كلها عذاب، فما لم يتخلص منها لم يتخلص من عذاب القبر، { { وَأَنِـيبُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ } [الزمر:54]. { وَسَارِعُوۤاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ } [آل عمران:133]. – الآية – وسئل بعض الأكابر عن عذاب القبر فقال: “القبر كلّه عذاب”.
واعلم أنَّ أول درجة من درجات السير إلى الله هو الخروج من مضيق العالم وقبر البشرية، وغبار الهيآت النفسانيّة، وفي الحديث عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): “من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي فلينظر إليّ” وأول ما ينكشف عليه من أحوال الآخرة، ويخبر بها منها هو أحوال الموتى، وكشف القبور، وتحصّل ما في الصدور، وما يتمثّل للميّت فيه من الحيّات والعقارب، والكلاب، والمؤذيات، والمعذِّبات، وسؤال المنكر والنكير.
وهذا أيضاً مما صعب دركه على أكثر أرباب الدقّة والبحث، والعقول الفلسفيّة، والطباعيّة، والدهرية، ولا يمكنهم الإيمان به، لكونه فوق أطوار عقولهم، فلم يقنعوا كسائر الناس بالتقليد المحض فيه، لاعتيادهم بعدم الإذعان بشيء إلاَّ من جهة الدليل، وليس للدليل إلى الأمور الشهوديّة والكشفيّة سبيل، فأخذوا في التعجّب قائلين: “كيف يجوز أن يسأل الإنسان ويخاطب في قبره، وينزل عليه ملكان يشهدهما الإنسان ويخاطبهما ويسمع كلامهما، ولم يرهما غير الميّت، ولم يسمع شيء منهما؟!” وفي هذا المقام سرّ عظيم لا يجوز التصريح به إلاَّ لمن ماتت رغبته في الدنيا، وخرجت روحه عن هذه المقبرة السوداء.
والغرض أنَّ الإنسان الكامل جامع جميع ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض، والسماء والأرض والنجوم، والملك والجن والحيوان، والجنّة والنار والكتاب، والصراط والميزان وغيرها، فهو خليفة الله في الأرض والسماء، فله جوهر ذاته، وأعراض صفاته، وسماء رأسه، ونجوم حواسّه، وشمس قلبه، وأرض بدنه، وجبال عظامه، وطيور قواه الإدراكيّة، ووحوش قواه التحريكية، بل كل ما أوجده الله تعالى في عالمَي الملك والملكوت، فهو مأمور بطاعة الإنسان الكامل، وسجوده، لأنّه خليفة الربّ تعالى، ومظهر جميع الأسماء لقوله: { وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ } [الجاثية:13]. وقوله: { وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً } [لقمان:20]. فجميع ذرّات الكونين يسبّح له كما يسبّح لله تعالى، وقد ورد في الحديث: “إنّ العالِم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر” .
فجملة أهل الملكوت والملك، وملائكة الله كلهم أجمعين، مأمورة من الله لقوله: { ٱسْجُدُواْ لآدَمَ } [البقرة:34]. بطاعة هذا النائب الربّاني، والسرّ السبحاني، وله خلافتان: خلافة صغرى، وخلافة كبرى، فالله تعالى لما أراد بقدرته التامة، وحكمته الكاملة، أن يجعل خليفة من قبله في أرض الخلائق، ونائباً مبعوثاً من حضرته في إنشاء الحقائق، وإفشاء المعاني، وبثّ الخيرات على القاصي والداني، سخّر له ما في الأرض جميعاً، ليجمع له أسباب السلطنة الصغرى الظاهرة وقد قيل: “السلطان ظلّ الله في الأرضين”.
وسخّر له ما في السماء ليجمع له أسباب السلطنة العظمى، فبنى له سريراً جسمانياً في بيت معمور القلب، في مملكة البدن وعالم القالب، ثم أمر الملائكة السفليّة بطاعته وانقياده، بقوله: { ٱسْجُدُواْ لآدَمَ } [البقرة:34] فسجد تحت قدمه كل ما في أرض البدن وجبال العظام، ومياه الفم والعين والأُذن، وأقاليم الأعضاء السبعة الظاهرة – وهي اليدان، والرّجلان، والظهر، والبطن، والرأس – ونجوم الحواس، وجحيم المعدة، وزبانية القوى الطبيعيّة، وعرش القلب، وكرسي الصدر، وسماوات الدماغ المشحونة بالإلهامات العقليّة، والمعاني الفكرّية، من جهة اللطيفة النورية، وهي بمثابة الملإ الأعلى لهذا الخليفة والملأ الأسفل بمنزلة الشياطين وأعداء الله، والنفس الخارجة من باطنه بمنزلة الهيولى القابلة لبسائط الصور ومركّباتها، والحروف الهجائية بمنزلة الصور النوعية البسيطة الفلكية والعنصرية، والكلمات الثلاث – وهي: الاسم، والفعل، والحرف – بمنزلة المواليد الثلاثة: الجماد، والنبات، والحيوان.
فإذا تمّت له الخلافة الصغرى، أيّده الله تعالى بجنود لم تروها لأجل الخلافة العظمى، وسخّر له بهذه الجنود الروحانية جميع عالم الملك والملكوت، لقوله تعالى: { { وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ } [الجاثية:13]. ثم أمر بطاعة هذا النائب الرباني، والسجود لهذا الخليفة الإلهي جميع ملائكة الكونين، فسد له الملائكة كلهم أجمعون، فتمّ له الخلق والأمر نيابة عنه تعالى {أَلاَ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْرُ} [الأعراف:54]. { فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ } [المؤمنون:14].
بسط كلام لتوضيح مقام:
هذا الباب الرباني، والعبد المقرّب السبحاني، والخليفة لله تعالى، والمرآة لصورة الأشياء، إنَّما فاق على الكونين بشيئين: العلم التام بحقائق الأشياء، والقدرة الكاملة على ما يشاء.
أما العلم: فعلمه منقسم إلى علم الظاهر وعلم الباطن:
فبعلمه الظهر يحيط بما يحتاج إليه في خلافته الظاهرة – من كيفية استنباط الصنائع، واستخدام الطبائع، ومعرفة تسخير الحيوانات، واصطياد الوحوش، والطيور، من الأرض والهواء، واستخراج الحيتان بقوة التدبير من قعور البحار، فينزل الطير بدقّة الفكر، وإصابة الرأي من أعلى الجو، ويصطاد الوحوش بكثرة الحيل من قُلّة الطود والجبل، ويستنبط بفرط الذكاء ودقّة الفهم، مقادير الأفلاك وأبعادها، ويعلم بمعرفة المساحة، وقوّة السّباحة بروج السماء، وتقاويم النجوم، ومقادير حركاتها وجهاتها، وأقاليم الأرض، ومقادير الجبال، ويحكم بخسوف القمر، وكسوف الشمس في أوقات معيّنة، وآنات معلومة، ويضع علوماً كعلوم الآداب، والشرائع، والأخلاق، وعلم السياسة، والحكومة، والنجوم والطب، واللغة والشعر، والأخلاق، وعلم السياسة، والحكومة، والنجوم، والطب، واللغة والشعر، والحساب والموسيقى، والفال والزجر، والشعبذة والقيافة والحيل، وجرِّ الأثقال، وإخراج القنوات، ومعرفة الجواهر والمعدنيّات، وعلم الأدوية والنباتات المفردة والمركّبة، وكيفية دفع السموم والأمراض، وعلم الدّهقنة والفلاحة، وسائر علوم الصناعات.
وأما علم الباطن فهو معرفة الروحانيات، ومكاشفة الملائكة العلويات، والإحاطة بجواهر العقليّات، والمثل الأفلاطونيّات، والاطلاع على المبادئ الأول، وما هو أول الأوائل، والغايات الأخر، وما هو غاية الغايات وبالجملة العلم بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإحاطة بصورة الوجود كله وبه يصير الإنسان، بحيث كأنه أحد سكّان الصّقع الربوبي، وموضوع العالم العقلي.
وأمّا القدرة فتمامها إنّما يظهر في النشأة الثانية، وهناك ينتج ما يكتسب هاهنا و { فِيهَا مَا تَشْتَهِيۤ أَنفُسُكُمْ } [فصلت:31]. وعند ذلك يشاهد انقياد الملائكة، وطاعتهم للإنسان الكامل طاعة لله، كما في قوله تعالى: { ٱسْجُدُواْ لآدَمَ } [البقرة:34] وفيها يتحقق خلافته لله بالحقيقة، وسرُّ قوله تعالى: { فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ } [الحجر:29].
أساس حكمي تبتني عليه أصول عرفانية:
إنَّ للحقائق المتأصلة عوالم ونشآت ومظاهر وتمثّلات، وجميعها ممّا يوجد في المسجد الجامع الإنساني، وهو صومعة أهل الذكر والتسبيح، ومعبد الخلائق كلّهم، فمنها الجنة، فإنَّ حسن خلقه الواسع جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسوء خلقه الضيّق جحيمه، وأعماله الحسنة هي الصّور الجنانيّة، من الأنهار والحور والقصور، وأعماله القبيحة صورة النيران والحيّات والمؤذيات، والحميم والزقوم.
وهذه الصفات والملكات الجملية والرذيلة، والأعمال والآثار الحسنة والقبيحة، إنَّما هي أصل ما يشاهده الإنسان في الآخرة، وبذر ما يوجد ويتحقق في العقبى، وجوداً وتحققاً، أتم وأثبت من وجود هذه الصور المادية الدنيوية فيتنعّم بها السعداء، ويتعذّب بأضدادها الأشقياء، ولأهل الجنّة اقتدار على إحضار ما يشتهون، واستحصال ما يذوقون، لهم فيها ما يدّعون، نزلاً من غفور رحيم، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين، حتى إنَّ أدنى أهل الجنان، وأبلههم يأكل في لحظة مقدار ما يأكل جملة أهل الدنيا من غير ملال وكلال، ويوجد لهم في لقمة واحدة لذات سبعين طعاماً من أطعمة الدنيا وحلاواتها.
وهذه جنة العموم – حتى البله وغيرهم – وأما جنة المحبين لله فهي ما عبّر عنها بقوله تعالى: { فَٱدْخُلِي فِي عِبَادِي وَٱدْخُلِي جَنَّتِي } [الفجر:30] وقوله: “أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر”.
والحاصل ان هذه الدرجات الجنانية العالية، ومقابلها من الدركات الجحيمية النازلة، حاضرة مع هذا الإنسان في الدنيا، والخلق غافلون عنهما إلاَّ من أيّده الله بالكشف التام، فيرى معهم وفي إهابهم ما لا ترى أنفسهم { أُوْلَـٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ } [فصلت:44]. { وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ * وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ } [الشعراء:90 – 91]. { وَمَا هُمَ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ } [الانفطار:16].
واعلم أنَّ الحق تعالى إله واحد، ورازق واحد، وباسط واحد. ينزل منه فيض واحد، ينبسط على الكل بقدر واحد من جانبه، لكن يختلف باختلاف الأذواق والمشارب، قوله تعالى: { فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ } [الحجر:22]. وقوله: { يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلأُكُلِ } [الرعد:4]. فمنه عذب فرات، لصفاء المحل وسلامة القلب، ومنه ملح أجاج، لكدورة المحل، بسبب المعاصي والآثام.
والاسم الجامع للجنة والنار، العام لجيمع مراتبهما الموجود في العالم الكبير والصغير وما فوقهما هو “الوصال للمحبوب” و “الفراق عنه” فجنة السعداء في الحقيقة هي وصولهم إلى ما يشتهون ويحبون { وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلأَنْفُسُ } [الزخرف:71]. وجحيم الأشقياء هي فراقهم عن مشتهيات الدنيا ولذَّاتها الباطلة { { وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ } [سبأ54]. وأما جنّة المقرّبين فمشاهدة معبودهم، ومقابلها وهو الاحتجاب جحيم المبعدين { { كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ } [المطففين:15].
قال بعض المحبين: “العشق هو الطريق، ورؤية المعشوق هي الجنة، والفراق هو النار، نار الله الموقدة التي تطّلع على الأفئدة”.
واعلم أن مذهب العشاق وطريقهم غير مذاهب الناس وطرائقهم، وحركة العشاق وسعيهم غير حركات الناس ومساعيهم، فاعلاً وغاية، حيث أنَّ محرّك العاشقين جذبة الحق التي توازي عمل الثقلين. وغاية سعيهم وسفرهم ومنتهى حركاتهم لقاء الله تعالى، وجحيمهم هو الاحتجاب عنه “الجار ثم الدار” وإنَّما يريدون الجنة ما قرب إليها من قول وعمل. لما فيها ظلال وجهه، وأشعة نور جماله.
ومما ينبّه على هذا الدعوى أنَّ رؤية الشمس شيء ورؤية شعاعها شيء آخر، إلاَّ أنَّ الشمس لا تعرف ولا يهتدى إليها إلاَّ بالشعاع، وهذا مثال إرادة العارف للأشياء، وطاعته لمن سواه، وهاهنا مثال آخر، أوضح من هذا عند أصحاب الفكر والخيال: إنَّ رؤية القمر في الماء شيء، ومعاينة وجه القمر ليلة البدر شيء آخر، فمن رأى وجه القمر في الماء فقد رآه إلاَّ أنَّه رآه مع حجاب من وهمه، وهكذا قلب العارف كالمرآة التي يتراءى فيها سرُّ الله، كما قال بعضهم: “مثل القلب كالمرآة، إذا نظر فيها تجلّى ربّه”.
وكان في مصحف ابن مسعود (رضي الله عنه): “مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح” فانظر كم بين قلب منوّر يشاهد فيها نور وجه الله، وبين قلب مسود منكوس كان عشّ الشيطان { { وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ } [النمل:82].
ولنعد إلى ما كنّا بصدده، وليعذرني أبناء العقول السليمة، فإنَّ الكلام يجرّ الكلام، وارتحلنا به إلى هذا المقام، وكان كلامنا أنَّ للحقائق أمثالاً في العوالم، بل بناء كل عالم على وجود المظاهر والأمثلة، فإنَّ جميع صور هذا العالم أمثلة لمَا في العالم الأعلى، يظره للنفس الإنسانية بواسطة مرائي الحواس، ومظاهر المشاعر، بل كل من كان في عالم من العوالم، يكون ذلك العالم شهادة عنده، حاضر لديه، وغيره غيباً عنه محجوباً عن نظره، والخلق وثوقهم واعتمادهم على ثبوت الصور الموجودة في هذا العالم، دون غيرها من الصور الموجودة في عالم آخر أعلى من هذا العالم، لاختلاطهم بالحواس، وامتزجهم بالمحسوسات، والعرفاء بخلافهم.
كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنَّه قال: “أنا أعرف بأحوال السماء من أحوال الأرض”وقول النبي (صلّى الله عليه وآله): “أطت السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع قدم إلاَّ وفيه [ملك] ساجد وراكع” صريح في أنه (صلّى الله عليه وآله) قد علم أحوال كل شبر من أشبار السماء، وما تعلق بها من نفس وعقل عبّر عنهما بالساجد والراكع.
والعامة والظاهريون من العلماء إنَّما اعتمادهم على صور هذا العالم، لعدم استطاعتهم على تجريد كل صورة عن جيمع خصوصيات المواد، فإذا تجردت صورة عن بعض خصوصيات المادة التي عاهدوها فيوشك أن ينكروها، لإلفهم بالمادة المخصوصة، واعتيادهم بالصور المحسوسة، وأما العالم الراسخ فكلما كانت الصورة أخلص جوهراً من المواد، وأجود وجوداً من الأغشية كانت أشدّ تحققاً عنده، وأقوم ثباتاً، وأدوم بقاء.
تأييد:
أما قرع سمعك ما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنَّه قال: “إن في الجنة سوقاً تباع فيه الصور” ونقل عن بعض الصلحاء أنّه قال: “رأيت ربّي في المنام على صورة أمي” وعبّر المعبّر “الرب” بالآيات القرآنية، و “الأم” بالنبي (صلّى الله عليه وآله) وعنده أُم الكتاب، وهذا ضرب من التمثيل ورؤية النبي (صلّى الله عليه وآله) جبرائيل تارة في وصرة أعرابي، وتارة في صورة دحية الكلبي، وتارة في صورة عظيمة كأنه طبّق الخافقين، كل ذلك من التمثيلات المختلفة بحسب المقامات المتفاوتة، والنشآت المختلفة وإلاَّ فجبرائيل حقيقة واحدة، وإنَّما اختلافه بحسب اختلاف العوالم والنشآت.
وعلى هذا القياس، الحكايات الواردة في باب النبي (صلّى الله عليه وآله) ورؤيته ربه، ورؤية سائر الأنبياء والأولياء (عليهم السلام) ربّهم على أنحاء مختلفة متفاوتة في الظهور والخفاء، بحسب ثخانة الحجاب ورقّته.
ومن جملة الحجب هوية السالك – “وجودك ذنب لا يقاس به ذنب” – وتعينه الموسوم بجبل موسى (عليه السلام)، فلما لم يفن السالك عن هويته، ولم يرتفع من البين جبل تعينه، ولم يضمحل، اضمحلال الجمد وذوبان الثلج عند استيلاء قهر شمس الحقيقة عليه، لم يشاهد ذات الحق تعالى، وأول ما يجب على السالك الذاهب إلى الله بقدم الصدق والمعرفة، أن يرفع من طريقه أذى هويته التي هي من جملة الآفلين، وإن تطورت في أطواره بصورة الطبيعة والنفس والعقل، كالكواكب والقمر والشمس، حتى يصدق كالخليل في دعواه: { وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ حَنِيفاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ } [الأنعام:79].
ومن علامات ولاية الله تعالى تمني الموت كما قال سبحانه: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوۤاْ إِن زَعمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } [الجمعة:6].
وممن شكى عن أذى هويته التي يجب على كل مسلم بمقتضى إسلامه إماطة أذاها عن طريق المسلمين – من قلبه وروحه وسرّه السالكين إلى الله تعالى – هو أبو يزيد البسطامي حيث قال: “البشرية ضد الربوبية، فمن احتجب بالبشرية فاتته الربوبية” وكذا الحسين بن منصور:
اقتلوني يا ثقاتي إنَّ في قتلي حياتي
أوَ لا ترى أنَّ المؤمنين حمدوا الله وشكروه على خلاصهم عن البشرية كما حكى الله عنهم بقوله: { { ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِيۤ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ } [فاطر:34].
تذكرة
واعلم أنَّ معرفة أحوال الموتى وذكر الموت من أعظم العبادات، لأنّ حجاب البشرية أعظم الحجب، ورفعه من أهم الأمور، ولهذا امتحن الله قلوب الناس بتمنّيه في قوله: { فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } [الجمعة:6]. وفي الحديث عنه (صلّى الله عليه وآله): “إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الموت وتلاوة القرآن” .
وإن سألت الحق، فلا يزول رين البشرية، وعين التعين عن القلوب، إلاَّ بجذبة من جذبات الحق – التي توازي عمل الثقلين – فانظر في أنّه إذا لم تخل مرآة قلب سيد الكائنات، وأشرف الممكنات عن أصيدة الالتفاتات، وعيون التوجّهات إلى هذا العالم حتى احتاج لحفظ مقام القرب والعبدية إلى الاستغفار في اليوم والليلة سبعين مرة – كما في الحديث المشهور – فمن الذي خلصت مرآته، ونقيت ذاته عن أوصاف البشرية بالكلية بمجرّد الاكتساب والعمل من غير جذبة ربانية؟
ولا بعد أن يكون قول بعض المشايخ حيث قال: “الصوفي هو الله” إشارة إلى نحو هذا، أي: التّصوف والتّجرد عن رقّ النفس وعبودية الهوى، والإقبال بالكليّة إلى الحق، إنّما يحصل بمحض جود الله، وإمداده في حق السالك المعتصم بحبله المتين، مثل إلقاء الله الإلهامات المتتالية في قلبه، وإفاضة المعارف المتواردة على سرّه، ليجرّه بالتعويد من عالم البشرية إلى عالم الربوبية، وذلك معنى قوله: { وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً } [الكهف:65].
ومن هاهنا ينكشف أنَّ العبادة من غير العلم لا وزن لها ولا قيمة، وسعي غير العارف، كحركات الأموات والجمادات لا قصد فيها، ولا معنى لها، ولا طائل تحتها، كالحركة بالعرض، فإنّ كل حركة تكون غايتها من جنس مبدئها كما يظهر بالقياس والاستقراء، وقد ثبت أنَّ الغاية هي عين الفاعل بوجه الكمال، فمبدأ الحركة إن كان طبيعة يكون غايتها أمراً طبيعياً، كالوصول إلى الحيّز الطبيعي، وإن كان أمراً حيوانياً فغايته أمر حيواني كالأكل، والشرب، والشهوة، والانتقام، وإن كان مبدأً روحانيّاً فغايته الوصول إلى عالم الملكوت كالمعارف الأخروية وإن كان أمراً إلهيّاً، فغايته القرب والمنزلة عند الله بفناء النفس عن ذاتها وبقائها بمدئها وغايتها.
فلو لم يأمر الله عبده ولا يأذن داعي الحق له في الدخول في بابه والوصول إلى جنابه في مثل قوله: { يٰأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ } [المزمل:1]. فمن الذي يقوم من نومه للصلاة أكثر الليل، ويصوم كل النهار؟ وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قبل البعثة يسهر ليله ويظمأ نهاره، ويقوم للعبادة في جبل حراء، حتى تورّمت قدماه، وكان يقول: “قرّة عيني في الصلاة” وذلك لغاية أنسه بذكر الله وعبادته، لأجل معرفته وعلمه بثمرة العبودية، وهي غاية الربوبية { { وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ } [الحجر:99] فالله سبحانه كان محرّكه وداعيه، ومربّيه وراعيه، لا شيء آخر دنيوي أو أخروي.
ولهذا سمّاه “يتيماً” في قوله: { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ } [الضحى:6] أي في جنة القدس وجوار الله وقربه، وإليه أشير بقوله (صلّى الله عليه وآله): “أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة” وجمع بين السبابة والوسطى، وإلاَّ فهذا العالم منزل الأنعام والدواب، “وهذه الدنيا جيفة وطالبها كلاب” فكيف يكون مأوى أشرف خلق الله، وإنما الدنيا كمنزل راكب وفيء زائل “وهذه دار من لا دار له” وفي الحديث عنه (صلّى الله عليه وآله): “ما مثلي ومثل الدنيا، إلاَّ كراكب استظل (قال – نزل – ن) في ظلّ شجرة، ثم راح وتركها” وإنَّما جاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى هذا العالم لهداية الخلق ونجاتهم { { قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ } [المائدة:15]. { وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } [الأنبياء:107].
ذكر تنبيهي:
بل نقول محرّك جميع الموجودات هو الباري جلّ ذكره بعشقه الساري في جميع الذرّات، ولكن بعضها بتوسط بعض، لقوله تعالى: { { إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً…. رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ } [الأعراف:54].
واعلم أنَّ العالم كلّه كشخص واحد رقّاص على اختلاف أوضاعه، وفنون حركات أعضائه، بعضها بالسرعة وبعضها بالبطؤ، وبعضها بالإيماء اليسير، وبعضها بالسكون، فيرقص ظاهره ويهتز باطنه فنوناً من الرقص والاهتزاز، بحسب الحركة الطبيعية، والنفسية، والعقلية، لدواعي مختلفة، وأغراض متفاوتة، متفاضلة في الدنو والعلو، تقرّباً إلى مبادئ مختلفة في العلوّ، والشرف، والجمال، حتى ينتهي إلى الغاية الأخيرة الإلهية للمبدإ الأول الفعّال، البريء بالكلية من النقص والزّوال في الموضوع القابل المحمدي عليه وآله أفضل الصلاة وأكمل الرحمات، فالصلوات والرحمات بمنزلة الصور المترادفة على موضوع الحركة، التي قيل في تعريفها: “إنها كمال أول لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة”.
وقس عليها حال الغاية، والفاعل، والقابل، فتحقق بقول من قال: “إنَّ من زعم أنَّ محمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية”.
إزاحة شك:
وإذا تحقّقت بما ذكر زال عنك إشكال التناقض بوجه آخر بين قول النبي (صلّى الله عليه وآله): “نورانيّ أراه” وبين قول أمير المؤمنين (عليه السلام): ” رأيته فعبدته لم أعبد ربّاً لم أره” وكذا التخالف بين ظاهري كلامين نقلا عنه (صلّى الله عليه وآله) في باب الرؤية، أحدهما: قوله لبعض أزواجه: “ما رأيت ربّي على انيته وحقيقته” والآخر: قوله (صلّى الله عليه وآله): “أول ما خلق الله نوري” وقوله: “من رآني فقد رأى الحق” .
وبما قررنا بيانه وأحكمنا بنيانه آنفاً ظهر صدق قول أساطين الحكماء: “إن القائل والحاكم بأنّ الله موجود هو نحو من البرهان الشّبيه، باللمّ، لا العقل” ويؤيده قوله (صلّى الله عليه وآله): “تفكروا في آلاء الله، ولا تتفكروا في ذات الله” لأنَّ الفكر لا يتسلّط على بارئ الكل { { وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً * وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ } [طه:110 – 111]. فذاته تعالى ممّا يستحيل لأحد الاكتناه والإحاطة به، وليس لأحد فيها قدم – أي مقام – { لاَّ تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَارَ } [الأنعام: 103] فلا يرى ذاته إلاَّ ذاته.
وفي الأدعية النبوية: “بك أحيى وبك أموت”.
ومن هذا ظهر قول ذي النون المصري: “رأيت ربي بربي، ولولا ربي لما قدرت على رؤية ربي” وقول أبي الحسين المنصور: “ما رأى أحد ربي سوى ربي”.