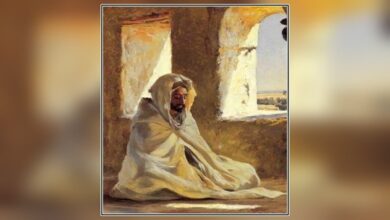طمأنينة النفس… طريق المتصوّفين إلى الله
عمر صوفي
(كاتب صحفي)
مع تقدّم الزمن، واختلاف أنماط العيش والحياة، ومع بروز أذرع الحداثة واختلاف العادات والثقافات، بتنا نعيش في عالم قلق يملؤه العنف واستغلال المصالح. بتنا في عالم ينهش الغنيّ الفقير، والكبير لا يرأف بالصغير، في عالم يقتل الأخ أخيه من أجل سيادة أو ثروة، فعن أيّ تقدّم يتحدّثون؟ في ظلّ هذه العتمة، لا بدّ من البحث عن مخرج الى النور، عن طريق لطمأنينة النفس والروح. فاذا قلّبنا في صفحات الزمن، نجد اولئك الذين زهدوا عن الدنيا وما فيها، واقتبسوا طريقا روحانيّا يوصلهم الى خالقهم، مبعث الأمن والراحة النفسية، اولئك الذين عرفوا بالصوفية. مع العلم أنّ مقالتي هذه ليست دعوة للتصوّف، بل هي دعوة للبحث عن نمط حياة روحانية، ودافع لاقتباس سلوك انسانيّ روحانيّ من أجل الابتعاد عن صراعات وتوتّرات الحياة.
يعدّ القرن الثالث هجري من أثمر القرون الفكريّة التي مرّت على العالم الاسلامي، فقد طبع متصوّفته توجّههم نحو النفس ودراستها والتعمّق بها. لقد عرف هذا القرن بقرن التناقضات وانتشار الفوضى والاضطراب، كثرت فيه الحركات التمرديّة والصراعات السياسية من أجل السيادة وتدمير الأمّة الاسلاميّة، فاتّخذت الاضطرابات أشكال عدّة، سياسيّة، اجتماعيّة، ثقافيّة وغيرها. فصوّر الحارث بن أسد المحاسبي (المتوفّى 243 ه)، أحد أكبر العلماء ذو التفكير الصوفي في ذلك الحين، الحال قائلا:” انّي تدبّرت أحوالنا في دهرنا هذا، فأطلت فيه التفكير، فرأيت زمانا مستعصيا قد تبدلت فيه شرائع الايمان، وانتقضت فيه عرى الاسلام، وتغيّرت فيه معالم الدين، واندثرت فيه الحدود”. ولكنّ المتصوفّين الحقيقيين عاشوا، رغم شدّة البلاء والمحن، حياة روحيّة خالصة، مبتعدين عن وسوسات الحياة، متسلّحين بنور ايمانهم وتوكّلهم على خالقهم. فكانت غايتهم البحث عن النفس المطمئنّة والروح المرتقية والقلب الموحّد لخالقه من أجل الوصول الى الهدف الأساسي وهو معرفة الله والحقيقة المطلقة. ان اردنا التعمّق بالحديث سنجد اختلافا بين النفس والروح والقلب، رغم تقاربهم، وطرق شتّى للوصول الى غاية كلّ منها، ولكنّ مقالتي هذه سوف تبحث في مجال النفس الصوفية وكيفيّة ارتقائها والمشاعر التي تتحكّم بصاحبها. لقد كان للقرآن الكريم الأثر الواضح لدراسة النفس لدى الصوفية والمرجع الأوّل لتحليلها ومعرفة أحوالها، فقد ذكرت بمواضع كثيرة وفي سور مختلفة ودلّت على معان متعدّدة، الّا أنّ الصوفية نسبوا اليها صفات عدّة وبدءوا بتحليلها. فكان الرأي المشتمل والمتّفق عليه أنّ النفس هي مصدر الآثام والشرور والعدوّ الأكبر الذي يجب على كلّ صوفيّ منازلته ومحاولة تروضيه. وقد قال الترمذي في هذا الموضع:” أنّ النفس جوهرها ريح حارّة مثل الدخان، ظلمانيّة سيّئة المعاملة، وروحها في الأصل نورانيّة، وتزداد صلاحا بتوفيق الله تعالى مع حسن المعاملة، وصحّة التضرّع”. لهذا سعى الصوفيّة الى الارتقاء بمقامات أنفسهم، من النفس الأمّارة بالسوء المحكومة بحبّ الشهوات وزينة الدنيا، الى النفس اللوّامة المعاتبة والمحاسبة على هفواتها، ليصلوا الى النفس المطمئنّة الراضية والمتوكّلة من أجل تحقيق غاية الوجود والقرب من الله، امتثالا بقوله تعالى:” يا أيّتها النفس المطمئنّة ارجعي الى ربّك راضية مرضيّة “. وقد ترافق مع شعور النفس المطمئنّة والراضية بما كتبه الله أحاسيس كانت للمتصوّف بمثابة مقام توّصل اليه، الّا أنّها اختلفت تفاسيرها وتحاليلها عند آخرين من فلاسفة وعلماء النفس، نذكر أبرزها شعور فقدان الخوف من الموت، واعتباره زفافا لبداية الحقيقة المنتظرة.
فاذا كان الوصول الى النفس المطمئنّة، وتحقيق مرتبة النفس الراضية، الطاهرة، القريبة من خالقها غاية لكلّ صوفيّ، فتعدّدت طرق الوصول اليها بتعدّد أنفاس الخلائق. فكلّ منهم رسم طريقه ورتّب مقاماته حسب ما يراه صحيحا له، ولكنّ نهاية المطاف كانت مشتركة وهدفهم كان واحدا. فبدئوا بتحرير أنفسهم من آفّاتها والتخلّص من أمراض قلوبهم، فلم يبق مكان لوسوسة الشيطان، ولا سبيل لتمّلك الغضب بهم، ولا دليل لصفة الغرور والتكبّر فيهم. هنا ينجح الصوفيّ بتصحيح ذاته وتجريدها من هفواتها وشهواتها، ليكون في موقع متقدّم في جهاده على نفسه، ويبدأ بالتدرّج والارتقاء من مقام حسن الى مقام أحسن، ومن حال كريم الى حال أكرم. فهذه المقامات، التي تعتبر بمثابة مدرّج سلوك للمتصوّف، والتي تعدّدت من واحد لآخر، تكتسب ببذل المجهود والسعي نحو تحقيق مقام النفس المطمئنّة وبالتالي الوصول للحقيقة المنتظرة. الّا أنّ النفس المطمئنّة والروح النقيّة كانوا نتاج التراقي في المقامات التي تنتهي بصاحبها الى التوحيد والمعرفة وهي الغاية المطلوبة للسعادة. فكانت أوّل الطريق التوبة والعفو ولوم النفس على هفواتها وتقصيراتها، اذ قال تعالى في كتابه الكريم:” وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلّكم تفلحون”، فكان طريق الفلاح عند الصوفيّة يبدأ بالتوبة والرجوع عن ما لا يرضي خالقهم. ولتتويج التوبة يأتي الصبر، فالتخلّي عن ملذات الدنيا واغراءاتها يحتاج للصبر والتحمّل ومحاربة الذات من أجل ارضاء الخالق، ويأتي الصبر مقترن بالشكر والحمد والثناء على أنعم الله التي لا تعدّ ولا تحصى وذلك لزيادة من قوّة ايمانهم ورضاهم بما كتبه الله لهم. وهنا يكون الصبر والشكر من أجل ما بعد الموت، من أجل ما وعدهم به ربّهم، فتكون هذه أعلى درجات التوكّل والرضا بما كتبه الله لهم، فيدركون أنّ الله هو صاحب الحول والقوّة وهو الذي بيده مصير كلّ شيء، فلا يبقى مكان للقلق والخوف في نفوسهم. وهكذا يكون ذلك الصوفيّ التائب، الصابر، الحامد والمتوكلّ قد أضفى على نفسه بالهدوء، الاستقرار، والطمأنينة النفسيّة.
عندما يصل الصوفيّ الى تلك المرحلة السامية، مرحلة االنفس المطمئنّة، يفقد كل شعور بالقلق من مصير مجهول أو الخوف من حقيقة مخفيّة، لأنه يدرك تماما أنّ ما ينتظره بعد الموت أجمل وأعلى مقاما من كلّ اغراءات الحياة الفانية. قال تعالى:”مثل الجنّة التي وعد المتّقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الذين اتّقوا وعقبى الكافرين النار”، فهنا ان كان الصوفيّ متوكّل على ربّه ومؤمن أنّ وعده سيحقّق، ويعوّض له عن كل ما زهد عنه من أجل خالقه، لا يبقى مكان للخوف في قلبه ويمسي منتظرا لحظة الموت وكأنّها فرحته المنتظرة. كيف يخاف من الموت وهو الوسيلة التي ستوصله الى ربّه، الى الحقيقة المطلقة، الى اللحظة المنتظرة والتي عمل من أجلها طوال حياته. فكان الموت هو الولادة الجديدة، اذ شبّهوا أنفسهم بالجنين في رحم أمّه، المكان الذي يعتبره كلّ ما يملك، الّا أنّه لا يدري أنّ ما ينتظره في العالم الحقيقيّ من نور وجبال وبحار أعظم ممّا هو فيه ولا يدركه الّا عندما يقبل الى الحياة، فكانت الدنيا للصوفيّة هي الرحم، والآخرة هي الولادة الحقيقية وما فيها أعظم وأحلى ممّا يحيط بهم. اذ اختتم فيلم بابا عزيز للمخرج الناصر خمير بقول بابا عزيز، المتصوّف، الزاهد، المتوكّل عند قبره وقبل موته:” لما أخاف، واليوم اللّيلة زفافي مع الأبديّة”. هكذا لا يعتبر المتصوّفون أنّ الموت يدعو للخوف بل للاشتياق والرجاء للّقاء مع خالقهم. فيبقى الخوف من الله والخشية من النار والرهبة من عقابه، عودة لقوله تعالى:” ويخشون ربّهم و يخافون سوء الحساب”، اعتبروا أنفسهم هم المخاطبون بهذه الآية، وأنّ هذا الخوف في قلوبهم هو الذي يظهر الخشوع في تصرّفاتهم، وميل جوارحهم الى الطاعات وتجنّب أنفسهم المعاصي وما لا يرضي خالقهم. فهنا تكون النفس المطمئنّة غاية، والموت لحظة منتظرة، وما بعد الموت الحقيقة المطلقة، والخوف يكون من ربّ الدنيا والآخرة.
لم يكن الخوف الوحيد الذي نظر اليه على أنّه مرض يتملّك بالانسان، بل الوسوسة، الحسد، الغضب وغيرها اعتبرها المتصوّفون من آفات النفس وأمراضها، وأنّها تؤثر سلبا على الانسان، لذا عملوا على مجاهدة النفس ومحاربة أمراضها. هنا يبرز دور الشيخ الصوفيّ، الذي يعتبر بمثابة ذلك الانسان الحكيم، الواصل لأعلى مقامات ودرجات التصوّف، والمرشد الذي يأخذ بنصائحه ويعتمد عليه بالتوجيه نحو الصواب. فتكمن الطريقة التي اعتمد عليها معظم الشيوخ لمعالجة النفوس المريضة، من خلال توضيح كمالات النفس وبثّ روح الايمان في النفوس الضعيفة عملا بقوله تعالى:”واذا سألك عبادي عنّي فانّي قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون”، فاعتبروا أنّ تطهير النفوس يبدأ بالايمان، وأنّ تقوية العزائم يحتاج لتفويض الأمور الى الله وامتلاء القلوب بالاخلاص والتوكّل. اضافة الى التدرّج في المقامات والاحوال التي تعدّ من كمالات النفس وتعمل على تهذيب النفس وتطهيرها، أوجد المتصوّفون اساليب وطرق للتعامل مع كلّ من المشاعر السلبيّة المتحكّمة بالانسان كالخوف، والغضب، والتكبّر وغيرها، وأحسنوا علاج اولئك المصابين بتلك الآفّات، لذا لقّبوا ب” أطبّاء نفوس من الطراز الأوّل”، أبرزهم الحارث بن أسد المحاسبي (المتوفى 243 ه). في الحقيقة لم يكن المحاسبي صوفيّا، لأنّه قد سبق نشوء تلك الحركة، الّا أنّه كان عالما كبيرا في وقته، وكانت طريقة تفكيره واهتماماته بالنفس وتهذيبها، جعلتهم يعتقدون أنّه صوفيّا. عرف المحاسبي بشخصيّته المستقلّة، وتوجّهه نحو دراسة النفس وتحليلها، فقد خلا الى نفسه زمنا طويلا يفكّر ويحلّل، ويحاول أن يجد مكانه في صف أهل السنة. ركّز المحاسبي، رائد علم النفس الاسلامي، على التحليل النفسي الدقيق وشدّد على أهميّة مراجعة الذات، فتوضّح مفهوم النفس اللوامة، وهي التي تعترض على الأفعال المؤدية للسوء وتحاول تجنّبها والندم اذا فعلتها، فقد ذكر المحاسبي أهميّة مراجعة النفس في كتابه التوهم، قائلا:”ان دأبت مكروها أصلحته وتحوّلت عنه، وان رأيت غير ذلك حمدت الله، وكانت عنايتك بذلك زيادة لك وقربة من خالقك”. هنا عندما يبدأ الصوفيّ بتنقية ذاته وتطهيرها، من خلال محاسبتها والعودة الى ما قصّر به، يخطو أوّل خطوة نحو غايته وتحقيق هدفه. وعودة لموضوع الخوف، نظر اليه المحاسبي على أنّ الخوف يكون على قدر الذنوب، أمّا الشخص المؤمن الذي طهّر قلبه من آفاته لا يبقي مكان للخوف والقلق، وقد ذكر في أحد الأحاديث أنّ للمؤمن قلبين، قلب يرجو به، وقلب يخاف به، فقد قصد أنّه عندما يحسن يرجو رحمة ربّه، وأمّا الخوف فيكون عندما يخطىء، وذلك الخوف هو من الله ومن رهبة عذابه، فيسرع الى التوبة والرجوع.
ختاما، بالرغم من انتشار الفوضى والتناقضات في القرن الثالث، وتوجّه الكثير نحو السيطرة والسيادة، بقي اولئك الذين زهدوا عن هذه الماديات الدنيويّة، وتعمّقوا في أنفسهم فحاولوا تهذيبها وتطهيرها من آفاتها. عرفوا هفواتهم وتقصيراتهم، فروّضوا نفسهم الأمّارة بالسوء وجنّبوها الملذات والشهوات، لينتقلوا الى مراجعة ذاتهم ولومها على أخطائها، وبعدها يبدؤا بالتدرّج من مقام الى مقام أعلى، ومن حال الى حال أحسن، متسلّحين بالرضا والتوكّل على الله واليقين أنّ قربهم من خالقهم هو سبيل وصولهم الى الحقيقة المطلقة. فعندما يصلوا الى مقام النفس المطمئنّة، لا يبقى داخلهم شعور خوف أو توتّر من مصير مجهول، وهذا ما يفسّر فقدانهم للخوف من الموت وانتظاره كأنّه فرحة ليلة زفافهم. اضافة الى ذلك، توضّحت أهميّة الشيخ والمرشد في هذا السياق، وكم يؤثّر في تطهير واستقامة تلك النفوس الضعيفة، فعرفوا بأطباء نفوس لدقة تحاليلهم وعمق توجيهاتهم. وهكذا يكون الصوفيّة قد نجحوا في السير نحو هدفهم وعملوا جاهدين على تحقيق غاية وجودهم، ولكن يبقى السؤال، وفي ظلّ عصر الحداثة وقرن التطورات والابتكارات، هل ستستطيع المجتمعات الزهد عن الماديات والسعي وراء معرفة سبب وجودهم في هذه الحياة؟
_____________________
*نقلًا عن موقع “الجامعة الأميركية في بيروت”.