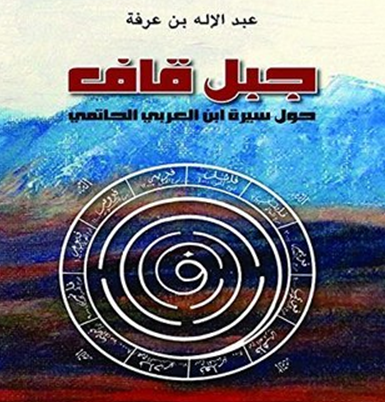
التجربة العرفانيَّة في الرواية العربيَّة المعاصرة
د. عبد الإله بن عرفة
انطلق مشروع “الرواية العرفانية” منذ مطلع الألفية الثالثة الموسوم بأحداث العنف والإرهاب ونظريات صدام الحضارات، ونهاية التاريخ التي رافقت ظهور العولمة بعد سقوط حائط برلين سنة 1989. فكان هذا المشروع إجابة أدبية غير مباشرة عن حقيقة الحضارة الإسلامية في عمقها وسطوتها، لا كما تصورها بعض وسائل الإعلام العالمية في صُوَر نمطية مغرضة. لم أكن واعياً بهذا الخَيار بما فيه الكفاية حينذاك، لكنه أصبح واضحَ المعالم بعد أن توالى إصدارُ أعمالي الروائية اللاحقة، للتّدليل على الخصائص العامة التي تطبع الحضارة الإسلامية، في كونها حضارة مبنية على المعرفة والرحمة.
قد يتساءل القارئ عن حُجِّيَّة استلهام التاريخ في الروايات التي كتبتها. وطبعاً، فقد سبق لي أن بيّنت موقفي من فلسفة التاريخ في عدد من البيانات الأدبية التي كنت أُصدِّر بها الروايات التي نشرتها، بإدخال مفهوم جديد هو مفهوم “الشهادة بالحضور”، أي أن المبدع حين يكتب عن أحداث الماضي يكتب عنها وهو حاضر فيها، منخرط في نتائجها المستقبلية، شاهد على ما جرى وما قد يجري. وبقدر حضوره في تلك الأحداث ونتائجها تُقبل أو تُرَدُّ شهادتُه. وبقدر حضوره يكون لتلك الشهادة صِدْقِيَّتُها من عدمها. كما أن حضور القارئ في النصِّ الروائي المكتوب هو الذي يحدِّد مستوى فهمِه لما حصل. وبقدر حضورِه يكون فهمُه. فهناك مستويات للفهم لأن هناك مستويات للحضور. وهذا التَّصوُّر الجديد في الكتابة الروائية هو الذي جعلني أشتغل على قضايا حضارية عالقة لحدِّ الآن. فقد نبَّهت على ضرورة تقديم إسبانيا لاعتذار تاريخي عن الجرائم التي ارتكبت بحق أبنائها من الموريسكيين الذين هُجِّروا وطُردوا وعُذِّبوا وقُتلوا في ظروف مَهينة وقاسية. لقد حاولت أن أُخلِّد بعض ملامح هذه الجرائم التاريخية في رواية “الحواميم” التي كشفَتْ بأبلغ صورة عن تلك الفظائع لما صَدَرَتْ سنة 2010 بمناسبة مرور الذكرى المئوية الرابعة على صدور قرار الطرد النهائي للموريسكيين من الأندلس في 22 سبتمبر 1609. ثم خَصَّصتُ أعمالا أخرى ارتبطت بأحداث مماثلة مع رواية “طواسين الغزالي” بمناسبة مرور 900 سنة على وفاة أبي حامد الغزالي سنة 2011، هذا المفكر الذي وضع الصياغة العامة والمصالحة بين دوائر المعرفة في العلوم الإسلامية من خلال كتابه المعروف “إحياء علوم الدين”. ورواية “ابن الخطيب في روضة طه” بمناسبة مرور 700 سنة على ولادة لسان الدين ابن الخطيب سنة 2012، وليس بمناسبة ذكرى وفاته تنبيهاً على رفض جريمة قتل هذا المبدع الكبير الذي ارتبط اسمه باسم الأندلس وصار عنواناً له حتى ألَّفَ المقَّري كتابَه الذي اختار له هذا العنوان الدال “نَفْحُ الطِّيب من غصن الأندلس الرَّطيب” وذِكْرِ وزيرها لسان الدين ابن الخطيب”. كما سيصدر بحول الله، العمل المقبل بمناسبة حلول الذكرى الألفية لقامة فكرية كبيرة. هذا الاهتمام بالتاريخ في علاقته بالراهن العربي الإسلامي يضعنا في الإشكالات الحضارية التي يراهن هذا المشروع الروائي العرفاني على رفعها ومعالجتها ضمن رؤية تنبني على فكرة الاستمرارية الحضارية والثقافية بدل فكرة الانقطاع والقطيعة مع تاريخ الأمة.
إن هذه الكتابة النورانية من حيث مصدرها (الفواتح النورانية القرآنية) وغاياتها تتوخَّى إخراجَ القارئ من ظلمة التِّيه الفكري، والجهل التاريخي، والفَوضى في المفاهيم، والكتابة السردية العدمية إلى نور الوَجْد والعلم والكِيَاسَة والرشد. ولولا النور الكامن في كل إنسان لما تخلَّصَ له النورُ المُدْرَكُ. إن المُدْرَكَ لا يُعطي المدرِك له من ذاتِه إلا بقدر استعدادِه لإدراكه. وليس الاستعداد سوى القابليَّة لِتَلَقِّي النور الكامِنِ فِي الإنسان المدرِك. فلا مِنَّةَ لأَحَدٍ عليه. وكما يقول أبو الحسن الششتري :
مِنِّي عَلَيَّ دَارَتْ كُؤُوسِي … مِنْ بَعْدِ مَوْتِي تَرَانِي حَيْ
أدب المعنى
لقد حاولت في أعمالي الروائية أن أشتغل على الأدب والرواية انطلاقاً من مفهوم جديد للأدب أسميته “أدب الحضور” و”أدب المعنى”. وأعني به التَّمَكُّن في الحضور الوجودي ذاتاً وزماناً ومكاناً. وبعبارة أخرى، إنه حضور في الآن الدائم أو الحاضر المستمر، والأين الواحد، والنَّفْسِ الكلية التي هي “المَثَلُ الأعلى” و”الكتاب المبين” و”المختَصَر الشَّريف”. ولا ينكشف المعنى إلا بالحضور. ويشبه هذا التصور للحضور ما نجده عند الفيلسوف الألماني “مارتن هايدجر” حين يتحدث عن مفهوم الدَّازَايْن. ولاشك أن ما نقوله هنا حول مفهوم “الحضور” يلتقي مع بعض دلالات ذلك المفهوم الفلسفي، لكنه أعمق من هذا وأوسع إذ لا تتحدَّثُ تلك الفلسفة إلا عن الوجود الظاهر ولم تُكابِدْ أو تَخْبُرْ قَطُّ ذَرَّة من الوجود الباطن، وليس في وسعها حتى أن تطرح السؤال عنه لأنه خارجَ دائرة يقينِها وقبضَتِها. كما أن غايةَ الحرية عندها في الموت، أما أعظمُ حرية في أدب الحضور، فهي تمتَدُّ لما بعد الموت.
إننا ندعو القارئ المُتبصِّر أن يستأنسَ بفلسفة التأويل (الهرمينوطيقا) في فهم هذا الأدب ليقف على مَسرَّات كشف المعنى لأن هذا النوع من الفلسفة هو أقرب أنواع الفكر الإنساني الكفيل بإدراك بعض أبعاد دائرة الحقيقة التي نتحدَّث من داخلها. ولقد صرَّحَتْ هذه الفلسفةُ أنها ليست نقاشاً حول المفاهيم فحسب، بل هي أولا وأخيراً كَشْفٌ للمعاني التي تُنَوِّرُ دواخِلَنا ومفاهيمنا. ومن هنا يُدرك القارئ لماذا نتحدَّث هنا عن النور الكاشف والكتابة بالنور. لأن الفهمَ يجب أن يكون هو أيضاً مُنوَّراً بهذا النور.
إن المعنى يتأسس من العلاقة بين الدَّال والمدلول، وإن ذات القارئ هي التي تؤسس هذا المعنى بين الدوال والمدلولات. أو بعبارة أوضح، إن حضورَ القارئ هو الذي يؤسس لهذه العلاقة، وغيابَه ينتجُ عنه فشلٌ في الإدراك، وبالتالي فشلٌ في الحضور، وغيابٌ عن الإدراك وغياب عن الحضور.إن حضور ذاتِ القارئ في مستوى حضوري من مستويات الفهم الممكنة هو الذي يؤسِّس لهذه العلاقة بين الدوال والمدلولات. وهو ما يسميه مارتن هايدغر (دازاين Dasein = هنا الآن)، ويسميه العارفون المسلمون والمحققون منهم بالحضرة والحضور. أن تكون هُنَا الآن يعني أن تُدْلي بشهادة حضور. هذا الشرط الوحيد هو الذي أطْلبُهُ من القارئ لأعمالي الروائية. أن يكونَ حاضراً هُنَا الآنَ وكفى، وأن يتركَ جانباً القولَ بالتأثيرات الخارجية التي لن تفيده في الفهم وتُبعده عن الحضور وتَشْرُدَ به إلى حيث يستَيْقِنُ بالأوهام، لأنه يتلمَّس الفهمَ من خارجٍ عن أبعاد الحضور الثلاثة، وهي الذات والزمان والمكان. وبعبارة أوضح، إنني أرجو أن يَسْتَنْكِفَ القارئ عن ممارسةِ وظيفة المؤرخ كما اعتاد بعض النُّقَّادُ ممارسَتَها. هذا الحضور هو الذي يُمَكِّنُ من فهم المعنى في الحاضر. فَبِدُونِ هذا الحضور لا مَطْمَعَ في انكشاف المعنى. ثم إن شكلَ وجودِ هذا الحضور الإنساني يتجلَّى في كشف المعنى بحيث يصبحُ ذلك المعنى في حدِّ ذاته مُنعَكِساً بتمكين الذَّاتِ الكاشفةِ من اكتشاف نَفْسِها.
هذه هي الكتابة بالنور كما أوضحناها في مرات متعددة في البيانات التي أصدرناها في مستهلِّ أعمالنا الروائية. وبالتالي هذا هو معنى النور ومعنى الكشف في مفهومنا. فكل قراءة متبصِّرة ينبغي أن تكون نورانية أي أن تكشفَ المعنى، وينكشف لها معناها الذاتي. ولاشك أن هناك مستوياتٍ مُتعدِّدة للفهم لأن هناك مستويات متعددة للحضور. فشكلُ الحضورِ أو الوجودِ هو الذي يحدِّدُ شكلَ الفهم. وكلما كان المرءُ أكثرَ حضوراً ووجوداً كلما كان أكثرَ فهماً ووَجْداً. فإذا لم يتيسَّر للمرءِ الإشهادُ بحضورهِ فلا مطمعَ له في إزاحة الحجب الذاتية المانعة له من الفهم. فالقارئ حِجابٌ عن نفسِه ما لم يشهَدْ بحضوره. ومقياسُ ذلك الحضورِ نستخلِصُه من مدى فهمِه وتحوُّلِهِ ووجودِه.
التأريخ والحضور الموضوعي
إن المؤرخ يدّعي أن لا علاقةَ له بأحداث الماضي وأنه غير مسؤول عمّا وقع رغم أنه يشتغل على نصوص ووثائق آتية من الماضي، وهو الذي يرتّبها ويُوجّه قراءتها، وبالتالي المعاني المستخلصة منها. فكيف يستقيم القول بعدم المسؤولية أمام مسارات التأويل التي ينهجها ؟ إن الأحداث بالنسبة للمؤرخ قد حدثَتْ وانقضتْ وهو غير مسؤول عمّا حصل، ولا يرغب في تحمُّل مسؤولية نتائج ما حصل لأنه رسم لنفسه حدودَ “الموضوعية” التي ينبغي أن يتحلّى بها حتى يُسمّى مؤرخاً. ونحن نقول على العكس من ذلك، إن ما يُنتِج الفهمَ الحقيقي للتاريخ هو الحضور في الأحداث واستثمار نتائجها في الحاضر والمستقبل. وبعبارة أخرى، إن الموضوعية الحقيقية تكمن في حضور ذاتية القارئ فيما يقرأ حتى يخلَع على الأحداث رداء المعنى. إن المؤرخ يدعونا إلى تصديقه بأنه لم يكن حاضراً في الماضي، ولا يرغب في هذا الحضور، ونحن نرى أن القارئ المتبصِّر المتأوِّل يجبُ أن يكونَ حاضراً فيما مضى مما لم يزل، لأنه لا وجودَ لشيءٍ مَضَى كما نفهم نحن، وكما تقول الفلسفة الوجودية. فإدلاؤه بشهادة الحضور يعني أنه يفتحُ إمكانيةَ المستقبلِ الكامنةَ في كُلِّ مَاضٍ. وهذا الفهمُ العميق هو الذي يجعلُ منه مسؤولاً عن الماضي وعن النتائج المستقبلية لهذا الماضي. وهذا هو ما يفسر تحمُّل الدول والشعوب والأفراد المسؤولية في الحاضر عن أخطاء أو جرائم الماضي،وتقديم الاعتذار بشأنها (العبودية، الحروب، المجازر، المحرقة…). كما أن هذه الشعوب والدول تخلِّد أمجاد الماضي وتحتفل بها وتربي أجيالها عليها، لأنها تعلم أنها هي المؤسِّسة لكيانها ووجودها وهويتها عبر التاريخ. فهل تستطيع إنسانية اليوم أن تكون من أهل الحضور وتتحمَّلَ مسؤولية ما مضى ممَّا لَمْ يَزَلْ، أم أنها تتجاهلُ تلك المسؤولية، وتعتبرُ أن ما مضى قد انقضى ؟
هذه بعض النتائج الأدبية والقانونية والفلسفية والأخلاقية التي طُرِحَتْ عَلَيَّ حين قرَّرْتُ أن أشتغل في أعمالي الروائية على فترات من التاريخ المنْسيِّ والمغيَّب، مثل طرد وتشريد الموريسكيين لترجمة هذا الصراع بين الحياة والموت، وكماله في زوج الحضور والمعنى الذي يظهر في الحاء والميم كما في رواية “الحواميم”.
إصدارات للكاتب:
– رواية طواسيم ابن حزم، دار الآداب، بيروت، لبنان2014
– رواية ياسين قلب الخلافة، دار الآداب، بيروت، لبنان، 2013.
– رواية جبل قاف حول سيرة ابن العربي الحاتمي، منشورات ضفاف،
دار الأمان، منشورات الاختلاف، بيروت، لبنان، 2013.
– رواية ابن الخطيب في جنة طه، دار الآداب، بيروت، لبنان، 2012.
– رواية طواسين الغزالي، دار الآداب، بيروت، لبنان، 2011.
– رواية الحواميم، المركز الثقافي العربي، بيروت- الدار البيضاء، 2010.
– رواية بلاد صاد، دار الآداب، بيروت، لبنان، 2009.
– رواية بحر نون، دار الأمان، الرباط، المغرب، 2007.
– رواية جبل قاف، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2002.
***
أعمال نقدية حول الرواية العرفانية :
– جماليات السرد في الرواية العرفانية، دار الآداب، بيروت، لبنان، 2014.
– الرواية العرفانية في تجربة عبد الإله بن عرفة، مطبعة الرسالة، الرباط، المغرب، 2012.
_________
* نقلًا عن موقع ” ثقافات”.





