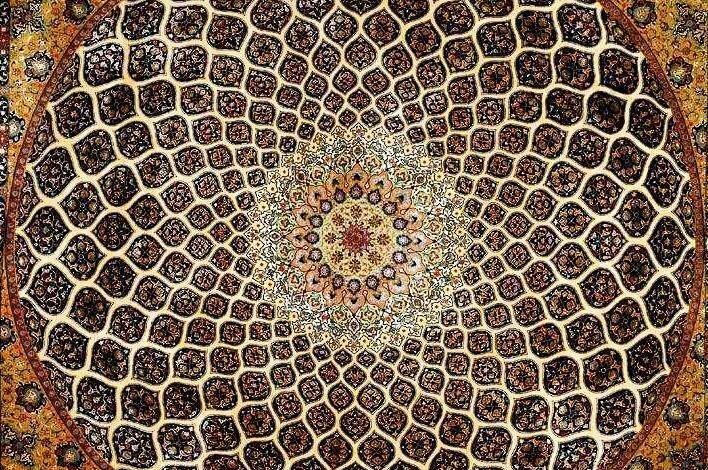
مصطلحات عرفانيَّة
الشيخ حسن بدران
توحيد
– المعنى المطابق للتوحيد – لغة واصطلاحًا – هو جعل الشيئين شيئًا واحدًا، أو صيرورة الشيئين شيئًا واحدًا، لأنه مصدر، والمصدر لا بدّ له من ذلك، فوضعوا لفظة بحسب الظاهر – الذي هو طريقة الأنبياء – لنفي آلهة كثيرة وإثبات إله واحد. يقول أهل الظاهر “لا إله إلا الله” لقوله تعالى: ﴿أجعل الآلهة إلها واحدًا إن هذا لشيء عجاب﴾. وهذا توحيد أهل الشريعة، الموسوم “بالتوحيد الألوهي”. وبحسب الباطن – الذي هو طريقة الأولياء – لنفي وجودات كثيرة وإثبات وجود واحد. يقول أهل الباطن: “ليس في الوجود سوى الله” لقوله تعالى فيه: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾. وهذا توحيد أهل الطريقة، الموسوم “بالتوحيد الوجودي”. وعلى كلا التقديرين – أعني بحسب الظاهر وبحسب الباطن – صحيح واقع مطابق، لأنه نفي وجود “الغير” من الآلهة وغيرها، ذهنًا وخارجًا، ظاهرًا وباطنًا، وإثبات وجود الحق فيهما، وهذا هو المطلوب. (الأسرار، آملي، الصفحة 76).
– حقيقة التوحيد أعظم من أن يعبر عنها بعبارة، أو يومئ إلى تعريفها بإشارة. (الأسرار، آملي، الصفحة 70).
– التوحيد: عبارة عن الوجود المطلق المحض، والذات الصرف البحت المسمى بالحق – جل جلاله – الذي لا يقبل الإشارة أصلًا ورأسًا، ولا العبارة قولًا وفعلًا، وذلك لا يكون إلا عند فناء الطالب في المطلوب، والشاهد في المشهود، وحين الاستغراق والاستهلاك في المطلق المحيط، ولا شك أنه لا يبقى مع ذلك لا الإشارة ولا المشير، ولا من الغير أثر في العقل والضمير. (الأسرار، آملي، الصفحة 72).
أقسام التوحيد
– التوحيد عند الإمام الفاضل والشيخ الكامل كمال الدين ميثم البحراني – قدس الله روحه – ينقسم إلى خمسة أقسام، كما ذكره في “شرحه الكبير لنهج البلاغة” في أول خطبته بقوله: “اعلم أن معرفة الصانع – سبحانه – على مراتب. فأولاها وأدناها أن يعرف العبد للعالم صانعًا. (المرتبة) الثانية أن يصدق بوجوده. الثالثة أن يترقى بجذب العناية الإلهية إلى توحيده وتنزيهه عن الشركاء. الرابعة مرتبة الإخلاص له. الخامسة، نفي الصفات – التي تعتبرها الأذهان له – عنه. وهي غاية العرفان ومنتهى قوة الإنسان”. (الأسرار، آملي، الصفحة 80).
– ينقسم التوحيد – بحسب المقامات العشرة – إلى عشرة أقسام، كما ذكره المولى الأعظم كمال الحق والملة والدين عبد الرزاق (الكاشاني) – قدس الله سره – في ذيل المقامات وتعريفها، وهو قوله: “وصورته (أي التوحيد) في البدايات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. وفي الأبواب تصديق الجنان بهذا المعنى، بحيث لا يخالجه شك ولا شبهة ولا حيرة. وفي المعاملات، العمل بالأركان المبني على اليقين الوجداني، وإسقاط الأسباب بحيث لا نزاع فيه للعقل، ولا تعلق فيه بالشواهد، ولا يرى صاحبه للغير تأثيرًا ولا فعلًا. وفي الأخلاق رؤية الملكات والهيئات ومصادر الأفعال كلها لله. وفي الأصول رؤية القصد والعزم والسير لله وفي الله وبالله. وفي الأودية شهود العلم والحكمة من صفات الله تعالى الأولية، وسبق الحق بعلمه وحكمه، ووضع الأشياء مواضعها، وتعليقه إياها بأحايينها، وإخفاؤه إياها في رسومها. وفي الأحوال شهود الحب من الحق بالحق للحق ذوقًا. وفي الولايات الفناء من رسم الصفات في الحضرة الواحدية، وشهود الحق بأسمائه وصفاته، لا غير. وفي الحقائق الفناء في الذات مع بقاء الرسم الخفي المنور بنور الحق، المشعر بالاثنينية، المثبت للخلة. وفي النهايات أحدية الفرق والجمع، وهو توحيد الحق ذاته بذاته”. والحق أنه كلام صادر من مشرب الذوق والشهود، ومعدن الفضل والكمال. (الأسرار، آملي، الصفحة 81).
التوحيد ألوهي وشهودي
– التوحيد أصل الدين والإسلام، لأن الإسلام الظاهر لا يحصل إلا بنفي آلهة كثيرة وإثبات إله واحد، كقولك: لا إله إلا الله. وهو كلمة التوحيد الألوهي. ولأن الإسلام الباطن لا يحصل إلا بنفي وجودات كثيرة وإثبات وجود واحد، كقولك: ليس في الوجود سوى الله، وهو كلمة التوحيد الوجودي. (الأسرار، آملي، الصفحة 68).
– التوحيد الألوهي: نفي آلهة كثيرة وإثبات إله واحد. (الأسرار، آملي، الصفحة 77).
– التوحيد الوجودي: نفي وجودات كثيرة وإثبات وجود واحد. (الأسرار، آملي، الصفحة 77).
– توحيد الأنبياء: هو التوحيد الظاهر، وهو دعوة العباد إلى عبادة إله مطلق من عبادة آلهة مقيدة أو إلى إثبات إله واحد ونفي آلهة كثيرة.. وهذا هو الموسوم بالتوحيد الألوهي. (الأسرار، آملي، الصفحة 83).
– توحيد الأولياء: هو التوحيد الباطن، وهو دعوة العباد إلى مشاهدة وجود واحد، ونفي وجودات كثيرة.. وهذا هو الموسوم بالتوحيد الوجودي. (الأسرار، آملي، الصفحة 83).
– المراد من التوحيد الألوهي وأحكامه ما كان إلا التوحيد الوجودي وأسراره، لأنه كان هو الأصل في هذه النشأة والمراد في مقام الشريعة، لأن الرسالة والنبوة التشريعية وأحكامهما – اللتين هما منشآ التوحيد الألوهي – ينقطعان بانقطاع الدنيا والنشأة الدنيوية وأحكامها والولاية – التي هي منشأ التوحيد الوجودي – باقية في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: ﴿أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين﴾. وأيضًا الولاية سابقة على النبوة والرسالة، بل هي منشؤهما ومبدؤهما. فكما كان الابتداء في الظهور بالولاية، ينبغي أن يكون الاختتام في الرجوع بها.. ولهذا في دولة المهدي – عليه السلام – تكون الدعوة إلى التوحيد الوجودي أكثر والتبري من الشرك الخفي أبلغ، حتى يكون الدين كله لله، أي الدين المسمّى بالخالص؛ لقوله تعالى: ﴿ألا لله الدين الخالص﴾، أي الدين الخالص عن الشرك الخفي والجلي، الباقي على التوحيد الصرف الوجودي الحقيقي. (الأسرار، آملي، الصفحة 100).
– التوحيد ألوهي ووجودي: التوحيد الألوهي هو توحيد الأنبياء – صلوات الله عليهم – وتوحيد الظاهر. وعليه نبّه قول الله – سبحانه -: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا أَرْبَابا مِنْ دُونِ اللهِ﴾. وقول نبيّنا – صلّى الله عليه وآله -: “أمرتُ أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلاّ الله”. والشرك المقابل لهذا التوحيد هو الشرك الجلي. وإليه الإشارة بقول الله – سبحانه -: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهة لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾. وها هنا توحيد آخر أعلى وأجلّ وأشرف وأكمل، وهو التوحيد الوجودي، وهو توحيد الأولياء – عليهم السلام -، وتوحيد الباطن. وعليه نبّه قوله – سبحانه -: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَ وَجْهَهُ﴾. وقول النبي – صلّى الله عليه وآله -: “لو أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله”. والشرك المقابل لهذا التوحيد هو الشرك الخفي. وإليه الإشارة بقوله – سبحانه -: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾. وقول النبي – صلّى الله عليه وآله – “دبيب الشرك في أمّتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء”. (عين اليقين، الفيض، 1: 335).
التوحيد عامي وخاصي وأخصي
– التوحيد العامي هو الاعتقاد بأن الله واحد مع الاعتقاد بكثرة الوجود وتباينه، و”الخاصي” هو الاعتقاد بأن الوجود الحقيقي واحد والكثرة هي الماهيات الاعتبارية، و”الخاص الخاصي” هو أن حقيقة الوجود واحدة في عين كثرتها لكونها ذات مراتب متفاضلة، وهذا هو الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة لكون المراتب سنخًا واحدًا كنوع فارد وهذا هو البينونة الصفتية؛ أو يراد بها أن افتقار وجود المعلول إلى العلة كافتقار الصفة إلى الموصوف والعرض إلى الموضوع؛ أو يراد بها أن الوجود المنبسط الذي هو فيضه مضافًا إليه إيجاده وعليته، ومضافًا إلى الماهيات معلوليتها ووجودها، فانظر كيف أبدى تفاوت الإضافة لتفاوت الأحكام. (شرح الأسماء، سبزواري، 440، الهامش 2).
التوحيد الذاتي
– التوحيد الذاتي هو إفراد ذاته القديمة عن الذوات كلها بمعنى إثبات الذات لله مطلقًا ونفيها عن غيره. (الأسرار، آملي، الصفحة 153).
– أما توحيد هذا الوجود وتفريده فلا يكون إلا بتمحيضه وتخليصه عما سواه، أعنى التوحيد الذاتى لا يمكن حصوله إلا بالخلاص عن رؤية الغير ومشاهدته، المسمى بالشرك الخفى.. ﴿أَلا لِلهِ الدينُ الْخالِصُ﴾؛ أي الخالص من الدين هو لله فقط. والخالص من الدين لا يكون خالصًا إلا إذا خلص من الشركين أي الجلي والخفي اللذين هما عبارة عن مشاهدة الغير. (الأسرار، آملي، الصفحة 127).
– الخلاص من الشرك لا يمكن إلا بمشاهدة وجود الحق المطلق وذاته بلا اعتبار غير معه أصلًا، لا ذهنًا ولا خارجًا. وإلى ذلك أشار تعالى بقوله أيضًا: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ أعني: إلى فناء كل شيء وهلاكه عند مشاهدته أشار بهذا القول، لأنه عند مشاهدة وجهه الكريم الذي هو وجوده، لا يبقى للغير اسم ولا رسم ولا أثر. وإلى إحاطته تعالى وشهوده في كل ذرة من ذرات الوجود، بعد ذلك كله – أي بعد فناء الكل وهلاكه – أشار تعالى أيضًا تأكيدًا للغرض وتتميمًا للكلام وتوضيحًا للمقصد، فقال: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾؛ أي أينما توجهتم بمثل هذا التوجه، وجدتم “ثم وجه الله” الذي هو ذاته ووجوده، وشاهدتم في الحال لا في الاستقبال معنى قوله تعالى: ﴿كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾، وصرتم عارفين به وبوجوده، واصلين إليه وإلى لقائه الموعود في القيامة الكبرى، وتحققتم أيضًا أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال في دعائه: “اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم”، وتيقنتم أنه ما طلب منه إلا اللقاء المذكور. (الأسرار، آملي، الصفحة 127).
التوحيد الصفاتي
– التوحيد الصفاتي هو إفراد صفته عن صفة غيره بمعنى إثبات الصفة لله مطلقًا ونفيها عن غيره. (الأسرار، آملي، الصفحة 153).
– صفاته في الحقيقة ليست بزائدة على ذاته المقدسة في الخارج. بل جميع صفاته في الحقيقة هي عين ذاته، أعني ليست بينها وبين الذات مغايرة حقيقة، لا ذهنًا ولا خارجًا، لأنها هي هي. (الأسرار، آملي، الصفحة 139).
– ليس هناك إلا ذات واحدة منزهة عن جميع الكثرات والاعتبارات، أعني عن الاسم والرسم والنعت والصفة، لأنه لا يصدق عليها هذه الاعتبارات إلا بالإضافة والنسبة إلى غيرها، أعني هذه الذات إذا أضفناها إلى المعلوم، سميناها عالمة وإذا أضفناها إلى المقدور، سميناها قادرة، وكذلك إلى المخلوق، والمرزوق، وغير ذلك. وإلا فهي في نفسها منزهة عن أمثال ذلك. (الأسرار، آملي، الصفحة 141).
– أحدي الذات: الحق تعالى وحداني الذات والصفات والأسماء والأفعال، بمعنى أن كل شيء نسب إليه ذات أو صفة أو اسم أو فعل، فنسبتها إليه مجازية؛ لأنها في الحقيقة عكوس أنوار تجليات الذات القديمة والصفات الأزلية والأسماء الأولية في مظاهر الكون، وليس لمظاهرها شيء منها حقيقة، كالمرآة للصور المتجلية فيها. وهذا كالسمع والبصر من الصفات مثلًا؛ فإنهما في أي موصوف كانتا فهما لله تعالى حقيقة. ونحو قوله عز وجل: ﴿وهو السميع البصير﴾ إشارة إلى تخصيصه بالصفات والأسماء، لأن “الألف واللام” فيه للحصر والتخصيص. وقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ إشارة إلى الوجود المطلق وتجرده ووحدته، والذي هو مقام الجمع والتوحيد الصرف. وقوله: ﴿وهو السميع البصير﴾ إشارة إلى الموجودات المقيدة وتنزل الوجود المطلق في مراتبه، الذي هو مقام الفرق والكثرة الأسمائية. وكذلك قوله: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾، و﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ لأن الأول إشارة إلى الفرق والكثرة، والثاني إلى الجمع والوحدة. وكذلك قوله: ﴿كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾. فالتوحيد في هذا المقام حينئذ يكون بقطع النظر عن جميع الأسماء والصفات له ولغيره، بحيث لا يبقى في نظر الناظر إلا ذات واحدة ووجود واحد منزه عن جميع الإضافات والاعتبارات، حتى يصل بذلك إلى مقام الإخلاص الذي هو التوحيد الحقيقي المشار إليه في قول الإمام عليه السلام: “وكمال الإخلاص له نفى الصفات عنه”. ويصير به من الموحدين المحققين الواصلين مقام الاستقامة والتمكين. رزقنا الله تعالى الوصول إليه بمحمد وولديه. (الأسرار، آملي، الصفحة 138).
التوحيد الأفعالي
– التوحيد الفعلي هو إفراد فعل الحق عن فعل غيره بمعنى إثبات الفاعلية لله تعالى مطلقًا ونفيها عن غيره. (الأسرار، آملي، الصفحة 153).
– اعلم أن فعل الله تعالى عبارة عن صدور الموجودات عنه، إجمالًا وتفصيلًا، غيبًا وشهادة، من الأزل إلى الأبد، صدورًا غير منقطع؛ لقوله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾، ولقوله تعالى: ﴿بل هم في لبس من خلق جديد﴾. وبيان ذلك على حسب الترتيب، هو أن الله تعالى لما أراد التنزل من حضرة الذات إلى حضرة الأسماء والصفات، ومنها إلى حضرة الأكوان المعبر عنها بالعالم، والظهور بصورها في قوله: “كنت كنزًا مخفيًا، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق” ظهر أولًا بصورة حقيقة كلية وتعين بها وتقيد بصورتها، وهي حقيقة “الإنسان الكبير” المسمّى بآدم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “خلق الله تعالى آدم على صورته” أعني “آدم الحقيقي” لا الصوري. وهذه الحقيقة لها أسماء كثيرة بحسب اعتباراتها: منها النور؛ لقوله عليه السلام: “أول ما خلق الله نوري”. ومنها العقل؛ لقوله: “أول ما خلق الله العقل”. ومنها القلم؛ لقوله: “أول ما خلق الله القلم”. ومنها الروح الأعظم؛ لقوله: “أول ما خلق الله الروح”. وغير ذلك من الأسماء. ثم بعد ذلك ظهر تعالى بصورة حقيقة أخرى، وهي نفس هذا الإنسان المسماة بـ “حواء الحقيقية” المخلوقة من ضلعه الأيسر، لا الأيمن؛ لأن ضلعه الأيمن إلى الله تعالى لا غير، أعني إلى الحق لا إلى الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾ الآية. ولها أيضًا أسماء كثيرة: منها النفس الكلية، واللوح المحفوظ، والكتاب المبين، وغير ذلك من الأسماء بحسب اعتباراتها أيضًا. ثم ظهر بواسطة هاتين الحقيقتين بصورة كل موجود في الوجود، علمًا كان أو عينًا، بسيطًا كان أو مركبًا، لطيفًا كان أو كثيفًا، من العقول والنفوس والأفلاك والأجرام والعناصر والمواليد؛ لقوله تعالى: ﴿وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء﴾ الآية. وكذلك إلى ما لا يتناهى، أي وكذلك يظهر بصورة كل موجود، بحسب الجزئيات والكليات أيضًا إلى ما لا يتناهى. فليس في هذا العالم، أو في هذا الوجود، فاعل بالحقيقة إلا هو، ولا فعل إلا له ﴿ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين﴾. (الأسرار، آملي، الصفحة 144).
– المواد تحت قهر الطبائع، والطبائع تحت قهر النفوس، والنفوس تحت قهر العقول، والعقول تحت قهر كبرياء الأول، وهو الله الواحد القهار. ومن وجه آخر إن الأرضيات تحت تأثير السماوات بإذن الله، والسماوات في ذل تسخير الملكوت، والملكوت في قيد أسر الجبروت، والجبروت مقهور بأمر الجبار، وهو الغالب على أمره والقاهر فوق عباده، فلا مؤثر في الوجود سواه ولا فاعل غيره:﴿وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ﴾، ﴿وَالسمَاوَاتُ مَطْوِياتٌ بِيَمِينِهِ﴾، ﴿وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾، و﴿ما مِن دَابةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾، أيدي الكل مغلولة بيد قدرته: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾، وأرجلهم معقولة بعقال مشيته: ﴿هُوَ الذِي يُسَيرُكُمْ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ﴾، وآمالهم منقطعة إلا بحوله وقوته: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَاد لِفَضْلِهِ﴾، ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾، ﴿فَسُبْحَانَ الذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ﴾، و﴿تَبَارَكَ الذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾. فكما أن الذوات كلها ترجع إلى ذات واحدة، وكذلك الصفات والأسماء، فكذلك الأفعال كلها ترجع إلى فاعل واحد؛ لاستهلاك أفاعيل الغير في فعله سبحانه كذواتهم وصفاتهم في ذاته وصفاته. ويسمى هذا بتوحيد الأفعال، كما يسمى الأول بتوحيد الذات، والثاني بتوحيد الصفات، والثالث بتوحيد الأسماء. والأسماء ترجع إلى الصفات، فالأقسام ثلاثة. وإليها أشير في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله حيث قال: “أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك” على سبيل الترقي. ثم قال: “لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك”. وكما أن لكل منها بيانًا، فكذلك لكل منها عيان، وهو أن يتحقق العبد بها ويشاهدها. (عين اليقين، الفيض، 1: 428).
تطبيقات التوحيد
– ليس له شريك في الملك: نعم الوجود الصرف الذي لا شريك له في الوجود ولا ثاني له في الوجوب كيف يكون له شريك في الملك (شرح الأسماء، سبزواري، الصفحة 609).
– لا إله غيره: أي لا معبود ولا متذلل إليه سواه قد سبق أن الموجودات لكل منها تذلل للآخر ولا سيما للسافل بالنسبة إلى العالي ولكنه باعتبار وجهه إلى الرب إليه التذلل فبالآخرة ينتهي إلى الله تعالى المعبودية والملجاية وقد قالوا في كلمة التوحيد لا بدّ أن ينظر في النفي إلى الممكنات وبطلانها الذاتي بما هي هي فينفي بكلمة لا وفي الإثبات إلى الجهة النورانية التي فيها من نور السماوات والأرض فتثبت بكلمة إلا (شرح الأسماء، سبزواري، الصفحة 668).
– لا يشبهه شيء: إذ لا ثاني له في الوجود فإن الكل منه وبه وله وإليه وما هذا شأنه بالنسبة إلى الشيء كيف يكون ثانيًا له (شرح الأسماء، سبزواري، الصفحة 741).
– في الدعاء “أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك”؛ فالفقرة الأولى إشارة إلى توحيد الأفعال والثانية إلى توحيد الصفات والثالثة إلى توحيد الذات. وفي دعاء أبي حمزة الثمالي: هربت منك إليك. (شرح الأسماء، سبزواري، الصفحة 415). وجه التوفيق بين الفقرات والتوحيدات أن الرضا هو الإرادة والمحبة والمشيئة. والمراد به المشيئة الفعلية وهي الوجود المنبسط “الله خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها”، وقال العرفاء: الوجود الحق هو الله، والوجود المطلق فعله، والوجود المقيد أثره. والمراد بالسخط هو الماهيات الإمكانية التي هي منبع النقيصة والبعد، وليست مجعولة إلا بالعرض للوجود. والمراد بالعفو الصفات اللطفية القاهرة على المظاهر، والعفو لغة المحو. والمراد بالعقاب الصفات القهرية. والمراد بالضمير في “بك، منك” هو الذات بلا تعين الصفات. (شرح الأسماء، سبزواري، الصفحة 415 الهامش).
– التوحيد هو معرفة المنزلة بين المنزلتين، والاقتصاد في العمل تحصيل الحسنة بين السيئتين، وهي أدق من الشعر وأحدّ من السيف كأن يجمع بين الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة والجبر في عين الاختيار والاختيار في عين الجبر. وورد في الأحاديث أن “بين الجبر والقدر منزلة ثالثة أوسع مما بين السماء والأرض”. وكذا في صفاته تعالى فإنه تعالى قريب في عين بعده وبعيد في عين قربه باطن في ظهوره ظاهر في بطونه عال في دنوه دان في علوه. قال آدم الأول علي عليه السلام – الذي قيل عنه: (وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي) – في بعض خطبه الشريفة: “مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة”. وفي خطبة أخرى له (ع): “لا تقدره الأوهام بالحدود والحركات ولا بالجوارح والأدوات لا يقال له متى ولا يضرب له أمد بحتى لم يقرب من الأشياء بالتصاق ولم يبعد عنها بافتراق تعالى عما ينتحله المحدودون من صفات الأقدار ونهايات الأقطار وتأثل المساكن وتمكن الآماكن فالحد لخلقه مضروب وإلى غيره منسوب”. وفي خطبة أخرى: “لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله لا يجري عليه السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه إذن لتفاوتت ذاته ولتجزء كنهه ولامتنع من الأزل معناه ولكان له وراء إذ وجد له أمام ولالتمس التمام إذ لزمه النقصان لا يتغير بحال ولا يتبدل في الأحوال ولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج”. وفي خطبة أخرى: “الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالًا فيكون أولًا قبل أن يكون آخرًا وظاهرًا قبل أن يكون باطنًا لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو منها باين”. وقال صلوات الله عليه: “هو في الأشياء على غير ممازجة خارج منها على غير مباينة فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه وأمام كل شيء ولا يقال له أمام داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل وخارج منها لا كشيء من شيء خارج”. وروى الصدوق في كتاب التوحيد عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر (ع) أنه قال: “إن الله تبارك وتعالى لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآن كما كان لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان ولا يحل في مكان ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور لا إله إلا هو الكبير المتعال”. وقال بعض العارفين: عرفت الله بجمعه بين الأضداد.. وإذا كان هذا هكذا فلما نزهه الداعي صار المقام مقام نفي التقييد وإثبات الإحاطة لعلمه وقدرته ونوريته فقال لا متحيرًا فيه ولا مفرغًا إليه ولا مطمئنًا به ولا مولعًا عليه وبالجملة لا معبود إلا أنت؛ فإن لكل موجود نصيبًا من المعبودية؛ لكونه محتاجًا إليه بوجه في نظام الكل، فللمحتاج تذلل له؛ ولذا كان عبده رسوله الخاتم، ومن ثم ومن أجل أن العبد الحقيقي وما في يده من وجوده الذي في عينه الثابت وتوابع وجوده من حوله وقوته وخيراته لمولاه، وهو صلى الله عليه وآله كان هذا شأنه، قدّم كلمة (عبده) في التشهد على (رسوله)، فهو صلى الله عليه وآله عبده بما هو هو، ونحن لسنا كذلك إلا بإعانته ووسيلته. اللهم قرب وسيلته وارزقنا شفاعته. حتى إن من غلب عليه مظهرية اسم من أسمائه تعالى صار عبد ذلك الاسم كالرحمن أو القهار أو غيرهما، ولما كان لكل موجود نصيب من المعبودية كثير من الأشياء اتخذت أصنامًا كالشمس والقمر والنجوم والنار والبقر وغيرها من الدراهم والدنانير والمشتهيات التي نعبدها حالًا لا مقالًا، وبذلك حقن دماؤنا. قال تعالى: ﴿ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان)، وقال عز اسمه ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه﴾، وفي الحديث: “شر إله أو أبغض إله عبد في الأرض الهوى”. والحاصل أنه عند طلوع نور الحقيقة ينكشف أنه لا معبود في الوجود إلا هو وأن جميع ما عداه باطل مضمحل ما خلا وجهه الكريم. (شرح الأسماء، سبزواري، الصفحة 96).
– الموجودات على تباينها في الذات والصفات والأفعال وترتبها في القرب والبعد من الحق الأول والذات الأحدية تجمعها حقيقة واحدة إلهية جامعة لجميع حقائقها وطبقاتها، لا بمعنى أن المركب من المجموع شيء واحد هو الحق سبحانه حاشا الجناب الإلهي عن وصمة الكثرة والتركب بل بمعنى أن تلك الحقيقة الإلهية مع أنها في غاية البساطة والأحدية ينفذ نورها في أقطار السماوات والأرضين فما من ذرة إلا وهو محيط بها قاهر عليها عز سلطانه.. وكل ما قيل أو يقال في تقسيم التوحيد ومراتبه ثنائيًّا وثلاثيًّا ورباعيًّا وخماسيًّا فلا يخرج عن هذين القسمين: الألوهي، والوجودي، إلا توحيد الحق سبحانه ذاته، فإنه خارج عنهما؛ وذلك لأن الكلام في التوحيد المتعلق بالسالك أو العباد، وإلا فالتوحيد الحقيقي ليس إلا ذاك. (عين اليقين، الفيض، 1: 343).
– اليه أشار الإمام – عليه السلام – بقوله أيضًا: “الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة”، إظهارًا بأنه لا ينكشف الحق حقيقة على أحد إلا عند ارتفاع الكثرة مطلقًا، اسمًا كان أو صفة. ولهذا قال: “سبحات الجلال” بدون “الجمال”، لأن الجمال مخصوص بالأسماء والصفات التي هي منشأ الكثرة لا الجلال. (الأسرار، آملي، الصفحة 72).
– قوله جل وعز: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾، والتقدير أنه تعالى يقول: سنكشف لهم حقيقة مظاهرنا الآفاقية والأنفسية، حتى يتبين لهم أي يتحقق لهم باليقين التام أن الآفاق والأنفس هي مظاهره لا غير. وبالحقيقة ليس لقاؤه الموعود في القيامة الكبرى غير ذلك. ولهذا عقبه بقوله: ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط) ليعلم أن لقاءه الموعود بغير هذا الوجه مستحيل ممتنع. وكذلك إلى مشاهدته في مظاهره الآفاقية والأنفسية أشار وقال تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾، أي أينما توليتم من الأمكنة وتوجهتم من الجهات، فثم ذاته ووجوده، لأنه المحيط، وشأن المحيط كذلك، أعني ليس مخصوصًا بمحاط دون محاط، وبموضع دون موضع. والوجه بالاتفاق هو الذات. (الأسرار، آملي، الصفحة 54).
– إلى بقاء ذاته وفناء غيره أشار وقال تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾، ﴿له الحكم وإليه ترجعون﴾. ومعناه الحقيقي، أي كل شيء مضاف إلى الوجود المطلق الذي هو وجهه وذاته، (هو) هالك زايل أزلًا وأبدًا، لأن وجوده إضافي غير حقيقي، والإضافات غير موجودة في الخارج. له الحكم وإليه ترجعون أي له البقاء الدائم والوجود السرمد، وهو الباقي على إطلاقه بعد طرح هذه الإضافات وإسقاط هذه الاعتبارات. وإليه ترجعون هذه الموجودات كلها، بعد طرح إضافتهم وإسقاط اعتبارهم. وبالنظر إلى هذا المقام قال أرباب الكشف والشهود: التوحيد إسقاط الإضافات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء. وقال العارف: (وهو) الآن كما كان، لأن الإضافات غير موجودة كما مر. وأيضًا كان في كلام النبي صلى الله عليه وآله بمعنى الحال لا بمعنى الماضي، مثل: كان الله غفورًا رحيمًا. (الأسرار، آملي، الصفحة 55).
– سر التوحيد: هذا السر المنقول من أمير المؤمنين علي عليه السلام وأولاده المعصومين إلى تلامذتهم ومريديهم، هو عند العوام من الصوفية وغيرهم موسوم بالخرقة، وعند الخواص موسوم بسر الولاية. فالذي قاله العوام: إن خرقة التصوف كانت لآدم عليه السلام وهو لبس من يد جبرئيل عليه السلام بإذن الله وأمره، وكانت من جنس الصوف أو غيره فوصلت منه إلى ولده شيث عليه السلام بالإرث الصوري ومن شيث إلى أولاده ومنهم إلى نوح عليه السلام ومن نوح إلى أولاده ومنهم إلى إبراهيم عليه السلام ومن إبراهيم إلى أولاده ومنهم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنه إلى علي عليه السلام ومن علي إلى أولاده وتلامذته ومنهم إلى تلامذتهم ومريديهم على الترتيب المذكور، ليس بصحيح ولا معقول. لأن الخرقة عند الخواص هي “سر الولاية” الذي كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة، لقوله: “كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين”. وانتقل منه إلى آدم بطريق العارية، على سبيل الوصية بعينه ومن آدم إلى ولده شيث، بالإرث الحقيقي المعنوي ومن شيث عليه السلام على الترتيب المذكور إلى محمد عليه السلام ومنه إلى علي، ومن علي إلى أولاده المعصومين وتلامذته وكذلك ينتقل من بعضهم إلى بعض، إلى يوم القيامة. وهذا الوجه أحق وأولى من الأول. لأن الخرقة الصورية من الصوف أو القطن أو غيرهما، ليس لها دخل في حصول “سر الولاية” في الشخص. فكأنها استعارة ومجاز لتفهيم “أهل الصورة” و”أهل الظاهر”. وإلا، فنسبة هذا المعنى إلى الخرقة، كنسبة “لباس التقوى” إلى التقوى، لقوله تعالى: ﴿وريشًا ولباس التقوى﴾. ومعلوم أن التقوى ما لها لباس. وكذلك حال “الفتوة” و”العقل” و”الشرب” المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام لأنها أيضًا معنوية. وأخذ أهل الصورة بالصورة ويعملون عليها، غافلين عن معناها. (الأسرار، آملي، الصفحة 229).
_________________
*نقلًا عن موقع” معهد المعارف الحكمية”- بيروت.





