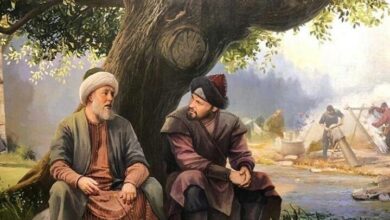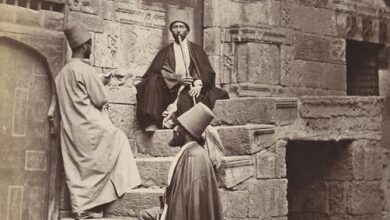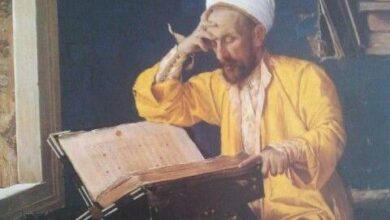والتحوُّل المستمرُّ للـ”الذرَّات” الكوانتوميَّة – دراسة مقارنة
مصحّح
تحوُّل الجسم الطبيعيِّ في فلسفة ملَّا صدرا
والتحوُّل المستمرُّ للـ”الذرَّات” الكوانتوميَّة – دراسة مقارنة([1]).
تدوين:
- فريد حجَّتي: طالب دكتوراه في الفلسفة المقارنة، قسم الفلسفة والكلام الإسلاميّ، جامعة قم، قم – إيران (المؤلّف المسؤول).
- مهدي منفرد: أستاذ مساعد في قسم الفلسفة والكلام الإسلاميّ، كليَّة الإلهيَّات والمعارف الإسلاميّة، جامعة قم، قم – إيران.
- حبيب الله رزمي: أستاذ قسم الفيزياء، كليَّة العلوم الأساسيَّة، جامعة قم، قم – إيران.
- ترجمة: د. علي الحاج حسن.
الملخّص:
تخضع الأشياء (الذرَّات) في النظريَّة الكوانتوميَّة لحالة تغيُّر مستمرٍّ ينشأ من أصل عدم القاطعيَّة، وتكون الذرَّة مع ما تحمل من أمواج تابعة للزمان حتّى أنَّ هذه التبعيّة تجعل الذرَّة المتحرِّرة خاضعة للتحوُّل المستمرِّ والدائم، فتكون حالتها غير متعيِّنة ومتبدِّلة.
وكذلك الأمر في نظريَات المدارات الكوانتوميَّة النسبيَّة، يعطي مفهوم الذرَّة والموج المغلق الأصالة لشيء مغلق يطلق عليه “المدار”، ويمتاز بعدم استقرار دائم في حالاته الأساسيَّة (الخلأ الكوانتومي). ومن جهة أخرى، يجري الحديث عن موضوع تحوُّل الجسم في فلسفة ملّا صدرا في قالب الحركة الذاتيَّة والتكامليَّة.
سنحاول في هذا المقال، وبالاستعانة بالمصادر الأساسيَّة والصحيحة في مجالَي الفلسفة الصدرائيَّة والفيزياء الحديثة، القيام بدراسة مقارنة بين الفلسفة الصدرائيَّة والفيزياء الحديثة. وسنثبت في النتيجة، كما أنَّ تحوُّل الجسم الطبيعيِّ في الفلسفة الصدرائيَّة لا يدلُّ على تحقُّق الوجود وفقدانه، كذلك الأمر في موضوع تحوُّل وتغيُّر الذرَّات الكوانتوميَّة، أو خلق وفناء الذرَّات الأساسيَّة، حيث يمكن المقارنة بين المسألتين انطلاقًا من نظريّة المدارات الكوانتوميَّة، كما يمكن المقارنة انطلاقًا من عدم القاطعيَّة الكوانتوميَّة، حيث تحتفظ الذرَّة بوضع واحد في زمانين ونظريَّة الحركة الجوهريَّة الصدرائيَّة التي توضح الحركة انطلاقًا من الزمان.
الكلمات المفتاحيّة:
فلسفة ملَّا صدرا، الحركة الجوهريَّة، الجسم الطبيعيّ، نظريَّة الكوانتوم، نظريَّة المدارات الكوانتوميَّة، أصل عدم القاطعيَّة.
مقدّمة:
دأب الفلاسفة باستمرار على البحث عن طريق لتبرير التحوُّل والحركة في عالم الطبيعة (باعتبار أنَّ عالم الطبيعة أحد مراتب الوجود). واختلفت طرق الوصول إلى هذا الهدف عندهم باختلاف المباني الفلسفيَّة التي اعتمدوا عليها، في النظام الفلسفي المشَّائيِّ، على سبيل المثال. ففي كلّ حركة وبحسب الغرض الذهنيّ، هناك أمر ثابت يجب أن يكون موجودًا في مراحل التحوّل والتغيير كافَّة، أطلق عليه أرسطو وابن سينا اسم “المادّة الأولى” أو “الهيولى” (ابن سينا، 1376، ص123؛ Aristotle, 1995, p.1005).
كذلك كان أرسطو صاحب رؤية خاصَّة في هذا السياق، فاعتُبِر مؤسِّسًا لنظريّة التركيب الانضماميِّ للأجسام من المادَّة والصورة (أرسطو، 1377، ص223). وتتحقّق الحركة في النظام المشَّائيِّ من خلال فناء صورة وخلق صورة أخرى. أمّا في النظام الفلسفيِّ الصدرائيِّ، فإنَّ للوجود مراتبَ مختلفة تُفاض من واجب الموجود انطلاقًا من نظريَّتي أصالة الوجود، والتشكيك فيه. وتختتم هذه المراتب بأضعفها وأدناها؛ أي “المادّة الأولى” أو “الهيولى”، وهي المرتبة اللَّامستقرّة، حيث تكون أجزاؤها غائبة بعضها عن بعض في تحقّقها، إلَّا أنَّها متَّصلة.
الوجود من وجهة نظر الملَّا صدرا قسمان: وجود ثابت ووجود سيّال. وقد اعتبر أنَّ الوجود السيَّال متَّصل الأجزاء، يتكامل أثناء الحركة على امتداد الزمان، وبالتالي فهو صاحب وحدة اتِّصاليَّة وشخصيَّة، وبهذا النحو تمكَّن من الاستدلال على بقاء الموضوع مع وجود الحركة في الجوهر (ملّا صدرا، 1378، ص82). كما اعتبر أنَّ “الجسم”، هو خلاصة التركيب الاتِّحادي بين المادَّة والصورة، فهما جوهران متَّحدان من ناحية الوجود في الخارج (ملّا صدرا، 1981م، ج5، ص283).
في الإطار عينه، قدّمت حكمة الإشراق رؤية خاصَّة حول الجسم، فالجسم الطبيعيُّ في هذه الحكمة، ليس جوهرًا مركَّبًا من مادّة وصورة، بل من جوهر وعرض. وفي الفيزياء الجديدة احتلّ موضوع الحركة وعلاقتها الوثيقة بالجسم أهميّة كبيرة، فبعد نيوتن – وعرضه نظريَّة ظهور الأنواع وعلى أساس مبدئيَّة الفعل وردَّة الفعل الميكانيكيَّة- وما قدَّمه من أفكار جديدة حول الطبيعة، ضعفت قضيَّة شرح الجسم على أساس ثنائيَّة المادَّة والصورة. وقد بدأ المفكِّرون البحث عن المادَّة ضمن شروط طبيعيَّة ومخبريَّة خاصَّة؛ ممَّا مهَّد الأرضيَّة لتحليل صور المادَّة المختلفة، وكشف النقاب من خواصِّها الظاهريَّة، حيث برزت العناصر الكيميائيَّة. ومع مرور الوقت، وبعد الجهود التي بذلها بعض المفكِّرين من أمثال دالتون، تامسون، رادرفورد و… حتَّى بداية القرن العشرين، تمَّ التعرُّف على الأجزاء الثلاثة المؤلِّفة للذرَّة (الإلكترون، البروتون والنيوترون) (پانوماريف، 1359، ص14-51).
ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ اكتشاف أجزاء الذرّة هذه ساعد الفيزيائيّين على تقديم نموذج عن الذرَّة. فبعدما فشل الفيزيائيّون التقليديّون حتّى أوائل القرن العشرين، في تقديم نموذج يتلاءم مع النتائج التي حصلت في المختبرات، جرى حلّ المشكلة مع فيزياء كوانتوم، انطلاقًا من الأعمال التي قدّمها ماكس بلانك (planck, 1901, p.533). وظهرت على أثر ذلك، بعض النظريَّات والأفكار من جملتها نظريَّة أينشتاين في توضيح آثار الفوتو إلكترونيك (Einstein, 1905, p.132)، نموذج بور الذريّ (Bohv, 1913a, pp. 1-24; Bohv, 1913b, pp.476-502; Bohv, 1913c, pp.857-875) ، أصل عدم القاطعيَّة عند هايزنبرغ (Heisenberg, 1927, pp.172-198)، نظريَّة تموُّج الذرَّات المادّيَّة في نظريَّة لوي دوبروى (De Broglie, 1923, p.540)، معادلة شرود ينكر (Schrodinger, 1926, pp. 1049-1070)…
وبناءً على نظريّة كوانتوم، فإنّ للأشياء (الذرَّات) التابعة للأتمّ تمتلك خاصيَّة ثنائيَّة التموُّج، وهذا يعني نوعًا من التمازج بين توضيح ماهيَّة الجسم ومفهوم الحركة.
يجدر القول أنَّ تموُّج الذرَّات في الفهم الكوانتومي لا يشبه التموُّج الكلاسيكيَّ التقليديَّ (الحركة المتقلِّبة أو ما يعبَّر عنها بالمتموِّجة)، بل هو تموُّج من نوع آخر تحدَّث عنه شرودينكر، ويختلف عن المعادلات الكلاسيكيّة والمعروفة في الأمواج، ويُبنى على أصل عدم القاطعيَّة عند هايزنبرغ، وهذا يعني أنّ الأشياء الكوانتوميّة ليس لها مكان وسرعة محدَّدان، وهي في حالة تحوُّل وتغيير مستمرٍّ لحالتها الفيزيائيَّة حتّى عند تحرُّرها الكامل (أي عندما تكون غير متأثِّرة بعامل خارجيّ).
وفي هذا السير التحوُّلي، يكون تموّج الذرَّة تابعًا للتموُّج الحاصل في اللحظة السابقة، والحالة السابقة كذلك بالنسبة إلى الَّلاحقة، وهو التحوُّل الزمانيُّ الذي يجري بناءً على معادلة الديفرانسيل الزمانيّة عند شرودينكر (Sukurai, 1994, p.86).
سنحاول في هذا المقال إجراء مقارنة بين موضوع الحركة من وجهة نظر الحكمة المتعالية، وما توصَّلت إليه آخر نتائج الفيزياء الكوانتوميَّة حول الحركة، وللوصول إلى هذا الهدف، لا بدَّ من حصول مسائل ثلاث: اختلاف المبادئ بين الحكمة المتعالية والفيزياء الكوانتوميّة، الوصول إلى لغة مشتركة تتيح القيام بعمليّة المقارنة، والوصول إلى أهداف المقارنة.
في الفلسفة المقارنة، تجري المقارنة بين تمام فلسفة على فلسفة أخرى أو على تاريخ الفلسفة، ويتحقَّق هذا الأمر المهمُّ مع وجود لغة مشتركة بين الفلاسفة وفلسفاتهم (منفرد، 1394، ص25). وعلى هذا الأساس، فعند المقارنة بين التحوُّل المستمرِّ والدائم لتموُّج الأشياء (الذرَّات) الكوانتوميَّة المغلقة، وخلق وفناء الذرَّات في نظريَّة المدارات الكوانتوميَّة النسبيَّة وبين الحركة الذاتيَّة والمستمرَّة للجسم الطبيعيِّ في الفلسفة الصدرائيَّة، ينبغي البحث عن أوجه الاشتراك والاختلاف الظاهريَّة بين المجالين، بالإضافة إلى المقارنة في التماميَّة والبحث في مبادئ وأصول هذين الاتّجاهين.
بناءً على ما تقدّم، يتضمَّن هذا المقال ثلاثة أقسام عامّة:
القسم الأوّل: يدرس المبادئ الفيزيائيَّة التي يحتاجها البحث، حيث نوضح فيه الحركة في الذرَّات الأساسيَّة، ومن ثمّ نبيّن موضوع الحركة في الذرَّات الكوانتوميَّة، بالإضافة إلى تحليل نظريَّة المدارات الكوانتوميَّة ومسائل والخلق والفناء في هذه النظريّة.
القسم الثاني: يدرس مسألة التحوُّل في الجسم الفلسفيِّ من وجهة نظر ملّا صدرا، بالإضافة إلى تعريف الجسم في الفلسفة ومختلف آراء الفلاسفة حول الجسم الطبيعيّ مّما يساهم في التعرُّف على إبداعات هذا الفيلسوف العظيم على المستوى الفلسفيِّ، وبعد التدقيق في مسألة التغيير والتحوُّل في الجسم الطبيعيّ، وانطلاقًا من التعريف المقدَّم سنعمد إلى دراسة الحركة الجوهريَّة عنده باعتبارها الطرف الثاني للمقارنة.
القسم الثالث والأخير: يجري مقارنة بين تحوُّل الجسم الطبيعيِّ في فلسفة ملّا صدرا والذرَّات الكوانتوميّة، ويقدِّم شرحًا للغة المشتركة بين الاتجاهين ونقاط المقارنة بينهما.
ممَّا لا شكّ فيه أنَّ توضيح ماهيَّة الجسم قد امتزج بمفهوم الحركة في الفلسفة والفيزياء، ويبدو أنَّ التحوُّل والتغيير الدائم للذرَّات في عالم الكوانتوم أو ما يمكن أن يُعبَّر عنه بشكل أكثر تطوُّرًا، خلق وفناء الذرَّات في عالم نظريّة المدارات الكوانتوميّة، والتي تطرح عند تقييم النسبيَّة في نظرية كوانتوم، يمتلك مواءمة وتناسقًا واضحًا مع التحوُّل والتحرُّك الدائم والتكامليِّ في فلسفة ملّا صدرا. طبعًا، الحركة الجوهريَّة الصدرائيَّة – طبق بعض القراءات – لا تختصّ بعالم المادَّة، بل تتضمَّن عالم المثال وحتّى عالم المجرَّدات طبق آراء أخرى (فياضي، 1389، ص260-265)، ومع ذلك وطبقًا لكلِّ القراءات، فإنّ حصول التحوُّل التدريجيَّ والتكامليَّ في عالم المادّة أمر مُسلَّم به، وكذلك في خصوص الفيزياء الكوانتوميّة المنحصرة بعالم المادّة والماديّات.
بشكل عام، يمكن القول أنَّ كلًّا من الفلسفة والعلوم التجريبيّة، قدّما مساعدات كبيرة في تقدّم وارتقاء أحدهما الآخر، وكانت النتيجة الارتقاء بمستوى المعرفة البشريَّة حول عالم الوجود، وفي هذا الإطار هناك الكثير من الموضوعات، والتي يمكن من خلال تتبُّعها الفلسفيِّ والعلميِّ، الوصول إلى جوانب عديدة ومتنوِّعة منها. وقد شهدت العقود الأخيرة جهودًا حثيثة في مسألة العلاقة التي تربط الفلسفة الصدرائيَّة والفيزياء الحديثة، خصوصًا الميكانيك الكوانتومي (دهباشي، 1387، ص46؛ نصيري محلّاتي وآخرون، 1397، ص163). طبعًا الاتّجاه الحاكم على هذه العلاقة هو نقد النظريَّة الكوانتوميّة ، بسبب بعض التحدّيات من قبيل نقض العليّة المبتنية على أصل عدم القاطعيّة أو نقد الواقعيّة وأمثال ذلك([2]).
مع العلم، أنّ النظريّة الكوانتوميّة كانت ناجحة وموفّقة حتّى الآن في القراءة التجريبيَّة للظواهر الميكروسكوبيّة، وحتّى لو اعتبرناها نظريّة غير كاملة، إلّا أنّه في حدود التنظير قد يمكن الاستفادة ممَّا تملكه الفلسفة الإسلاميّة، ولاسيَّما الصدرائيَّة من غنى. وسنعمل في هذا المقال على نوع من المقارنة، لا بل الأكثر من ذلك على “تقديم مبادئ فلسفيّة، لخاصيَّة الذرَّات الكوانتوميّة التي لا بديل عنها (ثنائيَّة التموُّج والذرَّة) بناءً على الفلسفة الصدرائيّة، وهذا ما لم يجرِ العمل عليه حتّى الآن حسب اطّلاعنا.
ممّا لا شكَّ فيه أنَّ التحوُّل والتغيير المغلق لتموُّج الأشياء الكوانتوميَّة أو خلق وفناء الذرّات الأساسيَّة على أساس الصعود والهبوط في البنية الأساسيّة، يقدّم دليلًا ومساعدة مهمَّة لإحكام الفكر الفلسفيّ، خصوصًا الصدرائيّ ممّا يساهم في فهم الموضوع بشكل أفضل، وهذا هو الهدف المهمّ والفائدة الأساسيّة للبحث الحاضر، حيث يشكّل الأمر مصداقًا مهمًّا لقبول نظريّة الحركة الجوهريّة الصدرائيّة في الأشياء الكوانتوميّة، ويساعد إلى حدود بعيدة في الوصول إلى نتائج صحيحة.
لا بدّ من الإشارة إلى مسألتين مهمّتين حول هذا المقال:
المسألة الأولى: يعتمد مضمون ونتيجة هذا البحث على أساس فرض أصل عدم القاطعيَّة أو ثنائيّة التموّج والذرّة، وكذلك صعود وهبوط المدارات الأساسيّة بشكل دائم (المشتملة على خلق وفناء الذرّات)، والذي يعتمد على مقولة معرفة الوجود أو في الحدّ الأدنى التجلّي الطبيعيّ لموضوع محوري بهدف معرفة الوجود في عالم الواقع، وإلّا فإذا اقتفينا أثر طريقة تفكير منتقدي نظريّة كوانتوم الذين اعتبروا أنّ بعض الموضوعات والأصول من قبيل عدم القاطعيّة نوع من الجهل المعرفيّ أو نوع من التعبير الإحصائيّ، عند ذلك ترد إشكالات على المقارنة التي سنقدّمها من الناحية الماهويّة.
نلفت هنا إلى نظريّة/ نموذج بوهميّ للميكانيك الكوانتوميّة -والتي هي أقوى نظريّة منافسة للميكانيك الكوانتومي القياسيّ- هو النموذج الذي تمكّن على مستوى التجربة والاختبار من الحفاظ على النتائج الإيجابيّة للميكانيك الكوانتومي القياسيّ، مع العلم أنّه قدّم على المستوى البنائيّ والأصولي نظريّة عليّة وواقعيّة (Bohn, 1952, pp. 166-179 & 180-193).
وينبغي القول أنّنا حتّى لو قبلنا الميكانيك الكوانتوميّة البوهيميَّة على أنّها النظريّة الأخيرة، والنموذج الثابت للفيزياء الحديثة، تحافظ المقارنة التي ستجري هنا على قيمتها؛ باعتبار أنّ الميكانيك الكوانتوميّة البوهيميّة تعتبر “الذرّة” -انطلاقًا من حاكميّة معادلة التحوّل الزمانيّ- شيئًا يعتلي موجًا ويشكّل أرضيّة التحوّل والتغيير المستمرّ.
إنّ وجود بعض الإمكانيّات البوهيميّة غير الموضعيّة يشكل وجه الاختلاف بينها وبين النظريّة القياسيّة، وهذا الذي أدّى إلى توجيه النقد للنموذج البوهيميّ، وهذا بحدّ ذاته لا يشكّل عائقًا أمام المقارنة المطلوبة، بل يعتبر دافعًا يساهم في تقويتها؛ ذلك لأنّ الإمكانيّات البوهيميّة غير الموضعيّة تبيّن عدم وجود بديل عن الأشياء (الذرّات) الكوانتوميّة في الفضاء والزمان المحدودين، وهذا أحد مجالات المقارنة مع الفلسفة الصدرائيّة.
المسألة الثانية: صحيح أنَّ الشكل المشهور لهذا التغيُّر والتحوُّل يدور حول الموقع المكانيّ والسرعة (وبشكل أدقّ قياس الحركة)، ولكن وانطلاقًا من أصل عدم القاطعيّة في أركان قياس الحركة، الطاقة، الزمان، …؛ يمكن القول أنّ التحوّل التدريجيّ الحاكم على الذرّات الكوانتوميّة ليس مختصًّا بمكان تلك الذرّة، بل هو خاصيّة عامّة.
الذرّات الأساسيّة والحركة:
تشير مختلف النظريَّات الفيزيائيَّة إلى أنّ الحركة والمادّة ممتزجان بعضهما ببعض. وتقسم الذرّات الأساسيَّة في الفيزياء الجديدة إلى صنفين: الأوّل، الذرّات الأساسيّة المشكّلة للمادّة، ومن جملتها الإلكترون، النيوترون والبروتون. والصنف الثاني، عبارة عن الذرّات الحاملة للطاقة، والتي تكون الحركة ممتزجة بها ذاتًا، من قبيل الفوتون التي تتحرّك بسرعة الضوء (كلوز، 1387، ص8، 24). وبناءً على مبادئ نظريّة الترموديناميك، فإنّ درجة حرارة الصفر المطلق، هي أدنى درجة حرارة في الكون، وإذا أخذنا بعين الاعتبار تناسب درجات الحرارة في مقياس كوين مع متوسّط الطاقة المتحرّكة في ذرَّات المادّة، في درجة حرارة كهذه يجب أن تصل طاقة ذرّات المادّة إلى أدنى المستويات، ولكن ما تجدّ الإشارة إليه أنَّ الطاقة المتحرّكة مرتبطة بسرعة الذرّات، لذا فإنَّ حركة الذرّات لن تصل إلى الصفر على الإطلاق.
وانطلاقًا من نظريّة الترموديناميك، فالحركة واحدة من خواصّ الذرّات الذاتيّة. وإذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر الكوانتوم، وعلى أساس أصل عدم القاطعيّة عند هايزنبرك، فالذرّات الكوانتوميّة ذات حركة وتحوُّل وتغيير ذاتيّ.
نظريَّة المدارات الكوانتوميَّة:
هذه النظريَّة ظهرت على أثر تعميم نظريَّة التموُّج الكوانتوميِّ باتّجاه نظريَّة المدارات، ومن خلال ما تحمل من نسبيَّة فيها، وهي تستخدم في الطاقة العالية وفي أبعاد شديدة الدقّة. (Dirac, 1927, p.243; Fock, 1932, pp.622-647). وهي تعتبر من أكثر النظريّات تطوُّرًا في وصف عالم الذرّات الأساسيَّة، وتُشكّل فروعها من قبيل “الإلكتروديناميك الكوانتوميّة” دعامة أساسيَّة لنموذج الذرَّات الأساسيّة، حيث تؤيّد الفيزياء الجديدة مبادئها النظريّة وتوقُّعاتها التجريبيَّة. كما أنَّها تدّعي إمكان تبيين الكثرات الموجودة في العالم المادّيّ بعدد محدود من المدارات الأساسيَّة.
في الفيزياء النظريّة، تُعتبر نظريَّة المدارات الكوانتوميّة إطارًا لصناعة نماذج الميكانيك الكوانتوميَّة من الذرّات الدقيقة في فيزياء الذرّات وشبه الذرّات. وهي تفرض أن تكون الذرّات على شكل حالات متحرّكة خارجة عن ساحة الفيزياء؛ لذلك يُطلق عليها عنوان “كوانتوم المدارات “. ومن هنا، تتشكّل الذرّات الأساسيّة من قبيل الإلكترون، البوزيترون، الفوتون و… كوانتوم المدارات؛ وقد ذكر على سبيل المثال أنّ “الفوتون هو كوانتوم النور”، وعلى هذا النحو يكون الإلكترون، وكذلك الذرّات الأساسيّة الأخرى، كوانتوم مساحة أو مجالًا خاصًّا؛ أي أنّها أمواج متراكمة تحضر في المدارات على شكل ذرّات. وعلى هذا النحو، يكون الحديث في نظريّة المدارات عن الذرّة والمدار. والمدار هو كالساحة الإلكترومغناطيسيّة للشيء المتّصل في الفضاء، والتي يمكنها الامتداد إلى كلّ مكان، إلّا أنّها قويّة في مكان وضعيفة في مكان آخر. وفي نظريّة المدارات لا يجري الحديث عن عدد الإلكترون، بل نقول “لدينا مدار إلكترونيّ”.
وإذا سألنا: ما هو الإلكترون؟ نقول: “الإلكترون هو كوانتوم المدار”، وكأنّ هناك موجًا متّصلًا بعيدًا، ونحن نرى قمّة الموج؛ مع العلم أنّ هذه القمم أفراد شيء متّصل واحد.
ألف- نظريّة المدارات الكوانتوميّة ومسألة الخلأ:
يساهم التوغُّل في فضاء الذرّة الداخليّ والخارجيّ في أن يتبادر إلى الأذهان عدم وجود أيّ شيء بين الذرّة والإلكترون، وفي الفواصل الواقعة بين الذرّات؛ مع العلم أنّ هذا الفضاء مليء بالمدارات الإلكترو مغناطيسيّة. إذًا، الخلأ في الفيزياء الجديدة مرفوض، إلّا أنّ ما يجري الحديث عنه تحت عنوان “الخلأ الكوانتوميّ” هو في الحقيقة موجود معقّد للغاية خالٍ من المادّة والموج، إلّا أنّه مشبع بالمدارات والطاقات. المقصود من المدار هنا، الموجود الكوانتوميّ الدائم الصعود والهبوط، والذي هو منشأ خلق وفناء الذرّات.
خلاصة هذا الخلق والفناء مجموعة من الذرّات وجزئيّاتها، ويعتقد العديد من الفيزيائيّين الجدد، أنّ “الخلأ” يتضمّن صعودًا وهبوطًا كوانتوميًّا يجري توضيحه على أساس أصل عدم القاطعيّة عند هايزنبرك (هايزنبرك، 1370، ص30، هاولينغ وملودينو، 1391، ص104). تجدر الإشارة إلى أنّ الخلأ هو ليس “لا شيء”، بل هو منشأ العديد من الظواهر المعروفة، كالظل الذي ينطلق من الذرّة لذاتها أو آثار كازيمير و…
بناءً على ما تقدّم، وبالالتفات إلى أنّ واحدًا من أقوى المرشّحين لتبرير الطاقة المظلمة في العالم هو الخلأ الكوانتومي، تطرح العبارة القائلة بأنّ الخلأ الفيزيائيّ ليس “لا شيء”، بل هو كلّ شيء بالنتيجة المهمّة لهذا الأمر، أنّ الفضاء لن يصبح خاليًا على الإطلاق، والخلأ الكوانتوميّ المشبع بالحركة سيكون موجودًا في الفضاء الخالي من المادّة والطاقة المتداولتان، وسيتضمّن الخلأ الكوانتوميّ حالة من الطاقة في حدودها الدنيا والمعروفة بـ”طاقة الخلأ”.
ب- الخلق والفناء في نظريَّة المدارات الكوانتوميّة:
يجري توضيح التفاعل الميكانيكي الكوانتوميّ بين الذرّات في نظريّة المدارات الكوانتوميّة على أساس التفاعل بين المدارات الخلفيّة المقابلة. يمكن اعتبار المدار في هذه النظريّة شيئًا متّصلًا تجري فيه عمليّة الخلق والفناء بشكل مستمرّ؛ فالمدار الذرّيّ الضعيف على سبيل المثال تجري فيه عملية خلق وفناء الإلكترون والبوزيترون بشكل دائم. وفي ما يتعلّق بخلق وفناء الذرّات في نظرية المدارات الكوانتوميّة، فإنّ المقصود من الخلق والفناء ليس حصول الوجود أو فقده؛ فالمدار يتمّ تعريفه على أساس الفضاء والزمان، ففي هذه اللحظة وهذه النقطة على سبيل المثال تكون الذرّة الفلانيّة موجودة، ثمّ إنّها لا تبقى موجودة في اللحظة التالية؛ فالحبل الممتدّ صاحب النتوءات، كلّما حاولت فكّ نتوءاته بسحبه إلى الإمام، كانت النتوءات تتقدّم وتختفي من الأجزاء المتقدّمة، إلّا أنّ أصل الحبل ما زال موجودًا.
وبعبارة أكثر دقّة وعمقًا، فإنّ خلق وفناء الذرّات على أساس الهبوط والصعود في المدار يمهّد لوجود الخلأ (الخلأ الكوانتوميّ). كما أنّ خلق وفناء الذرّات الأساسيّة، أمر يحصل في طول الزمان حتّى لو كان قصيرًا، وليس في آنٍ واحد. الذرّة في الفيزياء الكلاسيكيّة تبقى ذرّة حتّى بعد أن تقطع السير، بينما تكون في حال تغيير وتحوّل أو خلق وفناء دائم في عالم الكوانتوم؛ سواء نظرنا إليه من وجهة نظر موجية وعلى أساس معادلة سترودينكر أو نظرنا إليه على أساس نظريّة المدارات الكوانتوميّة النسبيّة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الشيء الذي يؤدّي إلى وجود هكذا وضع متحوّل؟ يمكن الحصول على الجواب من خلال فلسفة ملّا صدرا، أي الحركة الذاتيّة والتكامليّة للجسم الطبيعيّ؛ أي “الحركة الجوهريّة”.
من هذا المنطلق، ينبغي بداية البحث عن رؤية الفلسفة الصدرائيّة حول الجسم. تجدر الإشارة إلى ما يُذكر في الطاقة العالية وفي مجال الفيزياء النسبيّة، حيث يمكن الحديث عن تحوّل المادّة إلى طاقة وبالعكس، وهنا يصبح بالإمكان تبديل النور إلى مادة، وبالتالي إنتاج زوج من الإلكترون – البوزيترون بواسطة الفوتون أو زوال المادّة وتحويلها إلى نور كما في زوال الإلكترون – البوزيترون وتحويله إلى فوتون، حيث يعتبر هذا الأمر اليوم من الظواهر المعروفة على المستويين النظري والتجريبي في الفيزياء.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أصل بقاء الطاقة، وكذلك كل أصول بقاء الفيزياء الأخرى من قبيل “أصل بقاء الشحن الإلكترونيّ” الصادق حول هذه الظواهر، فعند ذلك يمكن الحديث عن هذا النوع من الخلق والفناء، ويدخل في إطار مضمون وهدف هذه الدراسة، إلّا أنّ الموضوع بذاته يتمّ تبيينه على أساس خلق وفناء الذرّات، باعتباره أساس وأصل الموجود وهو الذي يطلق عليه “المدار” القائم على أساس التغيُّر والتحوُّل المستمرِّ المبنيِّ على أصل عدم قاطعيّة النظريَّة الكوانتوميّة (Divac, 1927, p.243; Fock, 1932, pp. 662-647).
تحوّل الجسم الطبيعيِّ في فلسفة ملّا صدرا:
بما أنَّ فهم رؤية الملَّا صدرا للجسم الطبيعيِّ وتحوُّله متوقِّف على وجود فهم صحيح لهذه المفاهيم، وبما أنَّه أشار في مؤلّفاته لآراء الفلاسفة الآخرين في المسألة، خصوصًا الفلاسفة المشّائين، ثمّ قدّم إجابات على آرائهم، سنعمل في هذا المقال أيضًا على تبيين المفاهيم ذات العلاقة بالجسم الطبيعيّ وتحوّله، انطلاقًا من الفلسفة الإسلاميّة قبل الشروع بالحديث عن تحوّل الجسم الطبيعيّ.
*الجسم في الفلسفة الإسلاميّة:
يُبحث عن الجسم بشكل عام في الفلسفة الإسلاميّة ومن جملتها الحكمة المتعالية مع ذكر قيدين: الجسم الطبيعيّ والجسم التلعيميّ.
– الجسم الطبيعيّ: اختلف المفكّرون في تعريف الجسم الطبيعي؛ فعرَّفه ملّا صدرا وقال: “الجسم جوهر ذو طول وعرض وعمق”، ثمّ تابع الحديث مشيرًا إلى تعريف الحكماء والمتأخّرين للجسم: “جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على الزوايا القوائم”، وهذا يعني أنّ الجسم الطبيعيّ، جوهر يمكن أن يفرض فيه وجود الأبعاد الثلاثة (طول، عرض، عمق)، بحيث تتقاطع الخطوط الثلاثة مع بعضها فتشكّل ثلاثة زوايا قائمة (ملّا صدرا، 1981م، السفر 2، ج5، ص10-12).
أمّا المقصود من قيد “يفرض” في التعريف، فهو الجواز العقليّ باعتبار أنّ الأبعاد الثلاثة المذكورة لا تكون موجودة بالفعل في بعض الأجسام، كالكرة أو المخروط.
أمّا قيد “الإمكان”، فهو للإشارة إلى عدم ضرورة أن يكون الفرض بالفعل بل يكفي إمكانه، وإذا لم نتمكّن من فرض الأبعاد، عند ذلك لا يكون الجسم طبيعيًّا (ابن سينا، 1404، ص63).
– الجسم التعليميّ: الجسم التعليمي كمّ متصل يقبل الأبعاد الثلاثة، ويعرض الجسم الطبيعي، وبالتالي فهو لا ينفكّ عنه، فهما متّحدان في الوجود ويختلفان في التحليل العقلي، ويقدم الحكماء مثالًا لتوضيح الفكرة في “الشمع” الذي يمكن أن يتخذ أشكالًا متعدّدة، إلّا أنّ الجسم الطبيعي في الشمع واحد ليس أكثر.
وبالتالي، فالفرق بين الجسم التعليميِّ والجسم الطبيعيِّ، هو من حيث الإبهام والتعيُّن. يعتقد علماء الرياضيَّات أنَّ الكمَّ المتَّصل ذا البُعد الواحد هو “الخطّ”، الكمّ المتصل ذو البُعدين هو “السطح”، وأنّ الكمّ المتصل ذا الأبعاد الثلاثة هو “الجسم التعليميّ” (ملّا صدرا، 1981م، السفر 2، ج4، ص10-12؛ مطهَّري، 1384، ج5، ص537).
* الجسم الطبيعي من وجهة ملَّا صدرا:
أشرنا في ما تقدّم إلى وجود رؤيتين في الفلسفة، كما في الفيزياء حول الجسم الطبيعيّ، فيجري الحديث في الفيزياء عن الذرّة المنفصلة والذرّة المتّصلة. الذرّات الصغار الصلبة (مقولة ديمقراطيس) هي أجزاء لا تتجزّأ ومتناهية أو الجوهر الفرد (مقولة أغلب المتكلّمين)، وهي أجزاء لا تتجزّأ وغير متناهية (وهو القول المنسوب للنظام)، ومن جملة الآراء في الذرّة في الفلسفة مقولة التساوي بين الأجزاء التي لا تتجزّأ والهيولى الأولى (القول المنسوب إلى زكريا الرازي)، وكانت الرؤية الأكثر رواجًا منذ سقراط إلى القرن السابع عشر بين الفلاسفة، رفض فكرة تكوّن الجسم الطبيعي من الذرّات، والاعتقاد بأنّ الأجسام ليست عبارة عن عدد كبير من الأشياء التي اجتمعت إلى جانب بعضها البعض، بل الأجسام عبارة عن واحد متّصل ممتدّ وهو ما نشاهده.
لم يختلف أتباع هذه النظرية حول قبول الجسم الطبيعي القسمة، إلّا أنّهم لم يهتمّوا بالتفكير بالجسم الطبيعي لناحية فرض تقسيمه المستمرّ إلى جزئين، فهل سنصل في النهاية إلى الذرّة التي لا تتجزّأ، كما يقول ديمقراطيس أم أن هذه القسمة لن تتوقّف عند حدّ معيّن؟
يعتقد بعض المفكّرين من قبيل محمّد الشهرستاني صاحب “الملل والنحل”، بإمكان انتهاء القسمة في الجسم الطبيعي، إلّا أنّ أغلب الحكماء يعتقدون بعدم انتهاء قسمة الجسم الطبيعي إلى قسمين، ثمّ إنّ الحكماء قدّموا آراء مختلفة حول ماهيّة الجسم الطبيعيّ (مطهَّري، 1384، ج5، ص537).
في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى رؤيتين:
ألف- الجسم الطبيعي جوهر بسيط؛ يمكن أن يقسم اتصاله وامتداده الجوهريّ في الوهم والعقل وفي العالم الخارجيّ، وقد نسبت هذه النظريَّة لأفلاطون. (إبراهيمي الديناني، 1383، ص235-237).
ب- الجسم الطبيعي جوهر مركَّب؛ يقسم أتباع هذه النظريَّة إلى مجموعات عدَّة:
1- الجسم الطبيعي هو خلاصة التركيب بين المادَّة والصورة.
ويقسم أتباع نظريَّة تركُّب الجسم من المادّة والصورة إلى مجموعتين:
ألف. الجسم الطبيعيُّ هو نتيجة التركيب الانضمامي بين المادَّة والصورة: يعتقد الفلاسفة المشّاؤون أنَّ حقيقة الجسم مركّبة من جزئين جوهريّين، هما المادة والصورة. والمقصود من “الصورة”، هو الاتصال أو الامتداد في الجهات الثلاث، وهي تمام فعليّة الجسم، وهذا يعني أنّ الجُرم الممتدّ والصورة الجوهريّة الممتدّة هي التي يطلق عليها “الصورة الجسميّة”. وأمّا المقصود من “المادّة”، الاستعداد الموجود لقبول الصور النوعيّة وهي التي يطلق عليها “الهيولى”. (أرسطو، 1377، ص223).
ب. الجسم الطبيعي، هو نتيجة التركيب الاتّحاديِّ بين المادّة والصورة؛ وهي نظريَّة ملّا صدرا.
2- الجسم الطبيعيُّ هو الحاصل من تركيب عنصري الجوهر والعرض:
هذا الجوهر هو المقدار والجسم ليس شيئًا سوى المقدار، وبما أنَّ التشكيك يجري في المقادير؛ فما به تختلف الأجسام (المقادير المعنيَّة) يعود إلى ما تشترك به؛ أي المقدار المطلق. تعود هذه النظريَّة للشيخ شهاب الدين السهروردي التي ذكرها في كتاب التلويحات (إبراهيمي الديناني، 1383، ص235-237).
* الجسم الطبيعي وارتباطه بالتغيير في الفلسفة:
ألف- أقسام التغيير في الفلسفة: الدفعي والتدريجي:
بما أنّ الموجوديّة تتنافى مع القوَّة المحضة، فلا يكون أيّ موجود بالقوَّة من جميع الجهات، وعلى هذا الأساس، فالأشياء الموجودة إمّا أن تكون بالفعل من جميع الجهات أو بالفعل من بعض الجهات، وبالقوة من بعض الجهات الأخرى.
في الحالة الأولى، تمتلك الموجودات تمام الكمالات الوجوديّة، ولا يمكن أن نتصوّر فيها حالة تبدّل وتحوّل من القوة إلى الفعل، مثال ذلك ذات الله المقدّسة والعقول المفارقة، وأمّا في الحالة الثانية، فإنّ خروج الموجودات – من ناحية امتلاكها جهات بالقوَّة – إلى الفعل، ففيه وجهان: إمّا أن يكون الخروج دفعيًّا وهو الذي يطلق عليه “الكون والفساد”؛ كالانقلاب العنصريِّ وتحوّل الماء إلى هواء، وإمّا أن يكون تدريجيًّا وهو الذي يطلق عليه “الحركة”. (ملّا صدرا، 1378، ص41؛ ملّا صدرا، 1981م، ج3، ص21-24). وبما أنّ الخروج التدريجيَّ من القوَّة إلى الفعل هو حركة من النقص إلى الكمال، كان النقص والكمال صفتين للشيء المتحرّك أثناء الحركة.
ب- التغيير في الجسم الطبيعيِّ في الفلسفة المشَّائيّة:
قسّم أرسطو الموجودات إلى أربع مجموعات: الجواهر، الكيفيَّات، الكميَّات والنسب (الأين، الوضع، متى، الملك، الإضافة، الفعل، الانفعال)، واعتبر أنّ كلّ واحدة منها “مقولة”. (Aristotle, 1995, p. 1005). ويحصل التحوُّل والتغيير في مقولات أربع فقط: الجوهر، الكمّ، الكيف والأين. ويكون التحوّل في الجوهر على نحو الكون والفساد، وفي الأعراض (الكمّ، الكيف والأين) على نحو الحركة. طبعًا، رفض أرسطو فكرة الكون المطلق والفساد المطلق؛ ففي الكون المطلق يلزم أن يحصل الموجود من لا وجود مطلق. ويصدق الأمر أيضًا حول الفساد المطلق.
في الواقع، أذعن أرسطو كما هو الحال عند بارامنيدس بعدم تحقُّق العدم من الوجود أو الوجود من العدم، وأضاف بإمكان وجود حالة ثالثة بين الوجود والعدم هي غير مستحيلة من الناحية العقليَّة، بل ممكنة. ثمّ اعترف بوجود مرتبة أخرى بين الممكن والموجود، وأطلق عليه الأمر “بالقوَّة” (فولكيه، 1366، ص72-73).
اقتفى ابن سينا أثر أرسطو في القول بإمكان حصول التغيير في الجوهر على صورة الكون والفساد (الدفعي والآني)، وكذلك حصوله في الإعراض على صورة الحركة (التدريجيّ وعلى امتداد الزمان)؛ واختلف عنه في أنّه أجاز وقوع الحركة في مقولة الوضع (ابن سينا، 1375، ص105؛ ابن سينا، 1404ق، ص98). كما اعتبر أنّ الجسم هو نتيجة التركيب الانضماميّ بين المادّة والصورة، وللأجسام خاصّيَّة تنشأ من صورها فتصبح ذات بُعْد، وعلى هذا الأساس، تكون بالفعل، كما أنّ للأجسام خاصّيَّة أخرى تنشأ من المادَّة، فيحصل التغيير بسببها وتتحوَّل لتصبح شيئًا آخر، ومن هذا الجانب تكون بالقوّة. (ابن سينا، 1376، ص77). ويعتقد ابن سينا بعدم حصول التشكيك والشدَّة والضعف في الجواهر وصور الأجسام الجوهريّة (ابن سينا، 1357، ص123).
وفي التحوُّل الجوهريّ، تخلع المادَّة الأولى صورتها وترتدي صورة أخرى، وتتحقَّق هويَّة الشيء بصورته وليس بمادَّته، وتظهر الخواصُّ والأعراض في الشيء المادّيّ أو تعدم على أثر حدوث الصورة في الهيولى. (ابن سينا، 1357، ص124). وتكون المادَّة والصورة في عالم الكون والفساد ممتزجتان بعضهما ببعض على نحو لا يمكن الانفكاك، وهذا النوع من التركيب بين المادّة والصورة هو الذي يوجب التحوّل الدائم، حيث تترك المادّة صورة وتقبل صورة أخرى على نحو دائم. (ابن سينا، 1383، ص134-135).
التغيير في الجسم الطبيعي في الحكمة المتعالية:
وافق صدر المتألّهين على كلّيّات الحكمة المشّائيّة، ومن جملتها الجواهر الخمس والمقولات العشر، والتي هي من أقسام الماهيّة، وبنى الحكمة المتعاليّة على أساس أصول من جملتها “أصالة الوجود”، “وحدة الوجود” و”التشكيك في الوجود”، وقد ساهم اعتقاده بهذه الأمور في قدرته على الإبداع والتجديد في العديد من الأبحاث الفلسفيَّة، فافترق فيها عن المشّائيَّة، ومن جملة الأمور التي افترق فيها عنهم، موضوع “الحركة الجوهريّة”.
من أبرز وأهمِّ الأدلَّة التي ذكرها صدر المتألّهين على وقوع الحركة في الجوهر، قوله بأنَّ المقصود من الحركة، التجدُّد وعدم القرار، وفاعل الحركة المباشر يجب أن يكون أمرًا متجدّدًا لا قرار له؛ وذلك لاستحالة صدور المتجدّد عن الثابت والفاعل المباشر هو الجوهر الصوريّ للأجسام أو طبيعتها السيّالة والمتجدّدة ذاتًا. (ملّا صدرا، 1378، ص34).
ولأنّ “الماهيّة” -عند المشّاء- ذات أهميّة خاصّة، وهي تشتمل على الجوهر والإعراض، ولأنّ المادّة والصورة هما الجزءان المقوّمان لماهيّة الجسم الطبيعيِّ، والحركة في هذه الجواهر، تستلزم عدم بقاء موضوع الحركة وزوال الحقيقة ووحدة الموضوع الشخصيّة؛ لذلك رفض المشّاؤون الحركة في الجوهر، أمّا صدر المتألّهين وبسبب اعتقاده بأصالة الوجود وليس الماهيّة، ولاعتقاده بأنّ حقيقة الموجود وسبب وحدته الشخصيّة هو “الوجود” وليس “الماهيّة”؛ فلذلك ذهب إلى الاعتقاد بالحركة في الجوهر، مع الاعتقاد ببقاء الوحدة الشخصيّة.
وتوضيح ذلك بناءً على أصالة الوجود، أنّ الوجود هو الوحيد المتحقّق في العالم، وهو منشأ الآثار، وأنّ مراتب الوجود تفاض من قِبَل واجب الوجود – باعتباره الكمال المطلق وحقيقة الوجود – بسبب شدّة وجوده، وعلى هذا النحو يتنزّل الوجود من ذات واجب الوجود (المرتبة الوجوديّة الشديدة) إلى المادّة أو الهيولى، والتي هي أدنى وأضعف مراتب ممكن الوجود، وعليه يظهر نظام طوليّ مشكّك من تجليات ومظاهر واجب الوجود.
طبعًا، من لوازم الوجود والتحقّق، الثبات والقرار، وهو من خصائص الموجود المجرَّد، وأمّا في أدنى مراتب عالم الوجود؛ أي في عالم المادّة، فإنّ الموجودات واقعة عند حدود العدم، عدا عن أنَّها تفتقد الثبات والقرار بسبب ضعف وجودها، لا بل تفتقد القدرة على إيجاد المرتبة الأدنى منها. يعتقد ملّا صدرا أنّ هذه الموجودات متغيّرة بالذات لضعف وجودها؛ وفي عين تغييرها تمتلك ثباتًا وقرارًا، ومن هذه الجهة ترتبط بالعلّة الثابتة والمجرّدة؛ أي العقل الأخير؛ فالعلّة تفيض الذاتي وإفاضة تلك الذات ملازمة لنوع خاص من الامتداد (امتداد القوّة، والفعل والزمان)، بل هو عين الامتداد والعلّة تقوم بإيجاد الحركة والزمان. (مطهّري، 1383، ص68). والعلّة تقوم بإيجاد الحركة والزمان (مطهّري، 1383، ص68). وعلى هذا الأساس، فالجوهر الماديّ والجوهر الصوري كلاهما متغيّر بالذات.
عينيَّة الحركة والمتحرِّك في نظريّة الحركة الجوهريَّة:
يمكن القول أنّ الوجود في نظام الحكمة المتعالية يقسم في تقسيماته الأوّلية إلى قسمين: ثابت وسيّال. والحركة في هذا النظام هي نحو وجود المرتبة السيّالة، وعالم الطبيعة متجدّد ذاتًا. وعلى هذا الأساس، لا يمكن الحديث عن تمايز بين الحركة والمتحرّك، كما هو الحال في الفلسفات السابقة القائلة بالتمايز بين العرض والموضوع؛ لذلك كانت الحركة في النظام الصدرائيِّ عين المتحرّك.
يضاف إلى ذلك، وانطلاقًا من كون الواجب هو علَّة العلل والخالق وعلّة الوجود، ومن جملته الوجود السيَّال؛ لذلك يمكن القول أنّ جعل الحركة بسيط وليس جعلًا تأليفيًّا زائدًا على خلق المتحرِّك. ويعتقد صدر المتألّهين، أنَّ السيلان والثبات صفتان تحليليَّتان للوجود السيّال والثابت. وهذه الأوصاف لا تحتاج إلى موضوع عينيٍّ مستقلٍّ عن الوصف، بل عين الشيء هو الوجود المتحرِّك، وليس شيئًا له الحركة. (ملّا صدرا، 1981م، ج3، ص110).
ومن هنا، يعتقد صدر المتألّهين في جواب الإشكال القائل بأنّ وقوع الحركة في الجوهر يحمل إشكال بقاء الموضوع، أنّ موضوع الحركة يجب أن يكون ثابتًا من جهة لتعرُّض الحركة عليه. والواقع، أنّ هذا الأمر ثابت وإمّا أن يكون بالقوَّة أو بالفعل. فإن كان بالقوَّة، فهذا يعني أنَّه لم يتحقّق بعد، ومن المحال أن تعرض الحركة شيئًا لا فعليّة له. إذًا، يجب أن يكون موضوع الحركة أمرًا ثابتًا وبالفعل. وهذا الأمر الثابت وبالفعل لا يخرج عن حالين: إمّا أن يكون بالفعل من جميع الجهات أو بالفعل من بعض الجهات.
في الحالة الأولى، وبما أنَّ هذا الأمر لا قوَّة فيه، والحركة عبارة عن الخروج التدريجيّ من القوَّة إلى الفعل؛ لذلك كان وقوع الحركة في موضوع محال كهذا، وهذا يعني ضرورة أن يكون الموضوع أمرًا ثابتًا، وهو بالقوّة من بعض الجهات وبالفعل من جهات أخرى، وهي خاصّيّة ترتبط بالجسم الطبيعيّ. تدلّ جهة القوة على المادَّة وجهة الفعل على الصورة (ملّا صدرا، 1981م، ج3، ص59-60).
من هنا، يعتقد صدر المتألّهين أنّ الجسم الطبيعي عبارة عن وجود ممتدّ بالذات في الزمان والمكان، وهو نتيجة التركيب الاتحاديِّ بين المادَّة والصورة. وذكر مجموعة من الأدلّة لإثبات التركيب الاتحاديِّ بين المادّة والصورة من جملتها: صحَّة الحمل بين المادَّة والصورة، فعليَّة العناصر التي تتألّف منها الأشياء المركّبة، وحدة ماهيّة الصورة والجسم واتّصاف النفس بصفات البدن الخاصّة (ملّا صدرا، 1981م، ج5، ص283-286).
ألف- نفي الخلع واللبس في نظريَّة الحركة الجوهريَّة:
يعتقد ملّا صدرا أنّ العدم أو خلع الصور -كما يعتقد المشّاؤون- يتنافى مع غائيّة الكون، والسبب في ذلك أنّ للطبيعة غاية ويكون للشيء غاية إذا تحرّك نحوها. وإذا أعدمت صورة في الجسم الطبيعيِّ وحلّت مكانها صورة أخرى، فالحركة تتصوّر لتلك الصورة فقط، وليس لذاك الموجود الذي تواردت عليه الصور. إذًا، يجب أن يكون هناك صورة واحدة تتحرّك نحو الغاية من البداية وإلى النهاية، وهذه الصورة هي التي تتطابق مع “الحركة التوسُّطيّة”؛ أي أنّها أمر ثابت ومستمرّ. وفي نظريّة الحركة الجوهريّة تقبل المادة كلّ صورة وتقبل الصور اللَّاحقة، حيث يشكّل مجموع المادّة والصورة مادّة لقبول الصورة اللَّاحقة وهكذا. لذلك ووفق الحكمة المتعالية لا تُعدم أيّ صورة.
وقد أشرنا في ما تقدّم، إلى أنّ نظرية الكون والفساد عند ابن سينا وأتباعه قد ظهرت نتيجة الاعتقاد بأنّ “الجوهر” ليس مقولة تشكيكيّة؛ فلو كانت تشكيكيّة، للزم من ذلك أن تكون ماهيّة الشيء أي حقيقته في حال تغيير وتحوُّل مستمرّ، وهذا ما يدفع نحو الإشكال على بقاء الموضوع في الحركة العارضة على الجسم الطبيعي. إنَّ أساس العالم المادّيّ هو في حال حركة وعدم قرار مستمرّين، فلا يكون الأمر المادّيُّ على صورة واحدة في زمانين، وأمّا سبب هذه الحركة في عالم المادَّة – على أساس نظريَّة الحركة الجوهريَّة – فهو الفقر الوجوديُّ وعدم القرار والتغيير الذاتيِّ للجوهر المادّيّ و”ذاتي شيء لم يكن معلّلًا”.
ب- الحركة الجوهريَّة، الزمان والوحدة الاتصاليّة والشخصيّة:
الحركة – من وجهة نظر ملّا صدرا – هي خروج الشيء التدريجيّ من القوَّة إلى الفعل، ويتحقّق هذا الأمر على امتداد “الزمان”. كما أنَّ الاتصال هو من ضروريّات الوجود السيَّال؛ لأنّ هذا النحو من الوجود ومع أنّه واسع يترافق مع الحركة وتتحقّق أجزاؤه في كلِّ لحظة، إلّا أنّه يجب أن يكون وجوده السابق متحقّقًا في وجود الشيء في هذه اللحظة، وهذا هو المقصود من الاتصال الوجوديّ. هذا الوجود الفعليّ هو حقيقة واحدة يمتلك كلَّ الكمالات الوجوديّة للوجودات السابقة، بالإضافة إلى الكمالات الوجوديّة الأعلى على نحو البساطة والوحدة. من هنا، يجب أن تمتلك أجزاء الوجود السيّال، وحدة اتّصاليّة وفي النتيجة وحدة شخصيّة. ومن هنا، يمكن القول أنّ الحركة امتداد واحد واتّصال على طول الزمان، حيث يحفظ المتحرّك طوال مدّة الحركة وحدته الحقيقيّة (ملّا صدرا، 1981م، ج4، ص275).
مقارنة بين التحوّل في الجسم الطبيعيِّ والتحوًّل في الذرَّات الكوانتوميَّة:
بناءً على ما تقدَّم، يمكن القول على سبيل القطع، أنَّ الجسم الطبيعيَّ في الفلسفة الصدرائيَّة قد امتزج [جُبِلَ] بالتحوُّل والتغيير المستمرِّ، وكذلك الأمر في الذرَّات الكوانتوميَّة الدائمة التحوُّل والحركة على أساس الفيزياء الكوانتوميَّة، وهذه هي الُّلغة المشتركة والتناسب الذي أردنا البحث عنه في هذا المقال، إلَّا أنَّ التغيير في الفلسفة عبارة عن خروج الشيء من القوَّة إلى الفعل، حيث يحصل إمَّا على نحو دفعيٍّ (الكون والفساد)، وإمَّا على نحو تدريجيٍّ (الحركة). وقد عرض صدر المتألّهين نظريَّة الحركة الجوهريَّة ورفض نظريَّة الكون والفساد الأرسطيَّة؛ ليبيّن أنَّ التحوُّل في الجسم الطبيعيِّ يجري في قالب الحركة الذاتيَّة والتغيير التدريجيِّ الدائم.
في الحقيقة، يمكن توضيح تحوُّل وتغيير الذرَّات الكوانتوميَّة في فيزياء الكوانتوم، وكذلك خلق وفناء الذرَّات في نظريَّة المدارات الكوانتوميَّة على أساس “أصل عدم القاطعيَّة”، وكذلك حركة الأشياء الذاتيَّة في الحكمة المتعالية الصدرائيَّة على أساس الحركة الجوهريَّة والتغيير الدائم، إلَّا أنَّ المسألة الجديرة بالذكر هنا أنَّ هذا التغيير يترافق في الحالتين مع توارد الصور؛ وليس مع تحقُّق الوجود الفلسفيِّ وفقده، فالذرَّة في المدار الكوانتوميِّ تخضع للخلق ثمَّ الفناء، فهي في الحقيقة قد اتَّخذت صورة جديدة ثمَّ تزول تلك الصورة. وهذا ما شرحته الحكمة المشَّائيَّة تحت عنوان: الخلع واللبس، انطلاقًا من فكرة الكون والفساد، بينما شرحته الحكمة المتعالية تحت عنوان: اللبس بعد اللبس، وانطلاقًا من فكرة الحركة الجوهريَّة. ممَّا لا شكَّ فيه، أنَّ الذرَّة وبعد فنائها، يجب أن ترد عليها صورة أخرى (الذرَّة الجديدة المخلوقة في المدار)؛ وإلّا لزم أن تتحقِّق فعليَّة المادَّة من دون صورة، وهذا محال. المسلَّم به، أنَّ توارد الصور هذا على الذرَّات، سواء كان على شاكلة الخلع واللبس أم اللبس بعد اللبس، لا يحمل معنى تحقّق الوجود وفقده بالمعنى الفلسفيّ. كما يمكن القول أنَّ أصل عدم القاطعيّة عند هايزنبرك، هو شكل من أشكال التحوُّل والمرونة الدائمة، وبالذات لعالم الذرَّات الكوانتوميَّة.
بناءً على هذا الأصل، لا يمكن تعيين مكان ومتّكأ الذرَّة الواحدة في آن واحد على وجه الدقَّة. وهذا يعني أنَّ الذرَّة – وبسبب ما تحمل من حركة وتحوُّل ذاتيّ- لا تبقى على حال واحدة في لحظتين. ويتطابق هذا الأمر مع نظريَّة الحركة الجوهريَّة الصدرائيَّة التي تدلُّ على اللبس بعد اللبس والحركة على امتداد الزمان أكثر من تطابقها مع الخلع واللبس الذي لا يحصل على امتداد الزمان. وتوضيح ذلك، أنَّ الشيء المادّيّ يتحرَّك من القوَّة إلى الفعل في نظريّتَي الخلع واللبس، واللبس بعد اللبس، إلّا أنَّ الخلع واللبس هو خروج دفعيٌّ للشيء من القوَّة إلى الفعل، والذي يحصل في “الآن” واللبس بعد اللبس، خروج تدريجيٌّ من القوَّة إلى الفعل الذي يتحقّق على امتداد “الزمان”.
يعتقد ملَّا صدرا أنَّ “الزمان” هو مقدار الحركة في الجوهر؛ أي أنَّ عالم الطبيعة في حالة تحرُّك وتجدُّد مستمرَّين، والزمان هو مقدار هذا التجدُّد والتغيُّر في الطبيعة، إلّا أنَّ من جملة الإشكالات والتحدّيات المطروحة في الحكمتين المشّائيَّة والمتعالية في خصوص الحركة الجوهريَّة، والتي قدّم صدر المتألّهين إجابات متعدِّدة لها، هو بحث ثبات الموضوع، والذي على أساسه رفض المشّاؤون الحركة في الجوهر، حيث اعتبروا أنَّ ثبات الموضوع واحد من ضرورات الحركة وهو يتنافى مع الحركة الجوهريَّة.
أمَّا في الفيزياء الجديدة، عندما تفنى الذرَّة في ميدان خاصّ (مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ في أحدث النظريَّات الكوانتوميَّة؛ أي نظريّة المدارات الكوانتوميّة، تكون الأصالة للمدار والذرّات هي مظاهر أو تجلّيات الحالات الصادرة عن المدار، والتي هي في حالة تحوّل وتغيير دائم من دون أن تتعرّض للزوال)، وعندما تخلق الذرّة [نوع الذرّة عينها]، فهذا يشير إلى ثبات الموضوع، وهذا الذي ادّعته الفلسفة الصدرائيّة وأيّدته انطلاقًا من اعتبار الحركة نوع من الوجود، ومن العينيّة بين الحركة والتحرُّك. وفي هذا الأمر، يمكن ملاحظات التطابق بين الأمرين.
المسألة الأخرى، أنَّ الجسم الطبيعيَّ في الفلسفة الصدرائيَّة مركَّب من القوَّة والفعل وتدلُّ القوَّة على المادَّة والفعل على الصورة؛ ولذلك، فالقوّة مرتبطة بالجسم الطبيعيّ. وفي ما يتعلّق بالذرّة الأساسيَّة، فهناك ما يشير إلى وجود ما هو بالقوَّة، كما يقول هايزنبرك: “هناك إمكان للموجوديّة أو ميل نحو الموجوديّة”، وتدلّ هذه الجملة على أنَّ الذرّات الأساسيّة هي حالة المادّة التي هي بالقوّة وليس المادّة بالفعل، وتحصل المادّة بالفعل من خلال اتّصال هذه الذرّات بعضها ببعض (ناجي أصفهاني وقاسمي، 1395، ص110). كما تجدر الإشارة إلى أنَّ الحركة في الحكمة المتعالية عبارة عن الخروج التدريجيِّ من القوَّة إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال. إذًا، النقص والكمال صفتان للشيء المتحرِّك في طول الحركة؛ وهذا يعني أنَّ الحركة الجوهريّة في الفلسفة الصدرائيّة تتحقّق على أساس استكمال مادّة الصورة، أمّا في نظريّة خلق وفناء الذرّات الأساسيّة، والتي يبدو في الظاهر أنّها تتطابق مع نظريّة الكون والفساد المشّائيّة، فقد لا يمكن الحديث بوضوح عن هذا البُعد الاستكماليّ. مع العلم، أنّ المدار يتعرّض باستمرار لحال هبوط وصعود (تحوُّل) دائم، وهنا يمكن الحديث عن هذه المقارنة الاستكماليّة.
في الحقيقة، فإنَّ توارد الصور المتقدِّم الذكر في خصوص الذرَّات الأساسيّة، هو نوع من التكامل وهذا ما يجعل من المقارنة بينها وبين الحكمة المتعالية أكثر وضوحًا. ومع التدقيق والتعمُّق، ندرك أنّ نظريَّة الحركة الذاتيّة والتكامليّة للجسم الطبيعيّ، تتّضح من خلال فرض وجود مادّة أولى هي بالقوّة المحضة ولا فعليّة لها سوى كونها بالقوة؛ وإذا نظرنا إلى المادّة الأولى للذرّات الأساسيّة من ناحية كونها عين المدارات الكوانتوميّة، فللمدارات هذه فعليّة، وبالتالي هي ذات صور. إذًا، يجب البحث عن الجسم الطبيعيّ ومادّته الأولى في أمر آخر في عالم الذرّات الكوانتوميّة. يبدو أنّ المفيد هنا هو الفكر الفلسفيّ فقط، وليس الاختبارات التجريبيّة، فليس هناك أيّ مختبر يتمكّن من إثبات وجود مادّة لا أثر لها على الإطلاق.
النتيجة:
في ما يتعلّق بالمقارنة بين تحوُّل الجسم الطبيعيِّ في نظريَّة الحركة الجوهريَّة الصدرائيَّة، وتحوُّل الذرَّات الكوانتوميَّة المستمرِّ، يمكن القول أنَّه أمر مبرهن ومتقن، ويترافق مع توارد الصور وليس مع تحقّق الوجود وفقدانه بالمعنى الفلسفيّ. وانطلاقًا من أصل عدم القاطعيَّة عند هايزنبرك الذي يدلُّ على التحوُّل الدائم والذاتيِّ للذرَّات الكوانتوميَّة، فإنَّ أيَّ ذرَّة لن يكون لها وضع متساوٍ في لحظتين متتاليتين. وتتطابق هذه الحالة مع نظريَّة الحركة الجوهريَّة الصدرائيَّة، حيث تكون الحركة على امتداد الزمان، وليس في “الآن”. وعندما نقول إنَّ الذرَّة الأساسيَّة تفنى في مدار خاصٍّ، ثم يخلق نوعها من جديد، فهذا يدلُّ على ثبات موضوع هذا التحوُّل، وهذا ما أشار إليه الملَّا صدرا تحت عنوان “عينيَّة الحركة والمتحرِّك”.
المسألة الأخرى، أنَّ الجسم الطبيعيَّ في الفلسفة الصدرائيَّة والذرَّة الأساسيَّة كلاهما متَّحد مع القوَّة. الحركة – من وجهة نظر ملَّا صدرا- هي الخروج التدريجيُّ من القوَّة إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال والحركة الجوهريَّة تفيد استكمال المادَّة وتوارد الصور في الذرَّات الأساسيَّة نوع من التكامل.
أخيرًا، يتمُّ توضيح الحركة الذاتيَّة والتكامليَّة للجسم الطبيعيِّ مع فرض وجود مادَّة أولى بالقوَّة من جميع الجهات، ولكن إذا أنتجت المدارات الكوانتوميَّة عين هذه المادَّة الأولى للذرَّات الأساسيَّة، سيكون لهذه المدارات آثار وصور، وبالتالي لا يمكن لها أن تكون المادَّة الفلسفيَّة الأولى، كما يشير العديد من القرائن التي لا يمكن التطرُّق إليها في هذا البحث.
المصادر:
- إبراهيمي الديناني، غلامحسين (1383)، شعاع الفكر والشهود في فلسفة السهرورديّ، طهران، انتشارات حكمت.
- ابن سينا، الحسين بن عليّ (1357)، النجاة، طهران، جامعة طهران.
- ابن سينا، الحسين بن علي (1376)، الإلهيَّات من كتاب الشفاء، تحقيق حسن حسن زاده الآملي، قم، انتشارات مكتب الإعلام الإسلاميّ للحوزة العلميَّة.
- ابن سينا، الحسين بن عليّ (1383)، الرسالة العلائيَّة (قسم الإلهيَّات)، همدان، انتشارات جمعيَّة الآثار والمفاخر الثقافيَّة وجامعة أبو عليّ.
- ابن سينا، الحسين بن عليّ (1404ق)، الشفاء (الطبيعيَّات)، ج1 و2، تحقيق: سعيد زاند، قم، مكتبة آية الله المرعشي.
- أرسطو (1377)، الميتافيزيك، ترجمة شرف الدين الخراساني، طهران، انتشارات حكمت.
- بانو ماريف، ال. (1359)، در آنسوى كونت [في الجهة الأخرى من الكوانت]، ترجمة هوشنك طفرائي، مسكو، مركز نشريات مير (غوتنبرغ).
- دهباشي، مهدي (1378)، شبكة المنظومة الوجوديَّة الصدرائيَّة وتأثيرها في الفيزياء الحديثة، مجلَّة نامه فلسفه، 3(3)، ص46-66.
- الشيرازي، محمَّد بن إبراهيم (ملَّا صدرا)، (1378)، رسالة في الحدوث، تحقيق حسين موسويان، طهران، مركز الحكمة الإسلاميَّة صدرا.
- الشيرازي، محمَّد بن إبراهيم (ملّا صدرا)، (1981م)، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليَّة الأربعة (ج3، 4، 5)، بيروت، جار إحياء التراث العربيّ.
- فولكيه، بول (1366)، الفلسفة العامَّة (ما بعد الطبيعة)، ترجمة يحيى مهدوي، طهران، انتشارات جامعة طهران.
- فياضي، غلامرضا، (1389)، علم النفس الفلسفيّ، قم، مؤسَّسة الإمام الخمينيّ التعليميَّة والبحثيَّة.
- كوز، فرانك (1387)، فيزياء الذرَّات، ترجمة فيروز آرش، طهران، الثقافة المعاصرة.
- مطهَّري، مرتضى (1383)، دروس الأسفار، (بحث القوَّة والفعل)، طهران، انتشارات صدرا.
- مطهَّري، مرتضى (1384)، مجموعة آثار الأستاذ الشهيد مطهَّري، ط7، ج5، طهران، انتشارات صدرا.
- منفرد، مهدي (1394)، ما هي الفلسفة المقارنة؟ الدراسات الفلسفيَّة الكلاميَّة، 16(4)، ص25-42.
- ناجي أصفهاني، حامد وقاسمي، ناصر، (1395)، مقارنة بين الجوهر الفرد من وجهة نظر المتكلِّمين المسلمين والذرَّات الأساسيَّة في الفيزياء الحديثة، دراسات العلم والدين، مركز دراسات العلوم الإنسانيَّة والدراسات الثقافيّة، 7(2)، ص97-116.
- نصيري محلاتي، أحمد؛ كهنسال، علي رضا ومسعودي، جهانكير، (1397)، أصالة الوجود ونظرية الميكانيك الكوانتومي – دراسة مقارنة، الحكمة الصدرائيّة 6(2)، ص163-169.
- هاوكينغ، أستيون؛ ملودينو، لئوناردو، (1391)، الخطّة الكبرى، ط2، ترجمة سارة ايزديار وعلي هاديان، طهران، طبعة مازيار.
- هايزنبرك، ورنر (1370)، الفيزياء والفلسفة، ترجمة محمود خاتمي، طهران، شركة العلمي للطباعة والنشر.
References
Aristotle, Métaphysique.
Aristotle. (1995). Categories. In Barnes, J. (Ed.), & Ackrill, J.L. (Trans.), The Complete Works of Aristotle. Princeton University Press.
Avicenna (Ibn Sina). (1404 AH). Al-Shifa’ (Tabi’iyyat) [Book of Healing: Earth Sciences], vol.1 & 2. (Research by Zaid, S.). Qom: Ayatollah Marashi Najafi Library.
Bohm, D. (1952). A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of “Hidden” Variables. I. Physical Review. 85(2), 166-179. doi: 10.1103/PhysRev.85.166
Bohm, D. (1952). A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of “Hidden” Variables. II. Physical Review. 85(2), 180-193. doi: 10.1103/PhysRev.85.180.
Bohr, N. (1913). 1. On the Constitution of Atoms and Molecules. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 26(151), 1-25. doi: 10.1080/14786441308634955.
Bohr, N. (1913). LXXIII. On the Constitution of Atoms and Molecules. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 26(155), 857-875. doi: 10.1080/14786441308635031.
Bohr, N. (1913). On the Constitution of Atoms and Molecules, Part II, Systems Containing Only a Single Nucleus. Philosophical Magazine. 26, 476-502. 10.1016/S1876-0503(08)70046-X
Close, F. (2004). Particle Physics: A Very Short Introduction (1″ edition). Oxford: Oxford University Press.
Dahbashi, M. (1378 AP/1999-2000). Shabake-yi Sistemi-yi Hasti Shenasi-yi Mulla Sadra va Imkan-i Baztab-i aan dar Fizik-i Jadid [Mulla Sadra’s ontological systematic network and the possibility of its reflection in modem physics]. Name-yi Falsafe. 3(3), 46-66.
Dirac, P. A. M. (1927). The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. doi: 10.1098/rspa.1927.0039
Einstein, A. (1905). Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Annalen der Physik. 322(6), 132- 148. doi: 10.1002/andp.19053220607
Fock, V. (1932). Konfigurationsraum und zweite Quantelung. Zeitschrift für Physik. 75(9-10), 622-647. doi: 10.1007/BF01344458
Foulquie, P (1947). Traité élémentaire de philosophie: Métaphysique (In French): Les Editions de L’Ecole
Hawking, S. & Mlodinow, L. (2010). The Grand Design. United States: Bantam Books Press
Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift Für Physik, 43(3-4), 172-198, doi:
10.1007/BF01397280
Heisenberg, W. Physic und Philosophie (physics and philosophy). Frankfurt (A. M.). Berlin. Wien: Ull- stein doi:10.13140/2.1.4886.3521/1
Mahalati, N., Kohansal, A. R., & Masoodi, J. (2018). Comparative Review on the Idea of Priority of Existence and Quantum Mechanic Theory. Bianmal Scientific Journal Sadra’i Wisdom. 6(2), 163-169.
Munfared, M. (2015). What is Comparative Philosophy? Journal of Philosophical Theological Research, 16(4), 25-42.
Naji Isfahani, H. & Ghasemi, N. (2017). Muqayese beyne Jowhar-i Fard az Nazar-o Mutakalliman-i Islami va Zarrat-i Bunyadin dar Fizik-i Novin (a comparison between the essence of an individual according to Islamic theologians and foundational particles in modem phyics]. Researches on Science and Religion. 7(2), 97-116.
Planck, M. (1901). Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum. Annalen der Physik. 309(3), 553-563. doi: 10.1002/andp.19013090310
Ponomarev, L. Pod znakom Kvanta (In Russian).
Sakurai, J. J. (1994). Modern Quantum Mechanics (Revised edition; S. F. Tuan, Ed.). Reading, Mass: Addison-Wesley.
Schrödinger, E. (1926). An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules. Physical Review. 28(6), 1049-1070. doi: 10.1103/PhysRev.28.1049
Shirazi, S. D. (Mulla Sadra). (1981). Al-Hikmat al-Muta’aliyah fi al-Asfar al-‘Aqliyyat al-Arba’ (The Transcendent Theosophy in the Four Journeys of the Intellect), vols. 3, 4, & 5. Beirut: Dar Ihya Turath al-Arabi.
Shirazi, S. M. (Mulla Sadra). (1378 AP/1999-2000). Risalat fi al-Huduth. (Research by Musavian, H.). Tehran: Sadra Islamic Philosophy Foundation.
De Broglie, L. (1923). Waves and Quanta. Nature. 112(2815), 540-540. doi:10.1038/112540a0
Avicenna (Ibn Sina). (1357 AP/1978-9). Al-Najat [The Book of Salvation]. Tehran: University of Tehran Press.
Ponomarev, L. I. (1359 AP/1980-1). Dar Ansuye Qwant [The Quantum Dice]. (Toghraie, H., Trans.). Moscow: Bongah-i Nashriyyat-i Mir (Kotenberg). [In Persian].
Foulquié, P. (1366 AP/1987-8). Falsafe-yi ‘Umumi [Précis de philosophie Tome III Métaphysique). (Mahdavi, Y. Trans.). Tehran: University of Tehran Press. [In Persian].
Heisenberg, W. (1370 AP/1991-2). Fizik va Falsafe [Physics and Philosophy: Revolution in Modern Science). (Khatami, M., Trans.). Tehran: mi Publications and Publishing Company. [In Persian].
Avicenna (Ibn Sina). (1376 AP/1997-8). Al-llahiyyat min Kitab al-Shifa [Book of The Healing: Metaphysics]. (Research by Hasanzadeh Amoli, H.). Qom: Daftar-i Tablighat-i Islami-yi Howze-yi Ilmiyya Publications.
Aristotle. (1377 AP/1998-9). Metaphysique [metaphysics). (Khorasani, S. D., Trans.). Tehran: Hekmat Publications. [In Persian].
Avicenna (Ibn Sina). (1383 AP/2004-5). Daneshnameyi Alayi (baksh-i Ilahiyyat) [The Book of Scientific Knowledge: Metaphysics]. Hamedan: Anjuman-i Athaar va Mafakhir-i Farhangi va Daneshgah-i Bu Ali Publications.
Ibrahimi Dinani, G. H. (1383 AP/2004-5). Shu’a-yi Andishe va Shuhud dar Falsafe-yi Sohravardi [the range of thought and intuition in Sohravardi’s Philosophy]. Tehran: Hekmat Publications.
Mutahhari, M. (1383 AP/2004-5). Dars-hayi Asfar (Mabahith-i Quwwe wa Fe’l) [lessons on Asfar, discussion on potential and actuality]. Tehran: Sadra Publications.
Mutahhari, M. (1384 AP/2005-6). Majmu’a-yi Athaar-i Ustad Shahid Mutahhari [a collection of Mutahhari’s works], vol. 5 (7th ed.). Tehran: Sadra Publications.
Klose, F. (1387 AP/2008-9). Fizik-i Zarrat [Particle Physics]. (Arash, F. Trans.). Tehran: Farhang-i Muaser. [In Persian].
Hawking, S. & Mlodinow, L. (1391 AP/2012-3). Tarh-i Buzurg [The Grand Design] (2nd ed.). (Izadyar, S. & Hadiyan, A., Trans.). Tehran: Mazyar Publucations. [In Persian].
([1]) فصليّة الدراسات الفلسفيّة – الكلاميّة، العام 23، العدد 1، ربيع 1400 هـ.ق/ 2021م.