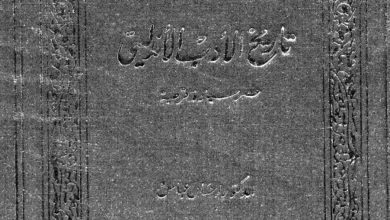الرواية الصوفيَّة المعاصرة.. بينيَّة التصوُّف والحداثة
محمد الأمين العلاونة
يعد الحديث عن مفهوم “الحداثة” في الفلسفات الغربية، حديثا عن مصطلح زئبقي لم يستقر على تعريف معين؛ سواء من حيث ارتباطه بالزمن، أو من حيث ارتباطه بمجموع أحداث، طارئة، عجلت بظهور المصطلح، فالدارس لمفهوم الحداثة، سيجد لا محالة ذلك التناقض في تحديدها.
أول ظهور لمفهوم الحداثة كان في بداية القرن السادس عشر (ق16)، مع الفيلسوف الألماني “إيمانويل كانط Immanuel Kant” فيما عرف حينها بفلسفة الأنوار التي تحث الإنسان على “الخروج من القصور الذي هو مسؤول عنه، والذي يعني عجزه عن استخدام عقله دون إرشاد الغير”، فالخروج من القصور، هو خروج عن تعاليم الكنيسة، خاصة إذا ما عدنا إلى الحقبة الزمنية التي تبعث ظهور الأنوار، أي؛ النظام الإقطاعي الذي ساد أوروبا قبل القرن السادس عشر، فيما عرف بعصر الظلام، حيث تحكمت الكنيسة في جميع تمفصلات الحياة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية، وهو ما عجَّل بظهور حركة فلسفية واسعة، تمثلت في ظهور العقلانية الأروبية، التي دعت لسقوط الميتافيزيقا، وارتقاء العقل، وهو ما نستشعره في رواية “الخيميائي”.
حيث أراد “باولو كويلو” أن تكون انطلاقة بطله الروائي “سنتياغو” من كنيسة مهجورة، “اسمه سانتياغو، كان النهار على وشك أن ينتهي عندما وصل، مع قطيعه، إلى باحة كنيسة قديمة مهجورة، كان السقف قد انهار منذ زمن بعيد”لتحيل الكنيسة إلى نهاية مرحلة الإقطاع، وبزوغ مرحلة الحداثة، خاصة مع عدم تحديد “كويلو” للزمن، واكتفائه بعبارة – منذ زمن بعيد- وهو ما يزيل اللبس القائم حول إشكالية تحقيب فترة الحداثة، فرغم أننا أشرنا إلى أنها وليدة القرن السادس عشر إلا أننا لا يمكن بمكان أن نجزم بذلك، لارتباط الحداثة بمجموع ظواهر وحالات نستقرؤها من خلال النص، لا من خلال الزمن، وهو ما يصرّح به “جون فرنسوا ليوتار”، في حديثه عن أزمة الزمن وعلاقته بمفهوم الحداثة، إذ يرى أنه لا الحداثة ولا المسماة ما بعد الحداثة يمكن تحديدها وتعريفها ككيانات تاريخية مرسومة بدقة، وأن الثانية تأتي دوما بعد الأولى، إذ تغيب الآنية أو “مفهوم الآن” إذا جزمنا فعلا بزمانية الحداثة.
ارتماء في اللا-نظام
يصّر “كويلو” على لا زمانية الأحداث في رواية الخيميائي، غير أنه يضعنا أمام مجموعة من الظواهر، أو الحالات باعتبار الحداثة ( حالة/ ظاهرة)، التي من خلالها نستطيع إدراج نص “الخيميائي” في مصاف النصوص الحداثية التي حاولت البحث عن مفهوم الحقيقة أو المعرفة بعيدا عن ميتافيزيقا الدين/ الكنيسة، لتحصر المعرفة الإنسانية في مسارين أو نمطين حسب ديكارت، نمط الإدراك بالذهن، ونمط التصرف بالإرادة؛ وهو ما يذهب إليه “ باويلو كويلو” في نفيه المعرفة الكنسية، “وذات مساء، تسلح بالشجاعة، وقال لوالده أنه لن يصبح كاهنا بل يريد أن يسافر”ففعل الرفض هنا، وعدم القبول، هو خروج عن النظام الكنسي، وارتماء في اللا-نظام، التي يتجسد في الرغبة في السفر، واختبار الحياة عن طريق الإرادة من أجل “ تحقيق “الأسطورة الشخصية”.
تحاول الحداثة، كما يراها “مارتن هايدغر” ويحذر منها، أن تصنع إنسانا “ينتج نفسه ويصنع ذاته وينشئ شخصه”، عن طريق استغلال الطبيعة وتدجينها، وهو فعلا ما انطلق من أجله “سانتياغو” كويلو، وقبله “سانتياغو” “ارنست همنغواي” في محاولته التغلب على البحر/ الطبيعة، يقول: “همنغواي” في وصف بطله: “كان كل ما فيه عجوزا مثله. إلا عينيه. عيناه كانتا في صفاء مياه البحر، يطل منهما المرح، وعدم الاعتراف بالهزيمة”؛ لتلتقي العبثية مع القوة وهو نفس ما نجده عند “كويلو”، إذ يرسم لنا بطلا خارقا يحاول التغلب على جميع العقبات المنثورة في طريقه التي تمثل في الصحراء، ليعبر بتطويعه للطبيعة عن شرط أساسي من شروط الحداثة.
إن الحديث عن ثنائية الدين وعلاقاته بالحداثة في رواية “الخيميائي”، وانتهاء النظام الكنسي خاصة، في العبارة، التي أردفها “كويلو” في نصه؛ والتي يصر فيها على سقوط الكنيسة والانتصار لتعاليم الطبيعة، أو اكتشاف الحياة عن طريق التأمل واستخدام العقل –دائما ما يشير باولو كويلو إلى الكتاب الذي يحمله سانتياغو معه أثناء ترحاله خاصة في الأندلس-، يقول: “ درس اللاتينية والإسبانية واللاهوت، ولكنه كان يحلم منذ نعومة أظافره بأن يخبر الحياة، وذلك شيء أكثر أهمية من معرفة الرب وآثام البشر”، فالدين عند سانتياغو لا يقتصر ثنائية الثواب والعقاب أو على الآثام والحسنات، وهو تقريبا نفس المنحى الذي ينحوه التصوف في مخالفته للشريعة، وهذا ما صرح به الشيخ ياسين، في رواية قواعد العشق الأربعون، إذ يقول مخاطبا شمس التبريزي: “توقف عن تشويش أفكار تلاميذي، قال الشيخ ياسين مقاطعا، أما نحن رجال الدين فيجب أن نهتم بما يفعله الآخرون، إذ يسألنا الناس أسئلة كثيرة، وينتظرون منا الإجابة عليها “لتقترب شخصية “سنتياغو” مع “ شخصية “ التبريزي” الذي رفض أن يكون مجمل الدين الحكم على أفعال الآخرين؛ ما جعل الشيخ ياسين، الذي جسد دور الدين، يثور على فكرة الدروشة والتجوال باعتبارها خروجا عن صحيح الدين ومعلومه.
تصوف الحداثة
يذهب أبو العلا عفيفي، في رؤيته للخلاف القائم بين المتصوفة والفقهاء إلى نقطة أساسية، اشتركت فيها الروايات الثلاث، حيث يرى أن المتصوفة: “خالفوا الفقهاء في اعتبارهم، النية أفضل من العمل؛ وفي تقديمهم التأمل على العبادة، والتحريم على الإباحة “وهو فعلا ما مارسه” سانتياغو” أثناء رحلته نحو الشرق، إذ أن الكتاب الذي كان يجسد عقلانية المعرفة في الغرب، تحول إلى ومضات تأملية، وكأن المعرفة بذلك تنتقل من العقل إلى القلب لتتصوف الحداثة، وتخرج من إطارها العقلاني إلى إطار آخر روحي، وكأن كويلو بذلك يقر بأن الفعل الحداثوي/ الحداثي لا يختص بمكان معين؛ بل قد يتحور المصطلح ليواكب الثقافات التي حل بها أو ارتحل إليها، وهو ما حدث مع “إيلا” بطلة رواية قواعد العشق الأربعون التي كانت تعيش حالة من الزيف الإيديولوجي، فهي كما قدمتها “ شافاق” امرأة متحررة، تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، يهودية غير متدينة”، فاليهودية عند “إيلا” مجرد ميتافيزيقا قد تغطي على عقلانية الغرب غير أنها لا تزيلها، لتشكل إيلا هي الأخرى حداثتها وفق حدود المجتمع الأمريكي الذي يؤمن بفكرة الانتماء، حالها حال الحداثة التي لا يمكن بمكان أن تخرج عن إطار المؤسسة، باعتبارها مركزا لا يجب الخروج عنه، فهل اعتماد “شافاق” و«محمد ديب” على نصوص تراثية يدخل في إطار الوفاء لمؤسسة التراث/ التاريخ؟
إن إشارتنا السابقة لعدم تحقيب الحداثة، هو جزء من إجابتنا عن السؤال المطروح، فما هو معاصر اليوم لا يعني بالضرورة أن يكون حداثيا، وما هو تراثي قد نجد فيه بعض ملامح الحداثة ذلك أن الحداثة “حركة انفصال، إنها تقطع مع التراث والماضي، ولكن لا لنبذه، وإنما لاحتوائه وتلوينه، وإدماجه في مخاضها المتجدد. ومن ثمة فهي اتصال وانفصال؛ استمرار وقطيعة” وهذا ما تمظهر في الروايات الثلاث، فـ«ديب” الذي غرف من مادية الغرب، وتشبع بالثقافة الغربية لم يجد من وسيلة للثورة عليها إلا استهلال كتابه “السيمورغ” بقصة تراثية شرقية، ومحاولته تلوينها واحتوائها، عن طريق إضافة نوع من “الميتا-نص” كامتداد للنص الأصلي، ومن ثمَّ تحويره وفق ما تقتضيه راهنية القص/ السرد، فالسيمورغ كنص فارسي، يحاول فيه “فريد الدين العطار” البحث عن الروحي الذي لا يدرك؛ إذ يعقل المعرفة الإنسانية بصفتين؛ معرفة مادية تتجسد في معنى أقرب ما يكون إلى “الصنمية” ومعرفة أخرى تستنفد الإنسان وتؤرقه؛ وهي “المعرفة الروحية” التي لا تتأتى للإنسان إلا إذا أدرك معنى الكمال، وهو ما نجده في نهاية كتاب منطق الطير في نسخته “العطارية”، يقول العطار: “جاءهم الخطاب من الحضرة، قائلا بلا لفظ، إنَّ صاحب الحضرة مرآة ساطعة كالشمس، فكل من يقبل عليه يرى نفسه فيه، ومن يقبل بالروح والجسد، يرى الجسد والروح فيه ولأنكم وصلتم هنا ثلاثين طائرا، فقد بدوتم في المرآة ثلاثين طائرا “لنجد ذلك التداخل/الصوفي بين ما كتبه العطار في القرن السادس الميلادي، وبين ما كتبه “محمد ديب” في الألفية الثالثة، غير أن الاختلاف يكمن في النهاية التي اختارها “محمد ديب” لنصه؛ حيث نجد أنه لم يوظف وسيطا بينه وبين “السيمورغ”؛ واختصرت نهاية نصه على عبارة “أنا السيمورغ” التي اعتمد فيها ضمير المتكلم “أنا “، والذي يحيل إلى “ذاتية” متخمة، فأنا “محمد ديب” تقترب من “أنا” ديكارت في قوله: أنا أشك..إذن أنا أفكر، إذن أنا موجود، فالذاتية كشرط حداثي، أفرزته “أنا أفكر” ديكارت، التي أسست لـ«حقيقة مجردة مبتورة لا أساس لها، سقطت في الذاتية المتعالية والمغالية حينما رأت أنَّ الـ«أنا أشك” هو اليقين الذي لا شك فيه.
لقد تمركزت حول نفسها، وتوهمت أنها تستطيع تأسيس يقينها الخاص بها حول نفسها”، إذ بقي الكوجيطو الديكارتي منغلقا على ذاته، من خلال توهمه الوصول إلى الحقيقة عن طريق الشك، وقبلها أنا “كانط الأخلاقية” في بحثها عن الواجب، ومعهما “أنا أحلم” الفرويدية، التي عجزت عن تكوين ذات واعية، واكتفت نظرية “فرويد” بالبحث عن مكانة ابستيمولوجية للتحليل النفسي، لتقارب أنا ديب جميع الأناة غير أنها لم تساوها، وهذا ما يتجسد في عبارة “ أنا السيمورغ” التي تعدت المفاهيم التقليدية للذات؛ وأصبحت “ذاتا أنطولوجية” تستنطق الوجود؛ باعتبار النص، أو اعتبار السارد لم يوضح طبيعة الرحلة التي خاضها، هل هي حلم؟ أم هي نزعة أخلاقية مضادة للنزعة المادية التي أفرزتها الحداثة الغربية؟ أم هي نزعة عقلانية تؤسس لمفهوم جديد للعقل عند ديب؟ خاصة حين نجده يقارن بين لا- لفظية العطار، وبين ضبابية الموسيقى، أو “ لنقل الأشياء بصيغة أخرى، لنقل أنك تجهل تماما معنى التدوين الموسيقي، ولا تعلم بوجوده أصلا، ولم تر في حياتك توليفة موسيقية أبدا ثم يحدث أن تصادف واحدة. واحدة مطبوعة أو أحسن من ذلك، أن تكون مخطوطة. الانطباع الأول الذي يتكون لديك هو أنها عمل فني منقوش هو ليس تصويريا بالضبط، ولا تجريديا. لن تتصور في كافة الأحوال هذا ولا ما تحمله من معاني.
خارج حدود الورقة
إنها تتحرك بحمولتها وتلك هي حقيقة وجودها الأولي، وسبب ما أعدت له وذاك ما يتخطى التعبير النحتي، وكذا حدود إطار الصفحة التي تمنح نفسها لنظرك. دون أدنى شك منك، أنت الأجنبي على هذا الفن، تبقى الموسيقى التي راحت تغني هناك بالداخل شفافة، تتواجد فيما وراء ذاك الخط خارج حدود الورقة”، فالموسيقى عند محمد ديب، هي قول بلا لفظ، هي توجه نحو المطلق والخيالي والميتافيزيقي بعيدا عن براثن العقلانية، إذ تمنحك روحها دون معرفتك إياها، إنها شبيهة بالمرآة التي أدركها “العطار” في منطقه والتي تأخذنا إلى معنى الفناء الصوفي، الذي يرى “الكلابادي” أنه يجب أن “يكون غيبة عن أوصافه – الله- فيرى بعين العتاهة وزوال العقل، لزوال تميزه، وهو على ذلك محفوظ في وظائف الحق عليه”، فزوال العقل عند “الكالاباذي” عن طريق الفناء الصوفي بين العبد والخالق دون مشاهدة – فناء المشاهدة-، أما الفناء عند محمد ديب، فيساوي تلك العوالم التي تأخذك إليها الموسيقى/ الفن، والتي يربطها -ديب- بـ«المطلق” الذي يأخذ دلالات مختلفة في الطرح الفلسفي، حيث يَخرج “اللوغوس” من وجوديته إلى عوالم أكثر انفتاحا قد تتجسد في فكرة “ الإله”، خاصة في الفلسفة الهيغيلية التي رأت أن اللا-نهائية هي التي تؤسس لوجود الدزاين، إذ تنطلق من فكرة الأطروحة ونقيضها، أو فكرة المجهول في الفلسفات الشرقية والذي جعل الديانات الشرقية القديمة تحاول معرفة كنه الخالق، وماذا يوجد خلف العدم، وهو ما عبر عنه “فريد الدين العطار” بتلك الرحلة الصوفية بحثا عن المبهم أو اللامحدد.
_______________________________
*نقلًا عن موقع ” فواصل “.