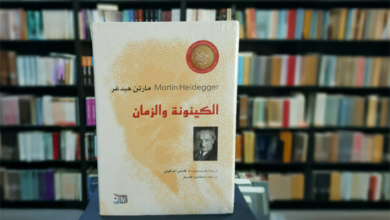قراءة في كتاب “مقاربات منهجية في فلسفة الدين” حين ينظر المتديّن إلى دينه من بُعد
محمود حيدر
قراءة في كتاب “مقاربات منهجية في فلسفة الدين” حين ينظر المتديّن إلى دينه من بُعد
محمود حيدر
تخيَّر المؤلف الشيخ شفيق جرادي لنفسه في عمله هذا “مقاربات منهجية في فلسفة الدين” أن يقرب أمرًا لا يؤخذ عنده إلا على اليقين. حتى إذا نظر إلى الدين من بوابة السؤال حلَّت مفارقة. فسيذهب من اعتاد ألّا يرى من جغرافية الفكر الديني المعاصر سوى الأبنية الصمّاء، إلى السؤال المعكوس: كيف لمفكّرٍ متديِّن أن يواجه بالسؤال ما يُظن للوهلة الأولى أنه مركوز في القلب، ومسدّدٌ بالعقل، ومثبَّت بالإيمان؟
أو كيف لرجل دين أن يمضي في فضاء ما يدعو إليه، فينشئ مساحة في نفسه من نفسه، ثم ليفارق تلك المساحة حتى يصير خارجها، وينظر إليها من مسافة نظرة الناقد المُسائل؟
هذان الاستفهامان المركّبان هما على رباط وثيق بما في الكتاب. وإن بديا كنافلة ترتبت على صلة النص بصاحبه. فلو رأينا إلى مقدِّمات النص ومقاصده لتحصّلت أسئلة لا حصر لها. أسئلة تبتدئ من معنى مفهوم فلسفة الدين، إلى المناهج والمقاربات التي عولج فيها الدين وقضاياه على نظام السؤال الفلسفي.
أي قصد أراده المؤلف في جعل ما هو منه؛ أي ما هو شأن اعتقادي بالنسبة إليه، مجالًا للمساءلة؟ ثم ما المنهج الذي أخذ به وسط حمّى السجال حول الدين بوساطات معرفية كثيرة، وفي مقدمها الواسطة الفلسفية؟
لعل أول ما يحتمله القارئ من كاتبٍ ذهب إلى هذه الدرجة من المحاولة هو أنه اتخذ لنفسه منطقة نظر محايدة؛ لأن المطلوب هو شغل إبستمولوجي، حيث إن كل نظرية معرفية واقعية تفترض التمييز بين الشيء والعلم بالشيء. فالشيء القائم بذاته هو موضوع للنظر والتأمل والاستقراء، وكذلك إلى التحليل والتفسير والتأويل. وأما العلم بهذا الشيء فهو فهمه بمنأى من شغف الشعور به، قربًا أو بعدًا، والطرائق والمناهج والآليات هي التي تفضي إلى ذلك الفهم. وإذًا، فالعلم بالشيء هو فهمه كما هو في الواقع من جانب الفاهم وبحسب سعة علمه وقدرته على الفهم. وإذا كان الشيء لا يعلم إلا بوصفه انحيازًا في الزمان والمكان، فلا يسع الساعي إلى العلم حالئذٍ، أن يعلم بمنأى من حضور المعلوم في الواقع. فالعلم كما يتفق الفلاسفة، هو صورة حاصلة في النفس مطابقة للمعلوم.
ولما كان الأمر كذلك، فسنفترض أن على القائم بالمهمة الفلسفية شدَّ الرحال وضبط النفس، وتسديد العقل، لكي لا يظهر ما هو مدار المساءلة أضيق ولا أوسع مما هو في الواقع.
وعلى تنبيهات ابن الهيثم في المنهج: أنه من الواجب على الناظر في كتب العلوم إذا كان غرضه معرفة الحقائق، أن يجعل نفسه خصمًا لكل ما ينظر فيه، ويجيل فكره في متنه، وفي جميع حواشيه، ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه، ويتهم نفسه أيضًا عند خصامه.
بهذا سنقترب من ما يسمونه درجة الحقيقة في الكتابة النقدية؛ لأن قصد المؤلف في الاقتراب من الدين عن طريق فلسفة الدين هو النقد. والنقد الفلسفي هو إبداع المفاهيم المستلّة من منطقة سُيِّجت بتحريمات الموروث وسلطانه. حتى إذا جاء النقد ليحفر في نظام الكلمات جعله ميدانًا مشرَعًا على أسئلة جديدة أو على أسئلة قديمة تقدَّمُ بطريقة جديدة. ولست أخال أن محاولة الشيخ الداخلة في عالم الحفر المعرفي في فلسفة الدين لن تنأى بنفسها عن منهجية النبأ اليقين الذي يمتلئ به محصول الفكر الديني. ففي المقدِّمة يعلن مؤلفنا أن الصيغة المتبنّاة هي الأخذ بالجامع الكلّي لنتائج الدراسات الدينية، والنظر إليها برؤية استكشافية نقدية تحمل روح البحث على أساس فلسفة الدين، وهي صيغة يقول المؤلف إنها تنطلق من النص الديني التأسيسي لتنشئ منهجية تقوم على مستوى من الجدل التوليدي للنص يستخرج منه المستبطن ثم يتقدم لملاقاة جدل توليدي آخر لواقع النتائج العلمية ليختبر قدراتها وخلفياتها ومستلزماتها في الفهم والتأويل، ثم ليوجد نحوًا من التلاقي النقدي غير التوليفي بينهما، وذلك عبر جدلية جديدة لا تقوم على إعدام حيثيتي المنطلق وهي تصوغ أطروحتها الجديدة. إنها مهمة تنبني على جدلية التوليد الذاتي لكل من النص المؤسس وعلوم الحياة وواقع الإنسان.
كيف استخدم المؤلف تنظيره المنهجي في جدلية التوليد الذاتي ليقيم مقارباته في فلسفة الدين؟
لعل أول ما يواجهه قارئ المقاربات هو: أي فلسفة دين يعنيها المؤلف ليقترب من موضوعاته، ثم ليؤسس عليها منهجه في الجدل التوليدي؟
ما الذي يضبط مساحة الجدل عند تخوم النص المؤسس من دون أن يتعداه، لا سيما وأن العمليات الجدلية للتوليد المعرفي لا تتناهى؟ فأين يتوقف النقد إذًا لنعرف الحد الذي أقامه المؤلف وهو يشتغل في فضاء السؤال الفلسفي؟
هذا السؤال المركّب ضروري لكي ندرك الحدود التي سيتوقف عندها الباحث في فلسفة الدين من دون أن يمس ما يؤمن به، وينظر إليه كمقدّس لا يأتيه الريب أو الشك أو المساءلة. لنرى كيف يمكن اجتياز مثل هذه المعضلة حيث يُحشر العقائدي مع المعرفي في الزاوية الحادة.
ما فلسفة الدين ومن فيلسوفها؟
ثمة تعريفات لفلسفة الدين وفيلسوفها سبق أن جُعلت كمنطلقات للبحث الفلسفي، وهي مع ذلك تبقى مفتوحة على الاجتهاد وقابلية التأويل. بالنسبة إلى فلسفة الدين فهي تمارس كفعل معرفي، ضمن أحوال شتى أهمها:
• حين يُدرس الدين وفقًا للمقولات الفلسفية، أنطولوجيًّا ومعرفيًّا وتاريخيًّا.
• حين يدرس الدين كموضوع يتناوله الفلاسفة كل على طريقته.
• حين يدرس الدين فلسفيًّا على أرض المقولات الدينية.
أما فيلسوف الدين فذاك الذي يسلك طرائق متعددة للدرس والبحث والتأويل:
• فهو كل فيلسوف يتكلم عن الدين كموضوع، أو كل من يستند إلى مقدمات فلسفية من خارج الدين للبحث في القضايا الدينية.
• وهو كل فيلسوف يعمل بمقدمات فلسفية من خارج الدين ويصل إلى الدين من دون أن يقصد بالضرورة إثبات الدين.
• وهو كل فيلسوف يشتغل بالسؤال الفلسفي للبحث في الدين بوصفه ظاهرة بشرية.
• وهو أخيرًا وليس آخرًا، كل فيلسوف يتعامل مع الدين بقصد إجراء بحوث مقارنة مع أديان أخرى.
ولا تتوقف إشارات الاستفهام عند هذا الحد، فإننا لا نفتأ حتى ندخل في إشكاليات استفهامية أخرى حول ما إذا جاز لفيلسوف الدين أن يكون متكلّمًا، أو فقيهًا أو عارفًا؟
ثمة من يذهب إلى أن بالإمكان أن تتعدد صفات الفيلسوف غير أن التراث الفلسفي الغربي حرص على أن يعمل وفق المنهج الخارج ديني ليدخل إلى دائرة الدين، ثم ليغادرها من دون أن تمسه مشاعر الداخلين فيه وأحكام المعرفة الإيمانية به لديهم.
لكن في مقابل هذا التوصيف ثمة من يجيز لفيلسوف الدين أن يتخذ لنفسه مثل هذه الصفة إذ هو يتمتع بوظائف أخرى منها:
• إن كل فيلسوف دين يتكلم عن الدين كموضوع يسمى فيلسوف دين.
• إن فيلسوف الدين يمكن أن يستند إلى مقدمات فلسفية من خارج الدين لبحثه.
• إن فيلسوف الدين يعمل بمقدمات فلسفية من خارج الدين ويصل إلى الدين من دون أن يكون القصد إثبات الدين.
• فيلسوف الدين يعمل بعدة الفلسفة ويتعامل مع الدين كظاهرة بقصد المقارنة بين الأديان.
محوران للتجربة
تفضي الموضوعات التي وردت في فصول الكتاب الثمانية إلى تنوع في القضايا دارت على الجملة بين محورين:
– محور نظري عام حول فلسفة الدين ومناهج التنظير الغربي.
– ومحور تحييز التنظير في نطاق جدليات الفكر الفلسفي الإسلامي.
ولسوف نجد أن المؤلف قد جعل لنفسه منطقة اشتغال منفردة في إطار الذمة الواسعة لفلسفة الدين، بحيث أبقى صلته على عروة وثقى بالنص المؤسس. فقد جعله صراطًا معرفيًّا يسعى من خلاله منح المشروعية لمنهجه الخاص في ما يسميه “الجدل التوليدي”.
إذا كانت مهمة فيلسوف الدين هو النظر إلى الدين كموضوع يتناوله البحث الفلسفي، فذلك ما لا يصح على موضوعات الكتاب؛ لأن الاشتغال بالسؤال الفلسفي لبحث الدين كظاهرة بشرية، وهو ما تعنيه فلسفة الدين بحسب التأويل الفلسفي الغربي، يستلزم التعامل مع الدين بوصفه أمرًا من صنع البشر، أو أنه وظيفة أبدية للروح الإنساني حسب هيغل، أو حسب فيورباخ الذي يرى أن الإنسان ينسب إلى الله طبيعته السامية، حيث خلق الإنسان إلهًا لنفسه على صورته يحمل ملامحه تمامًا، ووضعه في عالم متسامٍ كطبيعة سامية له، وهذه الطبيعة يجب أن تعود إليه. فالاعتقاد في الله- بحسب فيلسوف الدين الألماني- يأتي كنتيجة ضعف وفقر الإنسان؛ لأنه لو كان الإنسان قويًّا غنيًّا ما كان يحتاج إلى الله. ولذا فإن سر الدين- عند فيورباخ- هو الأنثروبولوجي، وليس الإلهي الوحياني.
لقد انطلقت جدلية المقاربات من المتسامي المقيم في النص المؤسس، فحاولت أن تبدأ رحلتها من الداخل الديني، ثم لتغادر قليلًا لتنظر إليه من الخارج من دون أن تنفصل عنه شعوريًّا، ثم لا تلبث حتى تعود إليه بغنيمة معرفية كان للآخر (غير الديني) فيها فضيلة الكلام المختلف والسؤال المختلف.
ماذا لو أفضت منهجية الجدل التوليدي إلى جعل النص المؤسس لا مجرد الفكر الديني، موضوعًا للمساءلة وإعادة الإنتاج، سواء من خلال ممارسة التأويل أو عبر استخدام المناهج العلمية الحديثة؟
إذا كان التوليد مهمة لا متناهية من وجهة نظر إبستمولوجية، وتحديدًا من وجهة نظر فلسفة الدين، فذلك ما قد يؤول إلى نزع الإطار اللاهوتي وتاليًا الفقهي، ويبقيه قدرًا متروكًا لإيمان الفرد، بحيث لا يُرى الله إلا بعين الفرد. أو كما قال السيد إيكهارت: إن العين التي يراني بها الله هي العين التي أراه بها، وإن عيننا هي عين واحدة، وإذا لم يوجد الله فإنني سوف لا أوجد، وإذا لم أوجد فلن يوجد الله.
نظرية الجدل التوليدي
هل تصل عملية الشغف المعرفي إلى هذا الحد عند صاحب الكتاب؟
لسنا نميل إلى تصور أن فلسفة الدين بحسب نظرية الجدل التوليدي تعمل في هذه المنطقة المعرفية، وذلك ما سنراه لو نحن بسطنا المقاربة من خلال السعي إلى الجواب على السؤال التالي:
هل تتدرَّج فلسفة الدين عند المؤلف لكي تبلغ مرادها المعرفي والإحيائي أن تمضي مثلًا إلى أن تعصرن لغة الدين؛ بمعنى أن تبدِّل من مفردات هذه اللغة مع الاحتفاظ بدلالتها المعنوية، وبذلك تجد مخرجًا مفترضًا من معضلة تجاور الاعتقادي/ المعرفي؟
هذا هو بالضبط ما فعلته الكاثوليكية في الغرب وهي تتمثل منجزات الحداثة وتتكيف شروطها المعرفية والفلسفية. وهذا ما فعله الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط وهو يبني عمارته الأخلاقية، حيث سلك طريقين يوضحان كيف أن تأثير الدين في الأخلاق لا يمكن حصره في شكل أو شكلين كاقتباس بعض المعاني المدنية أو “البناء على بعض الأصول العقدية”، بل إن له أشكالًا عدة منها الظاهر والقريب، ومنها الخفي والبعيد، ومن أخفاها وأبعدها أن يُتوسَّل بالدين لقطع الصلة بالدين. كما إذا أراد العلماني أن يضع نظرية علمانية بعناصر مأخوذة من الدين. ولعل الطريقين الآتيين هما شكلان من أشكال هذا التأثير الديني الخفي في بناء نظرية أخلاقية علمانية. حتى لقد قيل بأن فعلًا من هذا النوع هو “علمنة للدين المسيحي”:
أحدهما طريق المبادلة: والمقصود بهذا الطريق، أن واضع النظرية الأخلاقية يأخذ بدلًا من المقولات المعهودة في الأخلاق الدينية مقولات أخلاقية مقابلة لها غير معهودة بنفس الاستخدام النظري في هذه الأخلاق. فعلى سبيل المثال نورد ما سلكه كانط في هذا الميدان: فقد أخذ مفهوم العقل بدل مفهوم الإيمان، والإرادة الإنسانية بدل الإرادة الإلهية، والحسن المطلق للإرادة بدل مفهوم الإحسان المطلق للإله، ومفهوم الأمر القطعي بدل مفهوم الأمر الإلهي، ومفهوم التجريد بدل مفهوم التنزيه، ومفهوم احترام القانون بدل مفهوم محبة الإله، ومفهوم التشريع الإنساني للذات بدل مفهوم التشريع الإلهي للغير، ومفهوم الخير الأسمى بدل مفهوم النعيم، ومفهوم مملكة الغايات بدل مفهوم الجنة.
والثاني طريق المقايسة: والمقصود به أن واضع النظرية الأخلاقية يقدِّر أحكامه الأخلاقية على مثال الأحكام التي تأخذ بها الأخلاق الدينية. فكما أن هناك مثلًا أخلاقًا من تقرير الدين المنزَّل، فكذلك ينبغي أن تكون هناك أخلاق من تقرير العقل المجرَّد. وكما أن الأفعال في الأولى تكون خُلُقية بموجب طاعتها للأمر الإلهي، فكذلك الأفعال في الثانية تكون خلقية بموجب عملها بالأمر الإنساني. ومن هنا يتبيَّن أن المشابهة بين المعاني والأحكام الدينية، وبين المعاني والأحكام الأخلاقية إن لم تكن مقصودة لذاتها ومرغوبًا فيها، فلا أقل من أنها جاءت في غاية الاتساق والإطراد. حتى إنه لا مجال للشك في أن كانط أقام نظريته الأخلاقية العلمانية على قواعد دينية مع إدخال الصنعة عليها، حيث استبدل الإنسان مكان الإله مع قياس أحكامه على أحكامه، فإذن ليس لهذه النظرية من وصف العلمانية إلا الظاهر، بحيث تصير العلمانية هنا عبارة عن “ديانية” خفية مثلُها مثل الديانية الجلية في الأخلاق المنزلة، ولا تفترق عنها إلا في كون المستحق للتعظيم فيها صار هو الإنسان العيني وليس الإله الغيبي(1).
ماذا إذًا بالنسبة لموضوعنا في مقاربات الشيخ جرادي ضمن نَسَقية فلسفة الدين وأحكامها ومناهجها المعروفة؟
إذا كان لمقاربات المؤلف من مرمى في الزمن، أو من غائية ما بعيدة المدى، فهي لن تلتقي بالضرورة بما هو تنظير لاحتمال يمكن أو لا يمكن أن يوجد. وأميل إلى الاعتقاد بأن الفصل الأخير من الكتاب وهو فلسفة الدين والإحيائية الإسلامية المعاصرة يفضي إلى ذلك المرمى وتلك الغائية. أعني بهما جعل فلسفة الدين بمنهجية الجدل التوليدي الذي ينطلق من النص الأول (الكتاب والسنة) لتحقيق عملية الإحياء؛ أي التعامل معها كطريق معرفي لإصلاحية دينية ذات بعد معاصر، وإن لم يشر المؤلف صراحة إلى هذا الاصطلاح.
ينبني هذا البحث في منطلقاته التأسيسية – كما يقرر صاحب المقاربات- على غير قواعد اللاهوت وعلم الكلام، وإنما ينبني على “فلسفة الدين” بمنظار معرفي يحاكي الإنسان في إنسانيته، والواقع بمقتضياته من دون أن يهمِّش الدين، بل هو يعمل على إعادة الدور المركزي له بعد أن أكلته غفلة الجاهلين وجبروت السلاطين. على الأخص سلطة المؤسسات الدينية بجمودها القاتل في الكثير من الأحيان.
لو كان ثمة غائية من الاستعمال المعرفي لفلسفة الدين عند المؤلف لما وجدناها إلا في ما نسميه باستراتيجيا فكرية إحيائية للدين من نوع جديد، لكنها استراتيجية تستوي على صراط التساؤل، وهي من شأنها لو أفلحت في مشروعها، أن تتخذ من شرعية السؤال نظامًا يتخفَّف فيه العقل الديني من وطأة التشيؤ، ويبقي روح الدين على شأنه الأول بوصفه نظامًا جامعًا بين الدنيا والآخرة، وليس “نظامًا مانويًّا” يضع الأولى في قبال الآخرة.
لقد سعى الفيلسوف الفرنسي المعاصر بول ريكور إلى اجتياز معضلة “أدلجة” الدين، سواء جاءت “الأدلجة” من منطقة رفض الإلحاد، أو من منطقة قبول الإيمان بالنص قصد التوظيف.
لكن هذا المسعى لم يكن على صاحبه هيِّنًا.
يعترف ريكور بأن موضوعًا كهذا أرغمه على التصدي لتحدٍّ جذري سوف يختبر قدرته على الاضطلاع بنقد الدين الناتج عن الإلحاد. كنقد نيتشه وفرويد، مثلما يختبر قدرته في كل لحظة يمكن أن يعتبر نفسه أثناءها مسيحيًّا من وراء هذا الاختبار.
يلاحظ ريكور أنه إذا كان عنوان مسعاه وهو “المعنى الديني للإلحاد” غير باطل، فذلك يستلزم أن لا يستنفد الإلحاد معناه في السلب وفي هدم الدين، ولكن أن يحرر الأفق بالنسبة إلى شيء آخر، وبالنسبة أيضًا إلى إيمان يكون قادرًا على أن يسمّى إيمان ما بعد الدين، وإيمانًا بالنسبة إلى عصر ما بعد الدين. تلك هي الأطروحة التي شكّلت محور المسعى الريكوري وغايته والتي اقترح فيلسوف الهرمينوطيقا على نفسه وضعها موضع الامتحان واحتمال الدفاع عنها(1).
ذلك أن على المفكّر لكي ينتج فكرة جديدة مبتكرة أن ينأى مسافة ما عن المقروء الذي بين يديه؛ لأن هذا الذي بين يديه، بما يكتظ به من أفكار ومعارف صارت أقرب إلى المقدَّس، بل إنها صارت سلطة معرفية ينبغي أن يدخل معها في نزاع. فإما أن تغلبه بحيث يعيد إنتاجها كما هي، فلا يتغير في النص المنتج إلا شكله والسياق اللغوي الذي جاء فيه، وإما أن يتغلب هو على النص بحيث يستوعبه ويحتويه “ويهضمه” ثم ليتعداه برحمانية بالسؤال. ففي السؤال الرحماني يكمن تقوى الفكر والقلب.
لقد أضاء ريكور على مناطق معرفية في منتهى الإشكال وهو يرى إلى الدين من وجهة نظر فلسفة الدين. كان يخشى على الدوام السقوط في لجة الحكم المسبق؛ أي الحكم الذي غالبًا ما يتجلى عبر ثلاثية إشكالية توفرها له العملية الأيديولوجية:
• استحالة تفادي الأيديولوجيا في الممارسة المعرفية للدين.
• إمكان “الحيلة” في الممارسة الأيديولوجية حيال الدين.
• حقيقة أن هذه “الحيلة” هي أيضًا آلية أيديولوجية.
وليس من شك في أن مقاربات الشيخ جرادي تدخل في فضاء مخصوص، هو كمثل هذا المثلث الإشكالي، لكن الأهمية التي تمكث فيها تلك المقاربات، أنها فتحت على احتمال جدي وجريء لإنشاء جغرافيا معرفية تسعى إلى إجراء مصالحة بين المتعالي في الدين، وبين الرؤية الإبستمولوجية للظاهرة الدينية التاريخية من خلال ما يسميه المؤلف بمنهجية الجدل التوليدي.
هل ثمة أفق لمثل هذا المسعى؟
ذلك ما تعيِّنه الشروط الموجبة لنجاح مشروع نظري معرفي لما يزل في طور التكوين.
(1) – عبد الرحمن طه، سؤال الأخلاق، المركز الثقافي الإسلامي، 2000، ص 40.
(1) – ريكور بول، صراع التأويلات، دراسات هرمنيوطيقية، ترجمة منذر عياشي، مراجعة جورج زيناني، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، 2005، ص 503.
______________________
*نقلًا عن موقع ” المعارف الحكمية – معهد الدراسات الدينية والفلسفية”.