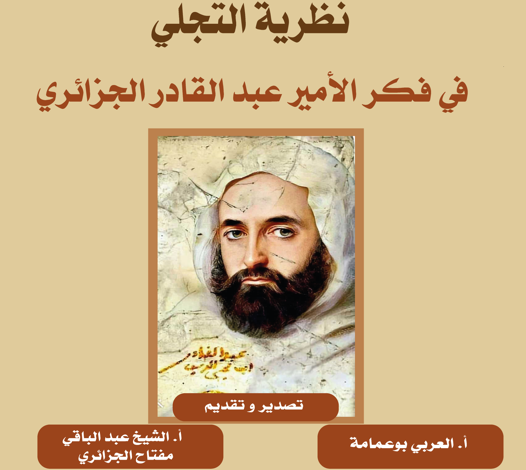
نظرية التجلّي في فكر الأمير عبد القادر الجزائري
الشيخ عبد الباقي مفتاح الجزائري
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أصل كلمة “تجليات” من:”تجلى الشيء” أي انكشف وظهر وبرز. ومن مرادفات “التجلى”: الفيض – الظهور – التنزل – الفتح. وفي القرآن الكريم وردت هذه الكلمة مع مشتقاتها في آيات، منها الآية 143 من سورة الأعراف: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ). وورد “التجلي” أيضا في أحاديث نبوية منها: (إنَّ اللَّهَ إذا تجلَّى لشَيءٍ من خلقِهِ خشَعَ لَه)- رواه ابن حزم في “المحلى”-.وهذه الكلمة ومشتقاتها كثيرا ما تتكرّر في كتب الصوفية، خصوصا الشيخ محيي الدّين ابن العربي. والملاحظ في الكثير من كتبه استعمالها متبوعة بنعت مناسب لسياق النص. فمثلا في كتابه “مواقع النجوم” يتكلم عن أنواع التجليات: الضيائي والنوري والصمداني. وفي شرحه لديوانه “ترجمان الأشواق” يتكلم عن “تجلي الهويّة”. ويستعمل أحيانا كلمة “تجليات” للإشارة إلى آيات القرآن. بل إنّ تجليات آيات القرآن عنده- خصوصا تجليات الأسماء الحسنى المذكورة فيه- هي أمّهات كلّ التجليات الأخرى جملة وتفصيلا.
وأهمّ مصدر لهذا الموضوع عند الشيخ الأكبر هو موسوعته الكبرى “الفتوحات المكية”. ولأهميّة موضوع التجليات تكرّرت فيه كلمة “تجلي” مع مشتقاتها أكثر من ألف مرّة. وفيه وُصفت التجليات المختلفة بنحو خمسين نعتا، منها مثلا: التجلي الإلهي، وتجلي الحق، والتجلي الإبداعي، والتجلي الإجمالي، والتجلي الأعظم، والتجلي الأقدس، والتجلي الأول، وتجلي الإنكار، وتجلي البُعد، وتجلي الجلال، وتجلي الجمال، والتجلي الدّائم، وتجلي الأفعال، وتجلي الصفات، والتجلي الذاتي، وتجلي النكاح، والتجلي في صور الاعتقادات، والتجلي في السراب، والتجلي في الأشياء.
ومن أهمّ مصادر الشيخ الأخرى في هذا الموضوع: “كتاب التجليات”، وهو الذي قال عنه الأمير عبد القادر الجزائري في الموقف 358 من كتابه “المواقف”: (لو كتب بماء العيون كان قليلا في حقه وهو أحق بقول القائل: هذا كتاب لو يباع بوزنه ذهبا لكان البائع مغبونا(…) أودع فيه من الحقائق والعلوم الإلهية ما لا يصدر إلا منه، ولا أقول لا يصدر إلا من مثله، فافهم]. وهو يتضمّن 109 تجليا، منها مثلا: تجلى الأحدية؛ تجلى الأمر؛ التجلي الأوسع الشمسي؛ التجلي البصري؛ تجلي نعوت تنزيل الغيوب؛ تجلي الواحد في المقامات؛ ـ تجلي الواحد لنفسه؛ التجلي الوجودي. وقد حقق هذا الكتاب تحقيقا ممتازا الأستاذ عثمان يحيى- رحمه الله-(ت:1998) مع شرح ابن سودكين الذي سمعه من مؤلفه الشيخ نفسه، ومع شرح آخر لمؤلف مجهول، ونشر في طهران سنة 1988، وأعيد نشره في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 2002. وفي نهاية هذه الكلمة فقرات مستلهمة من كلام عثمان يحيى في المقدّمة الثريّة الطويلة التي صدّر بها تحقيقه لكتاب التجليات. وقد كتبت شرحا على هذا الكتاب بالاستناد إلى مرجعيته القرآنية الخفيّة، وهي سورة البقرة: فكل تجلّ من تجلياته المائة وتسعة يرجع إلى آية أو آيات من هذه السورة. وقد طبع في دار عالم الكتب الحديث بالأردن سنة 2017. ومن الكتب المشابهة لهذا الكتاب كتاب للشيخ الكبير عبد الكبير الجيلي(ت:826هـ) عنوانه “المناظر الإلهية” ذكر فيه مائة منظر إلهيّ وآفة النفس في كلّ منظر.
ومن مراجع الأخرى في هذا الموضوع: كتابه “فصوص الحكم” الذي تكرّرتْ فيه كلمة “التجلي”، مثلا :”التجلي الصوري” في فص إسحاق السادس، و”التجلي في الأحدية” في فص إسماعيل السابع، و”التجلي في الصور” في فص شعيب الثاني عشر، و”التجلي في الرؤيا” في فص إلياس الثاني والعشرين، و”التجلي على قدر الاستعداد”، و”التجلي الذاتي”، و”تجلي غيب وتجلي شهادة”، و”التجلي الشهودي”،: و”التجلي يوم القيامة”. ولهذا فإنّ معنى “ التجلي “ في عرفان الشيخ الأكبر يتغلغل في كلّ مجالاته ويفسّرها، كالمسائل المتعلقة بالوحدة الوجودية المقترنة بالكثرة الثبوتية، وبعملية الإبداع الإلهي والخلق المتجدّد، وبالتكليف الوجودي العام والتكليف الشرعي الخاص، وبمظاهر الجلال والجمال والكمال السارية في كلّ شيء، وبالمآلات النهائية في منازل الخلود. وعموما تصنّف التجليات إلى نمطين: التجليات الوجودية، والتجليات الشهودية التي تُـنعت أيضا بالعلمية أو العرفانية.ففي “التجلي الوجودي” يظهر العالم بأسره كصور للتجلي الإلهي من حيث الاسم “الظاهر”. و”تجلي الحق في الأشياء” عبارة عن ظهوره فيها فيمنحها بهذا التجلي: الوجود. وهذا التجلي: دائم مع الأنفاس في العالم، ومع أنه واحد في إجماله هو يتكثر في مظاهره لاختلاف استعداداتها. فليس العالم إلا تجليه في صور الأعيان الثابتة في علم الله الأزلي، ويتصوّر بحسب حقائقها وأحوالها. فهو الذي يُكسب الممكنات الوجود. وأمّا الاسم “الباطن” فمن حقيقة هذه النسبة أنه لا يقع فيها تجل أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة.أمّا “التجليات الشهودية أو العلمية العرفانية” فلا يصح العلم الكامل باللّه الا عن طريقها، وتتنوّع بتنوّع الحضرات الاسمائية. وأعلاها “التجلي الإلهي الجمعي الاحدي” الذي يعطي المكاشفات الكلية، وفوقه “التجلي الذاتي”. والتجلي لا يكون الا بما عليه المخلوق من الاستعداد الذي به يقع الادراك الذوقي. والتجلي العلمي يُفني المتجلَّى له، بخلاف التجلي الوجودي الذي يُبقي. و”التجلي الدائم”: هو تجلي وجودي من ناحية، وشهودي من ناحية أخرى. فهو تجلي وجودي من حيث أنّ الحق هو دائم التجلي في صور الموجودات. وهو تجلي شهودي من حيث أنّ العلماء الذين علموا أنّ الحق عين كل صورة لا يزالون في تجلّ دائم. ومعنى”عين كلّ صورة” هو أنّ ما من صورة إلا ولا قيام لها إلا بالله تعالى جملة وتفصيلا.ومن بين التجليات العامّة: “التجليّ العامّ للكثرة”: وهو التجلي الإلهي للجميع الذي يُنتج علما واحدا. وهو تجلي الحق عند أخذه الميثاق من الخلق في عالم الذرّ . وهو تجلّ علميّ أنتج لهم شهود الربوبيّة، وبالتالي الاقرار بها لسؤاله تعالى : الست بربكم ! قالوا: بلى. ولهذا وقع الإنكار من أهل الموقف يوم القيامة عند ظهوره وقوله: أنا ربّكم، فلو تجلى لهم في الصورة التي اخذ عليهم الميثاق فيها ما أنكره أحد، فبعد وقوع الإنكار تحوّل لهم في الصور التي أخذ عليهم فيها الميثاق، وفي صور اعتقاداتهم، فيقرّون به. فذلك هو التجلي العام للكثرة.و”التجلّي الخاصّ الواحد للواحد”: هو تجلي الحق للعبد بعد دخوله الجنة في مُلكه فيها.وينادي الحق أهل الجنان جميعا إلى الكثيب ليتجلى لهم. فالتجلي واحد ولكن مراتب المتجلي لهم متفاوتة. فيتفاوت علمهم الناتج عن رؤيتهم للحق.و”التجلي العامّ في الكثرة”: هو تجلي الحق سبحانه في الدار الآخرة، في الكثيب على أهل الجنة عامة. فهو التجلي الواحد الذي يكون للجميع في آن واحد دون أن ينكره أحد، ويُنتج علوما تتكثر باستعدادات المحلّ. والعلماء باللّه لهم التجلي العام في هذا الكثيب.
وفي العديد من نصوصه في الفتوحات والفصوص وغيرهما يتكلم الشيخ عن التجلي الذاتي، فيقول عنه إنه ممنوع في غير مظهر، وهو بتجليه في المظاهر يسمى ذاتيّا إذا أعطى الكشف بحقيقة الحقائق، ولا يكون أبدا إلا بصورة استعداد المتجلَّى له. فالمُشاهِد المكمَّل يشهد التجلي الذاتي في قلبه، ويقول عنه في كتاب “المسائل”: (والتجلي الذاتي لا ينقال، لكن يُشهد، وإذا شوهد لا ينضبط، ولا يشهده إلا الخاصة، وليس في الكون طريق إليه يُنال به، فهو اختصاص مجرّد وليس جزاء). ومن هذه اللمحات يتبيّن وسع هذا الموضوع إذ هو مستوعب لكلّ الحقائق الوجودية والمعرفية. وقد نبّه الشيخ الأكبر على هذا المعنى حيث في الباب 177 من الفتوحات، وهو في معرفة مقام المعرفة، ما خلاصته:إنّ المعرفة في طريقنا منحصرة في العلم بسبعة أشياء، وهو الطريق التي سلكت عليه الخاصة من عباد الله. الواحد: علم الحقائق وهو العلم بالأسماء الإلهية. الثاني: العلم بتجلي الحق في الأشياء. الثالث: العلم بخطاب الحق عباده المكلفين بألسنة الشرائع. الرابع: علم الكمال والنقص في الوجود. الخامس: علم الإنسان نفسه من جهة حقائقه. السادس: علم الخيال وعالمه المتصل والمنفصل. السابع: علم الأدوية والعلل.فالنوع الثاني من علوم المعرفة وهو علم التجلي، إنْ لم يحصل للإنسان مع بقيّة إخوانه فليس بعارف ولا حصل له مقام المعرفة.فاعلمْ أنّ التجلي الإلهي دائم لا حجاب عليه، ولكن لا يُعرف أنه هو. وذلك أنّ الله لمّا خلق العالم أسمعه كلامه في حال عدمه، وهو قوله: “كن”، وكان مشهودا له سبحانه، ولم يكن الحق مشهودا للعالم، وكان على أعين الممكنات حجاب العدم. فلمّا أمرها بالتكوين لإمكانها واستعداد قبولها سارَعت لترى ما ثمّ، لأنّ في قوّتها الرّؤية كما في قوّتها السمع من حيث الثبوت لا من حيث الوجود. فعندما وُجد الممكن انصبغ بالنور فزال العدم، و فتح عينيه فرأى الوجود الخير المحض، فلم يعلم ما هو ولا علم أنه الذي أمره بالتكوين. فأفاده التجلي علما بما رآه لا علما بأنه هو الذي أعطاه الوجود. فلمّا انصبغ بالنور التفت على اليسار فرأى العدم فتحققه فإذا هو ينبعث منه كالظل المنبعث من الشخص إذا قابلة النور. فقال: ما هذا؟ فقال له النور من الجانب الأيمن: هذا هو أنت، فلو كنت أنت النور لما ظهر للظل عين. فأنا النور، وأنا مُذهبه. ونورك الذي أنت عليه إنما هو من حيث ما يواجهني من ذاتك، ذلك لتعلم أنك لست أنا، فأنا النور بلا ظل، وأنت النور الممتزج لإمكانك. فأنت بين الوجود والعدم، وأنت بين الخير والشر. فإنْ أعرضت عن ظلك فقد أعرضت عن إمكانك، وإذا أعرضت عن إمكانك جهلتني ولم تعرفني، فإنه لا دليل لك على أني إلهك وربّك وموجدك إلا إمكانك. فلا تنظر إليّ نظرا يفنيك عن ظلك فتدّعى أنك أنا فتقع في الجهل. ولا تنظر إلى ظلك نظرا يفنيك عني فإنه يورثك الصمم فتجهل ما خلقتك له، فكن تارة وتارة. واعلمْ أنّ التجلي الأوّل الذي حصل للممكن عندما اتصف بالوجود وانصبغ بالنور هو التجلي للأرواح النورية التي ليست لها هذه الهياكل المظلمة، ولكن لها ظل إمكانها الذي لا يبرح فيها. ثم بعد هذا التجلي الإبداعي الذي هـيّم بعض الأرواح النورية، تجلى تجليا لروح من هذه الأرواح المبدعة وهو العقل الأوّل، فعلم منه في هذا التجلي جميع المراتب التي تظهر عنه في عالم الكون إلى يوم القيامة. فلمّا علم العقل من هذا التجلي هذه المراتب، كان من جملة ذلك انبعاث النفس الكلية عنه، وهي أوّل مفعول انبعاثي، وهي ممتزجة بين ظلمة ما انفعل عنها وهي الطبيعة، وبين نور ما انفعلت عنه أي العقل. وانتقش فيها جميع ما للعقل من العلوم التي ذكرناها. ولها وجه خاص إلى الله لا علم للعقل به، فإنه سرّ الله الذي بينه وبين كل مخلوق لا تــُعرف نسبته ولا يدخل تحت عبارة، ولا يقدر مخلوق على إنكار وجوده، فهو المعلوم المجهول. وهذا هو التجلي في الأشياء المبقي أعيانها. وأمّا التجلي للأشياء فهو تجلى يُفني أحوالا ويعطي أحوالا في المتجلَّي له. ومن هذا التجلي توجد الأعراض والأحوال في كلّ ما سوى الله.ثم له تجلّ في مجموع الأسماء. فيعطي في هذا التجلي في العالم المقادير والأوزان والأمكنة والأزمان والشرائع وما يليق بعالم الأجسام وعالم الأرواح والحروف اللفظية والرقمية وعالم الخيال. ثم له تجلّ آخر في أسماء الإضافة خاصة: كالخالق وما أشبهه من الأسماء، فيظهر في العالم التوالد والتناسل والانفعالات والاستحالات والأنساب. وهذه كلها حُجب على أعيان الذوات الحاملات لهذه الحجب عن إدراك ذلك التجلي الذي لهذه الحجب، الموجد أعيانها في أعيان الذوات. وبهذا القدر تنسب الأفعال للأسباب، ولولاها لكان الكشف فلا يُجهل. فبالتجلي تغــيّر الحال على الأعيان الثابتة من الثبوت إلى الوجود، وبه ظهر الانتقال من حال إلى حال في الموجودات، وهو خشوع تحت سلطان التجلي، فله النقيضان: يمحو ويُثبت، ويوجد ويُعدم. قال – صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي صحّحه الكشف: “إنّ الله إذا تجلى لشيء خشع له”. فالله متجلّ على الدوام، لأنّ التغيّرات مشهودة على الدوام في الظواهر والبواطن. فشأن التجلي وشأن الموجودات التغيير بالانتقال من حال إلى حال. فمنا من يعرفه، ومنا من لا يعرفه، فمن عرفه عبده في كل حال، ثبت في الصحيح أنّ النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: “الحمد لله على كل حال”، فأثنى عليه على كلّ حال لأنه المعطي بتجليه كل حال. وأوضح من هذا في التبليغ ما يكون، مع إقامة الحدود وإنكار ما ينبغي أنْ يُنكر: “يَسْألُهُ من في السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأْنٍ”: أحوال إلهيّة في أعيان كيانيّة بأسماء نسبيّة عيّنتها تغييرات كونيّة. فتجلَّى أحديُّ العين في أعيان مختلفة الكون، فرأت صورها فيه، فشهد العالم بعضه بعضا في تلك العين، فمنه المناسب وهو الموافق، ومنه غير المناسب وهو المخالف. فظهرت الموافقة والخلاف في أعيان العالم دنيا وآخرة، لأنه لا تزال أعيان العالم تبصر بعضها بعضا في تلك العين المنجلية، فتنعكس أنوارها عليها بما تكتسبه من تلك العين، فيحدث في العالم ما يحدث دنيا وآخرة عن أثر حقيقة تلك العين لمّا تعلقت بها أبصار العالم. فالمؤثر روحاني، والذي تأثر طبيعي. وما من شيء تكون له صورة طبيعية في العالم إلا ولها روح قدسي، وتلك العين لا تنحجب أبدا. فالعالم في حال شهود أبدا، والتغيير كائن أبدا، لكن الملائم وغير الملائم وهو المعبّر عنه بالنفع والضرر] انتهى باختصار. بعد هذه المبادئ الكليّة حول التجليات الإلهية الدائمة المتواصلة إلى الأبد، ومنها تنشأ كلّ الموجودات وأحوالها وتغيّراتها، أعطى الشيخ تفصيلا لها في المظاهر الكونية والإنسانية، وذلك في الباب 206 من الفتوحات وهو في معرفة التجلي، وفيه يقول ما خلاصته: اعلمْ أنّ التجلي عند القوم ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب؛ وهو على مقامات مختلفة. فكل نور من هذه الأنوار إذا طلع من أفق، ووافق عينَ البصيرة سالماً من العمى والعشى والصدع والرّمد وآفات الأعين، كشف بكل نور ما انبسط عليه، فعاين ذوات المعاني على ما هي عليه في أنفسها، وعاين ارتباطها بصورة الألفاظ والكلمات الدالة عليها، وأعطته بمشاهدته إيّاها ما هي عليه من الحقائق في نفس الأمر، من غير تخيّل ولا تلبيس).
ثمّ فصّل الشيخ بإسهاب طويل أصناف هذه الأنوار الغيبية، وممّا جاء فيها قوله:[فلا يكن – يا أخي- دعاؤك أبداً إلا أنْ يجعلك الله نوراً. وهنا سر عجيب أنبهك عليه من غير شرح، لأنه لا يحتمل الشرح: وهو أن الله يضرب الأمثال لنفسه، ولا تضرب له الأمثال. فيشبه الأشياء، ولا تشبهه الأشياء. فيقال: مِثل الله في خلقه مِثل المَلك في مُلكه؛ ولا يقال: مِثل الملك في مُلكه مِثل الله في خلقه. فإنه عين ما ظهر، وليس ما ظهر عينه. فإنه الباطن، كما هو الظاهر في حال ظهوره. فلهذا قلنا: هو مثل الأشياء، وليست الأشياء مثله، إذ كان عينها وليست عينه. وهذا من العلم الغريب الذي تغرّب عن وطنه، وحيل بينه وبين سكنه، فأنكرته العقول، لأنها معقولة غير مسرّحة. وهذا نموذج من تجلي أنوار الأنوار].ومن هذه اللمحات حول التجليات يمكن أن نلحظ دورها الرئيسي عند الشيخ الأكبر والأمير عبد القادر، في ميادين ثلاثة متداخلة: في ميدان الوجود، وفي ميدان المعرفة، وفي ميدان السلوك.
التجليات الوجودية:فالتجليات، في دائرة الوجود، هي مظاهر لكل ما عليه “الحق تعالى” من جلال وجمال وكمالات لا نهاية لها. ولها ثلاث حضرات: في حضرة الذات، وفي حضرة الصفات، وفي حضرة الأفعال. فالتجليات الوجودية الذاتية هي تعيّنات للحق بنفسه لنفسه من نفسه، مجرّدة مطلقة عن كل مظهر أو صورة أو نعت. إنها “حضرة الأحدية” المنزّهة عن كل تقييد وتعيّن. والتجليات الوجودية الصفاتية هي تعيّنات الحق بنفسه لنفسه في مظاهر كمالاته “الأسمائية” ومجالي نعوته الأزلية. وحضرة هذه التجليات، هي “حضرة الوحدة”. وفيه تظهر الحقيقة الوجودية المطلقة في مظاهر كمالاتها، بعد كمونها في باطن”الغيب المطلق”، عن طريق “الفيض الأقدس”. وفي حضرة هذه التجليات توجد صور “الأعيان الثابتة”، وهي معلومات علم الله الأزلي، المعدومة بالنسبة إلى أنفسها الموجودة عند عالمها الحق تعالى.والتجليات الوجودية في حضرات الأفعال هي تعيّنات الحق بنفسه لنفسه في مظاهر الأعيان الخارجيّة والحقائق الموضوعيّة.وحضرة هذه التجليات هي “حضرة الوحدانية”. وفيها تظهر الحقيقة الوجودية المطلقة بذاتها وصفاتها وأفعالها عن طريق “الفيض المقدّس”. أي أنه في هذه الحضرة يتجلى “الحق” في صور الأعيان الخارجية، نوعيّة كانت أو شخصيّة، حسية أو معنوية، ولمّا كان الحق هو مبدأ للتجليات الوجودية ومُظهرها، فهي إذن “فعل مطلق” لا تكون في غير “دائرة المطلق”: فهي من الحق وبه وإليه، سواء في مستوى الذات أو الصفات أو الأفعال. ومهما تعددت مظاهرها الخارجية أو تنوعت آثارها الوجودية: فإنها عن الوحدانية صدرت، وبها ظهرت، وإليها تعود.
تلك هي بإجمال الخطوط الكبرى للتجليات الوجودية عند الشيخ الأكبر. وهي تختلف عن نظرية “الفيوضات” الفلسفية، وعن نظرية “الخلق” عند المتكلمين، وإنْ كانت تلتقي معهما في بعض الجوانب.فالفارق الأساسي بين فكرة “التجليات الأكبرية” وفكرة “الفيوضات” الفلسفية، هو كون الأولى واحدية في اعتبارها للوجود ، في حين أنّ الثانية تقول بتعدد الوجود وكثرته.
فالشيخ يعتبر الوجود من “مقولة المطلق لا بشرط”. وبالتالي لا يمكن أن تكون ثنائية أو كثرة وجودية البتة، فالتجليات الوجودية هي تعيّنات للحق المطلق، الذي هو واحد في “وجوده”، كثير في “ثبوته”، أي في مظاهره وتعيّناته ومراتبه. أمّا نظرية “الفيوضات الفلسفية” فهي تعتبر الوجود من مقولة “المطلق بشرط”. وبالتالي ترى إمكان كثرته عبر الوجودات، ذهنية كانت أو حسية، نوعية أو شخصية.والخلاف الجوهري بين موقفي الشيخ والمتكلمين في عملية الخلق أو الإبداع الإلهي هو أنّ علماء الكلام يرون عملية الخلق من عدم كأنها خارجة عن محيط الألوهية ذاتها، بدون أن يميّزوا ـ في دائرة الألوهيةـ بين ما هو مرتبة الذات أو الصفات أو الأفعال. بينما يقرر الشيخ الأكبر أن الظواهر الخلقية كلها هي من آثار “التجليات الوجودية الفعلية” التي هي نفسها مجلى “التجليات الصفاتية” التي هي مجلى “التجليات الذاتية”. وكلّ هذه التجليات تدور في دوائر كمالات الألوهية المطلقة، إذ لا شيء خارج عن دائرة المطلق.
التجليات العرفانية النورانية:أمّا بالنسبة للتجليات العرفانية أو النورانية، فهي التي تنجلي على مرآة القلب والعقل فتـُنتج فيهما المعرفة اليقينية الذوقية. وفيها تستحيل طبيعة المعرفة في قلب العارف إلى وجود، وطبيعة الوجود إلى معرفة، فتبدو حقائق الأشياء أمام العارف في صورها الخالدة.يتوزّع النور، لدى إشرافه على مرآة القلب، إلى مراتب متميّزة. فما يسميه الشيخ بـ”بنور الأنوار” صادر عن التجليات الذاتية للحقيقة المطلقة. ويطلق أيضا على هذا النمط من التجليات اسم “السبحات المحرقة” التي يصعق عند تجليها كل كون حادث… وهي التي تولّد في “السرّ” المعرفة اليقينية في أرفع درجاتها المسماة: “حق اليقين”.أمّا التجليات الوجودية الصفاتية فتصدر عنها: “أنوار المعاني” أو “أنوار الغيوب”عند تساقط أشعتها على صفحات القلوب. وبفضلها تنكشف للقلب حقيقة الوجود في”حضرة الوحدة”، ويرى صلة كل شيء بربه، وعنها تنشأ المعرفة اليقينية المسماة بـ “عين اليقين”: أي اليقين المتولد عن المشاهدة والعيان. وفي هذا المقام يلتقي العارف والحكيم في اكتساب المعارف، فيشتركان معا بكشف الظواهر الوجودية في نشؤها وتطوّرها. غير أنّ العارف المحقق يتلقّى هذه المعارف كأنوار سماوية، لا كظواهر طبيعية، أي أنه يستعرض على مسرح الوجود الخارجي ظلال الوجود العلوي، ويتأمّل في صفحات عالم الكثرة “الحروف العاليات” في “حضرة الوحدانية”. وبتجليات أنوار الطبيعة، تحدث المعرفة اليقينية المسماة بـ”علم اليقين”.
التجليات عبر معارج السلوك:والترقي في مقامات اليقين، من علم إلى عين إلى حق إلى حقيقة، هو التحقق بالسلوك الذوقي العرفاني. وخلاله يتحقق السالك بتجليات “الفناء” الذي هو رأس “الأحوال”، وبتجليات “البقاء” الذي هو رأس “المنازل”. فالفناء موت معنوي، إلا أنه حقيقي يتذوّقه السالك بمحض إرادته. به يتجرّد عن كلّ شيء، سوى مطلوبه الحق، ويظهر في ثلاث مراتب: فناء في الأفعال، وفناء في الصفات، وأخيرا فناء في الذات. إنه فناء عن كل ما هو فان، فعلا كان أو صفة أو ذاتا. وبتعبير أوضح: إنه فناء عمّا سوى الله ـ تعالى-! سواء في أفعاله أو صفاته أو ذاته. إنه يقتضي رقابة تامّة لكلّ ما يصدر عنه من قول أو فعل أو صفة وبذلك يغدو المرء بفضل هذه الحالة المعنوية الخاصة، مرآة صافية تشع عليها أنوار الحق بكامل لألائها وبهائها.أمّا “البقاء” فهو حياة مع الله وبالله وفي الله ولله. إنه “رأس المنازل” في ديار الحبيب. وهو ذو مظاهر ثلاثة، يتصل كل مظهر منها بتجلّ من التجليات الإلهية، في مرتبتها الوجودية أو العرفانية.فالمظهر الأول للبقاء الصوفي هو منزل البقاء في الأفعال. وفي هذا الموطن يتحد فعل العبد، بل يتسامى إلى أفق الفعل الإلهي في نظامه واطراده ودوامه. وهذه الصورة المعيّنة من “البقاء الصوفي” منبعثة عن آثار التجليات الالهية الفعلية (في مستواها الوجودي)، وعن أنوار الطبيعة (في مستوى التجليات العرفانية).والمظهر الثاني للبقاء، هو منزل البقاء في الصفات. وهذا يعني اتحاد صفات العبد، بل تساميها إلى ذروة الصفات الإلهية، في كمالها وأحقيتها وأبديتها. فيصبح قلب الإنسان، في هذا المنزل المعنوي، مرآة صافية نقيّة تنتقش عليها نعوت الخالق- جلّ جلاله-، كما أصبحت من قبل قواه الإرادية في منزل البقاء في الأفعال، أداة طيّعة صالحة تتحقق بها مقاصد الله في الكون وشؤونه الحكيمة في الحياة ـ وهذه الصورة من “البقاء الصوفي”، منبثقة عن آثار التجليات الإلهية الصفاتية (في مستواها الوجودي)، وعن تجليات أنوار المعاني (في مستوى التجليات العرفاني).والمظهر الثالث والأخير للبقاء، هو منزل البقاء في الذات. أو البقاء الذاتي. وفي هذا الموطن تتسامى ذات العبد إلى أفق الذات العليّة في وحدانيتها ورفعتها وإحاطتها. فيكون وجود السالك الروحي مستغرقا في وجود الحق ـ تعالى! ـ. فهو لا يبصر ولا يسمع ولا يريد ولا بتأمّل إلا بالحق، وهذا ما يسمّى بقرب النوافل، وفوقه قرب الفرائض الذي يتجلى فيه الحق بعبده كقوله في الآية10 سورة الفتح: “إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم”. وهذه هي الصورة التامة للبقاء الصوفي، والمرحلة النهائية للسير في “منازل الأبدال الأبطال”. ومنزل البقاء في الذات يتحقق بفضل التجليات الإلهية الذاتية (في مستواها الوجودي)، وبفضل تجليات نور الأنوار (في مستواها العرفاني).ولكن، ما هي وسيلة الصوفي للتحقق بحال الفناء؟ ما هي مطيته للوصول إلى منزل البقاء؟ يجيبنا الشيخ بأنه الحب الإلهي ولزوم العبودية الشرعية على منهاج كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم ـ، والتوفيق الرباني وحده هو الكفيل بجميع ذلك.
يقال بحق إنّ مشرب الشيخ الأكبر والأمير عبد القادر من تجليات الأسماء الحسنى هو: مشرب (الله الواسع العليم الرحمن الرحيم)، المستوعب لكل ما سبق ذكره في هذه السطور، وأزيد منه بكثير. وبالفعل لا نجد في التراث الإسلامي، بل العالمي، مَن أفصح بجلاء وتفصيل عن تجليات هذه الأسماء في جميع المراتب الوجودية مثل الشيخ الأكبر وورثة عرفانه المحمدي، وفي مقدّمتهم في القرن الثالث عشر الهجري: الأمير عبد القادر. وقد انساب وابل هذا المشرب الأصفى في روح وقلم صاحب هذه الأطروحة الممتازة: الأستاذ حمو فرعون. وهذا ما نستجليه فيها بوضوح ممتع، وموضوعية نافـــذة، ومقارنات واسعة شاملة، وتحليل عميق. ستساهم هذه المفاهيم بجدارة في فتح أبواب العرفان العالي التي طالما بقيت موصودة ومجهولة في الدراسات الجامعية خلال عقود كثيرة.
لقد بذل الأستاذ حمو جهدًا معرفيًّا كبيرًا في إخراج هذا العمل المبارك، وأسأل الله – تعالى- أن يجعل جهده هذا في ميزان حسناته، وأن يوفقه إلى مزيد من هذه البحوث في صميم العلم النافع السابر لأعماق معرفة: (من عرف نفسه فقد عرف ربّه) والمفجّر لشراب المقرّبين بعين الكافور: (عينا يشرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيرا).
_______________________________
*نقلاً عن موقع ” Alpha Doc”.





