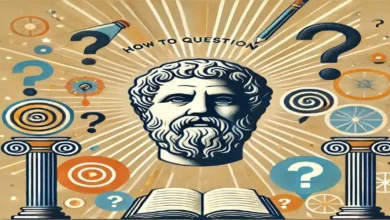السفر الصوفي وبناء الإنسان
خالد التوزاني
مفهوم السفر:
إن المتصفح لمادة “سفر” في معاجم اللغة العربية[1] يدرك بعض أسرار تعلق التصوف بالسفر، ومن تلك المعاني ندرك أنه ما ذكر معنى السفر على أنه قطع المسافة إلا بعد أن بين أصحاب المعاجم أن السَفْر يعني كشف الغطاء عن الرأس أو الخمار عن الوجه أو التراب عن الأرض أو الغيوم عن السماء، ومنه اشتقت كلمة المسافر بمعنى المغادر للمكان الذي كان فيه، وقيل سمي المسافر مسافرًا، لأنه يسفر عن وجهه وأخلاقه فيظهر ما كان خافيًا، أو يظهر على حقيقته وبجوهره، كما اشتقت كلمة سِفر؛ أي الكتاب وكلمة السُفرة لطعام السفر، ومن الاشتقاقات العديدة كذلك: الإضاءة والإنارة والإشراق وكلها معاني ينشدها الصوفي المسافر المتحرك بهمته إلى الله.
يشكل السفر حقيقة كل الأشياء، ومن الأسفار التي أحدثها الحق جل في علاه أنه أنزل القرآن الكريم، وخصّ رسله وأنبياءه كُلاًّ بسفر أو أسفار تتلاءم وطبيعة البعثة والنبوة، إذ أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأهبط آدم إلى الأرض، ورفع إدريس عليه السلام، وحمل نوحًا في البحر، وذهب بإبراهيم الخليل ليمنحه كراماته، وأخرج يوسف من الجب، وأسرى بلوط، وأمر موسى بالهجرة فرارًا من قومه، ورفع عيسى إليه، وذهب بيونس إلى بطن الحوت وأنزل الروح الأمين على قلوب أنبيائه، وأصعد الكلم الطيب إليه،[2] فكل هذه نماذج من الأسفار التي تطال أو يطولها الكل.
كما أن الإنسان يجسد في مساره كل أنواع السفر؛ فخروجه إلى الوجود سفر، ونموه الجسدي سفر، وجريان دمه في العروق سفر، وكلامه دائم السفر، وحروف كلامه مسافرة عند خروجها من أعماق النفس، وأفكاره دائمة السفر بين المحمود والمذموم، وفي المتنفس سفر للأنفاس، وفي الرؤية كما في الرؤيا سفر للأبصار في المبصرات، وفي تعبير الرؤيا سفر وعبور من عالم إلى عالم، وأما عوالم الخيال فكلها أسفار في أسفار. ثم إن موت الإنسان سفر أيضًا من العالم المحدود إلى العالم المطلق. فالإنسان إذن في سفر دائم قبل أن يخلق، وحياته عبارة عن سفر من الميلاد إلى القبر، ومنه إلى البرزخ، وفي البرزخ يسافر إلى الحشر، فإلى الصراط ثم إمّا إلى جنة أو إلى نار، وفي الجنة سفر دائم كما في النار سفر دائم، ولذلك قيل:
فاقـضوا مـآربكم عجـالاً إنما
أعماركم سفر مـن الأسفار[3]
وفي ظل كل هذه الأسفار تختزل الأسفار المشروعة للإنسان في ثلاثة أسفار، ضمن ثلاثة أنواع من السفر: سفر من عند الله وسفر إليه وسفر فيه، أهمها التي فيها السفر رباني، أو يكون فيها المرء مسافرًا به، كما هو حال الأنبياء والأولياء المصطفين، الذين عن الخوف والحزن فرُّوا.[4]
ويميز أبو حامد الغزّالي بين سفرين اثنين: “سفر بظاهر البدن عن المستقر والوطن، إلى الصحاري والفلوات. وسفر يسير القلب عن أسفل السافلين، إلى ملكوت السماوات. وأشرف السفرين السفر الباطن”[5]، فهو أحسن السفر كما قال أبو سالم العياشي:
مَا أحسَـن الضَّحك الجَارِي بِغير فَــــم
ورُؤْيَةٍ غابَ عَنْهَا هَيكـل البَصَر
كُنْ قَاطِنـًا ظاهرًا؟ والسِّر مُرْتَـحِــــــلٌ
فَالسَّيْرُ مِنْ دُونِ رِجْلٍ أحسن السَّفَر[6]
إنه سفر وجداني إلى مدارج الحقيقة الروحية، يُسْفِرُ عن معدن الإنسان، ويسير به نحو نوع من الترقي في عالم الحقائق، يقول عبد الكريم الجيلي: “فهذا سفر أسفر عن محياه، وأظهر ما منحه مولاه، فإذا تحقق الإنسان بهذه الحقائق، واستحضر هذه الطرائق، سافر من معدنه إلى نباته، إلى حيوانيته، إلى إنسانيته، إلى نفسه، إلى عقله، إلى روحه، إلى سرّه، إلى حقيقة حقيقته وكليته المطلقة”[7]، حيث يشير إلى مراحل بناء الإنسان الكامل المنسجم مع غاية وجوده، حيث لا حدود لفوائد هذا النوع من الأسفار الذي تكون النفس مسالكه وممالكه، ويكون القلب مسافرًا فيها، فالسفر عند الصوفية نوع من “الانتقال عن المقامات، والإنزال في أخرى، كالانتقال من مقام الإسلام إلى الإيمان، ثم من مقام الإيمان إلى الإحسان”[8]، ويقتضي ذلك قطع كل العلائق، والخروج عن الشهوات والعوائد، حيث “لا يتحقق السفر ويظهر السير إلا بمحاربة النفوس، ومخالفتها في عوائدها، وقبيح مألوفاتها وشهواتها”[9]، وحسب همة السالك يكون نوع السفر الذي يطيقه قلبه، وقد لَخَّصَ ابن عجيبة أنواع سفر القلوب إلى حضرة علام الغيوب في الانتقال من أربعة مواطن إلى أربعة أخرى، إذ يسافر أولاً: من موطن الذنوب والغفلة، إلى موطن التوبة واليقظة، ويسافر ثانيًا: من موطن الحرص على الدنيا والانكباب عليها إلى موطن الزهد فيها والغيبة عنها. ويسافر ثالثًا: من موطن مساوئ النفوس وعيوب القلوب، إلى موطن التخلية منها والتحلية بأضدادها. ويسافر رابعًا: من عالم الملك إلى شهود عالم الملكوت، ثم إلى شهود الجبروت، أو من عالم الحس إلى عالم المعنى، أو من عالم الأشباح إلى شهود عالم الأرواح، أو من شهود الكون إلى شهود المكوّن.[10]
هكذا، ندرك قيمة السفر الصوفي في بناء الإنسان بناءً سليمًا يحقق الكمال المنشود الذي ينشر السلام في الأرض ويدرأ عن الإنسان تهمة الإفساد والإخلال بنظام الكون، إذ يستمر المتصوف بالانتقال من صفة لأخرى أفضل منها حتى “يصير سفره وحضره على السوية”[11]؛ أي متوازنًا مكتمل البناء متحققًا بوصف “كان خلقه القرآن”. ومعلوم أن من كان خُلُقُه القرآن فقد بلغ أرقى ما يمكن أن يبلغه إنسان من الكمال، إذ لم يتحقق هذا المقام إلا لسيد الخلق محمد، صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة أن يطمح الصوفي في سفره لبلوغ هذا المقام، كما يقول ابن عجيبة: “لا مسافة بينك وبينه، حتى تطويها رحلتك، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك”[12]، وهو ما يبين بجلاء أهمية السفر الصوفي في صناعة إنسان متوازن؛ فالصوفية “لا ينقلون أقدامهم إلا حيث يرجون رضى الله (…) ولا يسافرون بقلوبهم إلا إلى حضرة القريب المجيب، بخلاف العامة: أنفسهم غالبة عليهم، وشهواتهم حاكمة عليهم، إن تحركوا للطاعة خوضتها عليهم، فأفسدت عليهم نياتهم، وأزعجتهم في هوى أنفسهم، تُظهر لهم الطاعة وتُخفي لهم الخديعة”[13]، وذلك لأن مدار السفر على “مجاهدة النفوس ومحاربتها في ردها عن عوائدها ومألوفاتها”[14] ومن عجز عن ذلك، لم يكن مسافرًا بالقلب وإن انتقل بالبدن.
لقد تنبَّه الصوفية للمعاني الخفية في الأسفار، فعملوا على تسخيرها في بناء الإنسان وتقويم سلوكه، وذلك لأن تجربة السفر الصوفي تعد سفرًا من أجل التكمل والتجمل وإعادة التوازن لما اختل من السلوك أو الفكر أو الخواطر.
إن المرء، وهو يقرأ كتابات القوم في مختلف أجناسها وأنواعها، “لا يفارقه الشعور بأن لدى الصوفية رغبة دفينة، رغبة محبطة أو مكبوتة أو ممنوعة، في بناء كون فاضل آهل بسكان فضلاء ينعمون بالقوة والأمن والحرية والمساواة والسعادة المادية والروحية”[15]، “وليس هذا مفهوم “السوبرمان” الذي حلم به “نيتشه”، لكنه مفهوم الإنسان الكامل والمتوازن في أقصى درجاته، الذي بناه الصوفية في كل زمان ومكان”[16]، إذ سعى الصوفية إلى السمو بالإنسان “من وضعه الطبيعي والإنساني إلى مرتبة الولاية؛ أي من تحديده الدنيوي؛ أي خضوعه لضرورات المكان والزمان والجسد، إلى مرتبة القدسية؛ أي التعالي عن تلك الضرورات إلى حدود الخرق والانتهاك.”[17] وهنا تكمن قيمة المشروع الصوفي في تعديل السلوك الإنساني من خلال سفر القلوب وترحالها من مألوف الأخلاق إلى محاسنها، ومن غفلة القلب إلى يقظته، ومن القلق والتوتر إلى الاطمئنان والثبات، إذ يترقى الوجدان وتنتعش الروح في مدارج التكمل والتجمّل، ليصبح المرء أكثر قربًا من خالقه، ومن ثم أكثر فائدة تعمير في الأرض.
________________________________________
[1] ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ت711هـ): لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، القاهرة، دار المعارف،، 1981، ج4، ص 368، وكذلك: الرازي (محمد بن أبي بكر): مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1415، 1995، ص 126. ومحمد عبد الرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، بيروت، دار الفكر، ط1، 1410هـ، ص 406
[2] ابن عربي، كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار، حيدر آباد الدكن، جمعية دائرة المعارف العثمانية، 1367/1948، ص ص 1- 2
[3] ماء الموائد، لأبي سالم عبد الله العياشي (ت 1090هـ)، تقديم وتحقيق: الدكتور خالد سقاط، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الأدب العربي تخصص: أدب مغربي- أندلسي، تحت إشراف عبد السلام الهراس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية- ظهر المهراز- فاس، السنة الجامعية 1998-1999، ج3، ص772
[4] ابن عربي، الإسفار عن نتائج الأسفار، مصدر سابق، ص ص 4-9
[5] أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت، طبعة دار المعرفة، د.ت، ج2، كتاب آداب السفر، ص 244
[6] ماء الموائد، ج2، ص 323
[7] عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي، الإسفار الغريب نتيجة السفر القريب، تحقيق وتعليق: بدوي طه علام، القاهرة، دار الرسالة للتراث، د.ط، 1982، ص ص 9-10
[8] ابن عجيبة، الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية، تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود، القاهرة، عالم الفكر، د.ط، 1983، ص 85
[9] المصدر نفسه، ص 86
[10] ابن عجيبة، الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية، مصدر سابق، ص 102
[11] ماء الموائد، ج2، ص 323
[12] ابن عجيبة، الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية، مصدر سابق، ص 102
[13] المصدر نفسه، ص214
[14] المصدر نفسه، ص 102
[15] الميلودي شغموم، المتخيل والقدسي في التصوف الإسلامي: الحكاية والبركة، مكناس، منشورات المجلس البلدي بمدينة مكناس، ط1، 1991، ص 258
[16] المرجع والصفحة نفسهما.
[17] عبد الحق منصف، أبعاد التجربة الصوفية: الحب، والإنصات، والحكاية، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، ط1، 2007، ص 270.
_____________________________
*نقلاً عن موقع ” مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث”.