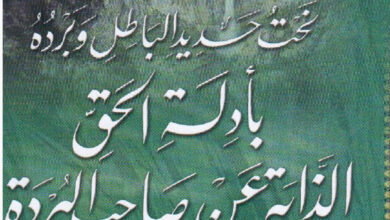التصوُّف في الأدب العربي المعاصر
التصوُّف في الأدب العربي المعاصر
على الرغم من أن ثمَّ حضورًا كثيفًا للأدب الصوفي في الكتابات الإبداعية الحديثة، وذلك عبر التداخل النصي واتخاذ الأقنعة الصوفية وغير ذلك من التوسلات الفنية؛ فإن المتلقي يشعر بوجود هوة فنية ورؤيوية بين النص الصوفي القديم والنص الإبداعي الحديث. ولعل ذلك راجع إلى أن التجربة الصوفية تجربة غنية المبنى عميقة المعنى كثيفة الترميز جريئة الطرح، لا تنتهي عجائبها، ولا تنقضي غرائبها.
علاقة التصوف بالفنون
ولقد كانت العلاقة بين الجمال والتصوف والإبداع والفنون بصفة عامة علاقة أصيلة؛ لأن التصوف يرتبط بأصل الجمال كله وهو الحقُّ مبدع الوجود والموجودات؛ فثمة علاقة وثيقة بين التصوف والإبداع والاتصال بمنابع الجمال والجلال والترقي في المعارج الروحية والجمالية والتخييلية، حيث هذا التجاذب الفني والتداخل الصوفي بين الإبداع ومنبع الجمال وأصل الجلال ومصدر الكمال. ومن ثمَّ كانت التجربة الصوفية رحلة روحية معراجية تغوص في عالم الأحوال عابرة لعالم الأقوال، لا تني ولا تقر باحثة عن الحق والحقيقة.
ولقد قدم لنا الموروث الصوفي العربي نصوصًا ومواقف ورؤى وتصورات تصل إلى الحالة القصوى من الجلال والجمال والإبداع. نرى ذلك في الموروث الصوفي شعرًا ونثرًا: في مخاطبات النفري، وفتوحات ابن عربي، وحكم ابن عطاء الله السكندري، والمنقذ من الضلال للغزالي، وكتابات الحارث المحاسبي، وأبي يزيد البسطامي، والجنيد، والحكيم الترمذي، والشبلي، والسراج الطوسي، وأبي طالب المكي، وشعر ابن الفارض، والحلاج، والسهروردي، وغيرهم كثير ممن يندون عن الحصر، حيث الروح الصوفي إدراك ذوقي أصيل، وكدح على مستوى اللغة للترقي في معارج التخييل والتشكيل إلى ما وراء الحروف والكلمات والدلالات.
تأسيسًا على هذا كله يمكن القول إن النص الصوفي كان نصًا إبداعيًا جسورًا خلاقًا عماده التأويل لا التفسير والتعليل، ظاهره الجمال وباطنه الجلال. إنه نص مشغول بتحطيم التابوهات، ويتميز بالجسارة على الخوض في تأمل المقدسات، والتحرر من القمعيات، والبحث في مسائل الألوهية والكون والوجود والاتحاد والحلول والفيض والعشق والمرأة والخصوبة وترميزات الغزل؛ حيث التنقل الروحي والوجودي من الحسي الدنيوي إلى الرباني الروحي، وما يستتبع ذلك من إبداع النص رموزه الخاصة ومصطلحاته السرية الهائمة في عوالم الظاهر والباطن والأحوال والمقامات والمشاهدات والمكاشفات والشريعة والطريقة والحقيقة والذوق والوجد.
ولعل هذه الجدلية الإنسانية الروحية الربانية في التجربة الصوفية قد حطمت كثيرًا من الحواجز الجمالية والسياسية والاجتماعية في الواقع العربي، سواء في الشعر القديم والمعاصر؛ وذلك على نحو فتح التجربة الإبداعية على أفق السؤال والقلق والاغتراب والمواجهة والثورة والتمرد والخروج. وكل هذه الدلالات التي ابتكرها الروح الصوفي قد أثْرَت الفنون المعاصرة الشعرية والمسرحية والدرامية والتشكيلية على اختلاف مدارسها ومقاصدها.
الروح الصوفي ثروة وثورة
لقد خلق الروح الصوفي ثروة روحية معرفية إنسانية كبرى في الروح العربية والعالمية، ومن هذا المنطلق المعرفي والمنهجي كان الروح الصوفي بحق ثورة روحية سلمية عميقة على كل ألوان السلطة: سلطة اللغة ـــ سلطة التفسير والتحليل والتعليل ـــ سلطة الوعي الديني الشائع ــ وقد استتبع هذه الثورة الروحية الجوانية أن صار الروح الصوفي ملهمًا عظيمًا لكل أشكال الفنون الحديثة؛ وهو مما جعل التجربة الصوفية من أروع ما قدمه الفكر العربي الإسلامي للفكر الإنساني العالمي.
إن بحث الإنسان المعاصر عن وجوده وغايته وجوهر مصيره الإنساني جره إلى التجربة الصوفية جرًا بما تفتحه هذه التجربة من آفاق جمالية ومعرفية ووجودية جديدة وعلى رأسها أفق السؤال عن المصير الإنساني. نجد ذلك واضحًا في جميع الفنون المعاصرة على نحو جعل من التجربة الصوفية ملهمًا عظيمًا لهذه الفنون. فثمة علاقة وثيقة بين هوية الإنسان وهوية الفن وهوية التصوف؛ حيث يجمعها جميعًا روح السؤال الإنساني اللا منتهي، خاصة بعد أن تبذلت الإنسانية المعاصرة في أوحال المادة والاستهلاك والثرثرة والاغتراب والانفصال والحيرة في عوالم الوسائط التكنولوجية التي أحدثت تحولًا هائلًا في الإنسان وجوهره، وفي الواقع والقيم، وفي الوجود وأساسه الأنطولوجي الأصيل.
التصوف والإبداع في الرؤية العربية
ربما دفع هذا التوجه كثيرًا من المفكرين والشعراء العرب إلى الكتابة الحرة العميقة عن العلاقة بين الشعر والإبداع والتصوف؛ ففي أعماق كل إبداع عظيم يكمن تصوف عظيم ينتمي إلى خبرة أصيلة بالسر المطلق الذي ينصرف إلى العمق الدرامي الكامن في الروح الإنساني والمتحول دومًا بين أنساق متعددة من الثنائيات: النسبي والمطلق، السماء والأرض، الروح والمادة، العقل والروح، الدنيوي والأخروي، الإنسان والمجتمع… إلخ.. أضف إلى ذلك أن كلًا من الخبرة الصوفية والخبرة الفنية يتجاوز كل صيغة عقلانية مغلقة محددة، إلى عالم حر طليق خلاق قوامه طلاقات الروح وجسارات التخييل وطفرات الخلق؛ يقول الشاعر عمر ابن الفارض:
إنْ قُلْتُ:عِندي فيكَ كل صَبابة
قالَ: المَلاحةُ لي، وكُلُّ الحُسْنِ في
كَمَلتْ مَحاسِنُهُ، فلو أهدى السّنا
للبدرِ عندَ تمامهِ لمْ يخسفِ
وعلى تَفَنُّنِ واصِفيهِ بِحُسْنِهِ، يَفْنى
الزّمانُ، وفيهِ ما لم يُوصَفِ
ولقدْ صرفتُ لحبِّهِ كلِّي على
يدِ حسنهِ فحمدتُ حسنَ تصرُّفي
فالعينُ تهوى صورةَ الحسنِ الَّتي
روحي بها تصبو إلى معنى خفي
والمتأمل في هذا النص يتحقق من أن النص الصوفي نَصُّ حالة لا نصَّ تشكيل؛ ونصُّ الحالة يختلف عن نص التشكيل. صحيح أن كل نص عظيم هو نص تشكيلي بامتياز، ولكن نص الحالة الصوفية نص أذواق ومواجيد وأحوال ومشاهدات ومغامرات، أكثر من كونه نص ثقافة وتشكيل وأنظمة. إن النص الصوفي معانقة حية للسر المطلق، ومشاركة مباشرة للأصل الأنطولوجي للوجود. ومن ثَمَّ فإن ذلك التوجه على مستوى الإبداع النصي يستتبعه بالضرورة الخروج الحتمي على المواضعات اللغوية والاصطلاحات البشرية السائدة، والدخول في كونية روحية غامرة؛ فالحالات الشعرية الصوفية تومض ومضًا، وتتلامح وجدًا، وتترامز شوقًا ولهفًا؛ “فبين النطق والصمت برزخ فيه قبر العقل وفيه قبور الأشياء.”
التصوف وشعر البعث والمهجر
ولقد امتد تأثير الروح الصوفي الخلاق إلى كل مظاهر الفنون المعاصرة شرقًا وغربًا، ولم تخلُ مدرسة فنية ولا مذهب جمالي من الروح الصوفي؛ فنجد ذلك لدى شوقي في صوفياته وإسلامياته خاصة (نهج البردة)، كما نجد ذلك لدى شعراء الديوان؛ لدى شكري الذي شيد أشكالًا جمالية روحية صوفية باذخة، ثم لدى مدرسة أبوللو لدى أحمد زكي أبو شادي خاصة في قصائده العظيمة المبتكرة التي قرن فيها بين الروح العلمي الخلاق والروح الصوفي المبدع في قصائده العلمية، كما نجد ذلك لدى محمود حسن إسماعيل في قصائده الخصيبة عن النور خاصة في دواوينه المتأخرة مثل: (هدير البرزخ) و(هتك البراقع) و(موسيقى من السر).
أما مدرسة المهجر فقد شكلت فضاءات جمالية ومعرفية باذخة من العوالم الصوفية الشعرية الرائعة، خاصة جبران الذي كان حالة جمالية صوفية نادرة في الشعرية العربية؛ فقد كان ملتقى توجهات روحية وميتافيزيقية متعددة. وربما دفعه تحرره العقدي والسياسي إلى اغتراب روحي عظيم، أدى به إلى انتماء صوفي إنساني كوني تذوب فيه الحدود والثقافات والعقائد والعصبيات والقوميات، حيث ينطلق الروح الصوفي صوب المطلق الذي يشمل الموجودات والثقافات والروحانيات في أبد كوني وسيع. كذلك نجد تلك العوالم الصوفية البديعة لدى ميخائيل نعيمة، حيث هذا القران الجمالي البديع بين الله والإنسان والطبيعة. ونجد تلك الملامح الصوفية نفسها لدى إيليا أبي ماضي والشاعر القروي وأمين الريحاني ونسيب عريضة وإلياس فرحات ونعمة قازان، ورياض وشفيق المعلوف، والشاعر إلياس قنصل.
التصوف والشعر الحر
وإذا انتقلنا إلى الشعر العربي المعاصر لدى مدرسة الشعر الحر؛ وجدنا رموزًا وأقنعة وعوالم من الموروث الصوفي تكتنف الشعرية العربية من جميع جوانبها مشكلة تجلياتها ودلالاتها ومقاصدها. نجد التناص الصوفي يبلغ ذراه التشكيلية والمعرفية في تشكيل النص، سواء كان شخصية أو حقبة تاريخية بأكملها، أو قناعًا موضوعيًا أو توجهًا فكريًا ميتافيزيقيًا؛ فنجد الحلاج الصوفي وعذابه رمزًا وقناعًا وأسطورة يحتل مساحات واسعة في الشعر والدراما معًا: نجد رمز الحلاج لدى البياتي في ديوانه (سفر الفقر والثورة)، ونجده أيضًا في مسرحية الحلاج لدى عبد الصبور. وكلا الرمزين يمثل الثورة على السلطة الغاشمة بالمعنى الشامل: السلطة السياسية/ سلطة اللغة/ سلطة الوعي الديني الشائع/سلطة الخيال. كما نجد رموزًا وأقنعة صوفية أخرى مثل قناع شخصية (بشر الصوفي الحافي) لدى عبد الصبور التي تجسد فقدان الإنسان المعاصر لمعنى حياته وانقسامه على ذاته، وعدم توافقه مع الوجود من حوله، وغرقه في أشياء العالم وتحوله من الإنسانية للشيئية الاستهلاكية المهلكة؛ يقول بشر الصوفي على لسان عبد الصبور:
حين فقدنا الرضا
بما يريد القضا
لم تنزل الأمطارْ
لم تورق الأشجار
…
تظل حقيقة في القلب توجعه وتضنيه
ولو جفت بحار القول لم يبحر بها خاطرْ
ولم يَنشُر شراعَ الظن فوق مياهها ملاحْ
وذلك أن ما نلقاه لا نبغيه
وما نبغيه لا نلقاه
التصوف وعوالم السرد
فإذا انتقلنا إلى تأثيرات الروح الصوفي في عالم الرواية؛ وجدنا تلك العوالم الجمالية والمعرفية الفريدة في تناص النص الروائي مع النص الصوفي. ولنأخذ مثلا الكاتب الليبي إبراهيم الكوني الذي تفرَّد من بين الروائيين العرب –وخاصة في رواية التبر-بتمثل إبداعي عميق للمنظومة الصوفية. فالرواية لا تمتح من القاموس الصوفي بسذاجة أو تعمّد يجردها من قيمتها الأصلية أو الحالية بعد حلولها في النص الحديث. بل هو متح رهيف يشعرك -بعد الانتهاء من القراءة-أنك كنت بالفعل في حضرة نص صوفي أصيل. لكن الأمر لا يقتصر على مفردات اللغة الصوفية، بل نرى الحديث النبوي المحوري الذي يوجه مسار الأحداث في الرواية حديثًا بالغ الأهمية في منظومة ابن عربي، حيث نال على يده من التأويل ما أدرجه ضمن الأحاديث التي يولع بها المتصوفة بغض النظر عن إسنادها؛ أعني الحديث المسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: “حبب إلى من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة”. لكن هذا التناص يعد كذلك ملمحًا أوليًّا من ملامح البعد الصوفي في الرواية، أما الملمح الأغنى فيمكن تلمسه في البنية ذاتها.
يظهر تأثر الكوني بالمنظومة الصوفية في تمثله تجليات الجسد الصوفي في علاقة الرجل بالمرأة، حيث يكون الجسد جسرًا إلى الحق. لكن هذه العلاقة تتجاوز الجسد المادي لترتبط ارتباطًا وثيقًا بثنائية الحب واللذة، وهو يرجع هنا إلى ابن عربي في قوله: “والصورة أعظم مناسبة وأجلها وأكملها، فإنها زوج أي شفعت وجود الحق، كما كانت المرأة شفعت بوجودها الرجل فصيرته زوجًا. فظهرت الثلاثة: حق ورجل وامرأة، فحن الرجل إلى ربه الذي هو أصله حنين المرأة إليه. فحبب إليه ربُّه النساء، كما أحب الله من هو على صورته”ويرى ابن عربي أن المرأة وسيلة إلى معرفة الحق (الله)، وهنا يؤكد على قيمتها استنادًا إلى الحديث؛ فيقول: “فابتدأ بذكر النساء وأخّر الصلاة، وذلك لأن المرأة جزء من الرجل في أصل ظهور عينها، ومعرفة الإنسان بنفسه مقدمة على معرفته بربه، فإن معرفته بربه نتيجة عن معرفته بنفسه”. وهذا يعني أنه لابد من أن يعرف المرأة التي هي جزء من نفسه أولًا، ثم يعرف نفسه، وبهذا يكون قد عرف ربه.
ونرى ابن عربي -في تحليله للحديث النبوي-يميل إلى وجود بنية ثلاثية في الإيروتيكية الصوفية فهناك الرجل والمرأة وما ينتج من نكاحهما. ولكن تظل هناك الحقيقة الباطنة، أعني ما يُلتذ به على الحقيقة، وهو الحق. فالثالوث المشار إليه ليس سوى تمثيل للبنية السطحية للعلاقة، أما البنية العميقة فتتضمن غائبًا حاضرًا. ويمكن أن نجد هذه البنية المعقدة وقد غلفت عمل إبراهيم الكوني الروائي بأكمله، حيث نرى دائمًا سعيًا حثيثًا نحو الآخر، لكنه شوق -على الحقيقة-صوب الأصل.
هذا الأصل له تجليات متنوعة فهو مرة السدرة -في أسطورة الطوارق الذين ينتمي الكوني إليهم عِرقيًا-وهو مرة الصحراء ذاتها، وهو مرة الإلهة الوثنية “تانيت”القابعة في الصحراء، وهو مرة الجمال -أو الكمال-في المهري الأبلق، وهو مرة الله -بالمفهوم الصوفي الإسلامي-الذي يسعى أتباع الطريقة القادرية إلى قتل أنفسهم سعيًا إلى لقائه (لقاء القدر): “شيوخ الطريقة في غدامس يقولون إن كل شيء يعود إلى الأصل في النهاية. العشبة تنمو إلى رتمة والرتمة تزهر. والزهرة تتحول إلى ثمرة. والثمرة تعود بذرة وتسقط إلى الأرض. إذا كان اللون أبلق في الأصل فلا بد أن يعود مع الوقت إلى هيئته. اصبر ولا تخف”.
الأصل الذي أشرنا إليه سابقًا بتجلياته المتعددة الإلهة تانيت، الصحراء، الناقة …إلخ-هذا الأصل ثم حجاب يحجبه، وهو المرأة التي قال عنها أوخيد: “كيف أعمته المرأة؟ كيف أعمته المرأة إلى الحد الذي أعماه عن رؤية عمله البشع؟ نعم. هي. المرأة. لولاها لما تجاسر. لولاها لما سها عن الإيفاء بالنذر لـ”تانيت”. لولاها لما حلت اللعنة التي أعمته عن رؤية فعله. لولاها لما جاء الولد إلى الدنيا. الولد الذي يجيء كي يطوق عنق الوالد ويديه ورجليه بقيد أقوى من الحديد. لا يطوق أطرافه فقط وإنما يشد عقله ويحجب قلبه. الأبناء حجاب الآباء. الأبناء فناء الآباء”.
هذا يتفق تمامًا مع الرؤية الصوفية الإيروتيكية التي رأيناها عند ابن عربي. إنه يرتبط بالأبلق -الأصل: مثال الجمال-برباط وثيق هو رباط الدم، فكأنهما صارا واحدًا “البلاء صنع منا مخلوقًا في اثنين”. الأبلق هذا هو من قال عنه الراعي إنه ليس سوى إنسان، ذلك أن الأبلق لم يطق صبرًا على بُعده عن “أوخيد”بعد أن رهنه الأخير لدى قريب زوجته. إن الاتحاد بينهما -أوخيد والأبلق-قديم، بل أزلي، كأنه علاقة النفخة الإنسانية بأصلها الروحي الإلهي: “مع فيض الألم تدفقت الذكريات، فرأى صداقتهما في الزمان الأول، قبل أن يولدا، قبل أن يكونا نطفتين في رحم الأمهات. قبل أن يكونا خاطرًا، عاطفة في قلوب الآباء. قبل أن يكونا رغبة تسيطر على الجسد. قبل أن يكونا هباءً في الفضاء الأبدي. عندما كانا صوتًا للريح. صدى لأغنية، نواح “امزاد”بين أنامل حسناء، زغرودة حورية في الفردوس. نعم. زغرودة إلهية لحورية رحيمة في ظلمة البئر … إن النبل هو الحرية، هو الإخلاص لرفيق عرفه في الفناء وعبر به ملكوت الصحراء طوال هذه السنوات. والنبل هو الذي يحتم عليه أن يضحي بالوهق واللعبة والوهم ويختار الأبلق ليواصل معه الرحلة في ملكوت الخلاء”.
ويؤكد هذه العلاقة الأصلية في موضع آخر: “الأبلق الآن له، وهو للأبلق. لن يفرقهما إلا الفناء. بل حتى الفناء لن يفرقهما. سوف يذهبان معًا. سيعودان إلى أصلهما معًا، كما كانا قبل أن يولدا”.
إن مصيرَيْ أوخيد والأبلق مرتبطان. الأبلق يتم إخصاؤه، ويفقد كل صلة بأنثاه، كذلك تؤخذ زوجة أوخيد منه غيلة. كلاهما يحيا رحلة ألم طويلة؛ يتقاسمان شقاءها. وأخيرًا ينتهيان معًا. إنهما وجهان لكيان واحد. ربما تبادر إلى ذهننا سؤال حول السبب في تمتع الإخصاء بهذا الثقل في الرواية. إن ذلك يرتبط بالرؤية الكلية للعمل الفني؛ فالإخصاء هنا سعى صوب الاكتمال أو لنقل الكمال، حيث لا يكون ثم احتياج للآخر، ويكون ثم انقطاع عن العالم، لتقفل الدائرة.
لقد كان “أوخيد”بحاجة إلى أن يتخلص من بدنه الذي يمثل سجنًا، حتى يستطيع العودة إلى الأصل “الإنسان رهين ما كسب كما هو سجين البدن”. وهو في هذه الرؤية يتفق كذلك مع الرؤية الصوفية التي ترى الجسد حجابًا مرحليًا، وهو ما يتمثل في أمرين: أولهما التدرج الروحي بدءًا بالزهد، وآخرهما التخلص من عناصر الجسد تخلصًا تصوريًا بالمعراج.
يتم التخلص من عناصر الجسد تخلصًا تصوريًا بالمعراج وذلك لطبيعة المعراج المعرفية، ذلك أن “الغاية من المعراج تتلخص في المعرفة، وتحديدًا في معرفة أصل الإنسان وتماثله مع بناء العالم.
ولنلاحظ أن الصحراء تتصف في “التبر”بصفات سبق أن وصف بها المرأة نفسها. “فكم هي عارية وكم هي خفية هذه الصحراء”. إن المرأة (الصحراء) تتجلى هنا بوصفها الصورة المقابلة للإنسان الكامل في الرؤية الصوفية. والعلاقة بين الحق والخلق علاقة جدلية يضفرها رمز المرآة. فالخلق مرآة الحق والحق مرآة الخلق.
وربما يحق لنا الآن أن نتساءل: هل كانت رحلة أوخيد -عبر الصحراء إذ يلاحق الأبلق في محاولة للإمساك به-نوعًا من المعراج؟ في هذه الرحلة ظلم أوخيد جسده، لكنه كان يستعين بكل طاقة فيه وبكل ما يحمل من أساطير مضادة للعار حتى يتمكن من اللحاق بالأبلق وعدم التفريط فيه، وقد انتهى الأمر بتوحدهما. إن هذه الرحلة تستدعي كل الميراث الصوفي من المعارج التي يتم التخلص فيها من عناصر الجسد من أجل تحقيق المعرفة. علينا ألا ننسى تلك الإشارة إلى “سدرة المنتهى”التي ألمح إليها الشيخ موسى، وهي في الأصل مقام رفيع في المعراج النبوي والصوفي. إن هذه الرحلة كما نرى نوع من المجاهدة الأصلية صوب التحقق الوجودي.
وعلى هذا النحو تسير الرواية في بنائها متناغمة مع الروح الصوفي، ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أننا لم نرصد كل تفصيلات التداخل بين الرواية والمنظومة الصوفية، مرجئين ذلك إلى سياق آخر. ولا يظنن ظان أننا نسعى هنا إلى عقد مشابهات أو التقاط ملامح تشابه متباعدة في كل من الرواية والرؤية الصوفية، ولكن الحدس يضعنا بالفعل في قلب الفرضية القائلة بهذا التشابه، ثم إن الدراسة العلمية المتأنية الفاحصة للنص والسياقات قد تثبت ذلك.
خاتمة
والحقيقة أن التجربة الصوفية واسعة خصيبة تنتشر بغزارة في عروق الفنون المعاصرة انتشارًا واسعًا وربما يحتاج هذا منا ومن غيرنا إلى متابعات نقدية متعددة تقرأ النصوص بمحبة تليق بها، وتعطيها ما تستحقه من مكابدة في التلقي والتأويل؛ لتكشف أسرارها وتستقبل على مرآة القلب ما تمنحه النصوص من البشارات والفتوحات والتجليات.
___________________________
*نقلًا عن “مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية”.